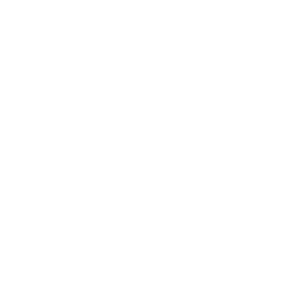مقدمة
وسواس التحقق (Checking OCD) هو أحد أبرز صور الوسواس القهري، ويتميّز بدافع قهري للتأكد المتكرر من أفعال أو نوايا أو حالات معرفية داخلية، بدافع الخوف من الخطأ أو الإثم أو الضرر. لكنّ هذا الاضطراب يتجاوز الأعراض الظاهرة ليكشف عن خلل بنيوي أعمق في طريقة التفكير، قوامه الشك غير المنطقي، والمثالية المعرفية، والمسؤولية الأخلاقية المطلقة. ويتجذر هذا النمط من التفكير غالبًا — بوعي أو بدون وعي — في تبنٍّ لمبادئ الداخلانية المعرفية، حيث يُشترط اليقين الداخلي الواعي لإقرار أي اعتقاد أو اطمئنان نفسي.
أقدم هنا تحليلًا لوسواس التحقق بوصفه نموذجًا للداخلانية المرضية، ثم أعرض الأسس النفسية والفلسفية للعلاج المعرفي السلوكي (ERP) بوصفه استجابة معرفية خارجانية مرنة تكسر الحلقة القهرية.
أولًا: وسواس التحقق كاضطراب معرفي شكوكي
1.1 التعريف المعرفي النفسي
وسواس التحقق هو نوع فرعي من اضطراب الوسواس القهري، يُجبر فيه الفرد على التحقق مرارًا من أشياء مثل إغلاق الأبواب، أداء الصلاة، أو حتى صحة معتقداته، نتيجة خوف داخلي من التسبب في ضرر أو الوقوع في الخطأ. يشك الفرد في قدرته على التمييز، ويتعامل مع الأفكار العابرة وكأنها أخطاء أخلاقية أو مؤشرات فساد داخلي.
“الوسواسيّ لا يتسامح مع الأفكار عابرة، بل يحاكم نفسه على كل ما يخطر بباله ويعامله كخطر حقيقي”.
1.2 أعراض وسواس التحقق
1. الشك المزمن وعدم اليقين، شعور دائم بعدم التأكد من إغلاق الباب، إطفاء الغاز، قفل السيارة، إلخ، حتى بعد التحقق، يبقى الشعور بعدم اليقين والقلق مستمرًا حتى لو زال لفترة قصيرة، هذا يحدث عند المريض تنافر معرفي بين شعوره بتهويل الشك وزيادته عن حده الطبيعي وحالته المعرفية التي ترى سخافة ما هو عليه بالذات بعد انتهاء نوبة القلق المصاحبة.
2. التحقق القهري والمتكرر، فحص الشيء ذاته مرات متكررة (مثلاً: الباب 10 مرات أو أكثر)، الشخص يدرك أن التحقق مفرط، لكنه لا يستطيع التوقف.
3. الخوف من التسبب في أذى، الخوف من أن يؤدي الإهمال إلى كارثة (حريق، سرقة، إيذاء أحدهم)، الشعور بالمسؤولية المفرطة عن سلامة الآخرين.
4. طقوس ذهنية ترافق التحقق، التفكير في “كلمات توكيدية” أو “أدعية” عند التحقق لإزالة القلق، العدّ بصمت أو تكرار خطوات معينة أثناء التحقق.
5. القلق الشديد عند محاولة التوقف عن التحقق الشعور بالذنب أو التوتر الحاد إذا لم يتم التحقق، وقد يشعر أنه سيكون كافرًا أو شاكًا بدينه إن لم يجادل وساوسه بقوة أو الحاجة للعودة من مكان بعيد فقط للتأكد من أمر بسيط.
6. تعطيل الحياة اليومية، التأخر عن العمل أو المناسبات بسبب طقوس التحقق، أو ربما ترك أعمال هامة خوفًا من تكرر الوساوس بسببها، مثل ترك الصلاة مخافة الوساوس، أو ترك قراءة القرآن، أو صعوبة إنهاء الأعمال المنزلية أو مغادرة المنزل.
7. طلب الطمأنينة المستمر، سؤال الآخرين مرارًا: “هل أغلقت الباب؟ هل أنت متأكد؟، هل جوابي عن هذه المسألة مقنع (حتى لو كان يعلم أنه مقنع له) باختصار: البحث عن تأكيد خارجي رغم إدراكه بعدم الحاجة لذلك.
8. ضعف الثقة بالذاكرة أو الإدراك، شعور بأن الشخص لا يستطيع الاعتماد على ذاكرته أو اقتناعه الشخصي وعقله وموازنته للأمور مهما كانت المسألة ظاهرة الأدلة أو صحيحة بالنسبة له، التأكد مرارًا لأنه “ربما لم يلاحظ أو يتذكر جيدًا”.
1.3 الأساس الفلسفي للوسواس: الداخلانية وتضخم التبرير
تقوم الداخلانية في نظرية المعرفة على مبدأ أن تبرير أي اعتقاد يتطلب امتلاك الشخص لأسباب داخلية واعية، يمكنه التأمل فيها واستحضارها عند الحاجة. ورغم أن هذا المفهوم فلسفي تنظيري، فإن مريض الوسواس القهري، وخصوصًا المصاب بوسواس التحقق، يمارس هذا المبدأ بشكل غير واعٍ في حياته اليومية.
فبدلًا من أن يكتفي بالأدلة الحسية أو الملاحظة الخارجية (مثل رؤية الباب مغلقًا) أو الثقة بالذاكرة أو الحكم العقلي السابق الذي احتفظت الذاكرة بصلاحية أدلته بغض النظر عن حضورها الواعي الآني، يُجبر نفسه على طلب تأكيد داخلي دائم وحاسم. يتحول التبرير لديه إلى سلسلة لا تنتهي من التأملات والشكوك الداخلية، ما يُعرف بـ”تضخم التبرير”، فيصبح غير قادر على الاطمئنان دون أن يصل إلى يقين داخلي مطلق، رغم عدم وجود دليل خارجي يُثبت خطأه.
هذا الشكل اللاواعي من الداخلانية يفسر طبيعة وسواس التحقق باعتباره اضطرابًا معرفيًا عميقًا، حيث تتحول العملية المعرفية الطبيعية إلى دوامة قهرية لا تنتهي من التأمل الذاتي، تعيق الوظائف المعرفية وتولد قلقًا مستمرًا.
| الاعتقاد الوسواسي | الجذر الداخلاني (غير الواعي عند المريض) |
|---|---|
| لا بد أن أكون أشعر ببرد اليقين داخليًا 100% | اليقين الداخلي الصارم شرط ضروري للمعرفة (حسب الداخلانية). |
| الشك في الذاكرة والاقتناع السابق بلا تغير في المعطيات. | يجب أن تكون المبررات حاضرة في الوعي حال استحضار الفكرة وإلا فلا قيمة لها معرفيّا. |
| وجود شعور بالشك أو القلق تجاه شيء يعني أنني بالفعل أعاني من مشكلة حقيقية تجاهه وقد ألام عليها. | الإنسان مسؤول تمامًا عن تكوين قناعاته بشكل إرادي (التهوين من المكون الفطري – الطبيعي التلقائي في نشأة المعتقدات). |
ثانيًا: الأسباب النفسية والدماغية لوسواس التحقق
تُظهر الأبحاث النفسية أن المصابين بوسواس التحقق يعانون من:
- تضخيم المسؤولية الأخلاقية عن الأفكار والمشاعر (Holaway et al., 2006).
- ضعف في تحمل الشعور بعدم اليقين.
- تنشيط مفرط في القشرة الجبهية القاعدية المرتبطة بالتكرار والتحكم المعرفي (Stern et al., 2013).
- مثالية معرفية صارمة تُحوّل أي احتمال صغير إلى تهديد كبير ومعايير غير سويّة في المعرفة (Simply Psychology, 2023).
هذا التكوين المعرفي المرضي يجعل أي خطأ ممكن — مهما كان نادرًا — مدعاة لفقدان الثقة الكامل، وينتج حالة من العقلانية الأخلاقية السامة التي ترى في “الخاطرة الداخلية” وحدها دليلاً على الخلل.
ثالثًا: التمييز بين الشك المعرفي السليم والشك الوسواسي
الشك المعرفي السليم هو حالة عقلية مقبولة تُحفز التحقق عند وجود أسباب منطقية واضحة، ويُمارَس بإرادة ورضى، ويتحمل صاحبه مسؤولية تبنيه باعتباره شكًا اختياريًا نابعًا من تفكيره الحر، لا من قهر داخلي.
أما الشك الوسواسي فهو شك متكرر غير عقلاني، يظهر رغم وضوح الأدلة، ويُصاحَب بفقدان التناسب بين الشك والواقع، وغياب لحظة “الاطمئنان المعرفي”، ويُنتَج عادةً عن قلق داخلي، لا عن سبب موضوعي.
ويمكن التمييز بين أنواع الشك والوسوسة بحسب ثلاث علامات رئيسية:
الإرادة، الرضى، والمسؤولية:
-
الوسوسة العارضة: فكرة طارئة خارجة عن الإرادة، لا يُرضى عنها، ولا يُحمَّل صاحبها مسؤوليةً، وغالبًا تُرفض فورًا دون جدال داخلي.
-
الوسواس القهري: تكرار قهري مزعج، يظهر رغم كراهية المصاب للفكرة ومقاومته لها، ولا يتحمل مسؤوليتها، بل يعيش صراعًا نفسيًا مرهقًا معها.
-
الشك الإرادي: شك نابع من تفكير حر، يصاغ ويُقبل بإرادة، ويُعامَل كجزء من هوية صاحبه المعرفية، وبالتالي يُحمَّل مسؤوليته الكاملة.
التمييز بين هذه الأنواع أمر جوهري، لأن الوسواس القهري — على خلاف الشك المعرفي السليم — لا يسعى للبحث عن الحقيقة، بل للطمأنة، ويستخدم الفكر كأداة دفاع نفسي، لا كوسيلة استدلال معرفي.
رابعًا: العلاج المعرفي السلوكي (ERP) كاستجابة معرفية
4.1 التعريف
ERP (التعرض ومنع الاستجابة) هو نموذج علاجي يتضمن تعريض المريض للمثيرات القهرية (مثل فكرة عدم غلق الباب أو الشبهة العقدية)، مع الامتناع الواعي عن التحقق. بمرور الوقت، يتعلم الدماغ أن احتمال الضرر ضئيل وأن القلق يزول دون الحاجة إلى التحقق، مما يعيد التوازن بين الخطر الحقيقي والتفكير المعرفي.
جدول خطوات التعرض ومنع الاستجابة
| الخطوة | الوصف التفصيلي |
|---|---|
| 1. التعرض | لا تُثِر الفكرة عمدًا، بل اسمح لها بالظهور طبيعيًا عند مواجهة المثيرات الحياتية دون تجنّب. لا تقمع الفكرة، بل استقبلها، ولا تتفاعل معها لا سلبيًا (بترك شيء)، ولا إيجابيًا (بفعل شيء لتخفيفها). التعرض هو تعايش مع الفكرة/الشعور، لا نقاش عقلي معها. |
| 2. إعادة التسمية والتصنيف | حين تظهر الفكرة الوسواسية، قم بتسميتها بدقة (مثل: “هذه مجرد فكرة وسواسية” أو “هذه رغبة تحقق قهرية”)، وضعها ضمن إطارها الصحيح كعرض من أعراض الوسواس. هذه التسمية ليست لفظية، بمعنى أنه لا داعي للتلفظ بعبارة توكيدية كل مرة تخطر الفكرة على بالك لتأكيد هذا، بل يكفي الوعي بذلك والبدء بباقي الخطوات التالية. |
| 3. عدم الاستجابة | امتنع تمامًا عن أداء الفعل القهري أو طقوس التحقق، وامتنع أيضًا عن أي سلوك بديل يبدو غير مؤذٍ لكنه يعيد الطمأنة (مثل التفكير في “أنا متأكد” أو تصورات التطمين). |
| 4. إعادة ضبط التركيز | وجّه انتباهك إلى اللحظة الحاضرة عبر الحواس الخمس أو المهمة الحالية، دون محاولة طرد الفكرة أو الانشغال بها، بل بتعزيز الحضور الواعي لما تفعله. |
| 5. عدم التحقق من الشعور | لا تبحث داخليًا عن “شعور يقين” أو “ارتياح داخلي مؤقت”. لا تختبر نفسك عاطفيًا أو معرفيًا (“هل أشعر أنني متأكد الآن؟”)، لأن ذلك يعيد دورة الوسواس بشكل خفي، ولا تتحقق بعد قليل هل مازال الوسواس أم لا. |
“الامتناع المتعمد عن التحقق، رغم القلق، هو ما يُعيد تدريب الجهاز المعرفي على الثقة بالعمليات الإدراكية الطبيعية.”
والامتناع عن التحقق هو ما حثت عليه الشريعة الإسلامية وما يطلق عليه العلماء “دفع الوسواس”، نقل الإمام حرب الكرماني في مسائله الاعتقادية:
سمعت إسحاق بن راهوية يقول في حديث النبي ﷺ وأصحابه والتابعين في الوسوسة : «إنه محض الإيمان، – . أو صریح الإيمان قال إسحاق : إذا نفى الوسوسة عن نفسه، فنفيه محض الإيمان، ليس الوسوسة محض الإيمان؛ ولكن نفيه، فأما الوسوسة إذا وقع في القلب فلم ينفه فهو الهلاك.قال: وأما ما روي عن أصحاب النبي ﷺ : أنهم كانوا إذا فقدوا الوسوسة عدوه نقضا، فليس أن يكونوا عدوا فقد الوسوسة نقصا ولكن كانوا إذا أصابهم ذلك نفوها عن أنفسهم، فإذا لم يصبهم ذلك عدوه نقصا؛ لأن نفي ذلك عندهم فضيلة. أو كما قال.
الهدف الأساسي من العلاج هو تفكيك الدورة المؤكدة على أن هذا النوع من الوساوس والخواطر هو خطر حقيقي، وأن هذا النمط من السلوك الدفاعي هو صحي ومفيد، ترسيخ عدم أهمية ولا فائدة هذا كله يكسر هذه الدائرة، نعم في البداية ستعاني من ضغط كبير، بل أكبر حتى من الضغط قبل العلاج لأن عقلك مصمم على إجبارك على التعامل مع الخطر، لكن مع الوقت سيتم برمجته على أن هذا ليس بخطر أصلًا بالتدريج وهذا المطلوب.
4.3 الجانب الإبستمولوجي للعلاج
يُعتبر العلاج بالتعرّض ومنع الاستجابة (ERP) أكثر من مجرد تقنية سلوكية؛ بل هو تجسيد عملي لاتجاه معرفي خارجاني يرى أن الاعتقاد المعقول لا يحتاج دائمًا إلى مبررات داخلية واعية أو تأملات عقلية لا تنتهي. من خلال ERP، يتعلّم المريض أن يبني يقينه على الإدراك الحسي الطبيعي—كأن يرى أن الباب مغلق، أو يسمع صوت القفل، أو يتذكّر تمامًا أنه فعل ما يجب—ثم يكتفي بذلك. لا حاجة للعودة إلى الداخل بحثًا عن شعور “الاطمئنان”، أو لإعادة فحص الفكرة بحثًا عن حجة عقلية مطمئنة.
في هذا الإطار، يُعاد الاعتبار للذاكرة كأداة معرفية موثوقة، لا بوصفها محلًا للتفتيش والتشكيك، بل كجزء من البناء الطبيعي للاعتقاد. فالمريض يتدرّب على الثقة بما تتيحه الذاكرة من معرفة مباشرة (سواء الذاكرة السلوكية التلقائية المتعلقة بالعادات، أو الذاكرة المعرفية المتعلقة بـ (أنا كنت أعرف كذا، أو كنت متأكد من كذا، أو كان لدي أدلة كافية للاقتناع بكذا حين اقتنعت به) دون أن ينغلق في سلسلة لا تنتهي من إعادة التحقق حول دقة التذكّر أو احتمالات الخطأ، لأن الوسواس يلعب على إضعاف الذاكرة والتشكيك في كفاءة العقل سابقًا حتى لو لم تستجد أي معرفة جديدة مؤثرة في الحكم السابق، فلا هو الذي يسمح لك بالثقة بالعقل، ولا هو الذي يجعلك تتخلى عن إعادة التحقق باستخدامه، بل ربما يصل بك الحال للاستعانة بعقول الآخرين للتحقق من الشيء وكأن عقلك نفسه غير كافي، ولا يخفى مافي ذلك من دور قبلي.
إن هذا التحول من الداخلانية المفرطة إلى الثقة بالحس والذاكرة يمثل جزءًا عميقًا من نجاح العلاج؛ إذ يُنقل مركز الثقل المعرفي من “ما أشعر به تجاه ما أعرف” إلى “ما أعرفه كما هو”، دون وسيط تأويلي مستمر أو اختبار دائم لصلاحية المعرفة. Essays on the Intellectual Powers of Man، Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense.
خامسًا: إصلاح البنية المعرفية: من الداخلانية المفرطة إلى الإدراك الطبيعي
العلاج الحقيقي لا يكتفي بكسر الطقوس القهرية، بل يهدف إلى تفكيك الافتراضات العقلية المغلوطة التي تديم الوسواس، مثل:
- “كل ما يمكن أن يحدث يجب التحوط له”.
- “أنا مسؤول عن كل شعور أو فكرة تخطر على بالي”.
- “إذا شعرت بشك، فهو حقيقي وانعكاس فعلي لحالتي المعرفية”.
هذه القواعد ليست منطقية، بل مدمرة، وتفترض قدرة عقلية خارقة على التحكم بالمستقبل والنية، ما لا يمكن تحقيقه واقعيًا. إعادة البناء المعرفي يتطلب قبول الفجوة بين الإدراك واليقين التام، والتعامل مع المعرفة الوافعية كبناء احتمالي، لا كمرآة مطلقة للنقاء العقلي، بل حتى معالجة تصور النقاء العقلي على أنه التخلي عن الحسد البدهي والالتزام بتسلسل الأدلة النظرية وعدم الثقة بالحكم العقلي المباشر! (راجع مقال عن الضرورات ومغالطات الداخلانيين فيها).
وهناك الكثير من المغالطات الوسواسية العقلية والسلوكية التي تتبعها الباحثون ويمكن للطبيب النفسي أن ينبهك عليها وقد ذركنا هنا بعضها.
سادسًا: أسئلة متكررة:
سؤال العامل الغيبي: هل الوسواس القهري له علاقة بوسوسة الشيطان؟
يعتقد البعض أن جواب هذا السؤال له أهمية كبيرة في علاج الوسواس، لكن الحقيقة أنه من فضول العلم، فنعم قد ورد أن الشيطان يوسوس للعبد، لكن هذا حاصل للجميع وليس بعض الناس دون بعض كما هو الحال في مرض الوسواس، وقد يقال أن مرضى الوسواس توافرت لهم من أسباب كثرة الوساوس ما ليس عند غيرهم، ولكن الله قد جعل لعلاجه أسبابًا شرعية وحسية، فالوسواس الديني مثلًا يعالج بالالتزام العادي بالعبادات دون تفريط ولا إفراط، ودون الالتفات للشكوك السلوكية أو المعرفية، فالانغماس في الممارسة يضعف من واقعية تأثير الوسواس كما ذكرنا ذلك في العلاج في مرحلة (إعادة التركيز).
ولا مانع من أن يشترك في مرض واحد أن يكون له أسباب غيبية وحسية في حصوله، وأسباب شرعية وحسية في زواله.
سؤال المساعدة: كيف أساعد كطالب علم، أو كفرد من أفراد العائلة؟
كطالب علم، إذا استشعرت أن السائل يعاني من أعراض الوسواس القهري، فيفترض عليك أن لا ترضخ لإلحاحه مهما بدا محتاجًا للإجابة، وأن تؤجل إجابته بكل الطرق، وإن أجبته لاحقًا تحيله لمادة تحتاج بعض التعب في التحصيل، وتطلب منه أن لا يتابعها إلا وهو خارج نوبة الوسواس والقلق وبحالة شعورية جيدة، ثم لاحقًا تقدم له جواب ملخص للمسألة إن لم يستطع هضم المادة لصعوبتها مثلًا وترشده للتعامل مع الوسواس بمعزل عن الانغماس في فروعه من هذا السؤال وذاك.
أما العائلة: فتكمن أهمية الأسرة في دعمه دون تعزيز سلوكياته القهرية، يجب أن تفهم العائلة طبيعة المرض، وتمتنع عن المشاركة في الطقوس أو تقديم الطمأنة المستمرة، لأنها تعزز الوسواس وتعيق العلاج. يُفضل استخدام عبارات داعمة دون الدخول في جدال منطقي، وتشجيعه على العلاج المعرفي السلوكي كتقنية التعرض ومنع الاستجابة (ERP). كما يجب وضع حدود واضحة بلطف، وتجنب اللوم أو السخرية، مع مراقبة التقدم دون ضغط. المشاركة في جلسات التوعية الأسرية مفيدة لفهم أساليب التعامل السليم وتقديم الدعم دون ضرر.
خاتمة
وسواس التحقق هو اضطراب شكوكي معرفي ناتج عن تداخل غير واعٍ بين الداخلانية الإبستمولوجية والمثالية الأخلاقية، حيث يُفترض أن كل خطأ محتمل يستحق قلقًا يقينيًا ورد فعل قهري. لكنّ العلاج الحقيقي لا يكمن في طمأنة المصاب، بل في تحريره من الحاجة إلى الطمأنة أصلًا، عبر تغيير طريقة تفكيره وتعامله مع المعرفة والشك والخطأ. من خلال ERP، والدعم المعرفي المصاحب له، يمكن للمصاب أن يستعيد ثقته بذاكرته، بإدراكه، وبالواقع نفسه.
المراجع
- BonJour, L. (1985). The Structure of Empirical Knowledge. Harvard University Press.
- BonJour, L. (2002). “Internalism and Externalism.” In The Oxford Handbook of Epistemology, edited by P. K. Moser, 215–236.
- Fumerton, R. (1995). Metaepistemology and Skepticism. Rowman & Littlefield.
- Haack, S. (1993). Evidence and Inquiry. Blackwell.
- Holaway, R. M., et al. (2006). “Intolerance of Uncertainty in OCD.” Journal of Anxiety Disorders, 20(4), 464–478. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2005.04.004
- Stern, E. R., et al. (2013). “Cognitive Control Deficits in OCD.” Biological Psychiatry, 73(5), 414–421. https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2012.09.019
- Simply Psychology. (2023). Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). https://www.simplypsychology.org/ocd-causes.html
- Simply Psychology. (2023). Checking OCD. https://www.simplypsychology.org/checking-ocd.html
- Haerle, P. H. (2023). “Is OCD Epistemically Irrational?” Philosophy, Psychiatry, and Psychology, 30(2), 133–146. https://doi.org/10.1353/ppp.2023.a899942
- Vazard, J. (2019). “OCD and Epistemic Anxiety.” Imperfect Cognitions. http://imperfectcognitions.blogspot.com/2019/02/ocd-and-epistemic-anxiety.html
- العلاقة بين نظرية المعرفة الداخلانية والوسواس القهري، الغيث الشامي.
https://srajarabic.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9/ - سلسلة قضايا معرفية، قناة سراج: https://www.youtube.com/playlist?list=PLv36DbX-QPt-rk0YrCPjBa0-taEQkdcvw