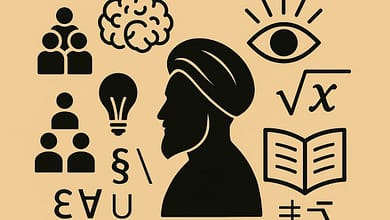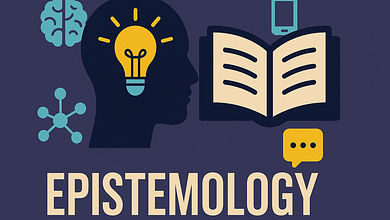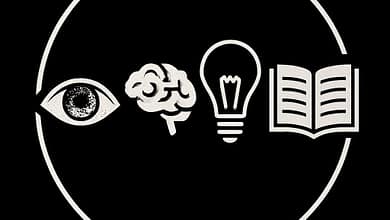لطالما مثّلت الداخلانية (Internalism) الاتجاه الغالب في نظرية المعرفة عبر قرون طويلة من الفكر الفلسفي واللاهوتي، حيث اعتُبر أن التبرير المعرفي لا بد أن يكون متاحًا للوعي، وقائمًا على دلائل داخلية يستطيع الفرد التأمل فيها وإدراكها. هذا النمط من التفكير، الذي يُعرف أيضًا بـ“الدليلية” (Evidentialism)، يُعيد إنتاج الإرث الديكارتي، بل يضرب بجذوره أعمق من ذلك.
ففي الفلسفة اليونانية، نجد أرسطو يربط العلم باليقين العقلي المؤسس على الحد والقياس المنطقي، ويمنح التبرير طابعًا صوريًا يُفترض فيه الانفصال عن الحس والممارسة اليومية. هذه الرؤية ستؤثر بعمق على علماء الكلام في التراث الإسلامي، الذين تبنّوا نظرية أرسطو في الوجود والمنطق، وجعلوا العقل – بوصفه قدرة تأملية – الحَكمَ الأعلى على العقائد والمعارف. وقد أُهمل في هذا التصور موقف الإنسان العادي، الذي يتعامل مع اللغة والتجربة بمرونة سياقية وعملية، وعدّه المتكلمون نوعًا من “التجسيم” أو التصور الحسي المرفوض، مما فاقم من الانفصال بين التفكير المعرفي والواقع الحي، وكان من أبرز من وجهوا نقدًا لاذعًا لهذا التصور هم أهل الحديث والأثر وتجد ذلك جليّا في كتابات ابن تيمية وابن القيم مثلًا.
ومع بداية العصر الحديث، بدأت الداخلانية تفقد مركزيتها. فقد جاء المنهج التجريبي ليضع الحواس والتجربة فوق التأمل العقلي، كما في أعمال بيكون، وهوبز، وهيوم. وتبع ذلك نقد المنطق القديم من قبل الفلاسفة التحليليين والعلماء، مما أضعف الثقة بالبنى الاستدلالية الصورية، وفتح الباب لتصورات معرفية ترتكز على الأداء والسياق والاستخدام.
في هذا السياق النقدي، تبلورت الخارجانية (Externalism) كموقف بديل، رافض لفكرة أن الوعي الداخلي هو مصدر التبرير، ومؤسس لنموذج معرفي يربط التبرير بالعالم، وبوظائف العقل، وبالممارسات الاجتماعية. وقد قدّم عدد من الفلاسفة المعاصرين طعونًا حاسمة في الداخلانية، نعرضها هنا ضمن عشرة محاور رئيسة، من خلال مواقف: توماس ريد، ألفن غولدمان، إرنست سوسا، ألفن بلانتينجا، هيلاري بوتنام، ولودفيغ فيتجنشتاين ومن التراث الإسلامي شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض النصوص السلفية السابقة له.
1. حجة التراجعية اللانهائية
من أبرز الحجج التي وُجهت إلى الداخلانية: هي حجة التراجعية اللانهائية (Infinite Regress Argument). تقوم الداخلانية على أن التبرير المعرفي يتطلب امتلاك الشخص لأسباب أو دلائل واعية تدعم معتقداته. لكن إذا كان كل مبرِّر يحتاج بدوره إلى مبرِّر آخر، فسنقع في سلسلة لا نهائية من المطالب التبريرية، ما يجعل الوصول إلى أي معرفة مبررة أمرًا مستحيلًا، أو يضطرنا إلى التوقف التعسفي عند نقطة دون تبرير أو التبرير بالشعور الضروري والثقة بالملكة المعرفية وليس بتبرير داخلي عقلي، وهو ما يناقض المبدأ الداخلاني نفسه.
استخدم بلانتينجا، وسوسا، وآلستون، حجة التراجعية اللانهائية لإبراز أن الداخلانية تقود إلى سلسلة لا تنتهي من التبريرات الواعية، مما يجعل التبرير المعرفي مستحيلًا أو غير عملي. وقد اعتُبرت هذه الحجة من أقوى الاعتراضات على شرط الوعي الداخلي الصارم في التبرير.
هذه الحجة تُظهر أن الداخلانية، بقدر ما تسعى إلى الصرامة العقلية، قد تؤدي إلى شلل معرفي ما لم يُعترف بوجود نقطة ابتداء مبرَّرة لا تحتاج إلى تبرير سابق، وهو ما تقدمه الخارجانية عبر الاعتماد على الأداء الموثوق والملكة السليمة بدلًا من التأمل اللانهائي.
وفي التراث الإسلامي قدم شيخ الإسلام ابن تيمية نقدًا مشابهًا لهذا السلوك الاستدلالي حيث قال:
“البرهان الذي ينال بالنظر فيه العلم لا بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطرية فإن كل علم ليس بضروري لا بد أن ينتهي إلى علم ضروري، إذ المقدمات النظرية لو أثبت بمقدمات نظرية دائماً لزم الدور القبلي، أو التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء.” (ابن تيمية درء التعارض: 3:309).
2. تفكيك التأمل النظري كمصدر حصري للتبرير
هاجم هؤلاء الفلاسفة افتراض أن المعرفة تتطلب وعيًا داخليًا بمبرراتها.
توماس ريد رفض هذه الفكرة مبكرًا في فلسفته حول “الحس المشترك” (Common Sense). فقد رأى أن ملكات الإنسان الطبيعية – كالحواس والذاكرة – تُنتج معرفة موثوقة دون حاجة إلى تأمل. الشك فيها لمجرد عجزنا عن تأمل أسبابها هو، عنده، ضرب من العبث الفلسفي.
ألفن غولدمان طوّر فكرة أن العمليات المعرفية لا تحتاج إلى تقييم داخلي كي تُنتج معرفة، بل يكفي أن تكون موثوقة في أدائها الفعلي. التأمل الذاتي ليس شرطًا في التبرير.
إرنست سوسا ميز بين “المعرفة الحيوانية” (Animal Knowledge) التي تكفي للمعرفة اليومية، و“المعرفة التأملية” (Reflective Knowledge) التي تتطلب مراجعة، معتبرًا أن الأولى – غير التأملية – ليست أدنى مرتبة في القيمة المعرفية دائمًا.
ألفن بلانتينجا رفض كذلك شرط الدليلية، مقترحًا أن بعض المعتقدات مبرّرة مبدئيًا (Properly Basic)، مثل الإيمان بوجود الآخرين أو وجود الله، لأنها ناتجة عن ملكات معرفية سليمة، لا عن حجج تأملية.
وفي التراث الإسلامي قدم شيخ الإسلام ابن تيمية نقدًا مشابهًا لهذا السلوك الاستدلالي حيث قال:
“وكثيرا ما يكون سبب العلم الحاصل في القلب غير الحجة الجدلية التي يناظر بها غيره فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطريق وأسباب قد لا يستحضرها ولا يحصيها ولو استحضرها لا توافقه عبارته على بيانها ومع هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك قد لا يعلم دليلا يدل به غيره إذا لم يكن ذلك الغير شاركه في سبب العلم، وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل إذا تصوره، فالدليل الذي يعلم به المناظر شيء، والحجة التي يحتج بها المناظر شيء آخر وكثيرا ما يتفقان كما يفترقان.” – شرح الأصبهانية.
3. الموثوقية والوظيفة السليمة كبديل للتبرير الداخلي
في مقابل التبرير الداخلاني، طرح الخارجانيون مفاهيم جديدة:
غولدمان رأى أن الاعتقاد مبرّر إذا صدر عن عملية معرفية موثوقة بطبيعتها، حتى دون وعي صاحبها بطريقة عملها.
بلانتينجا أعطى لهذا الأساس طابعًا بيولوجيًا ومعياريًا من خلال “نظرية الوظيفة السليمة” (Proper Function Theory): الاعتقاد يكون مبررًا إذا صدر عن ملكة تعمل في البيئة المناسبة ووفقًا لما صُممت له.
سوسا شبّه المعرفة بالمهارة: ليست مجرد صدفة ناجحة، بل إصابة عن جدارة (Aptness)، تنتج عن ملكة تعمل بكفاءة.
ريد أكد على الطبيعة التلقائية والموثوقة للملكات المعرفية، وهاجم منطق الشك الذي لا يتوقف حتى في مواجهة المعطى المباشر.
وفي التراث الإسلامي قدم شيخ الإسلام ابن تيمية نقدًا مشابهًا لهذا السلوك الاستدلالي حيث قال:
“جعل – الله – فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها، ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق، لم يكن النظر والاستدلال ولا الخطاب والكلام،” (ابن تيمية درء التعارض: 5:62)”.
4. دحض الداخلانية في اللغة والمعنى
الداخلانية تعتمد على أن المعنى ينبع من الذهن. هذا تم تقويضه من خلال تحليل اللغة:
هيلاري بوتنام في “تجربة الأرض التوأم” (Twin Earth) أثبت أن معنى الكلمات لا يتحدد فقط بما يدور في الذهن، بل بالعالم الخارجي. فالمعنى ليس في الرأس (Meaning ain’t in the head).
لودفيغ فيتجنشتاين، في “تحقيقات فلسفية”، هدم فكرة “اللغة الخاصة” (Private Language)، مؤكدًا أن المعنى يُولد من الممارسة داخل “ألعاب لغوية” (Language Games) اجتماعية، والمعرفة لا تُبنى إلا من خلال هذا الإطار الاستعمالي.
وفي التراث الإسلامي قدم شيخ الإسلام ابن تيمية نقدًا مشابهًا لهذا السلوك الاستدلالي حيث قال:
“فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. – كتاب الإيمان
“اللفظ المطلق من جميع القيود ؛ لا يوجد إلا مقدرا في الأذهان لا موجودا في الكلام المستعمل” – كتاب الإيمان
“إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا ؛ فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع.” – الإيمان الكبير
“« كَلَام النَّاس بَعضهم لبَعض فِي الْمُعَامَلَات والمراسلات والمصنفات وَغَيرهَا تجمعها كلهَا دلَالَة اللَّفْظ على قصد الْمُتَكَلّم وَمرَاده وَذَلِكَ متنوع بتنوع اللُّغَات والعادات وتختلف الدّلَالَة بالقرائن الحالية والمقالية ثمَّ إِنَّمَا يسْتَدلّ على مَقْصُود الرجل إِذا لم يعرف فَإِذا أمكن [الْعلم] بمقصوده يَقِينا لم يكن بِنَا حَاجَة إِلَى الشَّك لَكِن من الْأُمُور مَا لَا تقبل من قَائِله إِرَادَة تخَالف الظَّاهِر» – الإستقامة
وكلامه في المجاز والحقيقة وامتناع الكلام بلا سياق معروف بل إنه يقول إن جميع الكلمات والمعاني التي في الذهن تنتزع وتجرد من الخارج.
5. تفكيك الشكوك الداخلانية الراديكالية
بوتنام بيّن أن فرضيات الشك، مثل “الدماغ في وعاء”، غير معقولة لغويًا. فهي تتطلب قدرة على الإشارة إلى أشياء لا يمكن الإشارة إليها داخل هذا الفرض.
فيتجنشتاين، في كتابه “في اليقين” (On Certainty)، أكد أن المعرفة ترتكز على معتقدات أساسية لا نبررها، بل نعتمدها كإطار سابق على كل بحث أو شك، وهي ضرورية للغة والتفاهم والمعرفة.
الداخلاني لا يمكنه أن يقدم حجة منطقية لكي يثبت أنه ليس واهم في كل تجاربه الحسية، بينما الخارجاني لا يشترط هذه النوعية من الحجج بل يكفيه الشعور الضروري المبني على الثقة بالملكات المعرفية وهذه الثقة تكون مفعّلة بالممارسة الحياتية واللغة المشتركة.
وفي التراث الإسلامي قدم شيخ الإسلام ابن تيمية نقدًا مشابهًا لهذا السلوك الاستدلالي حيث قال:
“كثيرا من العلوم تكون ضرورة فطرية فإذا طلب المستدل ان يستدل عليها خفيت ووقع فيها شك إما لما في ذلك من تطويل المقدمات وإما لما في ذلك من خفائها وإما لما في ذلك من كلا الامرين والمستدل قد يعجز عن نظم دليل على ذلك إما لعجزه عن تصوره واما لعجزه عن التعبير عنه فإنه ليس كل ما تصوره الانسان أمكن كل أحد أن يعبر عنه باللسان وقد يعجز المستمع عن فهمه ذلك الدليل وان أمكن نظم الدليل وفهمه فقد يحصل العجز عن إزالة الشبهات المعارضة إما من هذا وإما من هذا وإما منهما وهذا يقع في التصورات أكثر مما يقع في التصديقات فكثير من الامور المعروفة إذا حدّت بحدود تميز بينها وبين المحدودات زادت خفاء بعد الوضوح لكونها أظهر عند العقل بدون ذلك الحد منها بذلك الحد”- درء تعارض العقل والنقل
6. السياق الاجتماعي للمعرفة والمعايير
المعرفة ليست فعلًا فردانيًا، بل نتاجًا لممارسات اجتماعية:
فيتجنشتاين أظهر أن استخدام المفاهيم المعرفية يتم في سياق قواعد وألعاب لغوية محددة، لا داخل عزلة عقلية.
بوتنام في “Reason, Truth and History”، ربط بين المعنى والمعرفة والسياق العلمي والاجتماعي الذي يتشكل فيه الاعتقاد. لا معنى مستقلًا أو تبريرًا منعزلًا عن هذا الإطار.
سوسا، في مفهوم “المعرفة التأملية”، دمج الأداء الفردي بالمعايير الجماعية، مؤكّدًا أن النقد والتقييم يحدث ضمن مجتمع معرفي ذي معايير.
وفي التراث الإسلامي قدم شيخ الإسلام ابن تيمية نقدًا مشابهًا لهذا السلوك الاستدلالي حيث قال:
“إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدا ؛ فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع . وأما إذا أطلق ؛ فهو لا يستعمل في الكلام مطلقا قط فلم يبق له حال إطلاق محض.”- الإيمان الكبير (ص: 56)
ويسبقه في ذلك الإمام الدارمي (قبل 200 هـ) رحمه الله حيث يقول:
« وإنما يصرف كل معنى إلى معنى الذي ينصرف إليه. ويحتمله في سياق القول، لا أن يجد الشيء اليسير في الفرط يجوز في المجاز بأقل المعاني وأبعدها عن العقول، فيعمد إلى أكثر معاني الأشياء وأغلبها فيصرف المشهورات منها إلى المغمورات المستحالات؛ يغالط بها الجهال، ويروج عليهم به الضلال. فيكون ذلك دليلا منه على الظنة والريبة، ومخالفة العامة.
والقرآن عربي مبين، تصرف معانيه إلى أشهر ما تعرفه العرب في لغاتها، وأعمها عندهم.» – [ النقض/١٥٦]
7. حجة الإنسان العادي
تفترض الداخلانية أن التبرير المعرفي لا يتحقق إلا لمن يملك وعيًا تأمليًا بالمبررات، ما يعني ضمنًا أن الفيلسوف وحده هو العارف، بينما يُترك الإنسان العادي – الذي لا ينشغل بالتأمل النظري – غارقًا في الجهل والتقليد. هذا التصور نبه إلى خطورته توماس ريد، الذي رأى أن الحس المشترك وملكاتنا الطبيعية تمنح معرفة موثوقة دون حاجة إلى حجج فلسفية، وأن التشكيك فيها نوع من العبث. كما أكد بلانتينجا أن المعتقدات الأساسية التي يؤمن بها الناس ببداهة، كالإيمان بالله أو بوجود الآخرين، مبررة لمجرد صدورها عن ملكات سليمة، لا عبر استدلال داخلي.
الخارجانية، بهذا المعنى، تُنصف التجربة المعرفية الفعلية للناس، وتعترف بشرعية المعرفة اليومية التي يمتلكها غير الفلاسفة.
وفي التراث الإسلامي اشتهر النزاع في إيمان المقلد حتى أن الجويني في مرحلة من حياته قال بكفر المقلد حيث قال في كتابه (الشامل في أصول الدين):
ولو انقضى من أول حال التكليف زمنٌ يسع النظر المؤدي إلى المعارف ولم ينظر مع ارتفاع الموانع ، واخترم بعد زمان الإمكان= فهو ملحق بالكفرة.
وقد وافقه على ذلك غيره من علماء الكلام، وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية من المتصدرين في نقدهم في هذا الباب، ولن أسوق الردود هنا لطولها ولكن الجانب المعرفي منها يتلخص في كون الإيمان فطري وأدلته حسية ظاهرة في الكون تحصل بسببها المعرفة في النفس المهيئة لتلك المعرفة بلا تكلف نظر واستدلال وربما لا يقدر العامي على صياغتها في دليل برهاني على شرط الفلاسفة، وأنقل بعضًا من كلامه:
“فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع، وحينئذ فالإقرار بوجود الصانع ومعرفته والإيمان به” – درء تعارض العقل والنقل (8/ 458)
“الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته”- مجموع الفتاوى: (6:73).
وبين أن الإنسان العادي لا يحتاج إلى الحد أو القياس في علومه:
فبين أن التصورات الأصل فيها أنها تنال من الحس لا من الحد وأنه قليل الفائدة صعب المنال، وأن التصديقات لا تحتاج إلى القياس بالضرورة بل قد تنال بغيره من الطرق بل أكثرها ينال بطرق فطرية، ولخص ذلك بقوله:
“وأيضا لا تجد أحدا من أهل الأرض حقق علما من العلوم وصار إماما فيه مستعينا بصناعة المنطق لا من العلوم الدينية ولا غيرها فالأطباء والحساب والكتاب ونحوهم يحققون ما يحققون من علومهم وصناعاتهم بغير صناعة المنطق .”
بخلاف الغزالي من المتكلمين حيث قال في المستصفى واصفًا المنطق:
“هي مقدمة العلوم كلها ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا”
وقد سبق إلى نقد ذلك السلف الكرام رضوان الله عليهم حيث رفضوا النزوع إلى الحدود والأقيسة المتكلفة (الكلامية) المنافرة لفطرة الرجل العادي (ككون الله في السماء فوق كل خلقه)، ورفضوا نزع الأهلية عن الاستخدام العادي للغة العرب في فهم الخطاب وشددوا على ضرورة فهم العربي للكلام الذي يكتسبه من الاستقراء والسليقة وأن للعربي العادي “المخاطب الأول” بالوحي فطرة تغنيه عن الاشتغال بعلم الكلام ليفهم مراد الله سبحانه من كلامه بخلاف من جرده عن سياقه وجعله تابعًا للنظر الآرسطي، فقد نقل الإمام البخاري في كتابه الجليل “خلق أفعال العباد” عن الإمام يزيد بن هارون (118 – 206هـ = 736 – 821م) أنه قال:
“«من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي”
8. حجة عدم إمكانية الوصول ونسيان الدليل
تشترط الداخلانية أن يكون التبرير المعرفي متاحًا وواعيًا لصاحب الاعتقاد، لكن هذا الشرط يصطدم بطبيعة المعرفة البشرية. فكثير من معرفتنا تتشكل دون وعي تأملي بالمبررات، كما في التعرف على وجه مألوف، أو فهم الكلام تلقائيًا، أو الوثوق بخبر مألوف سمعناه مرارًا.
وقد نبّه سوسا وغولدمان إلى أن هذه الحالات تدل على أن المعرفة لا تتطلب حضور المبرر ذهنيًا، بل يكفي أن تصدر عن عملية معرفية موثوقة وكفؤة. كما أن بعض المبررات تنشأ من استقراء ضمني طويل الأمد أو من تجربة حسية تراكمية لا يُدركها المرء بوصفها دليلًا منفصلًا، بل تغدو جزءًا من إدراكه الطبيعي للعالم.
تضيف “حجة نسيان الدليل” حرجًا إضافيًا: فلو استند الشخص إلى دليل مقنع ثم نسيه لاحقًا، فهل يفقد تبريره؟ الداخلانيون يقولون نعم، لكن هذا يناقض حدسنا بأن اعتقاده لا يزال مبررًا. وقد أشار بيرنارد وليامز إلى أن اشتراط الوعي بالمبررات يُفضي إلى التشكيك في جلّ معرفتنا، وهو ما تتجاوزه الخارجانية عبر ربط التبرير بأداء الملكات، لا بوعي الفرد.
وفي التراث الإسلامي قدم شيخ الإسلام ابن تيمية نقدًا مشابهًا لهذا السلوك الاستدلالي حيث قال:
“وكثيرا ما يكون سبب العلم الحاصل في القلب غير الحجة الجدلية التي يناظر بها غيره فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من المعلومات بطريق وأسباب قد لا يستحضرها ولا يحصيها ولو استحضرها لا توافقه عبارته على بيانها ومع هذا فإذا طلب منه بيان الدليل الدال على ذلك قد لا يعلم دليلا يدل به غيره إذا لم يكن ذلك الغير شاركه في سبب العلم، وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل إذا تصوره، فالدليل الذي يعلم به المناظر شيء، والحجة التي يحتج بها المناظر شيء آخر وكثيرا ما يتفقان كما يفترقان.” – شرح الأصبهانية.
بل لشدة مناقضة تصور الداخلانيين لطريقة الشخص العادي وحدسه بأنه يعرف ما يعرف، فإن شيخ الإسلام يشبه طريقة الداخلانيين الدليليين بالمصابين بالوسواس القهري حيث يقول:
“والإنسان قد يكون في قلبه معارف وإرادات، ولا يدري أنها في قلبه، فوجود الشيء في القلب شيء، والدراية به شيء آخر ; ولهذا يوجد الواحد من هؤلاء يطلب تحصيل ذلك في قلبه، وهو حاصل في قلبه، فتراه يتعب تعبا كثيرا لجهله، وهذا كالموسوس”– منهاج السنة النبوية (5/ 398)
9. حجة تفضيل الشك على العلم
الداخلانية، كما لاحظ عدد من الفلاسفة مثل توماس ريد وبلانتينجا، تضع معايير صارمة للمعرفة تجعل من الصعب الوفاء بها في الواقع، مما يؤدي إلى نتيجة غير مقصودة: ترجيح الشك على العلم. فبدلًا من قبول المعرفة الطبيعية المباشرة – كالثقة بالحواس أو الذاكرة – تطالب الداخلانية بمبررات تأملية وواعية لكل اعتقاد.
لكن هذا يؤدي إلى تعليق المعرفة، وإلى التشكيك في كل ما لا يمكن تقديم دليل واضح عليه، بما في ذلك أبسط المعارف اليومية. فتصبح الشكوك، لا المعرفة، هي الأصل. الخارجانيون يرون أن هذا ضرب من التشدد المعياري المقطوع عن الحياة، ويؤكدون أن الثقة العقلانية يمكن أن تُبنى على الوظيفة المعرفية السليمة والسياق العملي، دون الحاجة إلى مبررات تأملية لا يملكها سوى الفلاسفة.
نبه شيخ الإسلام على مثل ذلك حيث قال:
“تجدهم أعظم الناس شكا واضطرابا وأضعف الناس علما ويقينا وهذا أمر يجدونه في أنفسهم ويشهده الناس منهم وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا. وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والجدل ومن المعلوم: أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه منفعة وأحسن أحوال صاحبه: أن يكون بمنزلة العامي وإنما العلم في جواب السؤال. ولهذا تجد غالب حججهم تتكافأ إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر.” – مجموع الفتاوى (4/ 28)
ويقول:”فإذا كانت هذه حالُ حجَجِهم فأيُّ لغوٍ باطلٍ وحشوٍ يكونُ أعظم من هذا وكيف يليقُ بمثل هؤلاء أن يَعِيبوا 1 أهلَ الحديث والسُّنة الذين هم أعظمُ الناس علمًا ويقينًا وطمأنينةً وسكينة يَعْلَمُون ويَعْلَمُون أنهم يَعْلَمُون وهم بالحق يوقنون لا يشكُّون ولا يَمْتَرون؟!
فأما ما أوتيه علماءُ أهل الحديث وخواصُّهم من اليقين والمعرفة والهدى فأمرٌ يجلُّ عن الوصف ولكن عند عوامِّهم من اليقين والمعرفة والعلم النافع ما لم يحصُل منه شيءٌ لأئمَّة المتفلسفة المتكلمين وهذا ظاهرٌ مشهودٌ لكلِّ أحد.
غايةُ ما يقول أحدُهم إنهم جَزَموا بغير دليل وصمَّموا بغير حُجَّة وإنما معهم التقليد.
وهذا القدرُ قد يكون في كثيرٍ من العامَّة لكنَّ جزمَ العلمِ غيرُ جزم الهوى فالجازمُ بغير علمٍ يجدُ من نفسه أنه غيرُ عالمٍ بما جَزَم به والجازمُ بعلمٍ يجدُ من نفسه أنه عالم إذ كونُ الإنسان عالمًا وغير عالمٍ مثلُ كونه سامعًا ومبصرًا وغير سامعٍ ومبصرٍ فهو يعلمُ من نفسه ذلك مثلَ ما يعلمُ من نفسه كونَه محبًّا ومبغضًا ومريدًا وكارهًا ومسرورًا ومحزونًا ومنعَّمًا ومعذَّبًا وغير ذلك.
ومن شكَّ في كونه يَعْلَمُ مع كونه يَعْلَمُ فهو بمنزلة من جزَم بأنه عَلِمَ وهو لا يَعْلَم وذلك نظيرُ من شكَّ في كونه سَمِع ورأى أو جزَم بأنه سَمِع ورأى ما لم يَسْمَعْه ويَرَه.” – نقض المنطق د (ص: 45)
10. حجة الإدراك المتأخر (The Post-Hoc Justification Problem)
المضمون:
الداخلانيون يفترضون أن التبرير يجب أن يسبق الاعتقاد، وأن الفرد لا يُعد مبررًا إلا إذا توفرت له مبررات معرفية واعية قبل تكوين الاعتقاد. لكن في الواقع، كثير من المعتقدات الصحيحة يُكوّنها الإنسان أولًا، ثم يُقدّم لها مبررات لاحقة إذا سُئل أو احتاج لتفسيرها.
النقد:
هذا النمط من التفكير يظهر أن التبرير ليس دائمًا سابقًا على المعرفة، بل قد يكون لاحقًا لها. وهذا يقوّض أحد الشروط الأساسية للداخلانية، ويعزز أطروحات الخارجانية التي تركز على كيفية تولّد المعتقد – لا على ما إذا كان يمكن تأمله لاحقًا.
أبرز من أشار إليها:
ألفن غولدمان (ضمن نقده للشرط الداخلاني للوعي بالمبرر)، وبعض فلاسفة الإدراك الطبيعي والمعرفة الضمنية.
وفي التراث الإسلامي قدم شيخ الإسلام ابن تيمية نقدًا مشابهًا لهذا السلوك الاستدلالي حيث قال:
“كثير من المعارف، قد يكون في نفس الإنسان ضروريا وفطريا، وهو يطلب الدليل عليه ; لإعراضه عما في نفسه”
ويبين شيخ الإسلام أن مجرد المعرفة ليس هو نفسه القدرة على استحضارها على صياغتها في قالب جدلي، وقد يتطلب ذلك بعد الحصول عليها من باب إعلام الآخرين بها أو الرد على المخالف فيها.
خاتمة:
هكذا، تفككت الداخلانية لا عبر هجوم واحد بل من جبهات متعددة: نقد التأمل النظري، إسقاط شرط الوعي، هدم اللغة الخاصة، تبديد الشكوك الراديكالية، وربط المعرفة بالسياق الاجتماعي. وقد ساهم هؤلاء الفلاسفة في إعادة صياغة نظرية المعرفة لتكون أكثر قربًا من الواقع الإنساني، وأكثر احترامًا للملكات الطبيعية، والممارسات الحية، والبيئات الاجتماعية واللغوية التي تنشأ فيها المعرفة وتُمارس.
للتوسع راجع:
1. Goldman, Alvin. (1979). Epistemology and Cognition. Harvard University Press.
2. Goldman, Alvin. (1986). Knowledge in a Social World. Oxford University Press.
3. Putnam, Hilary. (1975). Mind, Language, and Reality: Philosophical Papers, Volume 2. Cambridge University Press.
4. Putnam, Hilary. (2002). The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays. Harvard University Press.
5. Sosa, Ernest. (2007). A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge. Oxford University Press.
6. Sosa, Ernest. (2010). Knowledge in Perspective: Selected Essays in Epistemology. Cambridge University Press.
7. Plantinga, Alvin. (2000). Warranted Christian Belief. Oxford University Press.
8. Plantinga, Alvin. (2002). Knowledge and Christian Belief. Eerdmans Publishing.
9. Reid, Thomas. (1785). An Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense. Edinburgh: Edinburgh University Press.
10. Wittgenstein, Ludwig. (1953). Philosophical Investigations. Blackwell Publishing.
11. Wittgenstein, Ludwig. (1969). On Certainty. Harper & Row.
12. Descartes, René. (1637). Discourse on the Method. (Trans. Ian Maclean, 1997). Oxford University Press.
13. Aristotle. (2002). Nicomachean Ethics. (Trans. W. D. Ross). Oxford University Press.
14. Al-Ghazali. (2000). The Incoherence of the Philosophers. (Trans. Michael E. Marmura). Brigham Young University Press.
15. Aquinas, Thomas. (1993). Summa Theologica. (Trans. Fathers of the English Dominican Province). Christian Classics.
16. الرد على المنطقيين، درء تعارض العقل، الرد على المنطقيين، شرح الأصبهانية، نقض المنطق.