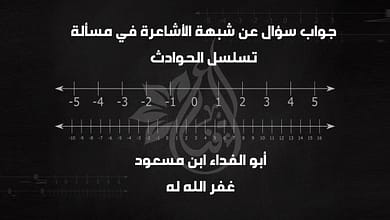مقدمة:
يُظهرُ التوافقُ البالغ بين نصوصِ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع متفرّقة، رغم تباين جهات التفصيل والسياق، عمقَ مقاصده واتّساق منهجه في النظر والاستدلال. فقد عُرف رحمه الله بكثرة التكرار والتفنّن في العبارة، مما يجعل اجتزاء كلامه أو اقتطاعه من بنيته الفكرية الكاملة آفةً خطيرة في القراءة المعاصرة لتراثه. وكثيرٌ من الدارسين اليوم يقعون في مزلقٍ منهجي حين يقتطعون نصوصًا له من سياقها، ثم يُسارعون إلى تحميلها ما يُتوهَّم من تناقضٍ أو تراجعٍ بلا بيّنةٍ رصينة. بل يتجاوز بعضهم ذلك إلى نسبة “موقفٍ جديد” إليه، بعد أن يُنزَع من تراثه الكلي، ويُعاد تفسيره بلسان خصومه، حتى يدخل على طلابه كما لو كان من قوله، فيغدو أشبه بحصان طروادة يُمرَّر من خلاله فكرٌ دخيل. ثم تُبنى على ذلك جبالٌ من اللوازم والتأويلات المتعسّفة التي تُحرف مراده وتطمس سياقاته الأصلية.
والمسألة التي نحن بصدد تناولها في هذا المقال تُعدّ من أبرز الأمثلة على هذا النمط من سوء الفهم والقراءة المبتورة لتراث شيخ الإسلام.
القول بأن الله لا تتعلق قدرته بالخلق عن عدم
فمن أَجْلى ما يمكن أن يوضّح مقصدي في المقدمة مسألةٌ بترتُها من نقاشه رحمه الله للمتكلّمين القائلين بعدم تعلّق قدرةِ الله بأن يخلق الجوهرَ من جوهر، وأنه لا بُدّ أن يكون الخلقُ عن عدم. وقد عقد في النبوات فصلًا طويلًا يناقش فيه مفهومَ المادّة والخلقَ منها عند المتكلّمين والفلاسفة، وحمل عليهم حملةً شديدة رحمه الله. وكعادته كان يستفصل، فيأخذ الحقَّ من الطرفين ويدع الباطل، فذكر قول الأشاعرة فقال:
“وهؤلاء، تحيّروا في خلق الشيء من مادة؛ كخلق الإنسان من النطفة، والحب من الحب، والشجرة من النواة، وظنّوا أنّ هذا لا يكون إلا مع بقاء أصل تلك المادّة؛ إمّا الجواهر عند قوم، وإمّا المادّة المشتركة عند قوم. وهم في الحقيقة يُنكرون أن يخلق الله شيئاً من شيء؛ فإنّه عندهم لم يُحدِث إلا الصورة التي هي عرض عند قوم” – النبوات لابن تيمية (1/ 312)
وقال:
“فهؤلاء عندهم لا يخرج جوهرا من جوهر، ولا عرضا من عرض؛ فلا يخرج حيا من ميت، ولا ميتا من حي، بل الجواهر التي كانت في الميت هي بعينها باقية كما كانت، ولكن أحدث فيها حياة لم تكن.”
وقال:
«وكذلك النطفة جواهرها باقية؛ إما الجواهر المنفردة، وإما المادة. والحادث هو عرض، أو صورة في مادة. ولا هذا، ولا هذا خلق من نطفة. وليس قولهم أنه لم يخلق من مادة، معناه أن الخالق أبدعه لا من شيء، وأنهم قصدوا بها تعظيم الخالق، بل الإنسان لا ريب أنه جوهر قائم بنفسه. وعندهم ذلك القائم بنفسه ما زال موجودا،» «النبوات لابن تيمية» (1/ 314)
ولاحِظْ كيف يجعلُ القدرةَ على الخلقِ عن عدمٍ من تعظيمِ الله، تمامًا كما قرّره في مسألة حدوث العالم، مع أنه يبيّن أن الخلقَ من مادة لا ينافي أصلًا إبداعَ الشيء بعد عدمه، بل فيه مزيدُ كمالٍ كقلبِ الحقائق فيقول: (وخلق الشيء من غير جنسه أبلغ في قدرة القادر الخالق).
ومثله في الدرء:
“لكن القائلون بإثبات الجوهر الفرد من المعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم يسمون هذا استدلالا بحدوث الصفات، بناء على أن هذه الحوادث المشهود حدوثها لم تحدث ذواتها، بل الجواهر والأجسام التي كانت موجودة قبل ذلك لم تزل من حين حدوثها بتقدير حوادثها، ولا تزال موجودة، وإنما تغيرت صفاتها بتقدير حدوثها كان تتغير صفات الجسم إذا تحرك بعد السكون، وكما تتغير ألوانه، وكما تتغير أشكاله.
وهذا مما ينكره عليهم جماهير العقلاء من المسلمين وغيرهم.
وحقيقة قول هؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم: أن الرب لم يزل معطلا لا يفعل شيئا، ولا يتكلم بمشيئته وقدرته ثم إنه أبدع جواهر من غير فعل يقوم به، وبعد ذلك ما بقي يخلق شيئا، بل إنما تحدث صفات تقوم بها، ويدعون أن هذا قول أهل الملل: الأنبياء وأتباعهم” – «درء تعارض العقل والنقل» (3/ 84)
وأن ما انتهى بهم إلى هذا القول هو قولهم: ( أن الرب لم يزل معطلا لا يفعل شيئا، ولا يتكلم بمشيئته وقدرته ثم إنه أبدع جواهر من غير فعل يقوم به، وبعد ذلك ما بقي يخلق شيئ) هذا تماما نظير قوله في النبوات:
“والذي يقول إن جنس الحوادث حدثت لا من شيء، هو كقولهم: إنها حدثت بلا سبب حادث“
وقوله في نفس الموضع:
“وهو بناء على قولهم: إنه تمتنع حوادث لا أول لها”
وكذلك قول بعضهم في تماثل حقائق الأجسام، يبين الشيخ ذلك في منهاج السنة النبوية (2/ 532):
“وينبني على هذا أن ما يحدثه الله من الحيوان والنبات والمعادن فإنها أعيان يخلقها الله تعالى على قول نفاة الجوهر الفرد، وعلى قول مثبتيه إنما يحدث أعراضا وصفات، وإلا فالجواهر باقية ولكن اختلف تركيبها، وينبني على ذلك الاستحالة.
فمثبتة الجوهر الفرد يقولون: لا تستحيل حقيقة إلى حقيقة أخرى، ولا تنقلب الأجناس، بل الجواهر يغير الله عز وجل تركيبها وهي باقية، والأكثرون يقولون باستحالة بعض الأجسام إلى بعض، وانقلاب جنس إلى جنس، وحقيقة إلى حقيقة، كما تنقلب النطفة إلى علقة، والعلقة إلى مضغة، والمضغة عظاما، وكما ينقلب الطين الذي خلق الله منه آدم لحما ودما وعظاما، وكما تنقلب المادة التي تخلق منها الفاكهة ثمرا ونحو ذلك، وهذا قول الفقهاء والأطباء وأكثر العقلاء.
وكذلك ينبني على هذا تماثل الأجسام، فأولئك يقولون: الأجسام مركبة من الجواهر، وهي متماثلة، فالأجسام متماثلة. والأكثرون يقولون: بل الأجسام مختلفة الحقائق، وليست حقيقة التراب حقيقة النار، ولا حقيقة النار حقيقة الهواء. وهذه المسائل مسائل عقلية لبسطها موضع آخر، والمقصود هنا بيان منشأ النزاع في مسمى الجسم.”
فيقول أن جزمهم بأنها حدثت لا من شيء هو بناء على أقوالهم هذه ويرد عليهم مرارًا في النبوات بأننا لا نشهد الحوادث إلا مخلوقة من مادة فيقول: “ولهذا لم يذكر الله قط أنه أحدث شيئا إلا من شيء.” ويقول: “وحقيقة قولهم [الجهمية]: أن الله لا يحدث شيئا من شيء؛ لا جوهرا، ولا عرضا؛ فإن الجواهر كلها أحدثت لا من شيء، والأعراض كذلك.”ثم يرد عليهم فيقول: “والمشهود المعلوم للناس إنما هو إحداثه لما يحدثه من غيره، لا إحداثا من غير مادة”
بل ويوظف مسألة أن الله لم يذكر إلا أنه خلق شيء من شيء ليرد على القائلين بأن الشرع يثبت أول مخلوق، فيبين أن قبل كل مخلوق تذكر النصوص أن قبله شيء وأنه خلق من شيء، وأن هذا أبلغ في العبودية فيقول في النبوات لابن تيمية (1/ 325):
“فكون الشيء مخلوقاً من مادّة وعنصر، أبلغ في العبودية من كونه خُلق لا من شيء، وأبعد عن مشابهة الربوبية؛ فإنّ الرب هو أحدٌ، صمدٌ، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد؛ فليس له أصل وجد منه، ولا فرع يحصل عنه.
فإذا كان المخلوق له أصلٌ وُجد منه، كان بمنزلة الولد له، وإذا خلق له شيء آخر، كان بمنزلة الوالد، وإذا كان والداً ومولوداً كان أبعد عن مشابهة الربوبية والصمدية؛ فإنه خرج من غيره، ويخرج منه غيره؛ لا سيما إذا كانت المادة التي خلق منها مهينة”
وقد قال مثله في «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» (ص114)
«روي من وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من المشركين من أهل الكتاب سألوه عن ربه ومعبوده الذي يدعو إليه مما هو؟ من ذهب أو فضة أو كذا أو كذا، وسموا ما سموا من أجناس الأجسام، فأنزل الله تعالى: {قل هو الله أحد} [الإخلاص/ 1]، وأنزل: {ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال} [الرعد/ 13]، وأصابته صاعقة فأذهبت بقحف رأسه.
فأهلك الله تعالى من سأل عن مجانسته المخلوقات. وهو من جنس سؤال فرعون {وما رب العالمين} [الشعراء/ 23]، فإنه لا يمكن أن يذكر أن الله تعالى أو شيئا من المخلوقات يشتركان في الحقيقة الجنسية، كاشتراك الإنسان وسائر الحيوان في الحيوانية، أو كاشتراك الحيوان والنبات في النمو والاغتذاء، ولا كاشتراك الأجسام النامية والجامدة فيما تتجانس فيه. ومن سأل عن ذلك فهو كمن سأل عن نسبه وقال: من أبوه ومن ابنه؟ولهذا أنزل الله تعالى سورة الإخلاص التي هي نسبته وصفته، فقال: {قل هو الله أحد (1) الله الصمد (2) لم يلد ولم يولد (3) ولم يكن له كفوا أحد}، فنزهه وقدسه عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال. وليس في المخلوقات شيء إلا ولا بد أن ينسب إلى بعض هذه من الأعيان والمعاني، فالحيوان من الآدمي وغيره لا بد أن يكون له إما والد وإما مولود وإما نظير هو كفؤه، وكذلك الجن والملائكة، ولهذا قال سبحانه: {ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون} [الذاريات/ 49]، قال بعض السلف: لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق الأزواج واحد.
وقال تعالى: {والشفع والوتر} [الفجر/ 3]، قال مجاهد: كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والأرض شفع، والوتر الله تعالى. وهذا هو الذي ذكره البخاري في صحيحه، فإنهم يعتمدون على تفسير مجاهد لأنه أصح التفسير، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وهذا القول اختيار جدي أبي البركات رحمه الله في هذه الآية.»
فعندما رد ابن تيمية على من قال بعجز الله عن خلق شيء من شيء بيّن أننا نشهد ذلك بالحس بل لا نشهد غيره ولا يذكر لنا غيره وأنه فيه حكم كثيرة وأن الدليل الذي لأجله يقولون بامتناع ذلك وهو امتناع حوادث لا أول لها يلزم منه ممتنعات كما بيننا آنفا
شبهة القوم من قوله: أننا لم نشهد إلا الخلق من مادة
أخذ الشيخ في رده على المتكلمين القائلين بامتناع الإستحالة وأن جنس الجواهر واحد ولها أول مسبوق بعدم جنس الحوادث كله يبين وقوع الخلق من شيء بل أننا لم نشهد ولم يذكر لنا إلا وقوعه، وأنه يتضمن الخلق عن عدم وزيادة وهو (قلب الحقائق الخارجية) ويبين حكمة الباري من ذلك.
بيان ابن تيمية للحكمة من عدم ذكر شيء لم يخلق من مادة:
يقول في النبوات:
“ولهذا لمّا خُلق المسيح من غير أب، وقعت به الشبهة لطائفة، وقالوا: إنّه ابن الله، مع أنّه لم يُخلق إلاَّ من مادّة أمّه، ومن الروح التي نُفخ فيها؛ كما قال تعالى: {وَمَرْيَمَ ابنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا} 5، [وقال تعالى أيضاً] 6: {فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرَاً سَوِيَّاً قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيَّاً قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ [لأَهَبَ] 7 لَكَ غُلامَاً زَكِيَّاً} 8؛ فما خلق من غير مادة [يكون] 9 كالأب له، قد يظن فيه أنّه ابن الله، وأنّ الله خلقه من ذاته.
فلهذا كانت الأنبياء مخلوقة من مادة لها أصول، ومنها فروع، لها والد ومولود. والأحد الصمد: لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.
وحدوث الشيء لا من مادة، قد يُشبه حدوثه من غير رب خالق، وقد يُظنّ أنّه حَدَثَ من ذات الرب؛ كما قيل مثل ذلك في المسيح، والملائكة أنّها بنات الله، لمّا لم يكن لها أب، مع أنّها مخلوقة من مادّة؛ كما ثبت في الصحيح؛ صحيح مسلم عن عائشة: أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: “خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم ممّا وُصف لكم”.
ولمّا ظنّ طائفة أنّها لم تُخلق من مادة، ظنّوا أنّها قديمة أزلية”
ولو كان الأمر واجبًا عقلًا لا تتعلق القدرة بخلافه فما الداعي لبيان الحكمة منه! والحكمة فرع المشيئة التي يجوز خلافها لكن الله خصها للحكمة التي لا تتحقق إلا بها، وبيان الحكمة من عدم حصول الممتنع لذاته كبيان حكمة الله من عدم جمعه بين النقيضين في الوجود!
فلو كان لا يقدر على الخلق إلا من مادة لما كان وجهًا لمدحه والثناء على حكمته من اختياره أن يخلق من مادة، وهذا نظير قول شيخ الإسلام في مسألة الثناء على الله لفعله العدل وتركه الظلم فيقول في منهاج السنة النبوية (5/ 104) :
“وكل أحد لا يفعل إلا ما يقدر عليه. فأي مدح في هذا مما يتميز به الرب سبحانه عن العالمين؟.
فعلم أن من الأمور الممكنة ما هو ظلم تنزه الله سبحانه عنه مع قدرته عليه، وبذلك يحمد ويثنى عليه ; فإن الحمد والثناء يقع بالأمور الاختيارية من فعل وترك”
بل ابن تيمية ينص على أن: “الحكمة تستلزم كونه قادرًا” ويقول: “ولهذا كانت الفلاسفة تثبت حكمته وعنايته، وإن كانوا لا يقولون بـ «القادر المختار»، وإن كانوا متناقضين في ذلك؛ لإثباتهم الملزوم دون لازمه”. – شرح الأصبهانية
ويقول في بيان تلبيس الجهمية (1/ 291):
“لكن لم نشهد تكون شيء إلا من شيء فهذا حق كما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز كما قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين”
بل ينص على ذلك صراحة في منهاج السنة النبوية (5/ 444) فيقول ما يوافق كل ما نقلناه من النبوات وبيان تلبيس الجهمية:
“فكان من حكمة الباري ورحمته أن أمطر مطرا أرضا بعيدة، ثم ساق ذلك الماء إلى أرض مصر.
فهذه الآيات يستدل بها على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته، وإثبات المادة التي خلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان مما يدل على حكمته .
ونحن لا نعرف شيئا قط خلق إلا من مادة، ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا من مادة” –
فلاحظ أن سياق الكلام عن الحكمة وهو نظير الكلام في النبوات تمامًا.
رد ابن تيمية على شبهة أننا لم نشهد ما يعلمنا قدرة الله على الخلق عن عدم:
رد الشيخ على تعجيز الفلاسفة لله على الخلق من عدم لكوننا لم نشهد ذلك في مسألة حدوث العالم (ص: 65) فقال:
“ومعلوم: أن عدم شهادة الحس لا تنفي ثبوت ما لم يشهده، ولو كان ما لم يشهده الإنسان بحسه ينفيه؛ لبطلت المعقولات والمسموعات”
بل واتهمه بالحماقة! فقال: “يقال له: يا أحمق؛ إذا جوّزت أن يكون مجموع العالم من غير مبدع ولا مادة؛ كيف يمتنع أن يكون بعضه من غير مادة مع كونه من صانع” -مسألة حدوث العالم (ص: 62)
بل هو يجعل الاستحالة والخلق من مادة فيه أصلا قدرة الله على خلق الشيء بعد عدمه وخلقه من مادة هو مزيد قدرة أصلًا! حين قال في النبوات: (وخلق الشيء من غير جنسه أبلغ في قدرة القادر الخالق) ويقول: “وهذا هو القدرة التي تبهر العقول؛ وهو أن يقلب حقائق الموجودات فيحيل الأول ويفنيه ويلاشيه، ويحدث شيئا آخر” ثم يبين تضمنها للخلق عن عدم وزيادة فيقول: النبوات لابن تيمية (1/ 317)
“والحقّ أنّ المادّة التي منها يُخلق الثاني تفسد، وتستحيل، وتتلاشى، ويُنشئ الله الثانيَ ويبتديه، ويخلق من غير أن يبقى من الأول شيء؛ لا مادة، ولا صورة، ولا جوهر، ولا عرض.”
وفي بيان تلبيس الجهمية (2/ 269) يقول:
“وأما الحيوانات والنباتات المشهودة فنفس هذه الذوات شهدنا حدوثها وخلقها، لكن خُلِقَت من شيء آخر ليس هو من جنسها ولا من حقيقتها، وهذا من أبدع الأمور وأعظمها؛ فلم يكن ما منه خُلقت هذه الأمور – وإن سماها بعض الناس مادة – مثل المواد المعروفة تكون بعينها باقية في الصور، أو تكون من جنس الصور. وإذا كان كذلك فقد شهدنا إبداع هذه الحقائق الموجودة وصفاتها بعد أن لم تكن موجودة”
ويقول: في نفس الموضع من بيان تلبيس الجهمية:
“وهذا الذي شهدناه من أبلغ الإبداع أنه يخلق من الشيء ما لا يكون مجانسًا له ولا يكون الأصل مشتملاً على ما فيه الفرع من الصفات فهذه الأمور المخلوقة التي لم تكن موجودة في أصلها ولا كامنة فيه هي مبدعة بعد العدم لا منقولة من وصف إلى وصف ولو كانت منقولة فنفس الصفات القائمة بها مبدعة بعد العدم فقد شهدنا إبداع الجواهر والأعراض بعد عدمها وهذا كاف في ذلك إذ لايجب أن نشهد إبداع كل جوهر وعرض بعد العدم بل إذا شهدنا إبداع ما شاء الله من الجواهر والأعراض بعد عدمها كان ذلك محسوسًا لنا ثم عقلنا بطريق الاعتبار والقياس ما لم نشهده وهكذا علمنا بجميع الأشياء نحس بعض أفرادها ونقيس ماغاب على ما شهدناه وإلا فلا يمكن أن يعلم الشخص بإحساسه كل شيء”
إلى أن قال:
“قوله (أي الرازي) أما حدوث الذوات ابتداءً فهذا شيء ماشاهدناه البتة ولايقضي بجوازه وهمنا ولا خيالنا فيقال له قولك لايقضي بجوازه وهمنا ولاخيالنا أن وهمنا وخيالنا يحيل ذلك ويمنعه أو تريد أنه لايعلم جوازه وأيما أردت فعنه جوابان أحدهما أن لا نسلم أن وهمنا وخيالنا يحيل ذلك ويمنعه لوجهين أحدهما أن الوهم والخيال لايمنع كل ما لم يعلم نظيره وإن قيل إنه لايدركه إلا أن يريد الوهم والخيال الفاسد فهذا لانزاع فيه الثاني أن الوهم والخيال قد أدرك نظير هذا كما قدمنا من تخيل ما أحسه من إبداع الجواهر وأعراضها بعد عدمها الجواب الثاني عن التقدير الأول أنا لو سلمنا أن وهمنا وخيالنا يحيل ذلك فليس محذورًا إذا علمنا جوازه بعقلنا وحسنا فإن أحدًا لم يقل إن كل ما أحاله مجرد التوهم والتخيل يكون ممتنعًا وإنما قيل ما أحالته الفطرة الإنسانية والبديهة والفرق بينهما ماتقدم وأما الجوابان على التقدير الثاني وهو أن الوهم والخيال لا يعلمان جواز ذلك فأحدهما أن لانسلم أن الوهم والخيال لايعلم جواز ذلك فإن الإنسان قد يتخيل ما أحسه بحواسه من الموجودات بعد عدمها وهو يؤلف بتخيل من ذلك ما لم يتخيله كما هو عادة التخيل فيتخيل نظير ذلك وما يركبه من ذلك مما ليس له نظير كما يتخيل جبل ياقوت وبحر زئبق فيتخيل من المخلوقات ما ليس له نظير ويتخيل الإبداع الذي ليس له نظير فكيف بما له نظير الثاني أنا لو سلمنا أن الوهم والخيال لايعلم جواز ذلك لم يضر ولو لم يعلم جواز نظيره أو وجوده بحس أو عقل فكيف إذا علم ذلك فإنما المدفوع ما علم بالفطرة امتناعه لاما عجز مجرد الوهم عن معرفته الوجه الرابع قوله من أنا سلمنا أنه تعالى هو المحدث للذوات ابتداءً من غير سبق مادة وطينة يقال له هذا الذي تذكره إنما ينفعك أن لو كان ماعلمناه بالفطرة يدفع ماسلمنا فكيف إذا لم يدفعه ماعلمناه لا بضرورة بل ولا يدفعه ضرورة ولا نظر بل كيف إذا كان ما شهدناه نظيرًا له ومشابهًا بل كيف إذا كان الذي شهدناه أبلغ من الذي سلمناه فإن الذوات التي ابتدعت ابتداءً إنما هي ذوات بسيطة كالماء ونحوه ومن المعلوم أن إبداع هذا الإنسان المركب بما فيه من الأعضاء المختلفة ومنافعها وقواها والأخلاط المختلفة ومقاديرها وصفاتها من أشياء بسيطة أعظم في الاقتدار وأبلغ في الحكمة من إبداع شيء بسيط لا من شيء لأن هذه المركبات كلها كائنة بعد عدم وتأليفها وتركيبها كذلك وما فيها من الجواهر والتأليف والصفات الكائن بعد العدم أبلغ مما في تلك البسائط وهذا كما أن ماشهدناه من الخلق الأول أبلغ مما أخبرنا به من الخلق الثاني في المعاد كما قال تعالى وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ [الروم 27] وقال وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ {78} قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ {79} [يس 78، 79] ونظائره في القرآن فإذا كان مستقرًا في الفطرة العقلية أن ابتداء الخلق أعظم من إعادته فمستقر فيها أن إبداع المركبات وتركيبها وصفاتها بعد العدم أبلغ من إبداع البسائط المفردات لكن المركب لابد أن يكون مسبوقًا”
فمع أنه سلم للفلاسفة في رسالة حدوث العالم أننا لم نشهد الخلق عن عدم بلا سبق مادة مباشرة، لكنه بين أن نفس الخلق من مادة خلق الشيء بعد عدمه وإخراجه بعد العدم ومزيد قدرة وحكمة، فمنه نعلم الإمكان الخارجي لأن يخرج الله الأشياء عن عدم، وأن قلب الحقائق هو قدر زائد عن إخراج الحقائق عن عدم وفيه مزيد قدرة، فمما نشهده نعلم قدرة الله على الإبراء عن عدم ولو لم نشهده مباشرة لأننا شهدنا ما يتضمنه وزيادة وهو أبلغ منه في القدرة أصلًا.
علمنا للقدرة على الخلق من العدم بالإمكان الخارجي:
بل ابن تيمية قد بين في هذه النصوص سابقة الذكر أن قدرة الله على الخلق عن عدم بل وخلق البسائط لا من مادة معلومًا من الإمكان الخارجي بكل الطرق: التي هي شهادة الشيء أو نظيره أو ما يكون هو أولى منه بالوجود، فيقول:
بشهادة الشيء:
يقول:
“وهذا الذي شهدناه من أبلغ الإبداع أنه يخلق من الشيء ما لا يكون مجانسًا له ولا يكون الأصل مشتملاً على ما فيه الفرع من الصفات فهذه الأمور المخلوقة التي لم تكن موجودة في أصلها ولا كامنة فيه هي مبدعة بعد العدم لا منقولة من وصف إلى وصف ولو كانت منقولة فنفس الصفات القائمة بها مبدعة بعد العدم فقد شهدنا إبداع الجواهر والأعراض بعد عدمها وهذا كاف في ذلك”
وبشهادة نظيره:
يقول:
“ومن المعلوم أن إبداع هذا الإنسان المركب بما فيه من الأعضاء المختلفة ومنافعها وقواها والأخلاط المختلفة ومقاديرها وصفاتها من أشياء بسيطة أعظم في الاقتدار وأبلغ في الحكمة من إبداع شيء بسيط لا من شيء لأن هذه المركبات كلها كائنة بعد عدم وتأليفها وتركيبها كذلك وما فيها من الجواهر والتأليف والصفات الكائن بعد العدم أبلغ مما في تلك البسائط”
وبشهادة ما هو أولى منه بالوجود:
وينص أن شهادة النظير هي شهادة لما يكون وجود ما هو أهون منه أبلغ وهو خلق البسائط لا من شيء فيقول:
“قوله (الرازي) من أنا سلمنا أنه تعالى هو المحدث للذوات ابتداءً من غير سبق مادة وطينة يقال له هذا الذي تذكره إنما ينفعك أن لو كان ماعلمناه بالفطرة يدفع ماسلمنا فكيف إذا لم يدفعه ماعلمناه لا بضرورة بل ولا يدفعه ضرورة ولا نظر بل كيف إذا كان ما شهدناه نظيرًا له ومشابهًا بل كيف إذا كان الذي شهدناه أبلغ من الذي سلمناه فإن الذوات التي ابتدعت ابتداءً إنما هي ذوات بسيطة كالماء ونحوه ومن المعلوم أن إبداع هذا الإنسان المركب بما فيه من الأعضاء المختلفة ومنافعها وقواها والأخلاط المختلفة ومقاديرها وصفاتها من أشياء بسيطة أعظم في الاقتدار وأبلغ في الحكمة من إبداع شيء بسيط لا من شيء“
بل يجعل العلم بقدرة الله عليه مستقرًا في الفطرة:
فيقول: “ونظائره في القرآن فإذا كان مستقرًا في الفطرة العقلية أن ابتداء الخلق أعظم من إعادته فمستقر فيها أن إبداع المركبات وتركيبها وصفاتها بعد العدم أبلغ من إبداع البسائط المفردات لكن المركب لابد أن يكون مسبوقًا“
بل يجعل شرط خلق المركب من بسائط (مادة سابقة وطينة) راجع لتعريفه أنه مركب، بينما البسيط ليس في مسماه ما يجعله مشروطًا بخلقه من شيء، بل لابد ألا يكون مركبًا من شيء وإلا لكان مركبًا وليس بسيطًا!
ويبين أن خلق الله لما يخلقه بالاستحالة خلاف ما يخلقه الإنسان بالأسباب والمواد التي يغير صورها مع بقاء أصلها بل تتضمن إبداع الحقائق عن العدم وتحويل الحقائق إلى بعضها كما سبق منا بيانه، فيقول في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (2/ 269) :
“ليست هذه المخلوقات من الماء والطين مثل الصور التي يصورها بنو آدم من المواد مع أن الذات باقية كتصوير الخاتم والدرهم ونحو ذلك من الفضة وتصوير السرير والباب ونحو ذلك من الخشب وتصوير الثوب من الغزل فإن هذه المواضع لم تحدث فيها الذوات وإنما تغيرت صفة الذات وأما الحيوانات والنباتات المشهودة فنفس هذه الذوات شهدنا حدوثها وخلقها لكن خلقت من شيء آخر ليس هو من جنسها ولا من حقيقتها وهذا من أبدع الأمور وأعظمها فلم يكن ما منه خلقت هذه الأمور وإن سماها بعض الناس مادة مثل المواد المعروفة تكون بعينها باقية في الصور أو تكون من جنس الصور وإذا كان كذلك فقد شهدنا إبداع هذه الحقائق الموجودة وصفاتها بعد أن لم تكن موجودة كما قال تعالى أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً {67} [مريم 67]”
وهذا نظير قوله في النبوات:
“فالإنسان مخلوق، خلق الله جواهره وأعراضه كلّها من المني؛ من مادّة استحالت، ليست باقية بعد خلقه؛ كما تقول المتفلسفة أنّ هناك مادّة باقية.
ولفظ المادّة مشترك:
فالجمهور يُريدون به ما منه خُلق، وهو أصله وعنصره.
وهؤلاء يُريدون بالمادّة جوهر باق، وهو محلّ للصورة الجوهرية. فلم يُخلق عندهم الإنسان من مادّة، بل المادّة باقية، وأحدث صورته فيها؛ كما أنّ الصور الصناعيّة؛ كصورة الخاتم، والسرير، والثياب، والبيوت، وغير ذلك إنّما أحدث الصانع صورته العرضيّة في مادّة لم تزل موجودة ولم تفسد، ولكن حُوِّلَت من صفة إلى صفة. فهكذا تقول الجهميّة المتكلّمة المبتدعة أنّ الله أحدث صورة عرضيّة في مادّة باقية لم تفسد؛ فيجعلون خلق الإنسان بمنزلة عمل الخاتم، والسرير، والثوب.
والمتفلسفة تقول أيضاً: إنّ مادّته باقية لم تفسد؛ كمادّة الصورة الصناعيّة، لكن يقولون: إنّه أحدث صورة جوهريّة. وهم قد يخلطون ولا يفرقون بين الصور العرضيّة والجوهريّة؛ فإنّهم يُسمّون صورة الإنسان صورةً في مادّة، وصورة الخاتم صورةً في مادّة؛ فيكون خلق الإنسان عند هؤلاء وهؤلاء من جنس ما يُحدِثه الناس في الصور من الموادّ، ويكون خلقه بمنزلة تركيب الحائط من اللَّبِن. ولهذا قال من قال منهم: إنّه يستغني عن الخالق بعد الخلق، كما يستغني الحائط عن البَنَّاء.”
فشيح الإسلام لم تقع له شبهة في مسألة الإحداث عن عدم والقدرة عليه، إنما فقط يقول، ما شهدنا ولم يذكر لنا إلا أنه يحدث شيء عن شيء، وطالما الأمر كذلك فلا بد أنه لحكمة، ونستطيع تعداد بعضها، لكن قلب الحقائق يتضمن الإبراء عن عدم وزيادة.
بعد كل هذا توهم القوم أن ابن تيمية يستدل بمحض الاستقراء الناقص على أن الله عاجز أصلًا عن الخلق عن عدم! فسبحان الله على سوء الفهم.
خلطهم بين أحكام الشيخ العادية والعقلية
بل خلطوا في أكثر من موضع بين أحكام الشيخ العقلية وأحكامه العادية؛ فمثلًا، في مسألة استحالة المنقسمات إلى غيرها عند الاستمرار في التقسيم، فإن الشيخ جوّز عقلًا أن يكون كل قسم أصغر من الأول، من غير الوصول إلى جوهرٍ فردٍ لا يمتاز فيه جانبٌ عن جانب. أي إنّ الاستمرار في التقسيم تتعلّق به قدرةُ الباري، من غير أن يفضي ذلك إلى جوهر فرد، أو إلى ما لا يتناهى من الأجزاء بالفعل دفعةً واحدة؛ لأن التقسيم يكون شيئًا فشيئًا، فالأجزاء الحاصلة بالفعل تكون دائمًا متناهية، ولو أنَّ نفسَ التقسيمِ مستمرٌّ إلى غير غاية.
غير أنه قال إنّ هذا لا يحصل في المشهود من العالم الخارجي، لأن الله جعل طبائع الأشياء تستحيل إلى غيرها في مرحلةٍ معيّنةٍ من التقسيم، واستدلّ على ذلك بكلام الفقهاء والأطباء والطبيعيين، فيقول: في درء تعارض العقل والنقل (3/ 445): “وجماهير العقلاء على مخالفة هؤلاء وقائلون باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض كما اطبق على ذلك علماء الشريعة وعلماء الطبيعة وغيرهم من اصناف الناس.. إلى أن قال: والاطباء مع سائر الناس يعلمون ان الماء يستحيل هواء والهواء يستحيل ماء والنار تستحيل هواء والهواء يستحيل ماء كما هو مبسوط في غير هذا الموضع”
فاستدل بالتجربة لإثبات حكم عادي، والعادة عنده تتبع مشيئة الله وحكمته في الخلق، يبين ذلك قوله في الرد على المنطقيين: “العادة تتبع إرادة الفاعل وإرادة الفاعل الحكيم هي إرادة حكيمة” وأن “انخراق العادات أمر معلوم بالحس والمشاهدة بالجملة” وأن الله “لم يخبر بان كل عادة لا تنتقض”، ومع ذلك حمل هؤلاء كثير من أحكامه العادية على أنها حكم عقلي ضروري لا تتعلق القدرة بخلافه! فسبحان الله، هل كل ما ينطق به ابن تيمية في أي سياق لابد أنه قد به حكم عقلي ضروري لا تتعلق القدرة بخلافه؟!
في قولهم إن ابن تيمية تراجع في النبوات عن تحريره لمسألة الخلق عن عدم في مسألة حدوث العالم
فقد استدل القوم بقول شيخ الإسلام في النبوات أن الإمكان الخارجي لابد له من محل خارجي، أما في حدوث العالم فقال بأن الإمكان محله الذهن قبل وجود الممكن ومحله نفس الممكن عند وجوده، فهذا تراجع منه
ومنهجنا في الرد عليهم هو:
- أننا لا نحتاج إلى دليل لبيان أنه لم يرجع فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت العكس، فيكفينا إبطال أدلتهم هم على التراجع.
- أن ما أثبته في حدوث العالم عين ما أثبته في النبوات، وما نفاه في حدوث العالم عين ما نفاه في النبوات.
- أن الجهة منفكة معنويّا بين ما نفاه في حدوث العالم وما أثبته في النبوات.
وعماد أدلتهم هو قوله في النبوات:
“وأيضاً فالدليل الذي احتجّ به كثيرٌ من النّاس على أنّ كُلّ حادث لا يحدث إلا من شيء، أو في شيء؛ فإن كان عرضاً لا يحدث إلاَّ في محلّ، وإن كان عيناً قائمة بنفسها لم تحدث إلاَّ من مادة، فإنّ الحادث إنّما يحدث إذا كان حدوثه ممكناً، وكان يقبل الوجود والعدم، فهو مسبوق بإمكان الحدوث وجوازه، فلا بُدَّ له من محلّ يقوم به هذا الإمكان والجواز.”
فيقولون أنه قبل سبق الإمكان الخارجي ، بينما نفاه في رسالة حدوث العالم، ونحن باذن الله نبين أن ما نفاه في النبوات، قد نفاه في حدوث العالم، وما قبله في النبوات، قد قبله في حدوث العالم.
فقد قال في رسالة حدوث العالم:
“ذكروا عن معلمهم أرسطو: أنه استدل على ذلك أيضاً: بأن المحدَث قبل حدوثه لا بد أن يكون ممكناً، والإمكان وصف ثبوتي؛ فلا بد له من محل؛ فيجب أن يتقدم المحدَث محل يقوم به الإمكان؛ وذلك يوجب قدم المادة.
فهذا ونحوه: هو كلام هؤلاء الفلاسفة الدهرية في مثل هذا، وهم الذين يقولون: لا يعقل موجود عن عدم.
وما قالوه خيالات عند أولي الألباب النبلاء؛ وإن كان كثير من الناس يظنون: أنها من أعظم الحجج عند فضلاء العقلاء.”
وركز أنه في المحلين يحكي هذا القول عن “الناس”، وليس من كلام نفسه، وفي المقامين يحمل “الإمكان” على ما يجعل الشيء قابلًا للوجود والعدم (ممكنًا لذاته) ويرفع عنه الإمتناع لذاته، وهو ما يحتج الفلاسفة أنه غير القدرة،
فتجد ابن سينا في النجاة ص280 يقول:
“إنه لا يمكن أن يحدث ما لم يتقدمه وجود القابل وهو المادة. ولنبرهن على هذا فنقول إن كل كائن فيحتاج أن يكون قبل كونه ممكن الوجود في نفسه؛ فإنه إن كان ممتنع الوجود في نفسه لم يكن ألبتة. وليس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه، بل الفاعل لا يقدر عليه إذا لم يكن هو في نفسه ممكنًا. ألا ترى أنا نقول: إن المحال لا قدرة عليه، ولكن القدرة هي على ما يمكن أن يكون، فلو كان إمكان كون الشيء هو نفس القدرة عليه، كان هذا القول كأننا نقول: إن القدرة إنما تكون على ما عليه القدرة” إلى أن قال “فبين واضح أن معنى كون الشيء ممكنًا في نفسه، هو غير معنى كونه مقدورًا عليه. وإن كان بالذات واحدًا وكونه مقدورًا عليه لازم لكونه ممكنًا في نفسه، وكونه ممكنًا في نفسه هو باعتبار ذاته، وكونه مقدورًا عليه باعتبار إضافته إلى موجده.”
فكلامه عن الإمكان الذاتي وهو قبول الوجود والعدم كما أشار له ابن تيمية في النبوات ورد عليه في حدوث العالم!، فقال في ص 66):
“فيقال لهم: الإمكان ليس وصفاً موجوداً للمكن زائداً على نفسه؛ بل هو بمنزلة الوجوب والحدوث والوجود والعدم ونحو ذلك من القضايا التي تعلم بالعقل، وليس العدم زائداً على المعدوم في الخارج، ولا وجود الشيء زائداً على ماهيته في الخارج، ولا الحدوث زائداً على ذات المحدث في الخارج، ولا الإمكان زائداً على ذات الممكن في الخارج، ولا الوجوب زائداً على ذات الواجب في الخارج.
والمقصود هنا الإمكان؛ فالممكن إما أن يكون معدوماً أو موجوداً؛ فإذا كان معدوماً فليس له صفة ثبوتية أصلاً؛ إذ المعدوم لا يتصف بصفة ثبوتية. وإن كان موجوداً؛ فقد صار واجباً بغيره؛ فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن؛ فما شاءه وجب وجوده، وما لم يشأه امتنع وجوده؛ لكن وجب بغيره وامتنع لغيره، وهو في نفسه قابل للوجود والعدم.
وقولنا: في الموجود ممكن. معناه: أنه موجود بغيره.
ومما يبيّن ذلك: أن الإمكان لو كان صفة زائدة على الممكن لامتنع قيامه بغيره؛ إذ صفة الشيء لا تقوم بغيره، وقبل وجود الممكن ليس له صفة؛ فيمتنع وجود إمكان هو صفة له قبل وجوده.”
وقال:
“وقال أيضاً لما أراد أن يقرر قول أرسطو: إن كل حادث فهو مسبوق بإمكان العدم، والإمكان لا بد له من محل، وقد رد ذلك أبو حامد بأن الإمكان الذي ذكروه يرجع إلى قضاء العقل، فكل ما قدر العقل وجوده فلم يمتنع تقديره، سميناه واجباً، فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى نجعل وصفاً له، لأن الإمكان كالامتناع، وليس للامتناع محل في الخارج، ولأن السواد والبياض يقضي العقل فيهما قبل وجودهما بكونهما ممكنين.”
وعند ابن تيمية الإمكان الذاتي لا يعلل أصلًا فإنه في المعدوم من قبيل الأحكام العقلية وهو الحكم بتجويز الشيء ومحله الذهن ونص عليه في النبوات وغيره كما سنبين، وفي الموجود هو صفة ذاتية له لا تسبقه ولا تنفك عنه فيقول في درء تعارض العقل والنقل (3/ 10):
“إنه إن أريد بذلك الحدوث مثلاً دليل على أن المحدث يحتاج إلى محدث، أو أن الحدوث شرط في افتقار المفعول إلى الفاعل، فهذا صحيح.
وإن أريد بذلك أن الحدوث هو الذي جعل المحدث مفتقراً إلى الفاعل فهذا باطل.
وكذلك الإمكان إذا أريد به أنه دليل على الافتقار إلى المؤثر، أو أنه شرط في الافتقار إلى المؤثر فهذا صحيح.
وإن أريد به أنه جعل نفس الممكن مفتقراً فهذا باطل.
وعلى هذا فلا منافاة بين أن يكون كل من الإمكان والحدوث دليلاً على الافتقار إلى المؤثر، وشرطاً في الافتقار إلى المؤثر.”
وقد قبل في النبوات سبق الإمكان الخارجي لا الذاتي! ولو سموه خارجيّا فقد عرفوه بما يعرف به ابن تيمية الإمكان الذاتي!وقبله بعد أن أقام تحقيقًا في أنواع الإمكان وأثبت كل أنواعه الذهنية والخارجية، بينما رفض في رسالة حدوث العالم خلط الفلاسفة بين الإمكان الذاتي والخارجي وجعلهم في منزلة واحدة كلها خارجية! فقال: “فتبيّن أن ما يدّعونه في إثبات إمكان وجودي من محل قبل وجود الممكن خيال محض.”
فابن تيمية أصلًا يخالفهم بأن الإمكان الخارجي هو شيء غير قدرة القادر أو قابلية القابل!
بل تجد خلطهم مستمرًا حتى في النبوات فبعد أن ساق دليلهم، ساق سؤالهم وحيرتهم فقال:
“وقد تنازعوا في هذا: هل الإمكان صفة خارجية، لا بُدّ لها من محلّ، أو هي حكم عقلي لا يفتقر إلى غير الذهن؟”
فهم يريدون حصر الإمكان في نوع واحد من هذه لخلطهم بين الذاتي الذي هو حكم ذهني على مسمى الشيء بأن مسماه جائز وهذا نقيض كونه ممتنعًا لذاته وفرضه يستلزم الجمع بين النقيضين يبين هذا المعنى قول الشيخ (وقد بطل كونه واجبا بنفسه أو بغيره، فلا يكون الامتناع ثابتا في الأزل، فيثبت نقيضه، وهو الإمكان.) ” وكونه ليس بواجبًا ولا ممتنع هو نفسه كونه ممكن فقير ذاتيّا يبين ذلك في درء تعارض العقل والنقل 3/ 201: “فتبين أنه إذا كان من الأمور ما هو ممكن في نفسه، لا يقف إمكانه على غيره، ومعنى إمكانه أنه لا يستحق بنفسه وجوداً ويمتنع وجوده بنفسه، وهو بالنظر إلى نفسه فقير محض، أي الفقر الذاتي الذي يمتنع معه غناه بنفسه “
فيخلطون هذا المعنى مع إمكان وقوعه وحدوثه في الخارج فيجيبهم ابن تيمية بتفصيله المعهود:
“والتحقيق: أنه نوعان: فالإمكان الذهني:
1 – وهو تجويز الشيء،
أو 2- عدم العلم بامتناعه، محله الذهن.
والإمكان الخارجي:
المتعلق 3 – بالفاعل،
أو 4- المحل؛
مثل أن [تقول] : يمكن القادر أن يفعل، والمحل؛ مثل أن تقول : هذه الأرض يمكن أن تزرع، وهذه المرأة يمكن أن تحبل. و هذا لا بد له من محل خارجي، فإذا قيل عن الرب: يمكن أن يخلق؛ فمعناه أنه يقدر على ذلك، ويتمكن منه. وهذه صفة قائمة به.” – النبوات
فيرفض أن يجعله نوعًا واحدًا ثم يقول أنه سابق لحدوث الممكن وله محل بلا تفصيل!
فالإمكان الذهني عنده :
التجويز (الإمكان الذاتي): (ويقول في تعريفه: كالأحكام العقلية الذهنية فينا، فإنه يصح في الأزل الحكم بالامتناع على الممتنعات كما يصح الحكم بالجواز على الجائزات) – «درء تعارض العقل والنقل» (2/ 394)
بل ويبدل بين لفظة الإمكان والجواز فيقول: (يبين ذلك: أنه قد يقال: صحة الحركة إو إمكان الحركة أو جواز الحركة، وصحة الفعل أو جواز أو إمكان الفعل إما أن يكون به ابتداء وإما أن لا يكون، فإن لم يكن له ابتداء لزم أنها لم تزل جائزة ممكنة، فلا تكون ممتنعة، فتكون جائزة في الأزل.)
ويقول:“فإن الإمكان الذاتي ثابت بالضرورة والاتفاق، وما من وقت يقدر فيه الإمكان إلا والإمكان ثابت قبله، لا إلى غاية، فليس للإمكان ابتداء محدود.”
ويقول في درء تعارض العقل والنقل (3/ 201) : “فتبين أنه إذا كان من الأمور ما هو ممكن في نفسه، لا يقف إمكانه على غيره، ومعنى إمكانه أنه لا يستحق بنفسه وجودا ويمتنع وجوده بنفسه، وهو بالنظر إلى نفسه فقير محض، أي الفقر الذاتي الذي يمتنع معه غناه بنفسه»
بل يعرّفه بالتفصيل في «درء تعارض العقل والنقل» (3/ 154) فيقول:
«وإذا قلنا: هذا الممكن يقبل الوجود والعدم، أو نفسه أو حقيقته لا تقتضي الوجود ولا تستلزم العدم، فنعني به أن ما تصوره العقل من هذه الحقائق لا يكون موجودا في الخارج بنفسه، وليس له في الخارج وجود من نفسه ولا يجب عدمه في الخارج بل يقبل أن تتحقق حقيقته في الخارج فيصير موجودا، ويمكن أن لا تتحقق حقيقته في الخارج فلا يكون موجودا، وليس في الخارج حقيقة ثابتة أو موجودة تقبل الإثبات والنفي بل المراد أن ما تصورناه في الأذهان: هل يتحقق في الأعيان أولا يتحقق؟ وما تحقق في الأعيان هل تحققه بنفسه أو بغيره؟»
وهذا محله عنده قبل وجود الممكن في الذهن أي الحكم العقلي بأن ذات الشيء مفتقرة أو أنها لا تحمل علة امتناعها في نفسها وهذا أعم ومع ذلك فقبل وجود ذاته فهو حكم عقلي وهذا مطرد في سائر كتبه كما يقول في النبوات: والتحقيق: أنه نوعان: فالإمكان الذهني: وهو تجويز الشيء، أو عدم العلم بامتناعه، محله الذهن، ويقول في حدوث العالم: “فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى jجعل وصفاً له، لأن الإمكان كالامتناع، وليس للامتناع محل في الخارج، ولأن السواد والبياض يقضي العقل فيهما قبل وجودهما بكونهما ممكنين.”
يوضح ذلك قوله في درء تعارض العقل والنقل (3/ 252) :
“فإن قيل: فالممكنات التي هي محدثة هي واجبة بغيرها، إذا وجدت تجب بوجوب سببها، فما شاء الله كان وجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده، وهي ممتنعة حال عدمها.
ومع هذا فهي تقبل الوجود والعدم، ولا يلزم من عدمها عدم الواجب.
قيل: الفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن تلك كانت معدومة تارة وموجودة أخرى فثبت قبولها للوجود والعدم العدم بخلاف ما هو لم يعدم قط ولم يكن عدمه في وقت من الأوقات.
الثاني: أن هذه لا يوجبها نفس الواجب إذا لو كان كذلك لكانت لازمة لذاته قديمة أزلية، بل إنما توجبها الذات مع ما يحدث من الشروط التي بها تم حصول المقتضى التام، فحينئذ ليست من لوازم الواجب بنفسه بل من لوازم مؤثرها التام، ومن جملة ذلك الأمور الحادثة التي هي شرط في حدوثها، وإذا عدمت فأنها تعدم لانتفاء بعض هذه الشروط الشروط الحادثة، أو لحدوث مانع ضاد وجودها، ومنع تمام علتها التامة فعدمت لعدم بعض الحوادث أو وجود بعض الحوادث، كما وجدت لحدوث بعض الحوادث.”
أو مجرد الجهل المحض بالامتناع الذاتي أو الغيري، فهذا جهل محض بخلاف التجويز فيكون مبنيّا على أدلة نعلم منها أن الشيء ليس ممتنعًا لذاته، وهذا قد يطلق عليه أيضًا الإمكان الذهني بالاشتراك لكن الشيخ دائمًا ما يقرنه بتعريفه بأنه فقط عدم العلم بالامتناع والشك والتردد، بخلاف الإمكان الذاتي الذي يجعله من العلم بل ويجعله مصحح القدرة.
وكل حكم عقلي محله عنده الذهن على أي حال، ولا يفيد علمًا بالوقوع إن كان حكمًا بمجرد الإمكان الذاتي أو الذهني، مع أن العلم بالإمكان الخارجي أي بإمكان الوقوع في الخارج هو أيضا حكم عقلي لكنه أزيد من مجرد العلم بالإمكان الذاتي، والعلم بالإمكان الذاتي أزيد من مجرد الإمكان الذهني،فإن العلم بالإمكان الذاتي الذي هو حكم عقلي علمي أي هو العلم بعدم الامتناع والذي يعرف بالوجود بعد العدم، فهو كالعلم بالإمتناع الذاتي أيضًا وهو حكم عقلي، كل هذا لا يكون إلا من طريق الحس والموجود، فالعلم بعدم الامتناع الذاتي أو الخارجي مبناه على العلم بالإمكان الخارجي، يبين ذلك قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى (9/ 226):
“والمقصود أن الإمكان الخارجي يعرف بالوجود لا بمجرد عدم العلم بالامتناع كما يقوله طائفة منهم الآمدي. وأبعد من إثباته الإمكان الخارجي بالإمكان الذهني ما يسلكه المتفلسفة كابن سينا في إثبات الإمكان الخارجي بمجرد إمكان تصوره في الذهن”
والإمكان الخارجي: وهو عنده هو نفسه الحكم بعدم الإمتناع بالغير سواء للنوع أو للشخص وهذا الحكم متعلق بوجود قدرة أو قابلية وجودية في الغير الذي سيوجب وجود هذا الممكن لذاته في الخارج، سواء لاحظنا فيه زمان الوقوع الذي يتم فيه التعليل ويعقبه وجود الشيء أم لا إذ يوم القيامة ممكن خارجًا بل واقع بالضرورة لكنه يمتنع خارجًا حدوثه قبل أوانه وتمام أشراطه فعند لحاظ زمن الوقوع فنقول أنه الآن ممتنع خارجًا ولو أن نوع البعث وإعادة الخلق ممكن لأن نظيره متحقق الآن لكن ذلك البعث بعينه ممتنع لغيره قبل أوانه، أما مجرد الكلام عن كونه سيحصل في الخارج بلا لحاظ زمن الحصول فنعم يمكن إطلاق إمكانه الخارجي لأن مقتضياته موجودة في الخارج على عكس ما يمتنع وجوده في الخارج أو يمتنع لذاته فلن توجد له مقتضيات يمكن أن تنتجه، فابن تيمية ينص على ما يكون نوعه ممكن خارجًا وشخصه ممتنع لاعتبار زائد (نوع البشر ممكن خارجًا لكن إنسان ساحر تحصل على يده أدلة نبوة ممتنع)، أو ما يكون نوعه ممكن وشخصه ممكن، وأيضًا ما يجب بغيره فيكون واقعًا، فيقول في النبوات: “الإمكان الخارجي: يراد به أن وجوده في الخارج ممكن” ويشرح ذلك في الفتاوى الكبرى فيقول: “ثم إنه إذا بين كون الشيء ممكناً فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا مجرد العلم بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك” ويشرح سبب ذلك فيقول: “إذ يمكن أن يكون الشيء ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه ؛ بخلاف الإمكان الخارجي”
بل لابن تيمية نص آخر في النبوات يشرح فيه معنى الإمكان الخارجي وللأسف هو منسي بين الباحثين حيث يقول:
“والإمكان الخارجي: يراد به أن وجوده في الخارج ممكن، لا ممتنع، كولادة النساء، ونبات الأرض، وأما الجزم بالوقوع وعدمه، فيحتاج إلى دليل.
وفي نفس الأمر ما ثم إلا ما يقع، أو لا يقع.
والواقع لا بد من وقوعه، ووقوعه واجب لازم.
وما لا يقع فوقوعه ممتنع، لكن واجب بغيره، وممتنع لغيره:
وقوع ما قدره الله واجب من جهات
وهو واجب من جهات: من جهة علم الرب من وجهين، ومن جهة إرادته من وجهين، ومن جهة كلامه من وجهين، [ومن جهة كتابته من وجهين]، ومن جهة رحمته، ومن جهة عدله.”
ويقول مثله في درء تعارض العقل والنقل (3/ 246)
“فلا بد من القدرة التامة والإرادة الجازمة، فلا يحصل الممكن بدون ذلك، ومتى وجد ذلك وجب حصول المفعول الممكن، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاء الله وجب وجوده، وما لم يشأ الله امتنع وجوده، فإن حصل للمكن المؤثر التام وجب وجوده بغيره، وإن لم يحصل امتنع وجوده لانتفاء المؤثر التام، فوجوده لا يحصل إلا بغيره.”
فالإمكان الخارجي إما أن يكون نفس علمنا بالإمكان الخارجي يبين طرائقه قول شيخ الإسلام: “والإنسان يعلم الإمكان الخارجي : “تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه فإن وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه” ويتعلق هذا الحكم بنفس ما به يكون الشيء ممكنًا في الخارج وهو قدرة القادر في الخارج أي (تمام التمكن، تمام التأثير، القدرة المقارنة للفعل “وجود الفعل عند وجود «الداعي التام» و«القدرة» – شرح الأصبهانية” =التي توجب الممكن بالغير = وهو الوجوب بالمشيئة والحكمة)، أو قابلية القابل لما يكون وجوده مشروط به أو أجزاء هذا من المقتضيات لكن بشرط إمكان أن تتم، وليس أزيد من ذلك، ومقابلته في النبوات بين الفاعل والقابل (المحل القابل) لا تنافي أنه جعل الإمكان الخارجي قائمًا بهما، فكلاهما يمكن أن يكون محل لها.
بل لاحظ كيف في النص أعلاه جعل العلم بأن النساء يمكن أن تلد والأرض يمكن أن تزرع لا يكفي بالجزم بإمكان وقوع الشيء المعين في الخارج ولو وجدت بعض مقتضياته التي تنتج مثله في العادة بل لابد من دليل يبين وجوب ذلك بغيره وهو مشيئة الله وعلمه وحكمته والخ، فجعل الأولوية في الإمكان الخارجي للمعين لله وصفاته سبحانه! يقول رحمه الله في «درء تعارض العقل والنقل» (3/ 110)
ومعلوم أن الحاجة إلى الفاعل فيما له فاعل أقوى من الحاجة إلى القابل فيما له قابل.
ويبين ذلك قوله:
“فإذا قيل عن الرب: يمكن أن يخلق؛ فمعناه أنه يقدر على ذلك، ويتمكن منه. وهذه صفة قائمة به.”- النبوات
إلى أن قال:
“وإذا قيل: يمكن أن يحدث حادث؛ فإن قيل يمكن حدوثه بدون سبب حادث، فهو ممتنع، وإذا كان الحدوث لا بُدّ له من سبب حادث؛ فذاك السبب إن كان قائماً بذات الرب، فذاته قديمةٌ أزليّةٌ، واختصاص ذلك الوقت بقيام مشيئةٍ، أو تمام تمكّنٍ، ونحو ذلك، لا يكون إلا لسببٍ قد أحدثه قبل هذا في غيره، فلا يحدث حادثٌ مبايِنٌ إلاَّ مسبوقاً بحادثٍ مباينٍ له.
فالحدوث مسبوقاً بإمكانه، ولا بُدّ لإمكانه من محلّ،”
فالإمكان السابق في محل وجودي هو متعلق الإمكان الخارجي لا الذاتي، وهي المقتضيات وكل ما به يكون تمام التمكن والقدرة المقارنة للفعل التي توجب المقدور، والعلة التامة في الإحداث هو اجتماع القدرة والمشيئة والحكمة التي بها تتحدد شروط إيجاد الموجود.
وبيان ذلك قوله في شرح الأصبهانية:“وحينئذ: فإذا صار الفعل والمفعول ممكنا بعد أن كان ممتنعا، لم يكن ذلك لامتناع ذاته بل لإمكان لوازمه وانتفاء موانعه التي هي شروط فيه. وعدم المانع حصل بانقضاء الفعل الأول، وأمكن حينئذ حصول الثانى بلوازمه، ولم يكن عدم المانع جزءًا من المؤثر، بل كان مستلزما كمال التأثير. ” وركز أن تمام التأثير كقوله في النبوات “فمعناه أنّه يقدر على ذلك، ويتمكّن منه. وهذه صفة قائمة به.” وكذلك قوله: “واختصاص ذلك الوقت بقيام مشيئةٍ، أو تمام تمكّنٍ”
وهو كقوله في الدرء:
“فكان إمكان حدوثه ممكناً، كوجود الولد المشروط بوجود والده، فإن كونه ابن فلان يستلزم وجود فلان، ويمتنع أن يكون وجود ابن فلان موجوداً قبل وجود فلان، والممتنع لذاته لا يكون مقدوراً”
وهو كقوله في منهاج السنة النبوية (1/ 249):
وأما إن عنيت بما تقدره حدوث حادث معين، فلا نسلم أن إمكانه أزلي، بل حدوث كل حادث معين جاز أن يكون مشروطا بشروط تنافي أزليته، وهذا هو الواقع، كما يعلم ذلك في كثير من الحوادث، فإن حدوث ما هو مخلوق من مادة يمتنع قبل وجود المادة“
ونكرر أنه يقصد الخارجي ويبين ذلك قوله في الأصبهانية: “وحينئذ: فإذا صار الفعل والمفعول ممكنا بعد أن كان ممتنعا، لم يكن ذلك لامتناع ذاته بل لإمكان لوازمه وانتفاء موانعه التي هي شروط فيه.”
وكقوله في مسألة حدوث العالم (ص: 86) :
ومعلوم: أنه إذا لم يكن حاصلاً في الأزل ثم حصل؛ وحصوله يستلزم حدوث حادث، وهو أن تمام المؤثرية لم يكن حاصلاً في الأزل.
وأنه لو قيل: إن تمام المؤثرية كان حاصلاً في الأزل لزم قدم جميع الآثار؛ وهو خلاف المشاهدة.
وكقوله في النبوات:
“والتحقيق: أنّ الرب يخلق بمشيئته وقدرته، وهو موجب لكلّ ما يخلقه بمشيئته وقدرته، ليس موجباً بمجرّد الذات، ولا موجباً بمعنى أنّ موجبه يقارنه؛ فإنّ هذا ممتنع. فهذان معنيان باطلان. وهو قادرٌ يفعل بمشيئته؛ فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن؛ فما شاءه وجب كونه، وما لم يشأ امتنع كونه”
وهذا مطرد في كل حادث معين مشروط فلا يوجد إلا بتحقق شرطه الذي تجدد العلم هو بأن هذا الزمن وهذا المكان هو موضع الحكمة من خلقه التي توجب المشيئة في زمن معين ومكان معين ومقدار معين والخ.. وهذا هو الإمكان الخارجي الثبوتي عنده، أما الخصوم فيشعرونك أنه اكتشف آخر حياته أن هناك إمكان خارجي بينما كان ينفيه سابقًا!، وأنه لا يكون قائلًا بالإمكان الخارجي إلا إن حصره في القابل دون القادر اعتباطًا!
ولاحط أن حل معضلة الترجيح بلا مرجح عنده هو كون كل حادث مسبوق بحادث لقوله في النبوات: “فلا يحدث حادثٌ مبايِنٌ إلاَّ مسبوقاً بحادثٍ مباينٍ له.” ، والحكمة من خلق الحادث التالي في مكان وزمان وصفة معينة له تعلق بحوادث حدثت قبله، ولا يحدث حادث إلا بسبب حادث وشرط حادث، وهذا أصلًا مطرد في كتبه كلها في النبوات وحدوث العالم وغيرهما.
وشرط إمكان وجود حادث معين أن نسأل، هل يسبق في الخارج مجموع أمور تكون هي التمام الحادث للعلة الذي يوجب أن يعتقبها معلولها في الزمن؟ ثم أي محل يقوم به الإمكان سواء الفاعل بشرط تجدد علمه وحكمته في أن يخلق الآن أو أن يكون وجود الحادث مشروطًا بمادة وقابل، فكل هذا يحقق شرط الإمكان الخارجي وتمام العلة أو التمكن أو التأثير الحادث.
وأيضًا فمن المعلوم أن معاني الإمكان الخارجي عند ابن تيمية هو قياس الأولى، فإن وجود المخلوق المعين دليل على أولوية سبق خالقه له بالوجود، يبين ذلك قوله في «درء تعارض العقل والنقل» (3/ 112)
“والمقصود أنه إذا كان قد علم أن الصفة المشروطة بمحلها تقتضي أن يكون محلها موجودا فالمفعول المفتقر إلى فاعل موجب يقتضي أن يكون فاعله موجودا بطريق الأولى.”
وهذا نظير تفريعه في مسألة الإمكان الخارجي، أن كل ما أمكن خارجًا لابد أن يكون حدوثخ مسبوقًا بمحل تقوم به قابلية إيجاده وإحداثه من باب أولى، فلابد أن يكون مسبوقًا بفاعل قادر قام عنده الداعي الحادث على إيجاده وإيجابه في ذلك الوقت دون الأزل فإن كان مشروطًا بمحل أو بغيره فلابد من وجود تلك الشروط، وإلا استحال حدوثه في الخارج أصلًا أو استحال في هذا الوقت دون غيره بلا مخصص يختص بهذا الوقت دون الأزل.
خلاصة الإمكان الخارجي عند ابن تيمية:
فالإمكان الخارجي مجموع أمور ومقتضيات بها تكتمل علة وجود الشيء في الخارج وينتفي مانعه الخارجي وهذا كله يحدث بقدرة الله وتحقق شروط حدوث الحادث المعين وإمكانه وعلى رأسها قدرة الله ومشيئته التي لولاها لكان حدوثه ممعتنًا لغيره وهو أن الله لا يريد أن يخلقه إلا من هذه الشروط وقد علم من نفسه فعل ذلك، فخلقه من شيء معين أو بعد شيء معين فهذا الشرط راجع لمشيئة الله لا لعدم تعلق قدرته على خلقه بشرط آخر لا يتضمن خلقه من شيء معين! والله يقدر على خلاف ما فعله ولو لم يفعله، يبين ذلك قول الشيخ في مجموع الفتاوى الثامن:
“وهذا قول بعض أهل البدع قالوا: لا يكون قادرا إلا على ما أراده” فيرد عليهم: {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} ولفظ الشيء في الآية يتناول هذا وهذا. فهو على كل شيء ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير؛ لا يستثنى من ذلك شيء ولا يزاد عليه شيء كما قال تعالى: {بلى قادرين على أن نسوي بنانه} وقال: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم} وقد ثبت في الصحيحين: أنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم {أعوذ بوجهك فلما نزل: {أو يلبسكم شيعا} الآية قال: هاتان أهون} فهو قادر على الأولتين وإن لم يفعلهما “
وهذا يفسر لماذا قال ابن تيمية في النبوات: “والإمكان الخارجي المتعلق بالفاعل، أو المحل” فيقول “أو” وهي للتخيير الذي يتناول كل الأحوال الممكنة لما تكون به الحوادث ممكنة خارجًا، ولا يقول “و” فيوجب الاثنين معًا، ومن المعلوم أن كل حادث فهو مشروط بالحكمة وبحادث سابق له، لكنه ليس مشروطًا بالاستحالة من شيء بالضرورة وهذا مثل قوله في حدوث العالم والقول أنه رجع عنه مصادرة على المطلوب.
وضرب ابن تيمية الأمثال في القادر والقابل هو لبيان كل الاحتمالات الممكنة وسبرها ، ففي سلامة الأرض للبذرة المشروط وجودها وأن البذرة تغتذي من الأرض وتكون في جوفها مع أنها لا تستحيل من مادتها الترابية أو تقوم بها قيام العرض بالجوهر بل الأرض لها حيز والبذرة لها حيز عدمي خاص يستبين أنها مشروطة بذلك لحكمة الله فيستحيل أن توجد إلا به وإلا لزم وجود المشروط بلا شرطه وهو كاجتماع النقيضين (بيانه أن فرض تحقق ذلك مع وجود ما يعارضه في الخارج وهو إرادة الله لعدمه (إمتناعه لغيره) من غير هذا الشرط مع وجوده من غيره هو جمع منك للنقيضين فهو فرض محال ممتنع لذاته ومحل هذا الفرض هو الذهن)، ولكن في نفس الأمر في الخارج فعدم خلقه من شرط آخر هو امتناع بالغير لا بالذات وهو نفس ما يرفعه إمكان الشيء خارجًا، وإلا فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب وسيخلقه يوم القيامة من عجب الذنب.
وسنبين كيف يضرب ابن تيمية مثالًا بما علم الله أنه لن يتحقق فتحققه محال لذاته (أي تحقق ما علم الله أنه لن يكون)، ولكن عدم كونه راجع لمشيئة الله فهو ممتنع لغيره في نفس سبب عدم حصوله، وفرض وقوعه بلا سبب وقوعه ممتنع لذاته، فلابد من التفريق بين هذه الاعتبارات.
أما الفلاسفة فليس عندهم وجوب بالمشيئة بل حتى العناية والحكمة هي تجب بمجرد العلم، فعلم الله أن كذا لابد أن يخلق من كذا فيحصل هذا ويمتنع غيره ويكون فرض خلافه ممتنعًا لذاته! إذ لا تتعلق المشيئة بتغييره أو وقوعه حتى!
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد عليهم:
“وإن أثبتم له حكمة مطلوبة – وهي باصطلاحكم العلة الغائية – لزمكم أن تثبتوا له المشيئة والإرادة بالضرورة فإن القول: بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدا لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين” – “مجموع الفتاوى (8/ 88)
وأما العلم عند ابن تيمية لا يكون مؤثرًا إلا من حيث دخوله في المشيئة أما أن نفس العلم بما هو واقع فهذا تابع لوقوعه بالمشيئة، فلابد من مشيئة تحقق الحكمة، وهذا فارق مهم في مسألة كون الحادث المشروط يمتنع وجوده بشرط آخر أو بدون هذا الشرط لأن الله شاء وجوده من هذا الشرط وعلم أنه لا يوجد إلا به، وبين كونه ممتنعًا لذاته باعتبار أن فرض وجوده بدون هذا الشرط أو بشرط آخر مع كون الله لا يريد ذلك ولا يشائه هو فرض ممتنع لذاته لأن فيه جمع بين النقيضين.
وطالما أن الله يريد خلق الشيء من شيء معين كخلق آدم من تراب معين فخلقه قبل التراب ممتنع، وفي التكرار إفادة.
بل ابن تيمية يجعل وصف الإمكان المشترك بين الذهني والخارجي بشكل عام لا يتعلق بالموجودات حال وجودها بل قبل ذلك، فالأشياء حال وجودها تكون وجبت بالغير وهي علتها السابقة عليها التي أوجبتها، فيقول:
“اما كون هذا الممكن له ذات وليس له من تلك الذات وجود ولا عدم، فهذا غير معقول في شيء من الموجودات، بل المعقول انه ليس في الممكن من نفسه وجود أصلاً ولا تحقق ولا ذات ولا شيء من الأشياء
وإذا قلنا ليس له من ذاته وجود، فليس معناه أنه في الخارج له ذات ليس له منها وجود، بل معناه أنا نتصور ذاتاً في أنفسنا، ونتصور أن تلك الذات لا توجد في الخارج إلا بمبدع يبدعها، فالحقائق المتصورة في الأذهان لا توجد في الأعيان إلا بمبدع يبدعها في الخارج، لا أنه في الخارج لها ذات ثابتة في الخارج تقبل الوجود في الخارج والعدم في الخارج، فإن هذا باطل
وإذا كان كذلك وعلمنا أن كل موجود فإما موجود بنفسه وهو الخالق، أو موجود بغيره وهو المصنوع المفعول، والمصنوع المفعول لا يكون إلا محدثاً مسبوقاً بالعدم، بل الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثاً مسبوقاً بالعدم عند عامة العقلاء”
درء تعارض العقل والنقل (3/ 349)
وفي بيان مذهب شيخ الإسلام في سبق العلة المؤثرة الفاعلة لمعلولها مطلقًا، يقول في درء تعارض العقل والنقل (1/ 341) :
“وحينئذ فمعلوم أن الأثر يكون عقب التأثير الذي هو المؤثرية، فإنه إذا خلق وجد المخلوق، وإذا أثر في غيره حصل الأثر، فالأثر يكون عقب التأثير، وهو جعل المؤثرية متأخرة عن الأثر.
وليس الأمر كذلك، بل هي متقدمة على الأثر، أو مقارنة له عند بعضهم، ولم يقل أحد من العقلاء: إن المؤثرية متأخرة عن الأثر، بل قال بعضهم: إن الأثر متأخر منفصل عنها، وقال بعضهم: هو مقارن لها، وقال بعضهم: هو متصل بها، لا منفصل عنها، ولا مقارن لها وهذا أصح الأقوال.”
لماذا جعل الفلاسفة الإمكان محصور في قابلية القابل دون قدرة الفاعل؟
ومن أسباب تحكمهم في جعل القابل هو حامل الإمكان دون الفاعل في الكلام عن الواجب، هو قولهم ببساطة الواجب وأنه لا يتغير ولا تحله الحوادث ولا تتعدد فيه المعاني، ولابد للمخصصات المعددة من تعدد المعاني في العلة التامة لها، فيقولون أن هذا المتجدد هو استعداد القوابل، يحكي عنهم ذلك شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (1/ 342) : “قال فإن قلت واجب الوجود عام الفيض يتوقف حدوث الأثر عنه على استعدادات القوابل” وكذلك نقل ذلك عنهم في رسالة حدوث العالم (ص: 83): “إن واجب الوجود عام الفيض؛ إلا أن صدور الأثر عنه يتوقف على استعداد القوابل” وفي الصفدية (1/ 280) مثله: “كما يقولون في العقل الفعال أنه عام الفيض لكن فيضه متوقف على استعداد القوابل”
يبين ذلك ما نقله من ردود ابن رشد على الغزالي في درء التعارض:
“وقال أيضاً لما أراد أن يقرر قول أرسطو: إن كل حادث فهو مسبوق بإمكان العدم، والإمكان لا بد له من محل، وقد رد ذلك أبو حامد بأن الإمكان الذي ذكروه يرجع إلى قضاء العقل، فكل ما قدر العقل وجوده فلم يمتنع تقديره، سميناه واجباً، فهذه قضايا عقلية لا تحتاج إلى موجود حتى نجعل وصفاً له، لأن الإمكان كالامتناع، وليس للامتناع محل في الخارج، ولأن السواد والبياض يقضي العقل فيهما قبل وجودهما بكونهما ممكنين.
فقال ابن رشد: (هذه مغالطة، فإن الممكن يقال على القابل وعلى المقبول، والذي يقال على الموضوع القابل يقابله الممتنع، والذي يقال على المقبول بقابله الضروري، والذي يتصف بالإمكان الذي يقابله الممتنع، ليس هو الذي يخرج من الإمكان إلى الفعل، من جهة ما يخرج إلى الفعل، لأنه إذا خرج ارتفع عنه الإمكان، وإنما يتصف بالإمكان من جهة ما هو بالقوة، والحامل لهذا الإمكان هو الموضوع الذي ينتقل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، وذلك بين من حد الممكن، فإن الممكن هو المعدوم الذي يتهيأ أن يوجد وأن لا يوجد، وهذا المعدوم الممكن ليس هو ممكناً من جهة ما هو معلوم، ولامن جهة ما هو موجود بالفعل، وإنما هو ممكن من جهة ما هو بالقوة ولذلك قالت المعتزلة: إن المعدوم ذات ما، وذلك أن العدم يضاد الوجود، وكل واحد منهما يخلف صاحبه، فإذا ارتفع عدم شيء ما خلفه وجوده، وإذا ارتفع وجوده خلفه عدمه.
ولما كان نفس العدم ليس يمكن فيه أن ينقلب وجوداً، ولا نفس الوجود أن ينقلب عدماً، وجب أن يكون القابل لهما شيئاً ثالثاً غيرهما، وهو الذي يتصف بالإمكان والتكون والانتقال من صفة العدم إلى صفة الوجود، فإن العدم لا يتصف بالتكون والتغير، ولا الشيء الكائن بالفعل يتصف أيضاً) وبسط الكلام في هذا.”
ويرد شيخ الإسلام على هذا القول في الصفدية فيقول:
“وذلك أن الممكن في كلام سلفهم الفلاسفة كأرسطو وأصحابه إنما يكون في حال العدم ولهذا يقولون إن الإمكان يفتقر إلى محل يقوم به قبل حصول الممكن ولهذا قالوا كل حادث فإنه مسبوق بإمكان العدم والإمكان وصف ثبوتي فلا بد له من مادة تقوم به…
… وإنما هذا تقسيم ابن سينا وأتباعه بل العالم عندهم من قسم الواجب لا الممكن فلفظ الممكن يراد به هذا وهذا وابن سينا لم يرض أن يجعله من باب الاشتراط اللفظي فقط بل أخذ القدر المشترك وهو إمكان أن يوجد وأن يعدم مع قطع النظر عما هو متصف به في الحال وهو السبب الموجب لأحدهما ولا ريب أن هذا يتصف به في الحالين وأما إذا أريد بالممكن أن يوجد أي يصير موجودا في المستقبل فلا يتصف به إلا المعدوم القابل لذلك.
وهذا الذي قاله يستلزم أمرين باطلين:أحدهما: ما غلط فيه هو وسلفه حيث ظنوا أن في الخارج حقيقة تقبل هذا وهذا وأنها متصفة بالوجود والعدم كالذين قالوا المعدوم شيء وقد بسط هذا في موضعه وبين أن الصواب أن هذه الحقيقة المتصورة في العقل هي المحكوم عليها بأنها تقبل أن تكون موجودة في الأعيان وتقبل أن لا تكون موجوده كما أن الممتنع كاجتماع النقيضين إذا قلنا إنه ممتنع فالمراد أن هذه الحقيقة المتصورة ممتنع ثبوتها في الخارج.. إلى آخر كلامه”
ويكمل رده فيقول:
“إذا تبين هذا فقولنا: مفتقر لذاته لا يريد به أن هناك ذاتا غير الموجودة ثابتة في الخارج هي الموصوفة بالفقر وإنما يسوغ هذا عند من يقول المعدوم شيء وحقيقته زائده على الوجود في الخارج وإنما المقصود بذلك أن هذا الموجود المخلوق في الخارج هو فقير محتاج فنفس حقيقته التي هي الموجودة هي الفقيرة وإذا قدر أن هناك وجودا زائدا عليه أو وجوده الذي هو مصدر فكل ذلك فقير محتاج كما أن نفسه الموجودة فقيرة محتاجة كما أن الرب غني بنفسه الموجودة وهذا المخلوق موصوف بالفقر والحاجة قبل أن يوجد وبعد أن وجد.
أما قبل وجوده فالمراد بذلك أنه لا يكون موجودا إلا بالخالق فلا يصير موجودا بنفسه وأما بعد الوجود فالمراد بذلك أنه ما صار موجودا ولا يدوم وجوده ولا صار له حقيقة ولا تدوم له حقيقة إلا بالخالق.
وإذا قلنا: لا يكون موجودا فقد أخبرنا عن شيء تصورناه قبل وجوده وهذه هي ما يتصور في الذهن منه.
ولا ريب أن الذين قالوا: المعدم شيء والذين قالوا: إن ماهية الشيء زائدة على وجوده وجدوا الفرق بين ما هو ثابت في الذهن وما هو ثابت في الخارج.”
لذلك فهم يقولون هذا الوجود لا يفيض إلا على القوابل الوجودية بخلاف الماهيات الممكنة لذاتها لكن لم يتجدد لها استعداد وجودي لقبول فيض الوجود عليها، حتى يفسروا لماذا تحدث حوادث متأخرة عن الأزل مع كون الواجب القديم لا تحل به الحوادث وليس له مشيئة، فليس لله مشيئة تخصص ممكنًا معينًا بالوجود في لحظة فتخرجه من عدم نفسه إلى وجوده، بل ما وجد فلوجود قوابله وما لم يوجد فلعدم وجود قوابله، وهذا وجه التخصيص، وكذلك لا يقولون أن قدرة الرب التامة المترنة بمشيئته هي الموجبة لوجود الشيء الممكن في الخارج، لأنهم يقولون الإمكان غير القدرة كما نقلنا عن ابن سينا أعلاه، وإلا لو قالوا بنفي المشيئة مع عموم فيض الوجود بلا اشتراط القابل الموجود المتجدد بل كفاية الإمكان الذاتي للممكنات للزم صدور كل الممكنات في الازل بلا فرق وهذا لا يفسر حدوث الحوادث في الحاضر بعضها دون بعض، فتأمل.
هذه المشكلة ترد عليهم لأنهم لا يقولون بأن الإمكان الذاتي للشيء مع قدرة الله المجتمعة مع تجدد مشيئة لحكمة معينة توجب تخصيص هذا الزمان والحيز لخلق المخلوق كافية في إيجاده في الخارج ووجوبه لغيره (وهو الإمكان الخارجي للمعين عند شيخ الإسلام كما بينناه).
فقولهم كما نقله عنهم شيخ الإسلام “يقول الفيلسوف في العقل الفعال بأنه موجب بذاته للصور الجوهرية والأنفس الإنسانية وإن كان ما اقتضاه لذاته متوقفاً على وجود الهيولى القابلة… بل هم يقولون: إن نفس إيجابه يتوقف على غيره بل وصول الأثر إلى المحل يتوقف على استعداد المحل. ” – درء تعارض العقل والنقل (4/ 242)
هو سبب تحكمهم في جعلهم الإمكان الخارجي هو في القابل المستعد حصرًا ولا يكفي الفاعل القادر المتمكن، وإلا ففي نفس الأمر فكل ما يقال في القابلية يقال في القدرة، فأنتم تقولون القدرة لا يمكن أن تكون هي الإمكان لأن القدرة لا تتعلق إلا بممكن فتعلق القدرة شيء والإمكان شيء، مع أننا نقول تعلق القدرة هو نفسه تمكن الفاعل وأن القدرة على الممتنع ليس لها معنى وهذا فرقها عن القدرة الممكنة وكل ما أمكن لله وجب له بقاعدة الأكملية المعروفة، فالله قادر على كل شيء أزلًا لكماله وأسباب إمكان الشيء خارجًا تكتمل عند وجوده أما قبلها فقدرة الباري القديمة هي من أسباب إمكان الشيء الخارجي التي تكتمل عند اقترانها بالمشيئة فتوجب المقدور، أما القول بأن الإمكان غير القدرة من كل وجه فهذا مجرد ألعوبة لغوية، لأن قولنا القادر يمكن له أن يفعل كذا من المفعولات المتعدية يتضمن إمكان إحداثه من هذه القدرة وباعتبار آخر أن وجود المقدور لا يلزم منه ممتنع فتكون القدرة عليه ممتنعة كذلك، ولكن بغض النظر عن ذلك، فكلامكم أيضًا يمكن أن يقال مثله في القابلية، فإن القابل لا يقبل إلا الممكن، وتقولون الإمكان عرض فلابد له من محل، والقابل موصوف هو محل القابلية، وكذلك القادر موصوف هو محل القدرة، لأن الموصوف هو محل الصفة، والجوهر هو محل العرض، والفاعل هو محل الفعل، فلماذا كانت القابلية أولى من القدرة في كونها هي الإمكان الخارجي ولماذا كان القابل أولى في أن يكون محل الإمكان الخارجي؟ مع أن الأصل أن هذا يتعلق بطبيعة الشيء وشروط وجوده وكما قال شيخ الإسلام أن القدرة والقابلية يمكن أن تكون هي ما يتمم علة إيجاد الشيء في الخارج، ولكن الأصل أن الفاعل هو الذي يوجب والقابل منفعل ليس له تأثير.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «درء تعارض العقل والنقل» (3/ 110) :
«ومعلوم أن الحاجة إلى الفاعل فيما له فاعل أقوى من الحاجة إلى القابل فيما له قابل.
وأيضا فإن القابل شرط في المقبول لا يجب تقدمه عليه بل يجوز اقترانهما بخلاف الفاعل فإنه لا يجوز أن يقارن المفعول، بل لا بد من تقدمه عليه.
ولهذا اتفق العقلاء على أنه لا يجوز أن يكون كل من الشيئين فاعلا للآخر لا بمعنى كونه علة فاعلة ولا بغير ذلك من المعاني، وأما كون كل من الشيئين شرطا للآخر فإنه يجوز، وهذا هو الدور المعي، وذاك هو الدور القبلي»
خلطهم بين الممتنع لذاته والممتنع لغيره
فنقيض الإمتناع الخارجي هو الإمكان الخارجي يبين ذلك قول الشيخ: “إذ يمكن أن يكون الشيء ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه ؛ بخلاف الإمكان الخارجي”، يبين الفرق بين النوعين قول الشيخ في منهاج السنة النبوية (2/ 291):
“جوابهم أن لفظ ” الممتنع ” مجمل، يراد به الممتنع لنفسه، ويراد به ما يمتنع لوجود غيره، فهذا الثاني يوصف بأنه ممكن مقدور بخلاف الأول. وإيمان من علم الله أنه لا يؤمن مقدور له لكنه لا يقع، وقد علم الله أنه لا يؤمن مع كونه مستطيع الإيمان، كمن علم أنه لا يحج مع استطاعته الحج.”
وكذلك في مقام رده على الرازي في مسألة الظلم: حيث يقرر الرازي شبهة أن الله لو كان منزهًا عن الظلم واجب له العدل بصفاته لامتنعت قدرته على الظلم أصلًا، فيرد الشيخ:
“أن لفظ «الامتناع» يُراد به: امتناع الممتنع لذاته.
ويُراد به: ما يعجز الفاعل عن فعله.
ويُراد به: ما يقدر عليه، لكن لا يفعله؛ لأنه لا يريده؛
فإنَّ وجود الفعل الاختياري ممتنع، فهو إذا لم يرده؛ امتنع وجوده؛ لعدم إرادته، لا لعجزه عنه، ولا لامتناع الفعل في نفسه.
ولهذا يقال: «إنَّ خلاف المعلوم ممتنع ومحال»، بمعنى: أن الله تعالى لا يشاء كونه، لا بمعنى: أنَّه سبحانه عاجز عنه لا يقدر عليه… إلى أن قال:
فقولُ الرَّازِي: (فعلُ القبيح: إِمَّا أن يكون ممتنعًا من الرَّبِّ، أو غير ممتنع)جوابه: «أنَّه ممتنع» بمعنى: أنَّه سبحانه لا يريده، لا بمعنى: أنَّه عاجز أو غير قادر، ولا أنَّه ممتنع في نفسه.
ولاحظ كيف يضرب ابن تيمية مثال وجوب وقوع الحادث بالعلم والعدل والرحمة (الحكمة) كما سبق أن نقلنا من النبوات قوله: “وقوع ما قدره الله واجب من جهات: من جهة علم الرب من وجهين، ومن جهة إرادته من وجهين، ومن جهة كلامه من وجهين، [ومن جهة كتابته من وجهين]، ومن جهة رحمته، ومن جهة عدله.”
فهم ينسبون له عين ما رده على الرازي في كلامه عن امتناع الظلم لذاته في شرح الأصبهانية حين قال له الشيخ:
“وحقيقة الأمر: أنه أخذ لفظ «الممتنع» و«الممكن» بالاشتراك والإجمال، ثم قال: «إن كان ممتنعاً؛ لم يكن قادراً، وإن كان ممكناً؛ لم يعلم عدمه». فإذا فُسِّرَ معنى «الممتنع» ومعنى «الممكن»؛ انجلت الشبهة، وأمكن الجواب عنها بعدة أوجه كما ذكرنا” (أي كما ذكر في النقل السابق)
ويقول في مقام رده عليه في شرح الأصبهانية أيضًا:
وقوله: (هذا الإيجاب يستلزم ألا يكون قادرًا)
قُلنا: لا نُسَلِّمُ، بل إذا كان هذا التَّرْك لعدم مشيئته لا لعدم قُدْرَتِهِ؛ كان ما وجب لمشيئته له لا يمنع كونه قادِرًا
ويقول: في جامع الرسائل لابن تيمية – رشاد سالم (1/ 129) :
“وحينئذ فليس في الوجود ظلم من الله سبحانه بل قد وضع كل شيء موضعه مع قدرته على أن يفعل خلاف ذلك فهو سبحانه يفعل باختياره ومشيئته ويستحق الحمد والثناء على أن يعدل ولا يظلم“
وهذا نظير قوله في درء تعارض العقل والنقل (9/ 114)
“بل الجائزات الموجوده كلها واجبة باعتبار فاعلها، وما لم يوجد من الجائزات، فهو جائز باعتبار يفسه، وهو ممتنع لغيره.
فكما أن ما وجد من الممكنات فهو واجب لغيره لا لنفسه، فما لم يوجد منها، فهو ممتنع لغيره لا لنفسه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فما شاء أن يكون، فلا بد أن يكون، وليس هو واجباً بنفسه، ولا له من نفسه وجوده، بل الله مبدعه.
وما لم يشأ لم يكن، فإنه يمتنع وجود شيء بدون مشيئة الله تعالى، وإن كان الله قادراً عليه، وهو ممكن في نفسه، أي يمكن أن يخلقه الله، لوشاء الله خلقه.”
فالممتنع خارجًا، هو الممكن في نفسه، الممتنع لغيره إما نوعًا أو عينًا عند ابن تيمية، وعكسه الممكن خارجًا الممكن لنفسه
فعند ابن تيمية كل ما شاء الله أن يخلقه فهو قادر على خلقه كيفما شاء، فإن شاءَ، اشترطَهُ بكذا، وإن لم يشأ، لم يَشترِطْهُ بكذا.، وإن شاء أن يخلقه من كذا لم يجز وجوده إلا من كذا، ولو علم أنه سيخلقه من كذا فلن يجوز وجوده إلا من كذا وهذا لا يناقض قدرته القديمة على كل المسميات والمخلوقات وقدرته على خلقها من أي شرط يريد، سواء خلقها من شيء أو بلا شيء إنما بشرط شيء،
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (8/ 391)
“والله سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها، وجعل خلق البعض شرطا وسببا في خلق غيره، وهو مع ذلك غنيٌّ عن الاشتراط والتسبب ونظم بعضها ببعض، لكن لحكمة تتعلق بالأسباب وتعود إليها، والله عزيز حكيم”
فاشتراطه خلق كذا من كذا بعينه فهذا لحكمته سبحانه، وطالما أنه شاء ذلك وعلم من نفسه مشيئة ذلك في الأزل فلن يتغير ذلك فإنه سبحانه لا يبدل القول لديه، لذلك يمتنع حصول إلا ما شاء ولو كان هو نفسه قادر على فعل خلافه في الأصل، يبين ذلك قول الشيخ في مجموع الفتاوى (8/ 10):
“{إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون} ولفظ الشيء في الآية يتناول هذا وهذا. فهو على كل شيء ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون موجودا قدير؛ لا يستثنى من ذلك شيء ولا يزاد عليه شيء كما قال تعالى: {بلى قادرين على أن نسوي بنانه} وقال: {قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم} وقد ثبت في الصحيحين: أنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم {أعوذ بوجهك فلما نزل: {أو يلبسكم شيعا} الآية قال: هاتان أهون} فهو قادر على الأولتين وإن لم يفعلهما وقال: {وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون} . قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم. ومعلوم أنه لم يذهب به وهذا كقوله: {أفرأيتم الماء الذي تشربون} إلى قوله: {وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون} وهذا يدل على أنه قادر على ما لا يفعله. فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجا وهو لم يفعله ومثل هذا: {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها} . {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض} . {ولو شاء الله ما اقتتلوا} . فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها.”
بل أوضح من ذلك قوله في شرح الأصبهانية ص422:
“يقال: لا ريب أن الله على كل شيء قدير، لكن لا يلزم إذا كان الشيء مقدورًا ممكنًا أن تكون الحِكْمة المطلوبة بوجوده تحصل مع عدمه، أو الحِكْمة المطلوبة مع عدمه تحصل مع وجوده؛ فإن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، والجمع بين الضدين ممتنع؛ فيمتنع.
ولهذا بَيَّن سبحانه قدرته على أشياء لم يفعلها، وبَيَّن حكمته في ترك فعلها”
ويقول في موضع آخر من شرح الأصبهانية (ج١ ص٣٦٥-٣٦٧) :
“فإذا علم سبحانه أنَّ فعله للشيء المعيَّن يناقض الحكمة التي لأجلها فعل لم يشأ فعله، مع كونه لو شاء لفعله؛ وهذا ليس يمتنع لنفسه، بل هو مقدور الله تعالى.” إلى أن قال”
“(إنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ)، فارادته له حين يريد خَلْقَه، وقوله له : كن، وما يستلزم ذلك؛ منا علمه بأن فعله فى تلك الحال لا ينافى حكمته والقدرة التى تختص بتلك الحال أمور وجودية بمجموعها حصل التأثير التام، والفعل الثام، المعين. وهذا أمر يُعقل في الشاهد والغائب. وعلى اصطلاحهم بمجموعها حصلت العلة التامة لوجود الحادث.”ثم قال: “وهم قد ضربوا مثلا في صدور الحادث عن الفاعل الواحد لانقضاء الحوادث المتقدمة – بالمسافر الذي يقطع المسافة، والحجر الذي يهبط من علو إلى سفل ؛ قالوا: فالموجب لقطع المسافة باقي دائما، لكن قطع الثانية مشروط بانقضاء قطع الأولى.
فيقال لهم: هذا المثال حجَّةً عليكم؛ فإنَّ القاطع ليس حاله عند الثانية والأولى سواءً، بل هو إذا قطع الأولى؛ تجدد له قدرة وإرادة لم تكن قبل قطعها”
ثم يبين أوجه وجوب هذه الحوادث بغيرها بالتفصيل فيقول:
في النبوات (2/ 912)
فمن جهة العلم:
“أمّا علمه: فما علم أنه سيكون، فلا بد أن يكون، وما علم أنه لا يكون، فلا يكون. وهذا مما يعترف به جميع الطوائف، إلا من ينكر العلم السابق؛ كغلاة القدرية الذين تبرأ منهم الصحابة.”
ومن جهة الحكمة:
“ومن جهة أنه يعلم ما في ذلك الفعل من الحكمة: فيدعوه علمه إلى فعله، أو ما فيه من الفساد، فيدعوه إلى تركه. وهذا يعرفه من يقرّ بأنّ العلم داع، ومن يقرّ بالحكمة.”
ومن جهة كلامه سبحانه:
“من جهة أنه أخبر به، وخبره مطابق لعلمه؛ ومن جهة أنه أوجبه على نفسه، وأقسم ليفعلنّه. وهذا من جهة إيجابه على نفسه، والتزامه أن يفعله.”
ثم يقول بعد أن ذكر عشرة وجوه في وجوب الجزم العلمي بحصول ما أراده الله في الخارج فقال: “فهذه عشرة أوجه تقتضي الجزم بوقوع ما سيكون، وأنّ ذلك واجبٌ حتمٌ لا بُدّ منه” فلاحظ أن كلامه على مقام العلم الدائر بين الجزم والشك في حصول حوادث معينة في الخارج وأن مشيئة الله وحكمته وعلمه يقتضي وجودها ثم يكمل:
“فما في نفس الأمر جوازٌ يستوي فيه الطرفان؛ الوجود، والعدم، وإنّما هذا في ذهن الانسان، لعدم علمه بما هو الواقع. ثمّ من علم بعض تلك الأسباب، علم الواقع؛ فتارة يعلم لأنّه أخبر بعلمه؛ وهو ما أخبرت به الأنبياء بوقوعه؛ كالقيامة والجزاء؛ وتارة يعلم من جهة المشيئة؛ لأنّه جرت به سنته الشاملة التي لا تتبدّل؛ وتارة يعلم من جهة حكمته، كما قد بسط في غير هذا الموضع” – النبوات لابن تيمية (2/ 914)
فالشاهد أن العلم بوجود أسباب تفضي لحدوث حادث معين بالعادة التابعة لإرادة الله وحكمته وسنته في العالم، ثم اجتماع هذه الأسباب وتمامها في نفس الأمر كما هو في علم الله ومشيئته وكتابته يفضي لوجود الشيء في نفس الأمر ولا يمكن للإنسان العالم أن يجزم أو يقول بإمكان شيء في الخارج دون إثبات إمكانه بأحد هذه الوجوه، وفرق بين القول بإمكان وقوعه بالعادة في الخارج وبين نفس وقوعه فعلًا وإمكان وقوعه كما هو في علم الله أي وجوب وقوعه في الخارج بمشيئة الله فالكلام في مسألة الجزم بما سيكون من قبل أن يكون.
وتفصيل المسألة بالمثال:
(إمكان النوع خارجًا) : أن الله خلق أفراد البشر في الخارج، فنوع البشر ممكن عقلًا لا يحمل علة امتناعه في مسماه، وقد علمنا ذلك لمشاهدة البشر في الخارج، وكذلك النوع ممكن في الخارج بخلاف أنواع الأحياء التي لم يخلقها مثل أفراد نوع (العنقاء)، ومن الانواع ما تكون ممتنعة خارجًا مثل نوع أفعال الظلم من الله، ومنها ما يكون واجبًا مثل نصرة المظلوم من الله سبحانه، وانفاذ وعيده، ومن الأنواع ما نخبر عن مسماها بأنها ممكنة خارجًا لثبوت بعض أفرادها، ثم تمتنع بعض أفرادها لأمر زائد عن نفس دخولها في مسمى النوع، كوجود إنسان ساحر تظهر عليه علامات النبوة، أو وجود إنسان هو ابن الله، فهذا يكون امتناعه في الخارج لشيء أزيد من مجرد كونه إنسان إذ ثبت أن نوع البشر لا يتعلق الامتناع الخارجي بنفس مسماه مثل الظلم، وهذا التفصيل ساقه شيخ الإسلام في كتاب النبوات في فصل الاستدلال بالحكمة وله تعلق كبير بمسألة سنن الله الكونية والعادة والاستقراء فليراجع فإنه نافع.
(إمكان الشخص خارجًا) : أننا قد نقول إن إمكان الشخص المعين في الخارج جائز لمسماه نفسه ودخول في نوع ممكن خارجًا لكن قد يكون اعتبار الامتناع الخارجي أزيد من نفس كونه من نوع معين ممكن خارجًا، كأن يقال هل “زيد” الذي هو ابن “خالد” ممكن في الخارج، فيقال لا لأن “خالد” عقيم، فزيد ليس ممتنع لنفسه لأن الله قادر أن يخلقه بلا أب أصلًا،، ولكن ممتنع من حيث أننا قيدناه بأن يكون ولدًا لخالد، وأن خالد عقيم، فصار زيد لأن الله لا يريد خلقه أصلًا ممتنع خارجًا.
فامتنع زيد خارجًا مع إمكان غيره من البشر خارجًا، بل وإمكان نوع البشر خارجًا، الذي علمناه بالحس.
ثم إن علمنا أن خالد ليس بعقيم فنقول إنه من الممكن في حدود علمنا عادة أن يكون له ولد إذ سبق منه إنجاب الأطفال، فان شاء الله يمكن أن يولد له زيد، لكن قد تأتي موانع خارجية تمنع ولادة زيد، لذلك ابن تيمية يقول أن العلم بالإمكان الخارجي المبني على العادة مفيد في إمكان النوع لكن لا يفيد بالقطع بإمكان الفرد الخارجي إلا بحس أو نقل صحيح أو استدلال بحكمة لله توجب وجود هذا الشيء بعينه إن أمكن ذلك.
بل إن تفصيل ابن تيمية في مسألة التعليق بالمشيئة متسق تمامًا مع تقريره هنا، فهو يفرق بين القدرة السابقة على الفعل والقدرة المقارنة له الموجبة للمعفول وقد طرد هذا التفصيل في رده على الرازي في شرح الأصبهانية في فصل التحسين والتقبيح فقال:”ولكن هو يقول في فعل العبد: «إنَّ القدرة والداعي توجبان وجود الفعل»، ولا يقول في فعل الربّ تبارك وتعالى مثل ذلك.” ثم يرد عليه فيقول:
فـ “قدرة الرب تعالى ومشيئته، وهي أولى بالإيجاب؛ كما قال تعالى: {وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا} (1)، وقال تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ} (2)، {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم} (3)، {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا} (4)، {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً} (5)، {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَبَعَثَ فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا} (6).
ومثل هذا مذكور في القرآن العزيز في غير موضع، يبين سبحانه أنه لو شاء الشيء؛ لكان، وهذا يبين أن مشيئته مستلزمة لوجود المراد، كما قال المسلمون: «ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن»، وذلك أنه سبحان قادر، فإذا حصل مع القدرة المشيئة؛ وجب وجود المراد، والله سبحان وأعلم.”
فنحن نعلق بالمشيئة ما أمكن حدوثه عادة فنقول إن شاء الله أن يكون لي ولد، ولا نقول إن شاء الله أن أشتري عنقاء! فإن هذا ليس في عادتنا في سنة الله وجوده فلا يعلق حصوله بالمشيئة بخلاف ما قام في نفوسنا أسباب العلم بإمكان نوعه ونظيره عادة لكننا متوقفين في الجزم بإمكانه هو في الخارج بحيث ألا تمنعه الموانع، ولا نجزم بوقوعه إلا بمشاهدته أو بإخبار الله لنا على وقوعه أو بغيرها من الأدلة الموجبة للجزم بوقوعه.
وبالطبع فالإمكان الذاتي (الذي هو حكم عقلي ذهني) هنا أي مجرد العلم بعدم امتناع المسمى واستلزامه للتناقض لذاته لا يفيد تجويز وجوده الخارجي بل فقط يفيد عدم استحالته، ومن باب أولى الشك بامتناعه الذاتي من عدمه، فكل أنواع الإمكان الذهني لا تفيد شيئًا يتعلق بإمكان وقوع الشيء في الخارج فضًلا عن وجوب وقوعه، بينما وقوعه يفيد إمكانه الذهني.
بل وفي نفس كتاب “النبوات” يرد على قول الأشاعرة في أن “كل مقدور مفعول” أي يمكن أن يفعله الله في الخارج وهذا لقولهم في مسألة الحسن والقبح فيقول:
“ومن أين علمتم أنّ الرب لا يخرقها مع دعوى النبوة إلاّ على يد صادق، وأنتم تجوّزون على أصلكم كلّ فعل مقدور، وخلقها على يد الكذاب مقدور؟!.”
فالله عنده لا يخلق خارق العادة الذي يختص بالدلالة على النبوة أبدًا على يد كذاب ومع ذلك فهو يقول أنه مقدور، فهو مقدور في نفس الأمر لإمكانه في ذاته، لكن الله لصفاته الزائدة على مجرد القدرة لا تجتمع قدرته مع مشيئه على إيجاد الخارق الدال على النبوة على يد كذاب وذلك لحكمة الله ورحمته وهدايته، ونظير ذلك ما قاله ابن تيمية في رده على الرازي في مسألة الظلم.
بل له نص ينقل فيه استحلال لعن من قال أن قدرة الله لا تتعلق بشيء من المقدور في الأزل! يقول في درء تعارض العقل والنقل (9/ 185)
“وإلا لزم أن يكون الرب لم يكن قادراً ثم صار قادراً، أو بالعكس من غير حدوث أمر أوجب انتقاله من القدرة إلى العجز وبالعكس.
وهذا فيه سلب للرب صفة الكمال، وإثبات التغير بلا سبب يقتضيه، وذلك مخالفة لصريح المعقول والمنقول.
ولهذا كان ما أنكره المسلمون على هؤلاء قولهم: إن الرب في الأزل لم يكن قادراً ثم صار قادراً، وهو مما استحل به المسلمون لعنة بعض من أضيف إليه ذلك من أهل الكلام، لا سيما من يسلم أن الرب تعالى لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات الكمال، فإنه يجب أن يصفه بأنه لم يزل ولا يزال قادراً، والقدرة لا تكون إلا على ممكن، فلزم إمكان فعله فيما لم يزل ولا يزال.
وقول القائل: من هؤلاء: أنه كان قادراً في الأزل على ما لم يزل، كلام متناقض.
فإنه يقال لهم: حين كان قادراً: هل كان الفعل ممكناً؟ فلا بد أن يقولوا: لا، فإنه قولهم.
فيقال لهم: كيف وصف بالقدرة مع امتناع شيء من المقدور؟ فعلم أنه مع امتناع الفعل يمتنع أن يقال إنه: قادر على الفعل.”
ولاحظ أنه يرفض القول بأن شيئًا من المقدور ممتنعًا! وبهذا يرد على من قال نحن نقول إن الحوادث كانت ممتنعة في الأزل وصارت ممكنة فيما لا يزال فعند ابن تيمية، فليست الأزلية عنده إلا صفة لموجود تعني أنه قديم لا بداية لذاته، وليست ظرفًا زمانيّا ينقضي فينقلب مع انقضائه إمتناع الحوادث فيه إلى إمكانها فيما بعده وهو ما لا يزال: يوضع ذلك قوله:
معنى الأزل عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
“ليس الأزل ظرفا معينا يقدر فيه وجود أو عدم، كما أن الأبد ظرفا معينا يقدر فيه وجود أو عدم، ولكن معنى كون الشيء أزليا: أنه ما زال موجودا، أو ليس لوجوده ابتداء، ومعنى كونه أبديا، أنه لا يزال موجودا، أو ليس لوجوده انتهاء.
ومعنى كون عدم الشيء أزليا: أنه ما زال معدوما حتى وجد، وإن كان عدمه مقارنا لوجود غيره.” – درء تعارض العقل والنقل، الثاني.
«وما من حين يقدر موجودا إلا وليس هو الأزل» – «درء تعارض العقل والنقل» (3/ 38)
“الأزل ليس هو شيئا معينا بل هو عبارة عن عدم الأولية كما أن الأبد عبارة عن عدم الآخرية فما من وقت يقدر إلا والأزل قبله لا إلى غاية”- الصفدية (1/ 65)
“قالوا: إن الممتنع هو القدرة على الفعل في الأزل، فنفس انتفاء الأزل يوجب إمكان الفعل والقدرة عليه.
قيل لهم: الأزل ليس هو شيئاً كان موجوداً فعدم، ولا معدوماً فوجد، حتى يقال: إنه تجدد أمر أوجب ذلك، بل الأزل كالأبد، فكما أن الأبد هو الدوام في المستقبل، فالأزل هو الدوام في الماضي، فكما أن الأبد لا يختص بوقت دون وقت، فالأزل لا يختص بوقت دون وقت، فالأزلي هو: الذي لم يزل كائناً، والأبدي هو: الذي لا يزال كائناً، وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه، الذي ليس له مبتدأ ولا منتهى، فقول القائل: (شرط قدرته انتفاء الأزل) كقول نظيره: (شرط قدرته انتفاء الأبد) .
فإذا كان سلف الأمة وأئمتها وجماهير الطوائف أنكروا قول الجهم في كونه تعالى لا يقدر في الأبد على الأفعال، فكذلك قول من قال: لا يقدر في الأزل على الأفعال، وقول أبي الهذيل: (إنه تعالى لا يقدر على أفعال حادثة في الأبد) يشبه قول من قال: (لا يقدر على أفعاله حادثة في الأزل)“- درء تعارض العقل والنقل (2/ 225)
فلا معنى قولهم إن الحادث كان ممتنعًا لذاته في الأزل إذا، بل الصواب أن يقال إن الحادث يمتنع أن يكون قديمًا لا بداية له، لكن لم تزل تتعلق قدرة الله بخلقه متى شاء من الأزل إلى الأبد بالشروط التي يريدها من الأزل إلى الأبد وتأخيره لذلك هو بمشئته وحكمته بل وتأخير شروط حدوثه عن وقت دون وقت هو لمشيئته، وقد نقلنا آنفًا قوله في شرح الأصبهانية: “وحينئذ: فإذا صار الفعل والمفعول ممكنا بعد أن كان ممتنعا، لم يكن ذلك لامتناع ذاته بل لإمكان لوازمه وانتفاء موانعه التي هي شروط فيه”
وسأنقل نصّا آخر في شرح الأصبهانية يقول فيه:
“لَمَّا ناظرهم الجهمية والقدرية؛ وادَّعوا أن الرَّبَّ لم يزل غير متمكِّن من أن يفعل ويتكلم1 بمشيئته، ثم صار متمكِّنًا2 من أن يفعل ويتكلم بمشيئته وقدرته، إما كلامًا مخلوقًا له على قول المعتزلة وغيرهم، وإما قائمًا به على قول الكَرَّامِيَّة وغيرهم – تسلَّط عليهم أولئك الدهرية، وقالوا: هذا يستلزم أنه صارت المفعولات والفعل ممكنة بعد أن كانت ممتنعةً من غير سبب أوجب ذلك، وأنها انتقلت من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي من غير سبب.
بل وشنَّعَ عليهم أئمة السنة وغيرهم من المسلمين بأن هذا يستلزم أن يكون الربُّ صار قادرًا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرًا عليه من غير سبب يوجب ذلك، وفيه وصف الرَّبِّ تعالى بعدم القدرة في الأزل، وفيه أن القدرة تجددت له من غير سبب يوجب تجددها.
فالتزمت المتكلمة من الجهمية والقدرية ومن اتَّبعهم من الكَرَّامية والكُلَّابية وغيرهم – هذا المعنى، وقالوا: نقول: إنه كان قادرًا في الأزل على الفعل فيما لا يزال.
فقيل لهم: إذا كان هذا الفعل في الأزل ممتنعًا عندكم: امتنع أن يكون مقدورًا في الأزل، فإن المقدور لَا بُدَّ أن يكون ممكنًا، فإذا أثبتم قادرًا في حال يمتنع فيها مقدوره؛ كنتم قد جمعتم بين النقيضين؛ وحقيقة قولكم أنه في الأزل قادرٌ ليس بقادر.
وقالوا لهم: إمكان الفعل والإحداث لا أول له، فإنه ما من وقت يفرض فيه الفعل إلا والإحداث فيه ممكن، فحينئذٍ لم يزل الفعل ممكنًا؛ فلم يزل قادرًا على الفعل.
قالوا: إذا قلنا: الفعل بشرط كونه مسبوقًا بالعدم لا أول له – لم يكن لهذا الإمكان بداية، مع أنه لا يستلزم دوام الفعل؛ فإنه قد شرطنا أن يكون مسبوقًا بالعدم.
فقال لهم الناس: أنتم قدَّرتم تقديرًا جمعتم فيه بين النقيضين، فإنكم قلتم: ما هو مسبوق لا أَوَلَ له، وما لا أَوَلَ له لم يسبقه شيء، فإذا جعلتموه لا أَوَلَ له، وقلتم: إنه مسبوق بالعدم – جمعتم بين النقيضين.
وقد يعبِّرون عن هذا: إن إمكان الأزلية غير أزلية الإمكان، أو بأن صحة الأزلية غير أزلية الصحة، وأنه لا يستلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر.
فقال لهم الناس: بل هذان المعنيان ملازمان، وإذا كانت الأزلية ممكنة، فالإمكان أزلي، وإذا كان الإمكان أزليًّا، فالأزلية ممكنة، فإنه إذا كان إمكان الفعل أزليًّا لم يزل، كان إمكان الفعل دائمًا أبدًا، فلا أول لإمكان الفعل، وهذا هو أزلية إمكان الفعل، وهو يستلزم إمكان أزلية الفعل؛ فإنه يتضمن أنه لم يزل الفعل ممكنًا، وهذا هو المراد بإمكان أزلية الفعل، وهو إمكان دوام الفعل، وإمكان كون الفاعل لم يزل فاعلًا.
فقال مُتَكَلِّمة الجهمية والقدرية: والإحداث والفعل لا يُعْقَل إلا مسبوقًا بالعدم؛ فإن معنى كون الشيء مفعولًا هو معنى كونه محدَثًا؛ والمحدَث لا يكون إلا مسبوقًا بالعدم.
فقال أهل السنة الذين ليس في قولهم ما يناقض صريح المعقول ولا صحيح المنقول: هذا الكلام حق أيضًا، وهو دليل على بطلان قول الفلاسفة الدهرية، الذين يقولون: إنه قديم وهو مفعول للرب. فإن كل ما هو مفعول فهو محدَث، لكن فُرِّق بين حدوث نوع الفعل والكلام وحدوث عين الفعل والكلام – بأنا نعقل أن كل ما يفعله فلَا بُدَّ أن يكون مُتَقَدِّمًا عليه، ونعقل أنه يمكن أنه لم يزل فاعلًا متكلمًا، ونعقل أنه يمكن دوام كونه متكلمًا فَعَّالًا، وأن تكون كلماته لا نهاية لها؛ كما قال تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} [الكهف: 109] 1، وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [لقمان: 27].
ولهذا نعقل أنه سبحانه يفعل ويتكلم، وإن كان كل واحد من أعيان ذلك ينقضي وينفد، وجنس الفعل والمفعول لا انقضاء له ولا نفاد؛ كما قال تعالى: {أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا} [الرعد: 35]، وقال تعالى: {إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ} [ص: 54] 3؛ فالجنس دائم لا نفاد له، وإن كان كلٌّ من أجزاء الأُكُل والرِّزْق له نفاد، وهو لا يدوم.”
فقول الفائل لم يزل الله قادرًا على إحداث شيء، معناه أن حدوث شيء في الأزل بحيث يصير أزليّا لا بداية له ممكنًا! إذ كما قدمنا ليس الأزل لحظة معينة حتى يمكن حدوث شيء فيها أو لا يمكن، بل معناه أن في الله قدرة قديمة على إحداث كل شيء، وحدوثه هو بدايته، لكن قبل حدوثه يسبقه عدمه الأزلي، وكل لحظة ماضية في هذا العدم الأزلي كان الله قادرًا على أن يحدثه فيها بلا ابتداء لهذه القدرة، ولو قدرنا حدوثه في أي لحظة من الأبد إلى الأزل بلا ابتداء لهذا التقدير فسيكون حادثًا فيها لا قبلها ولا بعدها، ولن يكون ممتنعًا ذاتيّا قبلها.
خلاصة القول في شبهتهم في خلطهم بين اعتبار الإمتناع بالذات واعتبار الامتناع بالغير:
فالشيء الممكن لذاته إذا كان فرضه بقيود أو حيثيات أو شروط تستلزم ممتنع زائدة على نفس ذاته وبتلك الحيثيات صار الفرض كله بالنظر لمجموع مافيه ممتنعًا لذاته بمعنى أنه يقتضي الجمع بين النقيضين، لا أن نفس مسمى الشيء ممتنع لذاته في الأزل.
مثال ذلك: قولي “إنسان معين موجود ومعدوم معًا” فهذا بمجموعه مع قيوده ممتنع لذاته، أو كفرض وجوده مع وجود ما يمنعه في الخارج كمشيئة الله ألا يكون، فيمتنع وجوده ووجوده في الخارج مع موانعه التامة يستلزم الجمع بين النقيضين.
لا أن نفس مسمى الإنسان بغير قيد وشرط ممتنع يصير أيضًا ممتنع لذاته ومسماه!، وتذكر تفصيل ابن تيمية في مسألة الظلم ومسألة خرق العادة على يد الكذاب ومسألة مسمى الحركة وجوازه الأزلي ثم بيان سبب تأخر أجزاء الحركة بعضها على بعض لكونها مشروطة بانقضاء بعضها، يستبين لك الأمر كله.
فالخلاصة كما ترون، أن تفصيله في النبوات لا يخالف تفصيله في رسالة حدوث العالم وسائر كتبه بل يكاد يتطابق اللفظ باللفظ فضلًا عن تطابق المعنى مع المعنى.
خلطهم بين ما علم إمكانه في نفسه من إمكانه الخارجي وبين ما لم يقم دليل حسي على إمكانه في نفسه
ينص شيخ الإسلام أن كل ما تتصوره في عقولنا من أشياء عند ابن تيمية قد تحصلنا عليها من الحس كقوله:
“«فإن قال: أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ كان هذا مكابرة لعقله، فإن العلوم الكلية المطابقة للأمور الخارجية ليست مغروزة في الفطرة ابتداء بدون العلم بأمور معينة منها، لكن لكثرة العلم بالأمور المعينة الجزئية يجرد العقل الكليات، فتبقى القضية العامة ثابتة في العقل لا تحتاج إلى شواهد وأمثلة جزئية، إلا أن يكون علم تلك القضية العقلية من تركب قضايا أخر، وقوله: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد) ليس من هذا ولا من هذا».”
فالعلم بالإمكان الخارجي الحسي يتضمن العلم الثبوتي بالإمكان الذاتي لمسمى الحادث المعين ونوعه، وركز أن هناك فرق بين الإمكان الخارجي نفسه وبين العلم به، والذي هو عنده علم بالحس والاستقراء ثم القياس.
يبين ذلك قوله في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (2/ 515):
“إن عدم استبعاد البديهة لايقتضي عدم استبعاد العلم النظري وكذلك كونه غير مدفوع في بديهة العقل لا يقتضي أنه لايكون مدفوعًا في نظره فإن حاصل هذا أنه لا يعلم بالبديهة امتناع هذا وفرق بين أن لايعلم بالبديهة امتناعه وبين أن يعلم بالبديهة إمكانه وإذا لم يعلم بالبديهة امتناعه لم يجز أن يقال فعلمنا أنه لايلزم من عدم نظير الشيء عدم الشيء فإن هذا لم يعلم مما ذكره إنما أفاد ماذكره عدم العلم البديهي بوجود موجود لانظير له لم يعدم وجود علم بإمكانه ولو كان قد قال نعلم بالبديهة أن الشيء قد يكون موجودًا ولا يكون له نظير ونعلم بالبديهة إمكان وجود شيء لانظير له لكان الدليل تامًّا لكن هو لم يذكر إلا الإمكان الذهني دون الخارجي والإمكان الذهني ليس فيه علم لا بالامتناع ولا بالإمكان ولكن العلم بالإمكان الخارجي فيه بالإمكان“
ومعلوم أن هذا في البشر فقط وإلا فالله علمه قديم لا يفتقر فيه لاستقراء النظائر للعلم بالإمكان الذاتي أو الخارجي!
بل معلوم أن ما لا يعلم الله وقوعه فهو ليس بواقع، كقوله تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـٰٓؤُلَآءِ شُفَعَـٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
يبين ذلك قوله في درء تعارض العقل والنقل (1/ 31)
“وما يحتج به بعضهم على أن هذا ممكن بأنا لا نعلم امتناعه كما نعلم امتناع الأمور الظاهر امتناعها مثل كون الجسم متحركا ساكنا فهذا كاحتجاج بعضهم على أنها ليست بديهية بأن غيرها من البديهيات أجلى منها وهذه حجة ضعيفة لأن البديهي هو ما إذا تصور طرفاه جزم العقل به والمتصوران قد يكونان خفيين فالقضايا تتفاوت في الجلاء والخفاء لتفاوت تصورها كما تتفاوت لتفاوت الأذهان وذلك لا يقدح في كونها ضرورية ولا يوجب أن ما لم يظهر امتناعه يكون ممكنا بل قول هؤلاء أضعف لأن الشيء قد يكون ممتنعا لأمور خفية لازمة له فما لم يعلم انتفاء تلك اللوازم أو عدم لزومها لا يمكن الجزم بإمكانه والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره والإمكان الذهنى حقيقته عدم العلم بالامتناع وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان الخارجى بل يبقى الشىء في الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجى وهذا هو الإمكان الذهني فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الشيء ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن إمتناعه بخلاف الإمكان الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعا
و(الإنسان يعلم) الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره وتارة بعلمه بوجود ما الشيء أولى بالوجود منه فإن وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه ثم إنه إذا تبين كون الشيء ممكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا فمجرد (العلم بإمكانه) لا يكفى في إمكان وقوعه إن لم يعلم قدرة الرب على ذلك فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله { أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا } سورة الإسراء 99 وقوله { أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم } سورة يس 81 قوله { أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير } سورة الأحقاف 33 وقوله { لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس } سورة غافر 57 فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك
وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله { وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه } سورة الروم 27 ولهذا قال بعد ذلك { وله المثل الأعلى في السماوات والأرض } سورة الروم 27 وقال { يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم } سورة الحج”
ولاحظ كيف جعل الإمكان الخارجي هو حكم علمي مبني على بيان قدرة الفاعل بأدلة حسية، ومنها نعلم إمكان الشيء لذاته وإمكان وقوعه، إذ لو كان ممتنعًا لذاته لما وقع، ولو كان ممكنًا لذاته لكن لا يقدر الله عليه لما وقع، ولو كان ممكنًا لذاته ممتنعًا لغيره في الخارج، أي أن حكمة الله ومشيئته تمنع وجوده لما وقع.
فلاحظ أنه يتكلم عن طرائق البشر في المعرفة، ويتحدث عن الإمكان الذهني بوصفه مجرد عدم علم بالامتناع سواء قدرنا أنه عدم علم بالامتناع الذاتي، او عدم علم بالامتناع الخارجي، ويربط حكم الإمكان الخارجي ببيان قدرة الرب على الشيء، فمنها نعلم إمكانه الذاتي إذ لو كان ممتنعًا لما تعلقت به القدرة، وكذلك نعلم إمكانه الخارجي.
يبين ذلك أيضًا قوله رحمه الله في مجموع الفتاوى (9/ 226):
“والمقصود أن الإمكان الخارجي يعرف بالوجود لا بمجرد عدم العلم بالامتناع كما يقوله طائفة منهم الآمدي. وأبعد من إثباته الإمكان الخارجي بالإمكان الذهني ما يسلكه المتفلسفة كابن سينا في إثبات الإمكان الخارجي بمجرد إمكان تصوره في الذهن”
فبالنسبة لطرق البشر في علمهم: فإذا شاهدنا الحركة المعينة، علمنا إمكانها وإمكان نظيرها لنفسه وأن نوعها لا يحمل علة امتناعه في مسماه فيكون مسماها الأزلي في علم الله لم يزل ممكنًا لا يحمل علة إمتناعه في مسماه، ولو امتنع بعض أفرادها لغيرهم فيقول في بيان ذلك: “إن الإمكان الذاتي ثابت بالضرورة والاتفاق، وما من وقت يقدر فيه الإمكان إلا والإمكان ثابت قبله، لا إلى غاية، فليس للإمكان ابتداء محدود.
يبين ذلك: أنه قد يقال: صحة الحركة إو إمكان الحركة أو جواز الحركة، وصحة الفعل أو جواز أو إمكان الفعل إما أن يكون به ابتداء وإما أن لا يكون، فإن لم يكن له ابتداء لزم أنها لم تزل جائزة ممكنة، فلا تكون ممتنعة، فتكون جائزة في الأزل.” – «درء تعارض العقل والنقل» (2/ 394)
ويقول:
“مسمى الحركة إما أن يكون ممتنعا في الأزل، وإما أن لا يكون، فإن لم يكن ممتنعا في الأزل ثبت إمكانه، فيكون مسمى الحركة ممكنا في الأزل، وإن كان ممتنعا في الأزل فامتناع إما لنفسه، وإما لموجب واجب بنفسه، أو لازم للواجب، وحينئذ فلا يزول الامتناع” – درء التعارض، المجلد الثاني.
بل كلامه المعروف في مسألة دليل الافتقار متسق تمامًا مع تقريراته هنا إذ يقول في الصفدية (2/ 189) :
“فكل ما سوى الله فإنه بذاته فقير إليه لا يتصور أن لا يكون فقيرا إليه وفقره إلى الله ليس لعلة أوجبت له أن يكون فقير بل فقره لذاته.
وأما كونه محدثا وكونه ممكنا يقبل الوجود والعدم فهذا دليل على فقره ومستلزم لفقره فإن المحدث كان معدوما وما كان معدوما لم يكن موجودا بنفسه بل بغيره وكذلك ما كان يقبل الوجود والعدم فإنه ليس له من ذاته أن يكون موجودا وهذا مثل قولنا مصنوع مخلوق ونحو ذلك فإن ذلك دليل على افتقاره وإلا ففقر الأشياء واحتياجها إلى الخالق هو لذاتها وقولنا لذاته هو بحسب ما اعتيد من الخطاب وإلا فليس لها ذات دونه توصف بفقر ولا غنى بل هو المبدع لإنياتها ولا إنية لها بدون إبداعه ولا دوام لإنياتها بدون إبداعه ولا علة لذلك أصلا كما أن وجوبه بنفسه لا علة له واستغناؤه عن غيره لا علة له.”
فالذي دلنا على فقرة وإمكانه الذاتي الذي لا يعلل الثابت لمسماه ولكل ما يشترك معه في مسماه (نظيره)، هو حدوثه المحسوس ووجوده الخارجي، فكشف لنا عن حكم عقلي ثابت لذاته أزلًا وهو أنه ممكن ذاتيّا ليس بواجب لذاته ولا ممتنع لذاته، يقول نظير ذلك في درء تعارض العقل والنقل (3/ 100) :
“والحادث عدم ووجد أخرى، فلا يكون ممتنعاً لأن الممتنع لا يوجد ولا واجباً بنفسه لأن الواجب بنفسه لا يعدم، فثبت أنه ممكن، وثبت أن في الموجودات ما هو ممكن بنفسه وأنه ليس كلها ممكناً، فثبت أن فيها موجوداً ليس بممكن، والموجود الذي ليس بممكن هو الواجب بنفسه، فإن الموجود إما أن يكون وجوده بنفسه وهو الواجب أو بغيره وهو الممكن، ولا يجوز أن يكون ممتنع لأن الممتنع هو الذي لا يجوز أن يوجد فيمتنع أن يكون في الوجود ممتنع.
فتبين أن في الموجودات واجباً وممكناً، وليس فيها ممتنع.”
ومسلكه هو عكس ما انتقده على خصومه بإثبات الإمكان الخارجي من الذاتي يبين ذلك قوله في الرد على المنطقيين (ص: 322):
“وابعد من اثباته الإمكان الخارجي بالإمكان الذهني ما يسلكه طائفة من المتفلسفة والمتكلمة كابن سينا والرازي وغيرهما في إثبات الإمكان الخارجي بمجرد إمكان تصوره في الذهن كما أن ابن سينا واتباعه لما أداروا إثبات موجودفي الخارج معقول لا يكون محسوسا بحال استدلوا على ذلك بتصور الإنسان الكلي المطلق المتناول للافراد الموجودة في الخارج وهذا إنما يفيد إمكان وجود هذه المعقولات في الذهن فإن الكلي لا يوجد كليا إلا في الذهن وهذا ليس مورود النزاع وإنما النزاع في إمكان وجود مثل هذا المعقول في الخارج وليس كل ما تصوره الذهن يكون موجودا في الخارج كما يتصور الذهن فأن الذهن يتصور ما يمتنع وجوده في الخارج كما يتصور الجمع بين النقيضين والضدين.”
رد ابن تيمية على من قال أن الله لا يقدر على الخلق إلا بوجود غيره من المواد
يجعل شيخ الإسلام الافتقار إلى المحل القابل أمارة حدوث فقال في بيان تلبيس الجهمية:
“فهو في إعطائه غير مستقل؛ بل لابد له من شريك ومعاون، وهذا لأنه ليس في المخلوقات ما هو مؤثر تام، فلا شيء يؤثر وحده، ولا شيء إذا أثر يكون الأثر واجبًا معه مطلقًا؛ بل قد يكون له من المعارضات ما يمنع أثره.
ومن أظهر ما يسمى مؤثرًا الشمس في الإشراق والتسخين، وهي لا تشرق إلا مع شيء آخر يقابلها، يتعلق شعاعها عليه، فيكون الضوء والشعاع حادثًا بسببين: بسببها، وبسبب الجسم المقابل لها، الذي يحل به الشعاع، ثم إن موانع الضوء والشعاع من السحاب وغيره موجودة مشهودة، وكذلك تسخينها مشروط بالمحل الذي تقوم به السخونة، وموانع السخونة”
ويقول:
“ولهذا كان من أصول أهل السنة أنه لاخالق إلا الله، ولا فاعل مستقل بالفعل ولا مؤثر تامًا غيره، وذلك أن كل ما يقدر غيره مما له فعل وتأثير ففعله موقوف على شروط من غيره يكون شريكًا وممنوع بمعارضات من غيره، وله كفو يفعل كفعله، وله شريك وله ندّ وله كفو.”
وهو نظير قوله في الصفدية (2/ 129)
“والقديم لا يجوز أن يكون مفتقرا إلى الحوادث لافتقار المعلول إلى العلة ولافتقار المشروط إلى الشرط ولكن قد تكون الحوادث لازمة له مفتقرة إليه وأما هو فلا يكون مفتقر لا إلى عينها ولا إلى نوعها”
ومثله يقول في مسألة حدوث العالم (ص: 64):
” فبيّن أنه سبحانه ليس له ظهير يظاهره ويعاونه على شيء من الأشياء، بل هو الغني عن كل شيء في كل شيء، وأن ما خلقه من الأسباب لم يخلقه لحاجته في خلق المسبب إليه؛ بل لأن له في خلقه من الحكمة ما له في خلق المسببات أيضاً؛ كما قال تعالى لما أمر المؤمنين بجهاد الكفار: {ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ}.”
والقائلون بأن الله يمتنع أن يخلق بغير مادة يقولون أن الله لو أفنى كل ما سواه لامتنع عليه الخلق لسبب حدث في غيره ولعدم كفاية نفسه في إيداع شيء سواه بما يخالف قول ابن تيمية رحمه الله في مسألة حدوث العالم (ص: 63): “إبداعه للأشياء لا يفتقر إلى مادة، بل نفسه كافية في إبداعها”، ولابن تيمية كلام في نظير هذا في برهان التمانع فيقول: “وأما القادر إذا كان ممنوعًا من غيره لا يقدر مع وجود الغير على ما يقدر عليه حال عدمه؛ فإنه يلزم أن يكون عاجزًا ممنوعًا بغيره، وهذا يقدح في قدرته.” – شرح الأصبهانية
فكذلك يجعل عجزه عن شيء مطلقًا بغير وجود الغير افتقارًا ونقصا وهذا بخلاف الشرط الذي يكون بإرادة الله وقدرته لا لامتناع المخلوق لذاته وعدم تعلق القدرة به كما بيناه من كلامه آنفًا حيث قال: “وحينئذ: فإذا صار الفعل والمفعول ممكنا بعد أن كان ممتنعا، لم يكن ذلك لامتناع ذاته بل لإمكان لوازمه وانتفاء موانعه التي هي شروط فيه.”
بل بعضهم يهرب من هذه المعضلة أي أن الله لو أفنى في لحظة كل ما سواه لما اكتفى في خلق شيء في اللحظة التالية بذاته سبحانه إذ لم توجد معه مادة يخلق منها ولو كانت ذبابة! فيقولون بل يمتنع عليه أن يفني آخر مخلوق! هروبًا من هذا الإلزام مع أن شيخ الإسلام يجعل أخص خصائص الممكن المفتقر بذاته هو قابلية العدم يقول في درء تعارض العقل والنقل (3/ 100): “وإن شئت قلت: إما أن يقبل من جهة نفسه العدم وهو الممكن، أو لا يقبل العدم وهو الواجب بنفسه، وإن شئت قلت إما أن يفتقر إلى غيره وهو الممكن أو لا يفتقر وهو الواجب.” فامتناع عدم الأخير إما لذاته وهذا لا ينسب لممكن عند ابن تيمية، أو لغيره فهي مشيئة الله والكلام الآن عن محض تعلق القدرة لا تعلق المشيئة، فليس كل مقدور مفعول لكن لا معنى للقدرة إلا القدرة على الفعل لو اقترنت بها المشيئة، فأنتم تجيزون قدرة الله على إفناء قدرته الذاتية على الخلق لو أفنى كل ما سواه! فيصير فناء ما سواه في لحظة معينة يقتضي فناء كمال من كمالاته القائمة بنفسه! أو يلزمكم أن تقولوا أنه عاجز عن ممكن، ولا يفيدكم أن تقولوا كماله يقتضي ألا يفعل هذا، فصار زوال كماله الذاتي ممكن لكنه يفعل فعلًا به يحفظ صفاته الذاتية من الزوال وكأن هذا ممكن في الأصل! كقول القائل يجوز على الله إعدام ذاته لكنه لا يفعل ذلك بمشيئته ولو شاء لفعل! فإن ذاته بصفاتها يمتنع عليها الزوال.
وختامًا نقول أن شيخ الإسلام بأقواله هذه خارج تمامًا عما ألزم به خصومه في النبوات حين قال:
“والذي يقول إنّ جنس الحوادث حدثت لا من شيء، هو كقولهم: إنها حدثت بلا سبب حادث، مع قولهم إنّها كانت ممتنعة، ثم صارت ممكنة، من غير تجدّد سبب، بل حقيقة قولهم أنّ الربّ صار قادراً بعد أن لم يكن، من غير تجدّد شيءٍ يُوجِب ذلك.”- النبوات لابن تيمية (1/ 328)
فكما بينا أنه يقول لهم أنتم تقولون أن الله لم يخلق شيء من شيء لقولكم أن جنس الحوادث والجواهر حدثت بلا سبب حادث، فيلزمكم الترجيح بلا مرجح، والخ..
أما هو ففي رسالة حدوث العالم وغيرها لم يزل يثبت القدرة والحكمة كما فعل في النبوات، بل تسلسل الحوادث وتسلسل الخلق! والقدرة القديمة والمتجددة (التامة المقارنة للمشيئة) على ذلك (التي هي إمكان خارجي عند الشيخ) وتحقق الشروط (الحكمة = ترجيح المشيئة بمرجح) التي قد يكون منها المحل القابل (المادة)، أو مخلوق سابق يجعل من الحكمة اختصاص ما بعده بزمان أو بحيز معين بخلق فيه لحكمة معينة تخص هذا الحيز وتميزه عن غيره من الأحياز والأزمان، فلا يلزمه ما ألزمهم.
فادعائهم أنه رجع عن قوله بالاكتفاء بالإمكان الذهني إلى القول بالإمكان الخارجي في النبوات مجازفة كبيرة أجنبية عن تراث شيخ الإسلام فلم يزل شيخ الإسلام يثبت الحكمة والقدرة والمشيئة التي بمجموعها وتجددها توجب إمكان الحادث المعين الخارجي ووجوب وقوعه في وقت دون وقت.
بل دعوى أن كتاب النبوات آخر كتبه فيها نزاع: إذ يقول الباحث فارس العجمي:
“القول بأن النبوات آخر مؤلفات ابن تيمية عندي محل شك، لكنه من مؤلفاته المتأخرة التي كتبها في آخر حياته، حتى المسألة التي اشتهرت هذه الفترة الأخيرة وأنه قالها في هذا الكتاب وهي مسألة الخلق من مادة، موجودة في بعض مصنفات ابن تيمية الأخرى، على الأقل في مصنفين آخرين، وإن كان ثم إشارات في مصنفات أخرى.”
فهل سبقني أحد إلى قولي أن الجهة منفكة بين ما أثبته في النبوات وما نفاه في رسالة حدوث العالم
أقول نعم بحمد الله، ولن أذكر الشهادات السماعية التي دارت في مجالس خاصة، بل سأكتفي بما يمكن التحقق منه ومنشور على الشبكة.
يقول الباحث الدكتور يوسف سمرين:
“ولينصر قدم العالم، يقدم حجة مفادها أن الحادث قبل وجوده كان ممكن الوجود، وهذا الإمكان ليس هو القدرة عليه، لأن غير الممكن غير مقدور عليه كالمستحيل، فلما ثبت أن الشيء قد يكون غير ممكن في نفسه، ولا يتعلق بالقدرة، إذا فالقول بأن شيئًا ممكن الوجود لا يعني أنه القدرة عليه، وفي توحيد بين تصور ممكن في نفسه دون القدرة عليه، وبين الواقع كما هو شأن المثالية يختم حجته بقوله: «وليس شيئًا معقولًا بنفسه يكون وجوده لا في موضوع، بل هو إضافي فيفتقر إلى موضوع، فالحادث يتقدمه قوة وجود، وموضوع» فهو: «يريد بيان كون كل حادث مسبوقًا بموضوع أو مادة».
ويقصد بالموضوع «محلها» ليس القدرة عليه، لكوننا نتصور الممتنع دون تصور القدرة، فالممكن موجود عنده دون القدرة، فابن سينا يجعل لتصوره العقلي وجودًا في الواقع، فهناك محل، ومادة موجودة في الواقع تسبق أي محدث لأنه يتصوره معقولًا في نفسه.” – نظرية ابن تيمية في المعرفة والوجود.
بل يجعل يوسف سمرين هذا القول نابع عن مثاليتهم فيقول:
“«والجوهر عند أرسطو يقوم بذاته، ولا يختلف من حيث الدرجة عن سواه فلا يقال في الرجل مثلًا إنه أبلغ رجولية عما سواه، ووجود الجوهر الذاتي عبارة عن اتحاد الصورة والمادة»، فأرسطو لما أراد إثبات الأشياء، كان لا بد عنده من مثال سابق عليها، وهذا المثال لا يقوم بالله كصفة له فليس العلم بالأشياء من صفات الله عنده، فأخرج العلم خارج الله ليصير (مبدأ الصور، أو المثال)، ثم لما كان الله عنده لا يتحرك، وهو محرك لغيره فحسب، أخرج قيام إمكان قيام الفعل به ليصير خارجه فقال بـ(الهيولى)، وبالتالي (الاستعداد) أو محل الإمكان خارجه، يتحد مع الصور (العلم) لتتعين الأشياء. ” – نظرية ابن تيمية في المعرفة والوجود.
بل وغيره من الباحثين كأحمد عصام نجار والدكتور أبو الفداء مسعود وسلطان العميري وغيرهم ممن يحملون نصوص الخلق من مادة على الحكمة والمشيئة لا على عدم تعلق القدرة بغير ذلك!
هذا والله أعلم
للاستزادة:
نقولات جامعة ومهمة عن شيخ الإسلام في مسألة إمكان الأزلية وأزلية الإمكان
في جواب شبهة هل الإمكان الذهني علم أم ليس بعلم؟
المَسَالِكُ المُحْكَمَة في نَقْضِ دعوَى وُجُوبِ الخَلْقِ مِنَ المادَّة
مناقشة ثلاثة اعتراضات على فصل (الخلق لا من مادة) في المجلد الثاني من كتاب (مسألة حدوث العالم).




![نفائس في الحكمة والتعليل [2] 4 ad6c78b635c8bdf2c87b9887ec76ea455 نفائس في الحكمة والتعليل [2]](http://mlugzamz35e7.i.optimole.com/cb:4Ifa.d56/w:390/h:220/q:mauto/rt:fill/g:ce/https:/srajarabic.com/wp-content/uploads/2025/07/ad6c78b635c8bdf2c87b9887ec76ea455.jpg)