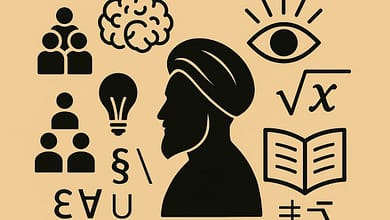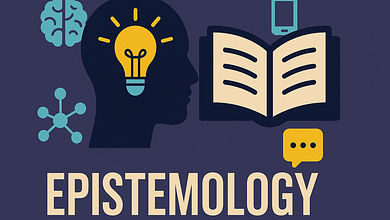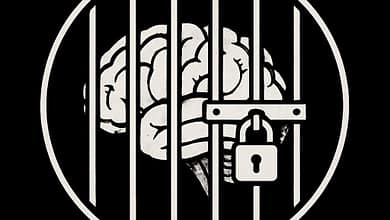تصلني الكثير من الأسئلة حول علاقة الضرورات بالقبلية والبعدية، وهذا مقال سأطرح فيه مشكلة هذه الطريقة في بحث هذه المسألة
أبدأ بنقل من كتاب “الكشاف المبين” لـ د. أبو الفداء ابن مسعود حيث يقول:
“حتى تلك الدعوى التي تمسك بها «بلانتينغا» من القول بأن ثمة حقائق بدهية كبرى لا بد من التسليم بصحتها من غير التماس برهان، وأن من تلك الحقائق وجود الباري جل وعلا بالغيب (وهو ما تكلم فيه تحت ما يسمى بالإبستمولوجيا المقومة Reformed Epistemology)، حتى تلك الدعوى نفسها، بذل الرجل من وقته وجهده ما بذل من أجل إقامة البرهان النظري عليها والرد على المخالفين فيها، فوقع في التناقض بمجرد ذلك! إذ لو كان صادقا في اعتقاده أنها بدهيات أو عقائد أساسية Basic Beliefs لا تفتقر إلى برهان، ما سعى في إثبات صحة موقفه في جعلها بدهيات لا تفتقر إلى برهان، لأن هذا المسعى منه يسوغ لخصمه أن يخالفه فيما يزعم هو أنه لا يصح وصف العقل إلا باتخاذه من جملة المسلمات الأولى التي لا تفتقر إلى برهان! عندما أقول إن هذه الحقيقة لا تفتقر (نوعا) إلى برهان، أي أنها يعرفها العقلاء كافة دون استدلال ولا نظر، ثم أقدم الدليل النظري على أنها لا تفتقر إلى برهان، فقد تناقضت بمجرد ذلك، لأن مخالفي إذن الذي لا يعجبه دليلي) يكون قد أثبت بمجرد المخالفة أنها تفتقر إلى برهان! ولكن لأنه «فيلسوف متخصص»، فقد وجد نفسه مطالبا بكتابة الدفاعات الفلسفية المفصلة عن ذلك الموقف الإبستمولوجي نفسه، وبإجابة اعتراضات الخصوم من غير تردد، فوقع من حيث لم يحتسب في نفس التسلسل المعرفي الذي كان يريد محاربته، والله المستعان!”
1- بين إمكان الاستدلال وضرورتيه
فما نزعمه ضروريًّا بدهيا من لوازم العقل الإنساني السليم، يفترض أنه لا يفتقر لاستدلال ولو أمكن الاستدلال عليه، وإمكان الاستدلال غير ضرورية الاستدلال!، إن من يشترط على نفسه إثبات قبلية الضرورات ليثبت ضرورياتها أو بديهيتها قد وقع في التناقض من مبدأ الطرح وأحالها لمسألة نظرية، يعني ما الداعي مثلًا لأقدم دليلًا نظريًّا على أن مسألة وجود الله فطرية للملحد وأنه يكذب على نفسه حين يجحدها! وكأنه يتوقف وجدانه لتلك الضرورة البدهية في نفسه على ما سأذكره من أدلة على وجدانه إياه بالفعل في نفسه!، ثم أقدم له الدليل أن البديهيات لا بد أنها قبلية، والقبليات لا بد أنها صحيحة، ثم أثبت أن الإله موجود، إذا كانت هناك أدلة أخرى على وجوده، إذا ما فضل هذا الدليل على دليل السببية مثلا؟ أم أن السببية نفسها أحتاج أن أثبت قبليتها لأستدل بها على الملحد؟!
على أن دليل الفطرة ليس دليلا بحيث تقام عليه مناظرة، إذ أساس المناظرة مبنية على إفحام الملحد، وقد يحصل فيها شيء من التنازل بحيث يقال، لو لم تكن الدعوى (أ) بديهية في نفسها كما نزعم (جدلا) لأمكن الاستدلال عليها بكذا وكذا من البديهيات المتلازمة معها مما تسلم به أنت، وإلا لزمك التناقض مع نفسك أو غيرها من الشناعات.
فبعض الناس يظن أننا حين نقر بأن مسألة وجود الله فطرية، وجب علينا في كل موضع تقام فيه مناظرة لأي سبب شرعي كان، أن نبقى طوال المناظرة نصرخ في وجه الملحد أن مسألة وجود الله فطرية لا تستدعي أي نقاش!.
2- عودًا على أصل المسألة
إن وضع أي معيار ما فوقي للتمييز بين النظريات والبدهيات الضرورية إما أن يكون:
- بدهيّا، فلزم وجود معيار فوقه حتى نميزه هو، ولزم التسلسل والدور القبلي.
- نظريّا، فالعلم به متوقف أصلًا على العلم بالبدهيات الضرورية، فلزم الدور القبلي.
3- القبلية كمعيار للبداهة الضرورية
لنعرف القبلي على أنه ما لا يتوقف العلم به سببيّا على الحس بل العلم به مغروز في العقل وعليه يبنى فهم المحسوس، ويمثلون عليها بالعلم بـ “السببية، عدم التناقض، مبدأ الهوية”
والبعدي، هي المعرفة الحاصلة بسبب الحس ويمثلون عليه بـ “العلم بأن الشمس تشرق كل صباح”
ولنسأل نفس السؤال هنا: هل القبلية يمكن أن تكون معيار للضرورة العقلية؟
- إن كان معيار القبلية بدهيّا لم يكن العلم ببدهيته متوقف على العلم بقبليته، إذ لو كان هو نفسه لا تثبت بدهيته إلا بعد إثبات قبليته، كان إثبات قبليته حاصل قبل العلم بضرورية إثبات قبلية المعارف الضرورية العقلية! فسيكون لا حاجة له أصلًأ.
- إن كان نظريّا فقد علمنا الضرورات قبله أصلًا فلا حاجة له.
فثبت على كل تقدير أن العلم بالضرورات غير متوقف على إثبات قبليتها.
4- البعدية لا تنافي الضرورة والشمولية
إن القول بأن الاستقراء لا يولد إلا معرفة ناقصة، ولا يكون إلا ناقصًا، هو قول متناقض، وقد نبه لذلك الفيلسوف فريدريك غيو، وقد نقد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية من قبله، إذ لو كان الاستقراء دائما ناقصًا، فالعلم بنقصان الاستقراء هو نفسه استقراء شامل لكل ما هو استقراء! فالقول به بذلك متناقض أصلًأ
إذ استقراء الاستقراء البشري نفسه هو عملية استقرائية، والقول بأنه ناقص لا بد لا يخلو إما أن يكون ناقصًا أو شاملًا، فإن كان شاملًا فقد نقضت الجملة نفسها، وإن كان ناقصًا قيل إذا نقصانه لا يكفي لإثبات قضية ضرورية مفادها “أن كل استقراء بشري ناقص بالضرورة” لإبطال أي احتمال لصحة البعدية وإثبات القبلية بشكل ضروري حتى تبنى عليها ضرورية جميع الضرورات لاحقًا!
5- حل آخر غير القبلية
يقول شيخ الإسلام في شرح الأصبهانية:
“«فإن قال: أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ كان هذا مكابرة لعقله، فإن العلوم الكلية المطابقة للأمور الخارجية ليست مغروزة في الفطرة ابتداء بدون العلم بأمور معينة منها، لكن لكثرة العلم بالأمور المعينة الجزئية يجرد العقل الكليات، فتبقى القضية العامة ثابتة في العقل لا تحتاج إلى شواهد وأمثلة جزئية، إلا أن يكون علم تلك القضية العقلية من تركب قضايا أخر، وقوله: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد) ليس من هذا ولا من هذا».”
فالعلم بالجزئيات متقدم على تصور الكليات، بل لا معنى لتصور الكلي قبل الجزئي، ولو حاولت تصور أي كلي مع تخيلك أنك لا تعلم أي جزئي من جزئياته لفشلت، ولو حاولت تصور أي كلي دون أن تعلم بالفعل أي جزئي من جزئياته لفشلت، وأقصد بالعلم هنا إمكان التمثيل على جزئياته حتى لو كانت تقديرات ذهنية مركبة.
فالعلم بقضية أن “كل حادث له سبب” يشتمل على كلمات يناظرها في الذهن كليات علمت من جزئيات في الخارج حين تعلم اللغة في الصغر، لكن المعضلة التي يطرحها القبليون هنا هي:
إذا كان العلم بالكليات كلها متوقف على الجزئيات، فكيف استطاع الذهن أن يجعل الجزئي سبب في تعلم الكلي دون وجود قواعد ومعايير من ضمنها السببية والهوية نفسها!؟
وجواب ذلك أن يقال:
هذا السؤال يتضمن عدة دعاوى ضمنية:
منها:
- يجب على العاقل أن يعرف كيف يعمل عقله حتى يعرف ما يعرفه، وهذه الدعوة منقوضة بأن الإنسان يستخدم حواسه قبل العلم بكيفية عملها كمثال، بل دعوى تعاني من الدور إذ لا يمكن للإنسان أن يعرف كيف يعرف إلا وهو قادر على المعرفة، وليس إلا وهو “يعرف شيء ما بالفعل”! إذ فساد القول بأن الإنسان “لا يعرف أي شيء” إلا بعد علمه بكيف يعرف! ظاهر الفساد.
- يجب أن يكون سبب قدرة الإنسان على المعرفة هو سبب ذهني معرفي (إما ضرورة أو نظر) إما (قضية كلية أو جزئية).. الخ، حتى يستطيع أن يعلم.
- لا يمكن تفسير نشأة الضرورات في الوعي البشري إلا بالقول بالتفسير القبلي
- لا تتعلق قدرة الله بخلق كيان قادر على تحصيل الضرورات بشكل بعدي بكيفية لا يتصورها العقل البشري لكونها لا نظير لها في العادة.
- الإنسان قادر على معرفة كيف يعمل العقل البشري بالفعل دون الوقوع في الاختزال النظري والتصور التبسيطي والجهل بالسببية الخفية عن الحس (على أن ارتباط الوعي الذي هو تجربة ذاتية محضة، بالأعضاء العينية المحسوسة من الجسد) هو أمر مغيّب عنا.
وكل هذه الدعاوى تعاني من مشاكل ظاهرة، ودون إثباتها خرط القتاد، وكونهم لا يتصورون تفسير تفصيلي غير القبلية لا يفيدهم بشيء، إذ طالما ثبت الإمكان العقلي وتعلق قدرة الرب بخلق سبب آخر لحصول الضرورات أيّا كان، بطل لزوم قولهم وعاد الأمر للإثبات بالحس أو الخبر، فلو عاملنا كلامهم على أنه نظرية تفسيرية فهو واقع بمشكلة تجاهل إمكان “البدائل غير المتصورة Unconceived Alternatives”.
5- بل تصور البديل حاصل بالفعل!
يكفي أن يقال إن الغريزة البشرية التي هي عضو في الإنسان أي شيء عيني مركب فيه وهو ما به تصح عملية التعقل (التي هي عرض) للإنسان، يعمل بشكل منظم ومعياري قبل أن يعرف الإنسان كيف يعمل وقبل أن يعرف الضرورات بحيث أن نظامه العيني الوجودي يتسبب بإنشاء الضرورات التي هي لوازم الإنسانية وبها يحصل تعلم اللغة وفهم المحسوس بشكل إجمالي للطفل الصغير.
فلأن الغريزة بها معيار اكتشاف الوجوه البشرية، والتفريق بين الحي ذو الإرادة من الجماد، واكتشاف السببية الجزئية، والتمييز بين الهويات والأجسام المختلفة، وإلخ.. فسينشئ في ذهن الطفل كليات وجزئيات كنتيجة لهذه العمليات والكيفية التي يعمل بها العقل بشكل فطري، لأن هذه المعارف الضرورية أصلًا لا نجد في نفسنا أنها لا تنبني إلا على قياس على هذه القضايا الكلية، بل الزعم أن المعرفة التي تحصل بالقياس لا تحصل بغيره من الأسباب التي يمكن أن يخلقها الله هو زعم فاسد ضرورة وبداهىة لأسباب كثيرة ظاهرة لكل ذي لب!
فنقول إن العلم الصحيح للغريزة الفطرية الوجودية سينعكس على تكوين وعي صحيح وضرورات صحيحة للإنسان سليم القدرات العقلية، وهذا هو التفسير الخارجاني للمعرفة، خلافًا للتفسير الداخلاني القبلي الذي هو أساسا تأثر بالفلسفة اليونانية المثالية، الذي يرى أن سبب العلم بالدعوى المعينة لابد أنه متاح داخل الوعي وأنه سبب عقلاني كأن يكون قياس أو يمكن رده لقضية كلية، بينما في الحقيقة يمكن أن يكون سبب خارجاني محض أي من خارج الوعي، كأن يكون سببه هو كيفية عمل الغريزة الوجودية التي بعملها الصحيح تقوم ملكة التعقل في الإنسان أصالة!، كما أن عمل العين التي هي عضو قائم بنفسه بشكل سليم ينعكس على الوعي البصري (الذي هو عرض).
وبالنسبة للتعميم الاستقرائي، فيقال إن الذهن قادر على اكتشاف العلاقات الضرورية من خلال نفس ملكة استيعاب المعاني، فهو عند استعيابه لمعنى الأعزب ومعنى غير المتزوج ينسب الضرورة لعبارة كل أعزب هو غير متزوج، وقس على ذلك، وعند اكتشافه للسبب يدخله تحت كلية أنشأها سابقًا من اكتشافاته السببية السابقة، والخ، وهذا راجع لكيفية عمله النظامي العيني وليس إلى كيفية النظام المعرفي المنعكس في الوعي لهذه العملية.
فنحن ندعي أن العقل بموجب كيفية غريزية لا كيفية معرفية قياسية، قادر على التفريق بين اللوازم الضرورية واللوازم العادية في المحسوسات والصفات والخ.
ولكن السؤال هنا:
6- الخاتمة
ما الداعي لتكلف جواب سؤال: كيف يعرف الإنسان الضرورات البدهية؟
لأننا كما ذكرنا، أي معيار يوضع لتمييز الضرورات أو إثباتها، سيعاني من المشكلة المذكورة في الفقرة الثانية من هذا المقال.
فإن قيل هذا المعيار هو في نفسه ضروري متلازم بشكل معي “أي دور معي” مع باقي الضرورات بحيث لا ينفك عنها، فجعل أمارة عليها، عاد السؤال نفسه بعد هذه القهقرة:
هذا المعيار نفسه الملازم لباقي الضرورات:
- كيف علمت بملازمته لكل الضرورات الأخرى؟ هل بشكل ضروري أم استقرائي؟، هل به أم دونه؟ إذ لو قلت به لوقعت بالدور إذ هو نفسه لا يصح كمعيار إلا بعد العلم بملازمته.
- هل علمته دون بنائه على نفسه؟
- هل علمت كون الضرورات ضرورات ثم كونه ملازم لها ثم بنيت قضية كلية أنك لاحظت أنه ملازم لكل الضرورات إذا هو يصح أن يكون أمارة عليها، فبنيته هو نفسه على هذا الإستدلال؟
- أم علمت كل هذه القضايا بشكل ضروري وتلازمها بشكل ضروري، ثم قلت ساستعمله بشكل عملي كأمارة لإلزام الخصم المكابر؟ ولنقل مثلا هذا المعيار هو عدم التناقض، ما يؤدي نفيه لتناقض فهو ضروري، وما يؤدي نفي بدهيته لتناقض فهو بدهي، وأنك لا تقول أن كل عاقل عليه أن يتبنى مذهب القبلية لتستقيم ضروراته ويعلم ضروريتها في نفسه، لكنك تقيم ذلك كتفسير لوجود الضروريات في النفس من جهة (أنطولوجية)، على أن ما لا يؤدي إبطاله بخصوصه لتناقض لا يلزم أن لا يكون بدهيّا بل يكفي أن الذهن لا يلتفت لنقيضه، كبديهة أننا لا نعيش في محاكاة حاسوبية وحقيقية العالم المادي خارج الذهن وأن البشر الذين هم أمامي لهم وعي حقيقي، وضرورية التواتر والخ، ولا تقل أن هذه أمور تعلم بالحس والحسيات حتى عند القائلين بالقبلية هي بديهية، لأن هذه هي فهم للحس قد ينازعك فيه السوفسطائي! فهي راجعة للفطرة العقلية لا لمجرد التلقي الحسي الذي هو كالكاميرًا!. (راجع مقال نقض حصر الضرورات فيما يرجع لعدم التناقض).
نقول لو قلت بالنقطة الأخيرة لخرجت من هذه المعضلة، لكن لبطل القول بضرورية النظر في مسألة القبلية والبعدية ولأمكن العلم بالضرورات بدونها، ولبطل ضرورية وضع معيار، إذ المعيار نفسه علم بلا معيار، وملازمته لكل ضرورة علمت بلا معيار، بل لولا ذلك لما كان له هو نفسه معنى! كما هو واضح.
بل وستبقى معضلة “البدائل غير المتصورة” الممكنة عقلًا من حيث المبدأ قائمة حتى لو زعمت تبنيك للقبلية كمجرد تفسير أنطولوجي لوجود ضرورات في نفوس البشر.
لا يزال البشر يعلمون ضروراتهم ويثقون بها ويعملون عقولهم دون تكلف تأسيس نظرية معرفة والدفاع عنها، أو تعلم علم المنطق، أو تحويل كل دعوى يدعونها إلى صورة قياس ما، وهذا عين ما دافع عنه شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه وعلى رأسها الرد على المنطقيين، وعلى رأس هؤلاء العقلاء، أكمل الناس عقلًا وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومن بعدهم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين.
فمن انتقص من عقول هؤلاء لأجل هذه الدعاوى السوفسطائية كان هو أجهل الناس وأنقص الناس عقلًا والله المستعان.
هذا والله أعلم.
للاستزادة راجع:
مقال: نظرية المعرفة: في الداخلانية الدليلية، والخارجانية الفطرية ومذهب شيخ الإسلام.
سلسلة: قضايا معرفية على قناة بودكاست سراج