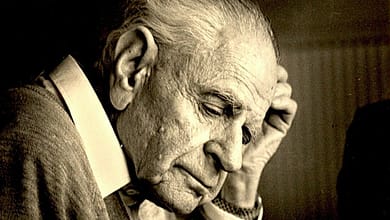ماهو التصور الوجودي الذي يجب على المسلم أن يعتقده في خصوص قوانيين الطبيعة؟ هل هي حاكمة للواقع بأكمله ام هي مجرد استقراء العادة من الحوادث التي نراها؟ وهل لقوانين الطبيعة وجود حقيقي تتحكم بالاشياء كما يؤمن بيها الطبيعانيين والدهرية؟
الجواب:
من الواضح أننا نحتاج في هذا المقام إلى الوقوف على تعريف واضح ودقيق للقانون الطبيعي، ما هو هذا القانون الطبيعي الذي أصبح لزاما على الإنسان حتى ينسب إلى العقل والعلم في هذا الزمان أن يجعله هو الحاكم على كافة الحوادث في هذا العالم بلا استثناء؟
هنا يلزم أن نفرق بين مفهومين کليين لا يستويان. الواقع الوجودي للنظام السببي المرتبط بطبائع الأشياء فيما يظهر لنا، والتصور المعرفي البشري للعلاقات والنظم السببية المحسوسة باطراد وبصورة مباشرة في إطار ذلك الحيز الضيق الذي يقع تحت عادتنا من هذا العالم.
فعند الطبيعيين، المفهومان متطابقان، وهذا باطل واختزال ومغالطة عقلية كبری!
وحتى يتبين لك المقصود بهذا الكلام، دعنا من جديد نرجع لنطرح السؤال: ما معنى القول بنظام سببي يجري في إطار العالم المحسوس بصورة ثابتة مطردة؟ معناه أن ثمة أنواعا معينة من الحوادث المحسوسة بالفعل أو بالقوة، ينبغي أن تقع أولا قبل الحادث المطلوب تفسيره والتنبؤ بنظائره، حتى يقع ذلك الحادث نفسه ترتبا عليها أو کمسبب لها. فإذا كان المقصود عند الطبيعيين بالقانون الطبيعي، هو أنه لا تقع الحوادث في العالم إلا تحت نظم سببية ثابتة لابد أن تكون سائر أنواع الأسباب فيها من جنس السبب الطبيعي (الذي يسعهم الوقوف على إدراکه بالحس والمشاهدة)، أي ليست من جنس ما هو محصور في دائرة العالم المحسوس والمعتاد وحسب، بل هي كذلك خاضعة للمشاهدة بصورة مباشرة، أو على الأقل قابلة للرصد والمشاهدة المباشرة ولو من حيث المبدأ! هو غاية ما فمن كان هذا هو تصوره للنظام السبي الوجودي كما هو في الخارج Ontology of Causality، فيلزمه ولا شك القول بالسببية الطبيعية المغلقة التي هي من أصول الملة الطبيعية، التي يجب على المسلم أن يرفضها رفضا باتا قاطعا، وأن يبين لأصحابها أنها باطل في العقل والفطرة والسمع جميعا! فعندما يتوصل الباحث الطبيعي إلى الربط السببي بين نوعين من أنواع الحوادث المحسوسة في العالم، فإنه لا يقضي بذلك (وجودیًّا) على نظامهما السببي بالاكتمال أو بتمام التعليل Complete Causation! وإنما غايته أن يقول: «لقد وقفت على إثبات العلاقة بين سبب واحد أو أكثر للظاهرة المراد دراستها، من جملة من الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي لا أقدر على إحصائها مهما تكلفته»!
لو صدق الباحث الطبيعي وتجرد للحق لصرح بهذا المعنى! ولكنهم كانوا ولم يزالوا – من زمان فلاسفة اليونان القدماء – حريصين، ولأسباب دينية محضة، على قصر السببية ونظامها على نوع المحسوسات وما يقع تحت العادة من حوادث العالم، فقط لا غير؛ ذلك أنهم قد جعلوا دينهم أنه لا موجود بحق إلا الطبيعة، كما بسطنا الكلام عليه في الباب الأول من هذا الكتاب!
وإذن فلا سبب إلا السبب الطبيعي! فما هو القانون الطبيعي في الدين الطبيعي؟ هو النظام السبي الحاكم للعلاقة بين نوعين أو أكثر من أنواع الحوادث، المطرد في كل مكان وفي كل زمان، بلا غيب ولا سبب غيبي ولا حد لاطراد القانون نفسه إلا ما قد ينشأ عن طرد نظام آخر من نظم الطبيعة نفسها! وإن قدر أن فرضوا أسبابا أخرى إضافية للظاهرة التي أثبتوا لها سببا في قانونهم، فمن شرطها عندهم أن تكون كلها من جنس ما أثبتوا، أسبابا طبيعية، أي تقبل القياس – مبدئيا – على ما في الحس من الأسباب المثبتة لديهم، ویرجی لهم الوقوف على درکها هي نفسها بالحس المباشر في يوم من الأيام.
فهنا عدة إجمالات يجب التفصيل فيها:
مصطلح “التصور الوجودي”، إن كان المقصود به أن ثمة شيئا ما في الأعيان اسمه القانون الطبيعي، هو الذي تنشأ عنه الحوادث كلها أو بعضها، فهذا غير صحيح، وهو من قول الأفلاطونيين ومن نحا نحوهم في المثالية من فلسفة العلم، أي في تشييء الكليات الذهنية وجعلها أعيانا خارجية.
وإن كان المقصود أن في هذا القدر الذي اعتدناه من العالم نظما رتيبة ثابتة تجري بأمر الله وخلقه، وهي ناشئة عن طبائع المواد التي جرت عليها عادتنا، مع غيرها من الأسباب الغيبية التي لا يحصيها إلا الله تعالى، فهذا حق ولا إشكال فيه. القانون الطبيعي حقيقة على هذا المعنى.
والقول بأنها هي مجرد استقراء للعادة من الحوادث التي نراها
إن كان المراد منه أن لتلك العادة نظاما رتيبا ناشئا، في جملة ما تنشأ عنه الحوادث من أسباب لا يحصيها إلا باريها، عن طبائع حقيقية مركبة في العالم ولها تأثيرها السببي الحقيقي، فصحيح، إذ أسباب الحوادث والمتولدات السببية في العالم منها تلك الطبائع المعروفة، ومنها ما تنشأ عنه تلك الطبائع نفسها في الأشياء وبه يحفظها رب العالمين فيها (وهو عمل الملائكة الموكلة بها، بأمر الله تعالى النازل إليها)، وغير ذلك من أسباب لا يحصيها أحد سواه.
وإلا فقد يفهم من قولك هذا إن الأمر ليس إلا عادة في خلق الحوادث خلقا آنيا كما تقوله الأشاعرة، من غير أن يكون لشيء تأثير في شيء، وهذا باطل.
وأما القول بأنها “حاكمة للواقع بأكمله” فإن كان المراد بالواقع كل ما في الوجود (كما هي عادة الفلاسفة في استعمال هذه الكلمة) فهذا باطل قطعا،
وإن كان مرادك منها كل ما في العالم، فهذا أيضا معنى فاسد، لأننا لا نعلم إلا ما دلنا عليه الاستقراء من انطراد تلك السنن في إطار القدر الواقع تحت عادتنا من هذا العالم، وأما ما لا يطاله الاستقراء والقياس فلا ثبوت له إلا بالسمع.
فما وراء ذلك القدر المعتاد مما لا رجاء لنا في الوصول إليه أو الوقوف عليه بالحس الصريح غير المؤول، فغيب مطلق لا يحيط بعلمه إلا باريه سبحانه.
وأما إن كان المراد بالواقع هو هذا القدر الواقع تحت العادة البشرية من السماوات والأرضين، فنعم، لا نعلم فيها جزءا لا تطرد فيه تلك السنن التي نعرفها، وإن كان بعضها بتفاوت وصفه من موضع إلى موضع كالجاذبية وغيرها. ولا نقول مع ذلك إنها “حاكمة” لذلك الواقع على المعنى الدهري الذي لا يجعل للحوادث أسبابا غيرها، فيجعلها هي والعشواء معا ما تتعلل به جميع الحوادث! وإنما هي من جملة الأسباب التي تتولد الحوادث عن مجموعها. ولهذا تتخلف وتنخرم أحيانا، لأن لاطرادها شروطا سببية غيبية لا يحصيها إلا رب العالمين. فإن كان المقصود بكونها حاكمة، أي مؤثرة مطردة من حيث الأصل، فصحيح، في الحدود التي ذكرنا، وإلا فالدهرية يقولون بالسببية الطبيعية المغلقة أو الحتمية السببية التي هي بمعنى: لا سبب إلا السبب الطبيعي، الذي يتولد عن القانون الطبيعي، فهذا تصورهم لكونها “حاكمة للواقع”.
فإن كنت تقصد بالوجود الحقيقي للقوانين هذا المعنى الذي حررناه ودفعنا عنه الاشتباه، فحق ولا شك،
وإلا فهو مما يؤمن به الماديون والدهرية، والله أعلى وأعلم