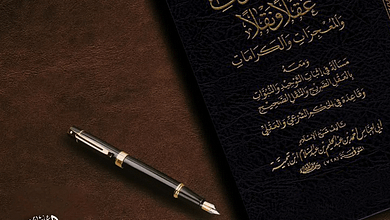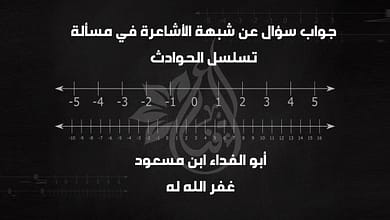الحمد لله وحده، أما بعد.
فمما يخطئ فيه بعض المنتسبين إلى أهل السنة، تحرير المراد بقولهم إن صفة الإرادة في الله تعالى قديمة، بينما المشيئة تكون حادثة، فالحق أن كلا المعنيين تكون نسبته إلى الله تعالى عند أهل السنة أهل الحديث والأثر، قديمة من وجه، وحادثة من وجه آخر، كما أن الكلام يكون قديما من وجه، وحادثا من وجه، والفعل يكون قديما من وجه وحادثا من وجه، والعلم يكون قديما من وجه وحادثا من وجه، وكذلك في السمع والبصر وغيرهما، فأما كونه قديما، فهو أن الله لم يزل موصوفا بنوع ذلك المعنى من الأزل بلا ابتداء، وأما كونه حادثا، فهو أنه تحدث منه أفراد ذلك النوع فردا بعد فرد، تكون بعد أن لم تكن. فهو لم يزل موصوفا بنوع الإرادة من الأزل، ولكن الإرادات المعينة، لا يقال في الواحدة منها إنها أزلية قديمة، وإنما تكون في نفسه بعد أن لم تكن. وكذلك في المشيئة، على تفصيل في الفارق بين المعنيين يأتي بيانه. وكذلك يقال في الكلام، لم يزل سبحانه موصوفا بأنه يتكلم بما يشاء إذا شاء، فهى صفة قديمة من هذا الوجه، ولكن الكلام المعين، لا يقال إنه قديم، وإنما يحدث عن ذاته كلمة بعد ككمة. وكذلك في السمع والبصر، فهو لا يزال سميعا لكل مسموع، مبصرا لكل موجود، من الأزل بلا ابتداء سبحانه، ولكن إذا حدثت آحاد المسموعات والمبصرات، حدث لكل منها سمع به يخصه، وبصر به يخصه بالضرورة، فلا يكون سمعه لهذا هو عين سمعه لذاك، ولا بصره بهذا هو عين بصره بذاك. وفي العلم يقال إنه لم يزل سبحانه موصوفا بالعلم التام الكاشف لكل موجود ولكل حادث من الأزل بلا ابتداء، لا يكتسب العلم بشيء كان يجهله سبحانه وتعالى، ولا يجوز ذلك عليه. ولكن إذا حدثت آحاد المعلومات، تجدد في نفسه علم بها يخصها، بأنها صارت حادثة في الماضي بعد أن كان معلوما أنها ستحدث في المستقبل. فالمعلوم المعين يظل العلم به قائما بالذات الإلهية من الأزل، وإنما تتغير النسبة أو التعلق، لا على المعنى العدمي الذي يقرره المتكلمون، ولكن على حقيقة وجودية تقوم بذات الله تعالى على النحو اللائق به. فالقدم في جميع ذلك معناه عدم ابتداء قيام المعنى بالذات الإلهية في الماضي، والحدوث معناه ابتداء ذلك بعد عدمه، ولا يمتنع عندنا نسبة الحدوث بهذا المعنى الذي حررنا لبعض المعاني التي يوصف بها رب العالمين، لأننا لا نؤسس عقائدنا في الإلهيات على ما يؤسس عليه الفلاسفة والمتكمون فيما يجوز وما يجب وما يمتنع لله تعالى، ولا نقول بمعنى الحدوث اليوناني الذي يقولون هم به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (مجلد 16، ص 301 وما بعدها):
وَمَعْلُومٌ بِصَرِيحِ الْعَقْل أَنَّ الْقَادِرَ إذَا لَمْ يَكُنْ مُرِيدًا لِلْفِعْلِ وَلَا فَاعِلًا ثُمَّ صَارَ مُرِيدًا فَاعِلًا فَلَا بُدَّ مِنْ حُدُوثِ أَمْرٍ اقْتَضَى ذَلِكَ.
وَالْكَلَامُ هُنَا فِي مَقَامَيْنِ: أَحَدِهِمَا فِي جِنْسِ الْفِعْلِ وَالْقَوْلِ هَلْ صَارَ فَاعِلًا مُتَكَلِّمًا بِمَشِيئَتِهِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ مَا زَالَ فَاعِلًا مُتَكَلِّمًا بِمَشِيئَتِهِ. وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَسَائِلِ الْكَلَامِ وَالْأَفْعَالِ فِي مَسْأَلَةِ الْقُرْآنِ وَحُدُوثِ الْعَالَمِ.
وَالثَّانِي إرَادَةُ الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ وَفِعْلُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إنَّمَا أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾، وَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾.
وَهُوَ سُبْحَانَهُ إذَا أَرَادَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلِلنَّاسِ فِيهَا أَقْوَالٌ. قِيلَ: الْإِرَادَةُ قَدِيمَةٌ أَزَلِيَّةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنَّمَا يَتَجَدَّدُ تَعَلُّقُهَا بِالْمُرَادِ وَنِسْبَتُهَا إلَى الْجَمِيعِ وَاحِدَةٌ وَلَكِنْ مِنْ خَوَاصِّ الْإِرَادَةِ أَنَّهَا تُخَصَّصُ بِلَا مُخَصِّصٍ. فَهَذَا قَوْلُ ابْنِ كِلَابٍ وَالْأَشْعَرِيِّ. وَمَنْ تَابَعَهُمَا. وَكَثِيرٌ مِنْ الْعُقَلَاءِ يَقُولُ: إنَّ هَذَا فَسَادُهُ مَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ حَتَّى قَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ: لَيْسَ فِي الْعُقَلَاءِ مَنْ قَالَ بِهَذَا. وَمَا عُلِمَ أَنَّهُ قَوْلُ طَائِفَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ أَهْل النَّظَرِ وَالْكَلَامِ. وَبُطْلَانُهُ مِنْ جِهَاتٍ: مِنْ جِهَةِ جَعْلِ إرَادَةِ هَذَا غَيْرِ إرَادَةِ ذَاكَ وَمِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ جَعَلَ الْإِرَادَةَ تُخَصَّصُ لِذَاتِهَا. وَمِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ عِنْدَ وُجُودِ الْحَوَادِثِ شَيْئًا حَدَثَ حَتَّى تَخَصَّصَ أَوْ لَا تَخَصَّصَ. بَلْ تَجَدَّدَتْ نِسْبَةٌ عَدَمِيَّةٌ لَيْسَتْ وُجُودًا وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءِ فَلَمْ يَتَجَدَّدْ شَيْءٌ. فَصَارَتْ الْحَوَادِثُ تَحْدُثُ وَتَتَخَصَّصُ بِلَا سَبَبٍ حَادِثٍ وَلَا مُخَصِّصٍ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِإِرَادَةِ وَاحِدَةٍ قَدِيمَةٍ مِثْلُ هَؤُلَاءِ لَكِنْ يَقُولُ: تَحْدُثُ عِنْدَ تَجَدُّدِ الْأَفْعَالِ إرَادَاتٍ فِي ذَاتِهِ بِتِلْكَ الْمَشِيئَةِ الْقَدِيمَةِ كَمَا تَقُولُهُ الكَرَّامِيَة وَغَيْرُهُمْ. وَهَؤُلَاءِ أَقْرَبُ مِنْ حَيْثُ أَثْبَتُوا إرَادَاتِ الْأَفْعَالِ. وَلَكِنْ يَلْزَمُهُمْ مَا لَزِمَ أُولَئِكَ مِنْ حَيْثُ أَثْبَتُوا حَوَادِثَ بِلَا سَبَبٍ حَادِثٍ وَتَخْصِيصَاتٍ بِلَا مُخَصِّصٍ، وَجَعَلُوا تِلْكَ الْإِرَادَةَ وَاحِدَةً تَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ الْإِرَادَاتِ الْحَادِثَةِ، وَجَعَلُوهَا أَيْضًا تُخَصَّصُ لِذَاتِهَا وَلَمْ يَجْعَلُوا عِنْدَ وُجُودِ الْإِرَادَاتِ الْحَادِثَةِ شَيْئًا حَدَثَ حَتَّى تُخَصِّصَ تِلْكَ الْإِرَادَاتُ الْحُدُوثَ.
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ قَوْلُ الْجَهْمِيَّة وَالْمُعْتَزِلَةِ الَّذِينَ يَنْفُونَ قِيَامَ الْإِرَادَةِ بِهِ. ثُمَّ إمَّا أَنْ يَقُولُوا بِنَفْيِ الْإِرَادَةِ أَوْ يُفَسِّرُونَهَا بِنَفْسِ الْأَمْرِ وَالْفِعْلِ أَوْ يَقُولُوا بِحُدُوثِ إرَادَةٍ لَا فِي مَحَلٍّ كَقَوْلِ الْبَصْرِيِّينَ. وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ قَدْ عُلِمَ أَيْضًا فَسَادُهَا.
وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُرِيدًا بِإِرَادَاتِ مُتَعَاقِبَةٍ. فَنَوْعُ الْإِرَادَةِ قَدِيمٌ وَأَمَّا إرَادَةُ الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّمَا يُرِيدُهُ فِي وَقْتِهِ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُقَدِّرُ الْأَشْيَاءَ وَيَكْتُبُهَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْلُقُهَا. فَهُوَ إذَا قَدَّرَهَا عَلِمَ مَا سَيَفْعَلُهُ وَأَرَادَ فِعْلَهُ فِي الْوَقْتِ الْمُسْتَقْبَلِ لَكِنْ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَإِذَا جَاءَ وَقْتُهُ أَرَادَ فِعْلَهُ فَالْأَوَّلُ عَزْمٌ وَالثَّانِي قَصْدٌ. وَهَلْ يَجُوزُ وَصْفُهُ بِالْعَزْمِ فِيهِ قَوْلَانِ. أَحَدُهُمَا الْمَنْعُ كَقَوْلِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى؛ وَالثَّانِي الْجَوَازُ وَهُوَ أَصَحُّ. فَقَدْ قَرَأَ جَمَاعَةٌ مِنْ السَّلَفِ ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ بِالضَّمِّ. وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: ﴿ثُمَّ عَزَمَ اللَّهُ لِي﴾ . وَكَذَلِكَ فِي خُطْبَةِ مُسْلِمٍ: ﴿فَعَزَمَ لِي﴾ . وَسَوَاءٌ سُمِّيَ «عَزْمًا» أَوْ لَمْ يُسَمَّ فَهُوَ سُبْحَانَهُ إذَا قَدَّرَهَا عَلِمَ أَنَّهُ سَيَفْعَلُهَا فِي وَقْتِهَا وَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهَا فِي وَقْتِهَا.
فَهُوَ سُبْحَانَهُ إذَا قَدَّرَهَا عَلِمَ أَنَّهُ سَيَفْعَلُهَا فِي وَقْتِهَا وَأَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهَا فِي وَقْتِهَا. فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ فَلَا بُدَّ مِنْ إرَادَةِ الْفِعْلِ الْمُعَيَّنِ وَنَفْسِ الْفِعْلِ وَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ بِمَا يَفْعَلُهُ.
ثُمَّ الْكَلَامُ فِي عِلْمِهِ بِمَا يَفْعَلُهُ هَلْ هُوَ الْعِلْمُ الْمُتَقَدِّمُ بِمَا سَيَفْعَلُهُ وَعِلْمُهُ بِأَنَّ قَدْ فَعَلَهُ هَلْ هُوَ الْأَوَّلُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ مَعْرُوفَانِ. وَالْعَقْلُ وَالْقُرْآنُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْرٌ زَائِدٌ كَمَا قَالَ ﴿لِنَعْلَمَ﴾ فِي بِضْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: “إلَّا لِنَرَى”.
فَإِرَادَةُ الْمُعَيَّنِ تَتَرَجَّحُ لِعِلْمِهِ بِمَا فِي الْمُعَيَّنِ مِنْ الْمَعْنَى الْمُرَجِّحِ لِإِرَادَتِهِ. فَالْإِرَادَةُ تَتْبَعُ الْعِلْمَ. وَكَوْنُ ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ مُتَّصِفًا بِتِلْكَ الصِّفَاتِ الْمُرَجَّحَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْعِلْمِ وَالتَّصَوُّرِ، لَيْسَ فِي الْخَارِجِ شَيْءٌ.
وَمِنْ هُنَا غَلِطَ مَنْ قَالَ «الْمَعْدُومُ شَيْءٌ» حَيْثُ أَثْبَتُوا ذَلِكَ الْمُرَادَ فِي الْخَارِجِ. وَمَنْ لَمْ يُثْبِتْهُ شَيْئًا فِي الْعِلْمِ أَوْ كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ إلَّا إرَادَةٌ وَاحِدَةٌ وَعِلْمٌ وَاحِدٌ لَيْسَ لِلْمَعْلُومَاتِ وَالْمُرَادَاتِ صُورَةٌ عِلْمِيَّةٌ عِنْدَ هَؤُلَاءِ. فَهَؤُلَاءِ نَفَوْا كَوْنَهُ شَيْئًا فِي الْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ، وَأُولَئِكَ أَثْبَتُوا كَوْنَهُ شَيْئًا فِي الْخَارِجِ.
وَتِلْكَ الصُّورَةُ الْعِلْمِيَّةُ الْإِرَادِيَّةُ حَدَثَتْ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ، وَهِيَ حَادِثَةٌ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ، كَمَا يُحْدِثُ الْحَوَادِثَ الْمُنْفَصِلَةَ بِمَشِيئَتِهِ وَقُدْرَتِهِ. فَيُقَدِّرُ مَا يَفْعَلُهُ، ثُمَّ يَفْعَلُهُ.
فَتَخْصِيصُهَا بِصِفَةٍ دُونَ صِفَةٍ وَقَدَرٍ دُونَ قَدَرٍ هُوَ لِلْأُمُورِ الْمُقْتَضِيَةِ لِذَلِكَ فِي نَفْسِهِ. فَلَا يُرِيدُ إلَّا مَا تَقْتَضِي نَفْسُهُ إرَادَتَهُ، بِمَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ، وَلَا يُرَجِّحُ مُرَادًا عَلَى مُرَادٍ إلَّا لِذَلِكَ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَجِّحَ شَيْئًا لِمُجَرَّدِ كَوْنِهِ قَادِرًا، فَإِنَّهُ كَانَ قَادِرًا قَبْلَ إرَادَتِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى غَيْرِهِ. فَتَخْصِيصُ هَذَا بِالْإِرَادَةِ لَا يَكُونُ بِالْقُدْرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ.
وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ الْإِرَادَةُ تُخَصِّصُ مِثْلًا عَلَى مِثْلٍ بِلَا مُخَصِّصٍ. بَلْ إنَّمَا يُرِيدُ الْمُرِيدُ أَحَدَ الشَّيْئَيْنِ دُونَ الْآخَرِ لِمَعْنَى فِي الْمُرِيدِ وَالْمُرَادِ، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُرِيدُ إلَى ذَلِكَ أَمْيَلَ، وَأَنْ يَكُونَ فِي الْمُرَادِ مَا أَوْجَبَ رُجْحَانَ ذَلِكَ الْمَيْلِ.
وَالْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ تُثْبِتُ الْقَدَرَ وَتَقْدِيرَ الْأُمُورِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهَا، وَأَنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ، وَهَذَا أَصْلٌ عَظِيمٌ يُثْبِتُ الْعِلْمَ وَالْإِرَادَةَ لِكُلِّ مَا سَيَكُونُ، وَيُزِيلُ إشْكَالَاتٍ كَثِيرَةً ضَلَّ بِسَبَبِهَا طَوَائِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ فِي مَسَائِلِ الْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ.
قلت: والمشيئة والإرادة بينهما فارق في المعنى يحرره أهل السنة، وتضطرب فيه أحلام المتكلمين كما مرت الإشارة إليه في كلام الشيخ رحمه الله. فالمشيئة أولا، أمر كوني قدري، كل ما يكون إنما يكون لأن الله تعالى قد شاءه، شاء أن يكون فكان. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالمشيئة تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، كل ما هو كائن محبوبا كان أو مكروها له سبحانه فإنه لا يكون إلا بأن يشاءه بعينه بخصوصه. وأما الإرادة فقد تكون بمعنى المشيئة، وهي إذن كونية قدرية، وقد تكون بمعى المحبة، كما مر في تحرير الشيخ رحمه الله، فلا تتعلق إلا بالمحبوب من مفعولات الله تعالى. ولهذا اصطلح العلماء فقالوا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وليس المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. لأن معنى الإرادة يرد عليه في اللغة معنى إضافي ليس من أصل الوضع فى لفظة المشيئة، وهو المحبة، قال تعالى: ((وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ))، فالإرادة هنا جاءت بمعى المشيئة، ولكن انظر إلى مثل قوله تعالى: ((يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ))، وقوله تعالى: ((يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ))، وقوله: ((يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا))، فالإرادة هنا مشيئة خصصت بالمعنى الإضافى الذي تقدم، وهو معنى المحبة الشرى، ولا يلزم منها وقوع المراد، خلافا للمشيئة أو الإرادة الكونية، وبعض أهل السنة قال إن المشيئة أيضا قد تكون بمعنى إرادة المحبوب خاصة، كما في قوله: ((بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ))، وقوله: ((يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)) ونحوهما. والذي عليه عامة أهل السنة أن المشيئة أخص من الإرادة على الوجه الذي بينا، ولهذا يعبرون عند ذكر مراتب القدر بقولهم “علمه فكتبه فشاءه فخلقه”، ولا يقولون: “فأراده فخلقه”، لأن لفظة المشيئة أخص، وليس لأن نفس التقدير والكتابة لم يسبقهما مشيئة تخصهما فهو شاء أن يقدر ما قدر، قبل أن يقدره، كما شاء لكل فرد من تلك المقدرات أن تقع في وقتها، وإن قيل في كلا النوعين: أراد على معنى الإرادة الكونية لم يمنع.
ولكن قال بعض الجهال ممن ينتسبون إلى أهل السنة، إن الإرادة المقصود بها العلم بأنه سيشاء كذا في المستقبل، وهذا قديم، فإذا جاء وقته، تعلقت به المشيئة فوقع، وهذا في الحقيقة تفريق ليس من أقوال أهل السنة في شيء، فالإرادة ليست علما عند أهل السنة، وإنما هي بهذا المعنى عند طوائف من أهل الكلام، يقولون إنما تعني اختيار ما هو معلوم له سلفا أنه فاعله. هكذا قال النظام من المعتزلة، قال:
“إذا وصف بأنه يريد أفعاله، فإنما المراد بذلك أنها خالقها ومنشئها على حسب ما علم، وإذا وصف بكونه مريدا لأفعال العباد فالمعنى أنه آمر بها أو ناه عنها (قلت: وهذا نفي لخلق أفعال العباد كما لا يخفى)”.
فتأمل قوله: خالقها على حسب ما علم! فهذه إرادته إياها! وهذا المعنى ينسب إلى بعض الحكماء من الفلاسفة الأقدمين، قالوا إن إرادته إنما هي علمه بجميع الموجودات من الأزل إلى الأبد، يقولون هي “عنايته”. وهذا يترتب عليه شبهة تأتي عليها فيما بعد إن شاء الله تعالى. ونقول بل هو يريد ويعلم أنه يريد، والفارق بينهما لا يحتاج إلى تفسير أو تحرير، العلم علم والإرادة إرادة، وليست هذه هي عين تلك في المعنى أو في الحقيقة التي تقوم بالذات فتوجب لها ثبوت المعنى. وكذلك زعم بعض أهل الكلام أن المشيئة إنما هي إيجاد الشيء، خلافا للإرادة التي هي الطلب، وقالوا من هنا اشتقت لفظة مشيئة، من الشيء، وهذا فاسد. نعم قد يصح أن يكون أصل الاشتقاق للفظة “شيء”، وهو أمر يحتاج إلى بحث، ولكن لا تكون المشيئة على معنى الإيجاد، لأن المخلوق كذلك تنسب إليه المشيئة لغة، ولكن لا يلزم وجود ما يشاء إذا شاءه، بل قد يمتنع!
فإن قالوا إنما أردنا بالإرادة ما يكتبه في اللوح المحفوظ وبالمشيئة ما يترجح به وقوع كل مراد من تلك المرادات، فهي متقدمة عليها زمانا، والإرادة قد يتراخى أثرها خلافا للمشيئة، قلنا فمن أين جئتم بهذا التفريق؟ قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [التكوير: 29] كان وما لم يشأ لم يكن، لا يدل عليه. فإنه لو قال ما أراد الله كان وما لم يرد لم يكن، لم يبطل من جهة اللغة! الإرادة قد لا يقع أثرها أصلا إذا أريد بها المحبوب خاصة، على القسمة التي ذكرنا، لكن جواز التراخي في وقوع المراد هذا إنما يختلف بحسب حقيقة المراد، وهو ما يرد على معنى المشيئة كذلك ولا فرق. فيجوز أن يقال إن الله أراد الآن (إرادة كونية) أن يخلق كذا بعد ألف عام، فإذا جاء وقته المقدر سلفا أراد أن يخلقه فورا فخلقه، فلا يقع إلا بما يريد وقتما يريد. ويجوز كذلك أن يقال إن الله إذا شاء الآن أن يخلق كذا بعد ألف عام، فإذا جاء وقته شاء أن يشرع في خلقه فأحدثه، فلا يقع إلا بما يشاء وقتما يشاء، وليس في اللغة ما يوجب تخصيص أحد النوعين بأحد اللفظين. وجواز التراخي على هذا المعنى لا علاقة له بكون المراد قد يقع وقد لا يقع إن كان المراد هو المحبوب خاصة. فليس جواز عدم الوقوع مساويا لجواز التراخي. فمن قال إن وقوع المراد قد يتراخى لهذا الوجه، خلافا لموضوع المشيئة، فقد خصص بلا مخصص صحيح.
الإرادة على المعنى القدري، تشمل التقدير الأول، إرادة ما يكتب في اللوح المحفوظ قبل كتابته، وإرادة كل فعل معين إذا جاء وقته، فيترجح باجتماعها مع القدرة التامة في وقته المكتوب سلفا.
هذه إرادة وتلك إرادة، على المعنى الكوني، وهذه أيضا مشيئة وتلك مشيئة، فما دمنا نتكلم عن الكوني القدري خاصة، فيرد عليه اللفظان في كل حال، المشيئة والإرادة، ولا إشكال. وليس معنى القدم داخلا على الإرادة دون المشيئة، وإنما كلاهما قديم من وجه حادث من وجه كما مر. فسواء إرادة الأمر المعين تكوينيا (على الفور أو التراخي) أو مشيئته (فورا أو تراخيا) فكلاهما يقوم بذات الله تعالى بعد أن لم يكن قائما، ولا يجوز أن يقال إن أحدهما قديم بوجه ما.
ولهذا غلط الأشاعرة فلم يفرقوا بين المعنيين أصلا، وحملوا الجميع على إيجاب التخصيص للممكنات، فرارا من إقامة الحقيقة الوجودية بالذات الإلهية، بما يكون عندهم تركيبا أرسطيا، وفرارا كذلك من نسبة الحوادث إليه،
قال التفتازاني:
“(والإرادة والمشيئة) وهما عبارتان عن صفة في الحق توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل”.
وقوله: توجب كذا وتقتضي كذا، ليس فيه تفريق بين إرادة كونية وشرعية كما مر، بل إذا وصف بأنه يريد شيئا ما، وجب أن يقع عندهم! لماذا؟ لأن الإرادة عندهم معنى قديم واحد، لم يزل قائما بالذات الإلهية، موجبا لوقوع جميع المرادات، بأن تتعدد متعلقاته، وهي المرادات المعينة، لا بأن تتعدد الإرادات وتحدث في الذات الإلهية إرادة بعد إرادة، ومشيئة بعد مشيئة، كل إرادة تخص مرادا بعينه! وهم لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كما عند أهل السنة، يزعمون أنه إن صح أن كان المشروع مراد الله تعالى لوجب وقوعه، إذ لا يتخلف وقوع المطلوب عن طالبه إلا بأن يكون الطالب مخلوقا ناقصا، والله منزه عن ذلك.
وهذا راجع في الحقيقة إلى نفيهم المعنى الإضافي للفظة الإرادة الذي ذكرنا آنفا وهو المحبة، وتسويتها إياه بصورة من صور إرادة التكوين من الوجه الذي يدعوه، وهي إرادة المثوبة كما قالوا. فنعم قد يحب الله شيئا ولا يقع، لأن ذلك يترتب عليه في علمه وحكمته ما هو أحب إليه سبحانه، فهذا ما به تترجح المُرادات من حيث التكوين والوقوع في علمه وحكمته سبحانه. فالذي يثبت لله تعالى المحبة والتفاوت في مقدارها بين محبوب ومحبوب، هو الذي يجعل الأمر التشريعي إرادة إلهية، وهو ما خرج منه بعض الأصوليين بقولهم: تكليف، هو سبحانه يكلف العباد، فمن جاء بالتكليف كان مستحقا للمثوبة، ومن لم يأت به كان مستحقا للعقوبة، فاختاروا تلك الألفاظ فرارا مما قد يفهم من خلافها. ولكن لا يجوز في العقل أن يكلف العباد بتكليف شرعي دون أن يكون ذلك التكليف راجعا إلى إرادة على المعنى الإضافي الذي بينا (إرادة أمر محبوب إلى الله تعالى)، كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله. فنعم هو مكلف وهو تكليف قطعا، ولا إشكال في الاصطلاح عليه في الأصول بهذا اللفظ، ولكنه تكليف يحبه رب العالمين، أراده قبل أن يأمر به لمحبته إياه ولا ما أمر به، ولم يعقل أصلا أن يأمر به سبحانه وهو يحبه لأن من مقتضيات كماله أن يحبه سبحانه، فهو يحب خير الخيرين، فيأمر به ویکره شر الشرين فينهى عنه. والمكروهات تتفاوت عنده في كراهتها كما تتفاوت المحبوبات في محبتها، خلافا لمن طمسوا ذلك التفاوت بحمل المعنى على إرادة المثوبة وإرادة العقوبة، وهذا من تدبره اندفعت عنه بإذن الله تعالى إشكالات كثيرة، وانكشفت لديه الروابط العقلية بين مقالات القوم وبدعهم وأسباب تلبسهم بها.
قال الجويني في الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد:
“مذهَبُ أهْلِ الحَقِّ أَنَّ الباري تعالى مُرِيدٌ بإرادة قديمة”
قلت: تأمل لم يقل موصوف بالإرادة منذ الأزل، وإنما قال إنه مريد بإرادة واحدة قديمة فلا يقال إنه أراد كذا بإرادة، وأراد كذا بإرادة أخرى، بل كل ذلك شيء واحد قديم، لا قيام له بذاته أصلا ولو فاصلتهم لانتهيت بهم إلى نظير قول المعتزلة بعدميتها، أو بأنها لا حقيقة لها إلا نفس المراد، يريد أن يخلق، فتكون إرادته هي نفس فعل الخلق فإرادته التي نسميها نحن بالكونية هي نفس التكوين عندهم، والتي نسميها نحن بالشرعية إنما هي نفس الأمر والتكليف.
قال النظام:
“إرادة الله تعالى هي فعله، أو أمره، أو حكمه”
وقال أبو الهذيل:
“الإرادة هي الذات والذات هي الإرادة، وإرادة الله تعالى غير المراد، فإرادته لما خلقه هي خلقه له، وهي معه، وخلق الشيء عنده غير الشيء، وإرادته لطاعات العباد هي أمره بها”.
وهي إذن صفة حادثة وليست قديمة أو صفة فعل على اصطلاح المتكلمين، وليس قائمة بالذات فكيف تكون صفة للرب وهي مع هذا صفة للمخلوق قائمة به لا بذات الباري سبحانه؟ محض تناقض. وهو ما حاولوا منه بجعل الإرادة إرادتين، إرادة قديمة هي نفس الذات الإلهية، وليس حقيقة تقوم بها (لأن الحقائق القائمة بها تعدد للقدماء عندهم، وهو من شرك النصارى والوثنيين)، وإرادة حادثة هي التعلق بين تلك القديمة وبين المحدثات، وهذه ما بين أن تكون لا في محل عندهم كما عند القاضي عبد الجبار وأتباعه، أو تكون قائمة بنفس المحدث المفعول، ولكنها غيره على أي حال وليست هي نفسه! قال القاضي في محل الإرادة إنها لا يجوز أن تحل في الذات لأن “الحلول” إنما يصح في المتحيز، ولا تكون حالة في الغير لأنها لو كانت حالة في الغير، فهذا الغير لو كان حيا، كان هو الموصوف بالإرادة وليس الرب سبحانه، ولو كان جمادا، لكان هو الموصوف بها كذلك من دون الله، ولكان الحي بها أولى، وإذن فلا محل لها !! صفة يوصف بها شيء يمتنع وجوده في الأعيان أصلا وهو اللامحل هذا، ثم هي مع هذا تنسب إلى رب العالمين نسبة الصفة إلى الموصوف بها! الصفة عندهم لا تكون إلا عرضا مركبا في جسم، ولهذا يقول الحلول لا يكون إلا في متحيزا فقيام الصفة بالموصوف “حلول” و “تركب” وهذا أصل فسادهم.
والرازي يعرف الإرادة بأنها صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر. وهذا تعريف سفسطائي في الحقيقة، لأن ما لا يحتاج العاقل إلى بيانه، يكون بيانه من السفسطة إذ توضيح الواضحات لا يكون إلا سفسطة. نعم لا شك أن الإرادة إذا تحقق موضوعها، كانت هي ما يرجح أحد طرفي الإمكان على الآخر. ولكن على هذا التعريف يلزم نفي الإرادة الشرعية كما ترى، لأنه يقول “تقتضي” أي توجب، فلا يوصف سبحانه بأنه أراد شيئا ما، إلا وجب وقوعه، على أيما وجه الإطلاق لفظة إرادة في حقه. وعبارة الآمدي كانت أهون من هذا، إذ قال هي عبارة عن معنى من شأنه أن يتخصص به كل واحد من الجائزين بدلا عن الآخر”. وكل هذا لا يصح حتى في المخلوق إذ المخلوق يشاء ويريد، ولكن لا يلزم من مجرد ثبوت الإرادة والمشيئة في حقه تخصص أحد الجائزين أو أحد طرفي الإمكان، والله تعالى يريد منا الأفعال الشرعية إرادة حقيقية على المعنى اللغوي الصحيح، ولكن لا يلزم من ذلك وقوعها منا كما هو معلوم، ولا يلزم من ذلك النقص لأن معنى الإرادة ليس من حقيقته الوضعية وجوب وقوع المراد كما زعمه المتكلمون.
وخلاصة تلك المذاهب تجدها بإيجاز في قول الآمدي في غاية المرام في علم الكلام:
“مَذْهَبُ أَهْلِ الحَقِّ أنَّ الباري تعالى مُريد على الحقيقة، وليس معنى كَوْنِهِ مُرِيدًا إِلَّا قِيامَ الإرادة بذاته، وذَهَبَ الفلاسفة والمُعْتَزِلة والشيعة إلى كَوْنِهِ غَيْرَ مُرِيدٍ على الحقيقة، وإذا قيل: إِنَّهُ مُرِيدٌ فمعناه عند الفلاسفة لا يَرجِعُ إلَّا إلى سلب أو إضافة، ووافقهم على ذلك النَّجَّارُ مِن المُعْتَزِلَةِ؛ حيثُ إِنَّهُ فَسَّرَ كَوْنَه مُريدا بسلب الكراهية والعِليَّةِ عنه، وأمَّا النَّظامُ والكعبي فإنَّهما قالا: إن وُصِفَ بالإرادة شرعًا فليس معناه إن أُضيف ذلك إلى أفعاله إلَّا أنَّه خالقها، وإن أضيف إلى أفعال العِبادِ فالمراد به أنه أمر بها، وزاد الجاحظ على هؤلاء بإنكار وجود الإرادة شاهدًا، وقال: مَهمَا كَانَ الإِنْسانُ غَيْرَ غافل ولا ساه عمَّا يَفْعَلُه، بل كان عالما به فهو معنى كونه مريدًا، وَذَهَبَ البَصْرِيُّونَ مِن المُعْتَزِلة إلى أنَّه مُريد بإرادة قائمة لا في مَحَلَّ، وذَهَبَ الكراميَّة إلى أنَّه مُريد بإرادة حادثة في ذاته، تعالى اللهُ عن قَوْلِ الزَّائِعَينَ”.
قلت: ولأن بعض الفلاسفة قالوا إن الإرادة الإلهية هي العلم الأزلي بكل موجود، قيل لهم إذا كان ذلك كذلك، فلابد أن ينتفي عنه الاختيار، لأنه إذن لا يزال من الأزل مريدا لما لا يمكن أن يقع غيره، لأن وقوع خلافه يكون نقصا في حقه ومن المعتزلة من قالوا إن الله لم يزل مريدا أن يكون ما علم أنه يكون”! وهذه هي مقالة القائلين بالفيض Emanation والربوبيين القائلين بأنه خلق العالم ثم ترك القانون الطبيعي ليكون هو الموجب والمرجح لكل حادث فيه !
قال ابن سينا في الإرشادات والتنبيهات:
“فالعناية هي إحاطة علم الأول بالكل وبالواجب أن يكون عليه الكل، حتى يكون على أحسن نظام، وبأن ذلك واجب عنه وعن إحاطته به، فيكون الموجود وفق المعلوم من غير انبعاث قصد وطلب من الأول الحق، فعلم الأول منبع لفيضان الخير في الكل”.
فحقيقتها كما ترى تصيير الممكنات واجبات على معنى الضرورة العقلية التي يلزم التناقض من خلافها. محال أن يكون غير ما كان، لأنه علم من الأزل أنه لا يكون غيره !! فأين الإرادة إذن؟؟ لا إرادة بل وأين الإمكان؟ لا إمكان على الحقيقة، بل وجوب محض إذا جعلت الإرادة بمعنى العلم هي نفس العلم، فالعلم لا يحدث أصلا، كل ما هو كائن فعلا في المستقبل لن يكون غيره في علم الله تعالى، ولا يمكن أن يكون فإذا كان هذا العلم هو الإرادة، فأين الاختيار على هذا، وأين ما يترجح به شيء على شيء ؟ لا اختيار ولا ترجح وهذا وراد على مقالة الأشاعرة بأن الإرادة واحدة قديمة، تتعلق بها جميع المرادات أي أن كل ما يحدث من الأزل وإلى الأبد فهو مرادها، مهما تعدد فهل أراد أولا ثم علم بعدما أراد شيئا ما أنه قد أراده؟ أم علم أولا، فلم يرد إذا أراد، إلا ما علم من قبل أنه سيريده؟ من جعل إرادة كل مراد معين، شيئا واحدا قديما لا ابتداء له، لم يمكنه الجواب عن هذين السؤالين إلا بتناقض وإذن لزم إبطال الإرادة أو العلم أو كليهما معا!
قال الغزالي:
إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته، لم يزل كذلك موصوفا بها، مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها، فوجدت في أوقاتها كما أراده في أزله من غير تقدم، ولا تأخر، ولا تبدل، ولا تغير، وفق علمه وإرادته.
قلت: أي أراد في الأزل وقوع كل حادث في الوقت الذي وقع فيه. والأزل عند الغزالي وعامة الأشاعرة إنما هو ما كان قبل الزمان، أو في “اللازمان”! أي قبل حدوث جنس الحوادث، الذي كان عندهم بابتداء العالم فقول الغزالي في الأزل لا معنى له أصلا على الحقيقة، لأنه ليس يعقل موجود يتقدم على مبدأ التقدم والتأخر الزماني نفسه !! وهو ظن أنه بذلك يخرج من الإشكاليات الواردة على كون العلم والإرادة الإلهيين أزليين على المعنى الذي كان عليه عامة الفلاسفة الأقدمين وعليه أهل الحديث والأثر للقدم والأزلية، ولكنه صير حدوث العالم بذلك محالا من المحالات من حيث لا يشعر، وإلزام الفلاسفة له بالقول إما بقدم العالم أو بحدوث الباري، معروف مشهور.
والحق أن الرب سبحانه لم يزل عالما بما يريد وما يحب وما هو أحب إلى نفسه، فإذا أراد شيئا لم يرد إلا ما سبق منه العلم بأنه سيريده سبحانه الإرادات تحدث كل واحدة في حينها، لكن العلم بأنها ستقع، قديم عنده سبحانه، والعلم بأنها قد وقعت إذا وقعت متجدد، ولا تعارض. ولا يلزم انتفاء الاختيار، لأن من الممكنات ما لو لم يكن كما كان، لما لزم ظلم ولا فساد راجح في علمه سبحانه فإن قيل ولكنه لا يخلق إلا ما هو أحب إلى نفسه، قلنا فما يمنعه من أن يختار ما هو دون ذلك سبحانه إذا شاء، ما لم يترتب على ذلك ظلم أو وضع للشيء في غير موضعه الذي تقتضيه حكمته ؟؟ لا شيء فهو سبحانه لا مكره له يخلق ما يشاء ويختار والفلاسفة إنما زعموا أن العلم السابق الكاشف بكل مراد على وجه التفصيل يقتضي نفي الاختيار، لأنهم قاسوا الرب على عباده في الأفعال. فالمخلوق قد يعلم أنه سيريد شيئا ما في المستقبل، لأن هذا أحب إلى نفسه فيما يعلم، ثم تراه يميل بنفسه إلى محبة خلافه إذا ما جاء الوقت الذي قدره سلفا، فيبدو له ما لم يكن يعلم، فيغير اختياره وإرادته فقالوا هذا ما به نعرف أنه حر في اختياره وهذا فاسد، لأننا إنما عرفنا أنه مختار، من مجرد حقيقة أنه فعل ما أراد، لا ما كان مكرها مجبرا عليه وما يكون من ذلك البداء والتحول في المخلوق، فإنما يرجع إلى نقصه وجهله، لا إلى كونه مختارا على الحقيقة كما يموه به هؤلاء فمن كان علمه السابق كاشفا فلا يرد عليه البداء وتحول الميل والإرادة، لأمور ظهرت له لم يكن يعرفها من قبل وإنما ينتفي الاختيار عن المخلوق إن قدرنا أن لم يكن ممكنا له أن يغير اختياره السابق لسبب ظهر له لم يكن من قبل يعرفه، فيفعل إذن على خلاف الخيار الذي يقتضيه ذلك العلم الجديد الذي كان عادماله عند اختياره الأول، ويكون إذن كارها أو مضطرا، وهذا ممتنع في حق الله تعالى. فمن سلم من تشبيه الأفعال وقياس كيفياتها على ما يكون في المخلوقين، لم تطرأ عليه تلك الشبهة أصلا، والله الهادي إلى سواء السبيل.
والحمد لله أولا وآخرا
ابو الفداء ابن مسعود غفر الله له ولوالديه.