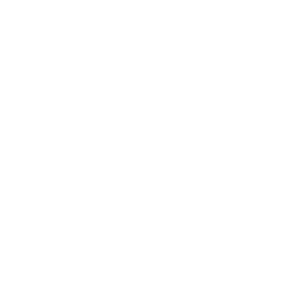مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أقام سوق البراهين على صدق أنبيائه، ونصَب الأدلة القاطعة على نبوة أوليائه، وألهم عباده من نور العقل ما يدركون به وجه الحق، ويميزون به الصادق من المفترِي، والمهتدي من الغوي المدَّعي. سبحانه ما أرسل رسولًا إلا وقد حفّه بعلامات النبوة، وأيده بآيات الصدق، وزيَّنه بخصال العدالة، حتى يكون صدقه أظهر من الشمس، وبرهانه أرسخ من الطود، لا يشتبه حاله على عاقل، ولا يتطرق إلى صدقه شك لبيب.
أما بعد: فقد سُئلت من بعض الأفاضل: هل من سبيل برهاني، يستقلّ به العقل في إثبات نبوة محمد ﷺ، من غير توقف على المعجزة، ولا استناد إلى خرقٍ للعادة؟
فأجبتُ – وبالله التوفيق –: أنَّ دلائل النبوة لا يحصيها العد، ولا يحيط بها حد، لأنها من رحمة الله التي وسعت كل شيء، فكما أن حاجة الخلق إليها أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، كانت أسبابها أدنى تناولًا، وأوسع انتشارًا، وأظهر في الوجود من غيرها؛ حتى يُعلم أن الله ما أراد لعباده أن يؤمنوا إلا بعد أن أقام عليهم البينات، ونوّع لهم السُّبل، ويسّر لهم الدليل.
وما من عبدٍ إلا وقد فُتح له من تلك الدلائل بابٌ يليقُ بحاله؛ فمنهم من يهتدي بالمعجزة، ومنهم من يهتدي بنور السيرة، ومنهم من يهتدي بما في الشرع من محاسن، ومنهم من يَهتدي من غيرِ أن يشعرَ بمسلكِ هدايته، إذ تتراكمُ عليه القرائنُ حتى يقعَ العلمُ دفعةً في قلبه، ولا يستطيعُ لبيانه عبارة، ولا لعدِّه قدرة، ولو حاولَ تفصيلَ ما علمَ ما وسعته العبارةُ، وإن وسعته لم تُطِقْه العبارةُ كما ينبغي، وهذا من أعجبِ طرائقِ العلم، وألطفِها، وأشدِّها مطابقةً للواقع.
وليس كل علمٍ يُنال بدليلٍ واحدٍ محصور، بل كثيرٌ من المعارف تُدرك بمجموع قرائن، قد تتراكم على النفس حتى يقع العلم من غير استحضار لكل واحدة منها، بل قد لا يحصيها الناظر، ولو أحصاها لم تسعف عبارته إلى تفصيلها، ولا قدر على سوقها بنظمٍ يستوعبها.
وقد أحببتُ – إجابةً للسؤال، وإيضاحًا للحجة – أن أذكرَ مسلكًا برهانيًّا من هذه المسالكِ الباهرة، هو من أقربها إلى بداهةِ العامة، وأدناها إلى القلوبِ قبولًا، وأرسخِها في النفوسِ ثباتًا، فإنَّ كثيرًا من الخلقِ لا يقدرون على التفاتِ الذهن إلى دقائقِ المعجزة، ولا يعون حكايةَ خوارقِ العادات، لكنهم وُهِبوا فطرةً تهتدي إلى الصدقِ كما تهتدي العينُ إلى النور، والسمعُ إلى الصوت، والأنفُ إلى الرائحة.
فرتبتُ هذا المسلكَ في صورةِ قياسٍ برهانيٍّ، من أوضحِ ما يركبُ من الأدلة، وأبينِها في أبوابِ الحجاج، وضممتُ إليه من القرائنِ ما يزيده ثباتًا، ومن اللطائفِ العقليةِ ما يزيده إشراقًا، والحمد لله على ما منّ، وله الفضل أولًا وآخرًا.
نصب البرهان
- الكبرى: كل خبر يصدر عن مخبر صادق، ويكون منتهيًا إلى حسّه، فهو خبر صادق.
- الصغرى: الإسلام صادر عن مخبر صادق، ومنتهٍ إلى حسّه.
- النتيجة: الإسلام خبر صادق.
وصغرى القياس مركبة من قضيتين حمليتين بسيطتين موصولتين بالعطف conjunction؛ إحداهما إثباتُ صدقِ المخبر، والثانية إثباتُ أنّ ما أخبر به قد انتهى إليه حسّه، فلا يتمّ صدقُها إلا باجتماع هذين الركنين.
فإذا أثبتنا – فيما يأتي – صدقَ المخبر، ثم أثبتنا انتهاءَ حِسِّه إلى ما أخبر به، انعقد من مجموعهما علمٌ ضروريٌّ بصحّة الصغرى، فصحّت النتيجة، وتمّ المقصود، وذلك هو المطلوب.
إثبات أول قضية: خبر الإسلام صادر عن مخبر صادق
اعلم ــ وفّقك الله ــ أن الصدق لا ينفك عن أماراتٍ تُشهد له، ودوافعَ تدعو إليه، كما أن الكذب لا يُزاول إلا وقد تقدّمته بواعثُ في النفس، ولوازمُ في الحال، يعرفها من خبر طبائع البشر، وتأمل أحوالهم في القول والعمل.
فإذا عُلم انتفاءُ ما يقتضي الكذبَ من غرضٍ أو هوًى أو رهبةٍ أو رغبةٍ، وثبت وجودُ ما يوجب الصدقَ من خُلقٍ أو وازعٍ أو حالٍ مانع، حصل العلمُ الضروريّ بأن المخبر صادق، إذ لا يُتصور حينئذٍ صدور الكذب عن مثله إلا على خلاف ما تقتضيه العادةُ الجارية، والجبلةُ المستقرة، والقرائنُ المتضافرة.
وهذه الأماراتُ أكثر من أن تُحصى، وأظهر من أن تُنكر، غير أن المقام لا يتّسع لبسطها جميعًا، فنكتفي بما يقيم الحجّة، ويُتمُّ المقصود، من أوجه جامعة، تُثبّت بها القلوب، وتُجلي بها السُّحب عن وجه اليقين، والله المستعان.
الوجهُ الأول
أن انتفاءَ الداعي إلى الكذب، دال على الصدق، وقد انتفتْ عن رسولِ الله ﷺ دواعي الكذب، فتعين أنه صادق.
– بيان الأولى: أن الصدقَ مُلاءمٌ للطبعِ، فلا يحتاجُ إلى باعثٍ خارجيٍّ يُحرِّك النفسَ إليه، بل هو الأصلُ الذي تستقرُّ عليه السجايا، وتطمئنُّ به النفوس، بخلاف الكذب، فإنه منافرٌ للطبع، لا تُقدِم عليه النفوسُ إلا لداعٍ يُغري، أو باعثٍ يُضطر، أو طمعٍ يُطغِي؛ فإذا ثبت انتفاءُ هذه الدواعي، وجب رجوعُ الأمر إلى الأصل، وهو الصدقُ، إذ لا صارفَ عنه، ولا غرضَ يُبرِّر العدولَ عنه، فتأمل هذا الموضع فإنه من محكّات العقول.
– وأما الثاني: فإن العادةَ الجارية أن من يكذب في دعوى النبوة إنما يطلب بذلك حظوظًا دنيويةً: من مالٍ أو سلطانٍ أو رياسةٍ أو رفعةِ ذكر، فإذا نظرنا في حال النبي ﷺ، وجدنا أنه أبعدُ الناسِ عن هذه المقاصد، وأزهدهم فيها، وأصبرهم على ما يُنافيها.
فأما المال، فقد تواتر عنه ــ تواترًا معنويًّا ــ زهدهُ في الدنيا، ورضاه بالقليل منها، بل ما زالت حجرته في المدينة ــ عليه الصلاة والسلام ــ آيةً باقيةً في البُعد عن التَّرف والتوسعة.
وأما الجاه والملك، فقد عُرض عليه ما لو شاء لنال به الرياسة العظمى على قومه، فلم يزد على أن أعرض عن ذلك كلِّه، وآثر طريق البلاء، حتى أُخرج من أحبّ البقاع إليه، وأوذي أشدّ الأذى، مع أن طالب الملك إنما يرغَب فيه لتحصيل المال، فإذا بطل المال، بطل التبَع، وانتقضت العلّة.
وأما ما دون ذلك من الحظوظ، فهي أحقر من أن تُوازن ما تحمَّله من العناء، وما صبر عليه من الابتلاء، إذ العقلاء مجمعون على أن من طلب منفعةً، لا يركب في سبيلها مفسدةً أضعافَها، والأنفسُ لا تصبرُ على اللأواء إلا إذا كانت الغايةُ تَعدلها أو تزيد، فكيف إذا كانت الدنيا بأسرها غيرُ مرجوة، ولا مُتناولة، ولا مقصودة؟!
وبيانه من وجه آخر: أن من تأمَّل خبر القرآن، ونظر في مقاصده نظر بصيرٍ منصفٍ، علم يقينًا أن مدارَه كلَّه، ومحورَه الذي تنتظم حوله سائر تشريعاته، ليس فيه أدنى مصلحة دنيوية راجعة إلى المخبر به ﷺ، ولا غرضٌ شخصيٌّ يحوم في فلكه؛ بل المقصود الأعظم، والغاية التي يتردّد صداها في كل آيةٍ وسورةٍ، هي: أن يكون الله هو المقصود وحده، وأن يُفرد بالحب والخوف والرجاء والطاعة، وأن يكون حقُّه مقدمًا على كل حق، ومرضاته فوق كل غاية، وأن يُصرف إليه وجه القلب، لا رجاء دنيا، ولا خوف مخلوق، ولا طلب جاه أو مال.
فتأمَّل ــ رعاكَ الله ــ هذه النكتة البديعة: شريعةٌ مركزُ ثقلها تعظيمُ الخالق وتعفيرُ الجباهِ على أعتابِ مرادِه، ودعوةٌ لا تَعِدُ أتباعَها بدنيا عريضةٍ، ولا تُمنيهم بملكٍ أو سلطان، بل تُحمّلُهم من التكاليف ما يثقل على النفوس، وتُعرّض صاحبَها لما لاقاه من الأذى والتكذيب والحصار والطرد، ثم انظر بعين الإنصاف: أيُّ مصلحةٍ دنيويةٍ يُرجِيها كاذبٌ حتى يحتملَ لأجلها تلك الصِّعاب، ويصبرَ على ذلك العذاب، ويضحّي براحته وماله ونفسه وعشيرته، لا يزداد مع الأيام إلا شدّةً في البلاء وثباتًا على الدعوى؟!
الوجه الثاني
ثم من وجوه الدلالة القاطعة على صدقه ﷺ: استفاضة العادة بتركه الكذب العمد طول حياته قبل البعثة، حتى صار ذلك معروفًا مستفيضًا عند من خالطه وعاشره، في صغائره وجلائله، في لهوه وجده، في سوقه وبيته، في أماناته وخصوماته؛ فكان صدقه مضرب المثل، وعدله موضع الثقة، لا يُعرف عنه كذب في صغير ولا كبير.
وبيان وجه الدلالة: أن من كانت عادته الصدقَ في كل ما يُجريه لسانه، ولم يُعرف عنه كذبةٌ واحدةٌ تُخدش بها عدالته، لا في تجارةٍ، ولا في معاشرة، ولا في مداعبة، ثم ادّعى دعوى هي أعظم ما يُكذَب فيه ـ وهي النبوة ـ، كان انقلاب حاله إلى الكذب فيها ممتنعًا عادةً، بل مستحيلًا في العادة الجارية، فإن النفوس لا تنتقل دفعة من أصدق الناس لهجةً إلى أعظمهم فرية، لا سيما إذا كانت تلك الفرية تقتضي دوام الكذب عشرين سنة في كل قولٍ وفعل، سرًّا وعلانيةً، وجهادًا وتشريعًا، ومخالطةً لأتباعه وأعدائه، وتحمُّلًا لأذًى لا يُطاق، وكل ذلك على نسق واحدٍ لا يضطرب، وعلى صدق لا يختل، وسيرة لا يُعرف فيها كذبة واحدة.
وقد تقرر ذلك بشهادة قومه له، كما ثبت في الصحيح من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}، أنه ﷺ لما قام يدعوهم، قال لهم على رءوس الجموع: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلًا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جرّبنا عليك كذبًا قط». ونظير ذلك شهادة أبو سفيان في حديث هرقل المشهور.
فأقرّوا ـ وهم خصوم دعوته ـ بصدقه المطلق في كل ما عُهد منه قبل البعثة، ومثل هذه الشهادة من الخصم، في مقامٍ كهذا، لا تُطلب بعدها بيّنة.
ومما يقرره: أن خصومه من قريشٍ، مع شدّة عداوتهم له، رموه بالكهانة، وبالسحر، وبالشعر، وسلّطوا عليه شتى التهم؛ غير أنهم لم يجرؤوا قط على وصفه بالكذب فيما سلف من عمره، مع أن تكذيبه من جهة خُلقه أيسرُ حجةً عليهم من تأويل القرآن بالشعر أو الجنون أو السحر، فدل أنهم لم يجدوا إليه سبيلاً. ولو كان في سيرته الأولى ما يُستمسك به لَاتّخذوه حجّةً صارخةً يَدحضون بها دعواه، ولجعلوه عمدة قدحهم في دعواه، فلما لم يفعلوا، ثبت انتفاؤه، وهو المطلوب.
ثم إن تكثر الخصال الحسنة كاشف عن ملكة العدالة المانعة من الكذب، فقد تواتر قبل البعثة وبعدها حلمه ووفائه وجوده وكرم عشرته، وتواضعه وحيائه ﷺ؛ وتكثر الخصال الحسنة = كاشف عن ملكة العدالة، المنافية لما يقتضيه الكذب في ادعاء النبوة من الكذب والمكر الكثير للسنين الطوال، فتعين بطلانه.
الوجه الثالث
ترك الكذب عند قيام دواعيه كاشف على صدق المخبر في نفسه، إذ لو كان كاذبا لكذب متى ما وُجد الداعي، فإن وُجد الداعي ولم يكذب تعين صدقه.
فلو كان النبي ﷺ كاذبًا ـ وحاشاه ـ لما امتنع من استعمال الكذب في المواضع التي يشتد فيها الداعي إليه، ويعظم فيها نفعه، وتَسْهُل فيها الحيلة على العقول الضعيفة، وتُقبل فيها الدعاوى بلا منازع ولا مناقش.
ومن أظهر الأمثلة على ذلك: ما اتفق من اقتران موت ابنه إبراهيم بكسوف الشمس، فوقع في قلوب الناس أن الشمس كُسِفت حزنًا عليه، وهي فرصة سانحة للكاذب ليدّعي تأييد السماء له، وتصديق العالم العلوي لمقامه؛ ومع ذلك كله، صدع بالحقّ، وقال كلمته التي نقضت توهّمهم من أصله، فقال: «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس»، فنفى المناسبة التي علّقوا عليها تأويلهم، وردّ ما وقع في قلوبهم مما لو أقرّه لنُسب إلى السماء، ولقُبل من غير طلب دليل.
ومثله: حصول الدواعي لترك الكذب، والاستمرار على نفس الإخبار؛ فإنه ﷺ لم يزل حاله في سائر طريق دعوته على دعوة واحدة، لم يبدّلها ولا تنازل عن بعضها مع شدّة الأذى، ولا غيّرها مع تعاقب المحن، ولا رغب عنها إذا اشتدت الفتنة، ولا ضاق بها صدره مع ضعف الناصر وقلة المعين؛ بل ثبت على ما قال، يدعو إليه سرًّا وجهارًا، ليلاً ونهارًا، في مكة والحصار، وفي المدينة والتمكين، في حال الاستضعاف، وفي حال السلطان، فلم يُعرف عنه اختلاف في المبدأ، ولا اضطراب في الدعوى، ولا ارتباك في البلاغ، ولا تردُّد عند الشدائد، ولا تلوُّن يُشبه حال المتكلفين أو المتحيّرين.
الوجه الرابع
ما استقرت به العادة وتواترت به المشاهدة من انسجام ظاهره مع باطنه، وتوافق إخباره مع عمله؛ فإن من أعظم ما يُستدل به على صدق المخبر، أن يكون سلوك المخبر مطابقًا لما يدعو إليه، لا يُعرف له مخالفةٌ في خلوةٍ ولا في علانية، ولا يثبت عليه تفاوتٌ بين ما يُظهره وما يُبطنه، إذ هذا الاطرادُ في السيرة آيةُ الصدق، ومطردُ العادة الجارية في الصادقين.
وقد ثبت بالتواتر الذي لا مدخل فيه للريبة، أن النبي ﷺ كان عملُه موافقًا لما يُبلِّغه، وأنه لم يكن يأمر بشيءٍ إلا وسبق الناس إليه، ولا ينهى عن شيءٍ إلا وكان أبعدهم عنه، بل كانت أفعاله تفسيرًا دقيقًا لما نطق به لسانه، حتى عُدَّ فعله في نفسه دليلاً على الشرع، وأُخذ عنه الدين بالاقتداء بسيرته كما أُخذ بالاستماع لكلامه، لا فرق بينهما عند الصحابة رضي الله عنهم؛ إذ كانوا يعدّون كلّ ما يصدر منه تشريعًا، سواءً نطق به لفظًا أو صدر منه فعلًا.
يوضحه: أن أوائل من صدّقه وآمن به، وبذل دمه وماله دون دعوته، كانوا هم أهل بيته، وأقرب الناس صِلة به، وأعرفهم بسرّه وعلنه، ومقامه في خلوته وجلوسه، ومداخل أحواله ومخارجه.
فإنه لا يَخفى على عاقل أن هؤلاء الألصقون بالمرء، الذين يشاركونه معاشه ومأكله ومبيته ومحادثته، أدرى الناس بصدق دعواه، وأقدرهم على كشف كذبه إن كذب، أو فضح أمره إن تظاهر بما ليس فيه، وهم مع ذلك كانوا أسرع الناس إلى تصديقه، وأسبقهم إلى الإيمان به، وأشدهم في نصرته وتأييده، وأعظمهم بذلًا لنفوسهم وأموالهم دونه، حتى قُتل بعضهم في سبيله، ونُكّل بآخرين لأجله، وتركوا ديارهم وأموالهم وهجروا أوطانهم لنصرته.
فإمّا أن يُقال إنهم كانوا شركاءه في الكذب، وهذا مما تأباه حالهم من الدين والتقوى والعدالة التي شهدت بها سِيَرهم وآثارهم، فقد كانوا أعفّ الناس وأزهدهم؛ فبطل هذا الاحتمال.
فثبت قطعًا أن ما رأوه من حاله في خلوته وعلانيته، وسرّه وجهره، لا يناقض دعواه، بل يصدقها ويشهد لها، وهو المطلوب إثباته.
إثبات ثاني قضية: انتهاء حس المخبر إلى المخبر به
اعلم أن الأصل في المخبر أن ينتهي حسه إلى المخبر به، والحائل بينه وبين ذلك لا يخلو إما أن يكون:
أ- عارضا، كالوهم: وهو باطل لأنه لا يكون دائميا ولا أكثريا، والأخبار من هذا الجنس متكاثرة.
ب- أن يكون حائلًا لازمًا، كاختلالٍ في العقل، أو فسادٍ في القوة المدركة، وهذا معلوم البطلان إما من قرائن حال المخبر: فإن هذا يُبطله ما تواتر عن النبي ﷺ من قرائن حاله، الظاهرة والباطنة، مما يُثبت رسوخ عقله، وكمال فطنته، وسداد رأيه، واعتدال طبعه، وقوة تمييزه، وحسن تدبيره، وثباته في مواضع الاضطراب، ورباطة جأشه في المواطن التي تُزلّ فيها الأقدام، وتشيب فيها الرؤوس.
فمن تأمل سيرته ﷺ في جميع أطوارها، من مبدأ دعوته في مكة، إلى توسّع دولته في المدينة، ثم ما كان عليه في غزواته، وصلحه، وقضائه، وسياسته، ورعايته لشؤون الخاصة والعامة، علم علمًا قطعيًا أن سلامة العقل، وجودة التقدير، وحسن النظر في العواقب، واستقامة القوى النفسية والعقلية، كانت من أظهر خصاله، وأشدها رسوخًا فيه.
وأيسر منه أن نبطله، من نفس المخبر به، إذ لو صح الفرض لم يصدر القرآن، التالي باطل فالمقدم مثله؛ وبيانه لوجوه:
- الأول: ما كان من بلاغة نظم القرآن، وهذا مما لا مماراة فيه لمن ذاق شيئا من العربية، حتى لو تنزلنا عن منزلة الإعجاز، فقد شهد له فحول الشعراء بالبلاغة، وهذا مما ينافي الفرض المتقدم؛ فلو قيل هو شاعر بارع:لَلزمَ الإقرارُ ببراعةِ قائله، ومقتضى ذلك سلامةُ قريحته وتمامُ تمييزه، وقد قدمنا العلم بصدقه فبطل هذا القسم أيضا، فلم يبقى إلا أنه نبي.
- الثاني: ما في القرآن من دقائق قصص الأنبياء المطابقة لما في كتب الأولين، التي تحتاج العلم باليونانية والسريانية والعبرية، والاطلاع على العهد القديم والجديد، والتلمود، وكتابات الآباء. فإنا وإن تنزلنا في عدم أمية ﷺ، وفي إمكان النظر في جميع تلك الكتب في ذلك العصر، فإن أي تفسير يقدمونه هادم للفرض المتقدم وهو المطلوب، وباجتماعه مع ما تقدم من ثبوت الصدق يبطل التفسير أيضا فيتعين صدق النبوة.
- الثالث: ما في الوحي من تشريعٍ كاملٍ متناسقٍ مطّردِ المقاصد في جميع أبواب الحياة؛ أصولُه وفروعه على نسقٍ واحد، يخلو من التناقض والاضطراب، ويزداد إحكامًا بالنظر فيه. ومثل هذا النظام لو فُرض بشريًّا لم يصدر إلا عن عقلٍ في غاية السلامة والرجحان، وقد قدمنا إبطال فرض الكذب العمد، فيثبت أنه وحي.
- الرابع: أن القرآن الذي جاء به يدعو إلى توحيدٍ خالص، مطابقٍ لما تقضي به الفطرة، وتوجبه العقول السليمة، من أن التعلّق بالله وحده، علمًا ومحبةً وتعظيمًا وطاعةً، هو أكمل ما تتعلّق به قوى الإنسان، وأنه الغاية التي يليق بكمال الخالق أن تكون هي مقصد خلقه.
وبيان ذلك: أن العقل الصريح يشهد أن كل فعلٍ مقصودٍ لفاعلٍ حكيم، لا بد أن تكون له غاية تليق بحكمته وكماله، وأن هذه الغاية تتفاضل شرفًا ورفعةً بحسب المتعلَّق بها؛ فكلما كان متعلَّق الفعل أشرف، كان الفعل أشرف، كما أن العلم يشرف بشرف المعلوم، والمحبة بكمال المحبوب، والطاعة برفعة المطاع.
فإذا تقرر أن الله تعالى هو أكمل الموجودات، وجب أن يكون التعلق به هو أكمل الغايات الممكنة للإنسان، وأن يكون جعله غايةً لعباده هو مقتضى حكمته، وموجب كماله، لا يجوز في العقل خلافه.
فإذا ثبت أن هذا التوحيد هو غاية الخلق، وغاية الشرع، وغاية دعوة النبي ﷺ، تعيّن أن يكون مبلغُ هذا الغرض الإلهي الجليل صادقًا في دعواه؛ إذ لا يليق بحكمة الخالق الكامل أن يُجري أسمى مقاصده على يد من هو صادق في نفسه مختلّ في قواه، فإن ذلك ينافي الحكمة، ويدخل في باب السَّفَه الممتنع في حقّ العليم الحكيم.
بل لو نُسب هذا إلى ملكٍ من ملوك الأرض، يرسل سفيرًا إلى رعيته يعلم منه خللًا في عقله، عُدّ ذلك نقصًا في عقل الملك وسوء تدبيره؛ فكيف يُظن هذا برب العالمين؟!
فتثبت بهذا البيان الباهر نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.