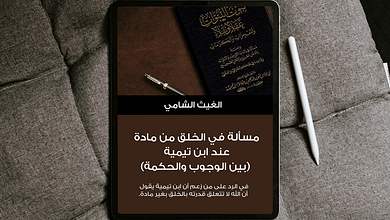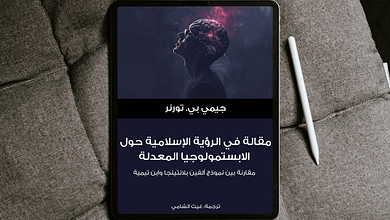تمهيد:
بئس الحوار مع الملحد، حوار من كان من قبل مسلما ثم أعلن إلحاده ثم تاب!
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، أما بعد، فيظن كثير من الناس أن خير من يحاور الملحد هو من كان من قبل مرتدا عن الإسلام إلى الإلحاد، مجاهرا بردته، معاندا عليها، ثم تاب ورجع! وهذا غلط عظيم، مبناه على الظن والتصور ذي الأصول اليونانية الضاربة بعمق في الثقافة السائدة في بلاد المسلمين، بأن الملحد بعموم إنما يلحد بسبب جهله وعدم درايته بالسبب الصحيح السالم من المعارضات والإيرادات العقلية والفلسفية، للمعرفة بوجود الباري سبحانه، وباستحقاقه لأن يعبد وحده لا شريك له. فإذا كان هذا التائب حديثا من الردة، العائد من الإلحاد إلى الإسلام، بعد انتصار للإلحاد ومنافحة عنه، قد “اقتنع” أخيرا بأن الإسلام حق، فلابد أن يكون قد اجتمع عنده العلم بأقوى اعتراضات الملاحدة، التي يمكن أن تخرج الرجل من إسلامه إن تعرض لها، والعلم كذلك، وفي نفس الوقت بجوابات تلك الاعتراضات التي يرجى منها أن تكون سببا في إقناع الملاحدة عامة سواء كانوا مرتدين أو أصليين، كما اقتنع هو!
ووجه الغلط في ذلك الظن أو الوهم، أن المرتد إلى الإلحاد، الذي بلغ أن أظهر ردته في المسلمن، وعرف عنه ذلك، لم يقع له ذلك، من حيث السبب الأصلي الأول وبيت الداء وأصل العلة والمرض، من أثر جهل اعتراه بأصول الدين، أو بفلسفات ونظريات مخصوصة وبراهين نظرية معينة، بحيث إن اكتسب ذلك العلم المنشود، عرف ما يدعوه إلى الإيمان والتسليم كما آمن المسلمون وسلموا! وإنما تلبس بذلك لأنه قد صرعه في قلبه ونفسه من الهوى الفاحش والكبر العظيم ما وهّن لديه الخوف من عقوبة الآخرة الأبدية التي يعرفها ولا تخفى عليه، حتى زال بالكلية! هذه هي الآفة، فاعرفها وعض عليها بالنواجذ! وقد بسطت الكلام عليها وأطلت النفس في مجلد كبير، وهو كتاب “الكشاف المبين لما في نفوس المستكبرين”. الآفة يا كرام، وبيت الداء، بإيجاز أرجو ألا يكون مخلا في هذا المقام، هو أن الزاجر والحاجز القلبي عن مكابرة المعقول والسفسطة عليه ومغالبة دلالة الفطرة التي لا يرد عليها المعارض النظري مبدئيا عند العاقل سوي النفس، والإصرار على ذلك وإظهاره بين المسلمين، هذا الزاجر أو الحاجز النفسي يسقط من قلب الرجل، إذا ترك نفسه تترسل مع شهواتها العاجلة، فتبلغ ألا تحب إذا أحبت إلا ما يحقق لها تلك الشهوة العاجلة، ولا تكره إذا كرهت إلا ما يحول بينها وبين تلك الشهوة! الآفة بإيجاز شديد هي الغفلة عن النفس وما فيها وما يحركها من الميول والشهوات! فاستعيذوا منها فإن فيها هلاك الدين، نسأل الله السلامة! الغفلة تقع في الإنسان، لأن النفس قد ركب الله فيها ابتلاءً، غريزة تميل بها إلى التّفلّت من سلطان صاحبها، وإلى الجموح في الشهوات والملذات بلا زمام ولا خطام! تلك الشهوات والملذات التي منها حب السيادة والرياسة والتصدر في المجالس! فإن لم يراقبها ويحكمها، مداوما على ذلك في يومه وليلته ما استطاع، جرته خلفها كالبهيمة أعزكم الله، لا تشعر أنها تقاد إلى هلكتها! فلربما لم ينتبه صاحبها إلا وقد أخرجته من السنة إلى البدعة، أو أخرجته من الإسلام بالكلية، نسأل الله السلامة! يترك لغريزته السلطان على أمره، فتميل به إلى مجالسة أناس يجد في مجالستهم إشباعا لشهوة ما، على ما فيهم من البدع والمخالفات، يستحسن مجالستهم ومسامرتهم، وهم من أهل البدع والانحرافات، فإذا به تميل به نفسه لتهوين أدلة أهل السنة في نقض تلك البدع والرد على أصحابها، وتصوير النزاع في صورة النزاع المستساغ، والأمر الهين، الذي لا يكون المخالف فيه متوعدا بالنار! فإن عدم من يحب مجالستهم في الجهة المقابلة، من أهل السنة الحريصين على صاحبهم ألا يزيغ ولا يضل، وأصبح بحيث لا يخاف من شيء يفقده في عاجل أمره إن أعلن مفاصلة أهل السنة بالكلية، والانضمام إلى أولئك الخلطاء المحببين من أهل البدعة، وغفل عن العاقبة الأخروية بالكلية، تم التهام الذئاب له، ووزعته نفسه على ذلك وزينته له، فصار يرى الحق باطلا والباطل حقا! الشاة القاصية لماذا قصت وبعدت، حتى التهمها الذئب؟ لأن القلب مال بها عن بقية الغنم، إلى أرض ليست من مرعاها! لا لأنها كانت تجهل أمرا ثم تعلمته أو تعلم أمرا ثم جهلته! المعرفة الفطرية تظل قائمة في النفس، لا تزول ولا تتبدل! ولكن قد يعتري النفس من الغفلة الناشئة عن اتباع الشهوات والترسل مع المحبوبات والمستلذات، ما يجعلها تميل إلى تسويغ ما كانت من قبل تبطله وتشنع على أهله كما هو حقهم أن يشنع عليهم! فأمر الهوى وميل النفس أمر عظيم لا يستهان به! وهو بريد الكفر والردة!
فإذا وقع ذلك الميل في غفلة من صاحب تلك النفس، إذا بالدعوى التي كانت فيما مضى شبهة، وكلاما فاسدا لا يمكن للعقل أن يقبله، تنقلب، من تغير ميل النفس وهوى القلب، فتصبح قولا وجيها له حظ من النظر والاعتبار! ويصبح الحق الجلي الواضح الذي ما كان من قبل ليرد عليه الشك أو الارتياب أو الترديد أبدا، يصبح أمرا نظريا جدليا ترد عليه الواردات الكثيرة، والاعتراضات الوجيهة، الجديرة بالاعتبار وباحترام أصحابها! لا لأنها هي محترمة في نفسها، من حيث هي مقالات لها شبهات تورد معها على أنها أدلتها، ولكن لأنه يصبح وقد مالت قلبه إلى احترام أصحاب تلك المقالات وتعظيمهم والطمع فيما عندهم! فهنا، يتم استدراج تلك النفس المريضة، الغافلة عن أسباب مرضها، التي بقيت على تلك الغفلة السرطانية ربما لسنوات تعد بالعشرات، للخروج من الدين بالكلية، وادعاء الجهل بأسباب المعرفة بصحته، وبأنه هو الدين الحق! ولا يكون ذلك إلا وقد تمهدت الأسباب أمام صاحب تلك النفس ليجاهر بردته ويظهر نفسه في مظهر البطل الجريء الشجاع الذي لا يخاف من بطش الناس به!
لذا جاء الشرع بمخاطبة المرتد المصرح بردته بالاستتابة، لا بالمناظرات والحوارات المفتوحة كما يسلكه الجهال ومن تشربوا بطريقة الكلام والفلسفة!! تُبيَّن له شبهته، مع الاستتابة ثلاثا عند القاضي الشرعي، فإن تاب وإلا قتل! لأن التعرض للسيف والتيقن من الهلكة عند الإصرار على الباطل الجلي الظاهر، يفقد النفس ما كانت من قبل تتعلق به من شهوة لتصحيح ذلك الباطل والشبهة التي تحته، واعتبارها من جملة الأدلة المعقولة على صحته! فإن كان يرجى لهذا خروج من تلك الحال، فالسيف من أسبابه، بل على رأس أسبابه! وصحيح إنه ليس كل من يكون ملحدا، يكون إلحاده بسبب الإصرار على الباطل بعد تبين الحق، كما فيمن كان مسلما ثم ارتد إلى الإلحاد، لأن الملحد قد يكون ملحدا أصليا، كما في كثير من بلاد الغرب اليوم، يولدون على الإلحاد ويموتون عليه، لا يعرفون غيره، إلا أن الغفلة والترسل معها، والغرق في الشهوات والملذات، وترك حبل النفس على غاربها، هذا هو سبب إلحاد الجميع، وانتصارهم لإلحادهم إن خوطبوا فيه، حتى هؤلاء! وإلا فإني أزعم أنه ليس في العالم اليوم من لا يعرف ما أصل الدعوى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء يدعو الناس لعبادة الرب الواحد الذي خلق كل شيء، وتعظيمه كما هو حقه أن يعظم، وألا يعبد معه غيره! اللهم إلا من ولد في شاهق جبل أو عاش عمره كله في أحراش إفريقيا وغابات الأمازون، لا يعلم عن العالم من حوله إلا ما عليه أهل قريته، وهؤلاء لا يكونون ملاحدة، بل وثنيين على الأغلب.
فإذا كان هذا هو سبب انحدار من تربى على الإسلام ونشأ بين أهله، إلى حمأة الردة والإلحاد، وإظهارهما بين الناس، فبأي عقل يقال إن خير من يخاطب الملحد رجاء إفاقته وإرجاعه إلى الحق، أو دعوته إليه، هو من كان من قبل مرتدا إلى الإلحاد مجاهرا به ثم تاب، لأنه يكون أخبر بأسباب الإلحاد والخروج منه من غيره؟؟ إذا كان ما وصل إليه الدكتور مصطفى محمود قبل التوبة، علامة على وصول القلب والنفس إلى أحط دركات الغفلة والتشبع بالأهواء وبالركون إلى أهل الباطل العظيم الذي ليس في الأرض ما هو أبطل منه، وألا يرى الإنسان ما يحجزه في نفسه عن الغرق في أبلغ وأفحش صور المكابرة والمغالطة والسفسطة والجحود على الإطلاق، مع جهل عميق الغور بدين الله تعالى، وعامية محضة فيه، فغاية الرجل إذا وفق للتوبة، أن يجاهد نفسه ما بقي له من العمر، وأن يضرع إلى الله في ذلة وانكسار، رجاء أن يصلح له قلبه، وأن يخلّصه من تلك الميول الشيطانية التي كادت أن ترديه في قاع جهنم لولا أن رحمه ربه! أما أن يصبح “مفكرا إسلاميا”، وظيفته “التفكير في الإسلام”! هكذا! يتصدر في التصنيف عن الإسلام وعن الإلحاد، والرد على الإلحاد ومحاورة الملحدين وهذه الأشياء، دون أن ينقطع لطلب العلم الشرعي ويثني ركبه بين أيدي العلماء الكبار، كما يسلكه كل طالب يريد تحصيل العلم بدين الله تعالى كما يتعلمه الناس، فهذا دليل في مجرده على أن أصل الكبر والاغترار بالعقل والإعجاب بالرأي في نفسه لم يزُل منها بعد التوبة، وإنما أعيد توجيهه إلى وجهة جديدة، أهون أثرا وأخف في ثمرتها من الوجهة الأولى، نسأل الله السلامة! غايته أن تكلف في عقله الباطن شيئا من تهذيب هواه وكبره وإعادة توجيهه، لا أنه وفق للتخلص منه بالكلية! ومثل هذا، تتوقع، من قبل أن تقرأ كتابه في الرد على الملحدين، أن ترى الجهل فيه طافحا، وأن تراه ينقل الملحد إلى ما الله به عليم من صور الزندقة والجهمية وفساد الاعتقاد! لماذا؟ لأنه لابد، والحالة هذه، أنه إنما أسس إيمانه على نفس نوع الأصول التي كان من قبل قد أسس عليها إلحاده، كلها أو بعضها، وبنفس الطريقة الفلسفية الفاسدة! ولو أنه تعلم السنة وصبر على تعلمها بعد توبته، لهداه الله للخروج من تلك الأصول جملة، ولكن أمثاله لم يروا أنهم يحتاجون إلى تعلم شيء من الدين أصلا، لا قبل التوبة ولا بعدها! هم في أعين أنفسهم أكبر من هذا، نسأل الله العافية!
الحتمية الجينية وكتابة القدر في الجينات!!
يتكلم الدكتور في مقدمة الكتاب (1) عن اكتشاف الجينوم البشري وفك الشفرة الوراثية وهذه الأشياء، ودلالتها على طلاقة القدرة الإلهية، فيقول: “وحينما ظهر أمر الجينوم البشري، ذلك الكتيب الصغير من خمسة ملايين صفحة في خلايا كل منا والمدون في حيز خلوي ميكروسكوبي في ثلاثة مليارات من الحروف الكيميائية عن قدَر كل منا ومواطن قوته ومواطن ضعفه وصحته وأمراضه.. أفاق العالم كله كأنما بصدمة كهربائية، كيف؟ ومتى؟ وبأي قلم غير مرئي كتب هذا “السفر” الدقيق عن مستقبل لم يأت بعد، ومن الذي كتب كل تلك المعلومات، وبأي وسيلة، ومن الذي يستطيع أن يدون مثل هذه المدونات؟ ورأينا كلينتون رئيس أكبر دولة في العالم يطالعنا في التلفزيون ليقول في نبرات خاشعة: أخيرا أمكن جمع المعلومات الكاملة عن الجينوم البشري وأوشك العلماء أن يفضوا الشفرة التي كتب الله بها أقدارنا. هكذا ذكر الله بالاسم في بيانه” (2)
قلت: فهو كان يعتقد أن قدر الإنسان، أي ما هو واقع في مستقبل أيامه منذ أن يولد وحتى يموت، مكتوب في كتاب الجينوم داخل خليته! وهذا ليس اعتقادا فاسدا لأنه لا دليل عليه من السمع وحسب، ولكن لأن الطبيعيين يعتقدون أن الجينات تشكل الإنسان ظاهرا وباطنا، وبعض غلاتهم يعتقدون أنها هي التي توجهه للتناسل والتكاثر حرصا على أن تتناسخ في نسله فتظل باقية في الأرض من بعده، كما في كتاب دوكينز الشهير “الجين الأناني”! أي أنها هي التي تملي عليه كثيرا مما يفعل، طلبا في مصلحة بقائها! وهذا مما يمكن أن يقال له الحتمانية الجينية Genetic Determinism، وهو من شرك الطبيعيين ولا شك! فإن لم يكن الدكتور قد بقيت فيه بقية من ذلك أو من أصوله الفلسفية عند أصحابه، فما الذي أدى به إلى أن يربط بين الجينوم والجينات وبين القدر وما هو كائن للإنسان في مستقبل أمره كما عبر هنا؟؟ الله المستعان!
يقول معلقا: “نعم، كانت صحوة مؤقتة أعقبها جدل وضجيج وعجيج وتكلم الكثير باسم الدين وباسم العلم واختلفوا، وعادت الأسئلة القديمة عن حرية الإنسان، وهل هو مسير أم مخير، وإذا كان الله قدر علينا أفعالنا فلماذا يحاسبنا؟ ولماذا خلق الله الشر، وما ذنب الذي لم يصله قرآن.. وما موقف الدين من التطور، ولماذا نقول باستحالة أن يكون القرآن مؤلفا. وعاد ذلك الحوار القديم مع صديقي الملحد ليتردد، وعادت موضوعاته عن الجبر والاختيار والبعث والمصير والحساب لتصبح مواضيع الساعة.”
قلت: فهو يقر من ادعى أنه قال إن الله قد كتب قدر الإنسان في جينومه، ويعجب من “اعترافه” بهذا المعنى، ثم ينتقل إلى الكلام عن القدر هل هو جبر أم لا، وهل الإنسان “مخير أم مسير” وما شاكل ذلك والله المستعان!!
الله خالق قانون السببية!
في أول جواب لسؤال الملحد، في أول صفحة من الحوار: “من خلق الله؟”، وزعم الملحد أن إثبات مخلوقية العالم بقانون السببية يوجب القول بمخلوقية صانعه تحت نفس القانون، يجيب الدكتور فيقول فيما يقول: “والوجه الآخر لفساد السؤال، أنك تتصور خضوع الخالق لقوانين مخلوقاته، فالسببية قانوننا نحن أبناء الزمان والمكان، والله الذي خلق الزمان والمكان، هو بالضرورة فوق الزمان والمكان، ولا يصح لنا أن نتصوره مقيدا بالزمان والمكان، ولا بقوانين الزمان والمكان. والله هو الذي خلق قانون السببية، فلا يجوز أن نتصوره خاضعا لقانون السببية الذي خلقه. وأنت بهذه السفسطة أشبه بالعرائس التي تتحرك بزمبلك، وتتصور أن الإنسان الذي صنعها لابد هو الآخر يتحرك بزمبلك. فإذا قلنا لها بل هو يتحرك من تلقاء نفسه، قالت: مستحيل أن يتحرك شيء من تلقاء نفسه، إني أرى في عالمي كل شيء يتحرك بزمبلك.”
قلت: هذا الكلام فيه أغلاط كبيرة بل طوام والله المستعان! قوله: السببية قانوننا نحن أبناء الزمان والمكان، والله هو الذي خلق الزمان والمكان وخلق قانون السببية، هذا الكلام فاسد من وجوه: فأولا، السببية مبدأ عقلي ملازم ضرورة لمعنى الحدوث والابتداء بعد العدم. فكل ما يحدث في الأعيان بعد عدمه، أو يبدأ في الوجود بعد عدمه، لابد له من سبب يرجح وقوعه على عدمه! هذه الضرورة العقلية الأولى، يصيرها الدكتور إلى شيء مخلوق، وكأنها قانون طبيعي مركب في طبائع العالم، كقانون الجاذبية مثلا. وهذا يقتضي بأدنى تدبر، أن يكون الاستدلال به على مخلوقية العالم، من قبيل مغالطة التركب Fallacy of Composition، فيقال، كما قاله بعض فلاسفة الملاحدة فعلا في الرد على برهان الحدوث، إن ما يصح في كل جزء من أجزاء الشيء وأبعاضه، لا يلزم أن يصح في كله ومجموعه. فلإن سلمت لك يا صاحب البرهان، بأن كل ما كان مركبا في غيره (كما هو شأن كل جزء من أجزاء العالم) كان حادثا وكل حادث لابد له من سبب، لم أسلم لك بالضرورة بأن العالم نفسه بكليته يحتاج إلى سبب! فالمنطق المطروح في البرهان هنا هو المنطق الميتافيزيقي اليوناني في إطلاق الأحكام على الموجودات بالقياس، وهو المدخل الذي منه تسلط الفلاسفة على تلك المقدمة، وقالوا إنها تقتضي تلك المغالطة! فلإن صح أن كان طريقنا إلى الحكم بأن موجودات العالم كلها حادثة، ولحدوثها أسباب، هو استقراء العادة فيما هو مشاهد محسوس منه، على أساس أنه قانون طبيعي مخلوق مركب في العالم على نحو ما، لم يلزم من ذلك أن يكون العالم نفسه بكليته، الذي هو محل لجريان ذلك القانون وغيره من القوانين، له سبب قد أحدثه هو نفسه بعد عدمه! ولو أنك تمسكت بذلك اللزوم، من ذلك الطريق (طرد الاستقراء وإطلاقه)، للزمك أنت أن تجعل الصانع الذي تثبته هو الآخر له سبب قد أحدثه! فإن قلت ولكن هذا يقتضي التسلسل، قالوا لك فما الذي يمنع من أن يكون العالم نفسه بكليته هو ذلك الموجود الذي ينتهي عنده تسلسل الأسباب والعلل، وليس موجودا من ورائه؟ وهذا منتهى طريقة الكلام، التي هي بحذافيرها طريقة الفلاسفة في السفسطة على تلك القضية! فالمتكلم يريد أن يكون أكثر ملكية من الملك كما يقال! فنحن نقول إن هذه القضية، قضية السببية، ليس طريق ثبوتها عندنا هو الاستقراء أصلا! وإنما نعرفها فطرة وجبلة بتلازمات عقلية نجدها مركبة في نفوسنا من قبل أن نتعلم اللغة نفسها! وهي ما به يعرف كل رضيع أن يلتقم ثدي أمه حتى يتغذى، من قبل أن يعرف ما الثدي وما اللبن وما الغذاء ومن قبل أن يلتقط أي كليات معنوية من مشاهدة جزئيات العالم المشتركة في معنى كونها أسبابا وكون ثمراتها مسببات وهي تتكرر أمامه! والقصد أن قضية “كل ما يحدث لابد له من سبب” ليست إطلاقا ميتافيزيقا مبناه على مشاهدة أحوال الموجودات في العالم، وإنما هي ضرورة عقلية لا ينفيها إلا مسفسط مكابر. وأما المعرفة بأن الله تعالى هو السبب في كون العالم على ما هو عليه، فلا نحتاج أصلا إلى تقريرها وتأسيسا نظريا حتى نعرف أنه سبحانه موجود، وأنه منتهى العلل والأسباب وجودا وضرورة! بل إن وجودي أنا ووجودك أنت أيها الملحد، وحدوثه بعد عدمه الذي تشهد به ولا تقدر على نفيه مهما فعلت، يدل دلالة قاطعة ضرورية على وجود من أحدثك بعد أن لم تكن، واختار لك أن تكون على ما أنت عليه، بعلم وإرادة وحكمة، لأنك لو أرجعت ذلك كله إلى طبع مركب في المواد، فلا تزيد بذلك على إرجاء العلة التامة المرجحة لجميع ذلك، دون أن تنفيها! ولا يمكن أن تنفيها لأن نفيها يفضي إلى التناقض وامتناع حدوث جميع ما أفضى (من حوادث الطبيعة وطبائع المواد التي كان يمكن أن تكون كلها على خلاف ما كانت عليه) إلى وجودك أنت، وامتناع أن يترجح شيء من الممكنات على خلافه! هذا هو المدخل الصحيح للنقض على الملحد إن ادعى أننا نغالط إذ نثبت الصانع من طريق قانون السببية! فجوابنا على من يتحدانا بسؤال “من خلق الله” عند الكلام عن السببية، هو بأن يقال للملحد إن منتهى سلسلة الأسباب والعلل التامة الذي يجب عليك أن تثبته لوجودك أنت نفسك في هذا العالم حيث وجدت وكما وجدت ومتى وجدت، هو الرب الصانع ذو الإرادة سبحانه، وجوبا وضرورة، وإلا ما حدثت ولا أمكن لك أن تحدث ولا أن يترجح وجودك على خلافه كما ترجح! لا أن نقول كما قال الرجل هنا: السببية من قوانين الطبيعة، وخالق الطبيعة لا تسري عليه قوانين الطبيعة التي خلقها!!
ثانيا: الرجل على هذا التقرير يلزمه ألا يجعل للعالم سببا خارجا عنه أصلا، لأنه يقرر أن السببية من قوانين الزمان والمكان، والله متعال على الزمان والمكان، بإطلاق، لأنه هو من خلقهما! وهذا يقتضي امتناع أن يكون سببا في وجود العالم أصلا!! لو صح أن الله “خلق السببية” بهذا الإطلاق، وبهذا المعنى، فلا يجوز أن يكون هو نفسه “سببا” في شيء، كما لا يجوز أن يكون قد تسبب في وجوده شيء، من نفس الجهة العقلية، فتأمل!! لماذا؟ لأن حدوث العالم حدوث، كأي حدوث من حيث المعنى الكلي! فإن قدرناه بكليته حادثا، وأن الرب هو الذي أحدثه بعد أن لم يكن، فالرب إذن كان موجودا في زمان ماض قبل الخلق وليس معه هذا العالم المخلوق، ثم وقع فعل الخلق منه، فحدث العالم بعد أن لم يكن، ثم صار في زمان لاحق موجودا فوق العالم بعد حدوثه! هذا هو المعنى المأخوذ ضرورة وبداهة من كونه قد أحدثه بعد أن لم يكن، وأوجده بعد أن كان معدوما. فإن قلت إنه سبحانه هو خالق الزمان، وإذن فلا تسري عليه معاني الزمان التي منها السببية، منعت من أن يكون قد خلق العالم أو تسبب فيه أو في شيء من موجوداته بأي وجه كان، لأن الخلق إحداث لما لم يكن موجودا، وابتداء له بعد عدمه، والقبلية والبعدية الزمانية من ضرورات معنى الإحداث ومعنى سببية الحدوث كما بينا، لا يقال في شيء إنه حدث “بعد أن لم يكن” أو “خلق” بعد أن لم يكن مخلوقا، إلا على هذا الوجه! فكيف يكون العالم قد حدث، وتسبب صانعه في حدوثه، مع أن التسبب والحدوث من خواص الزمان المخلوق في هذا العالم، ولا جريان له على خالق العالم بوجه ما؟ نحن لا نقول إن الرب يكون خاضعا لقانون من قوانين الحوادث المخلوقة إذا صح أنه تلبس بفعل الخلق الإلهي تلبسا حقيقيا، وقام بذاته ذلك التلبس على الوجه اللائق بذاته، فكان في زمان ماض غير خالق، ثم صار خالقا، ثم صار بعدُ وقد فرغ من خلق السماوات والأرض واستوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا! هذا الترتيب الزماني الذي به ننسب الحدوث إلى أفعاله القائمة بذاته سبحانه، لا يقتضي عندنا أن يكون مماثلا للمخلوقين، خاضعا للقوانين التي تحكمهم، وإنما يقتضي ذلك عند المتشبعين بميتافيزيقا الفلاسفة والمتكلمين، الذين يبدأ أحدهم بأن يقول: الحدوث (بهذا الإطلاق) من خصائص هذا العالم، أو الزمان (بهذا الإطلاق) مخلوق، أو يقول كما قال الدكتور هنا إن “السببية من خصائص العالم المخلوق”، والقوانين المخلوقة لا يخضع لها خالقها! والفلاسفة المثبتون للصانع لما أدركوا لوزام ميتافيزيقاهم الفاسدة، اضطروا إلى القول بقدم العالم، وبنسبة تسبب الصانع في وجوده إلى صورة بخلاف التسبب في الحدوث (وهو ما يسميه الدكتور هنا بقانون السببية)، حتى يقولوا بسببية لازمانية تكون هي النسبة السببية بين الصانع وبين صنعته! وهي ما مثل له كانط بالعلاقة السببية بين القاعد على المقعد، وبين أثر مقعدته في المقعد، وأنه يكون قائما ما دام المؤثر موجودا، ومثل له بعضهم بالعلاقة بين شعاع الضوء ومصدر انبعاثه، وهو ما بات يعرف في الأدبيات العصرية بنظريات الانبعاث أو الانبثاق Emanationism! الله على هذا المذهب لم يبدأ في خلق العالم أصلا، وإنما هو موجود بضرورة وجود ذاته في الأعيان، قديم بقدمه! ولا يمكن أن يصح فيه أنه أحدث منه شيئا بعد شيء، بحيث يكون هو الخالق المختار المريد لكل مخلوق، لأن ذلك كله يورد عليه، على ميتافيزيقاهم الفاسدة، من الإيرادات ما لا سبيل أمامهم إلا الخروج من تلك الميتافيزيقا بالكلية إن أرادوا الخروج منه، وهو ما تأباه عليهم نفوسهم المستكبرة ولا يقبلونه أبدا! أنزل عن صفات الباري صفة صفة، وأعطله فعلا فعلا، ولا أبالي، لا بأس! أما أن أتراجع وأقول إن نظريتي الميتافيزيقية كلها غلط في غلط وعدوان على الغيب ما كان يحق لي أن أتكلفه أصلا من مبدأ الطرح، فلا وألف لا! أهل السنة العقلاء لا يتلبسون بما يتلبس به المتكلم والمتفلسف من أجل أن يصل إلى استعمال قانون السببية والاستدلال به في هذه المسألة، فلا يرد عليهم ما يرد على أهل الكلام أصلا، لأنهم لا ينطلقون في تقريراتهم العقلية من إطلاقات ميتافيزيقية يونانية فاسدة غاشمة، كهذا الإطلاق الذي حرره الدكتور في كلامه! ولكن ما أدراه هو بالفارق بين طريقة أهل السنة وطريقة أهل الكلام؟ لم يدرس شيئا ولا ظن أصلا أنه يحتاج إلى أن يدرس شيئا! وهذا هو نفس الكبر والاغترار بالعقل الذي أورده مهلكة الإلحاد أصلا حين وردها، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله!
فتأمل بربك حجم المصائب والإشكالات الفلسفية المدمرة التي فتحها الرجل على نفسه في أول فقرة من فقرات حواره مع الملحد من حيث لا يدري ولا يشعر! هذا الفساد كله تفتحه بضعة أسطر فقط في أول صفحة من الكتاب!! فخبرني بربك كيف يكون هذا الكتاب مرجعا للدعاة إلى الله في الرد على القوم وفي إبطال شبهاتهم وأكاذيبهم واعتراضاتهم، كما رأيت بعض الدعاة المتصدرين في هذا الباب يعدونه من جملة المصادر؟! النسخة الرقمية التي بين يدي الآن، قام بصفها ونقلها إلى الصورة الرقمية من الكتاب المطبوع، للأسف الشديد، أخت من الأخوات صاحبات النشاط الواسع في منتدى التوحيد (وهي نفس الأخت التي كانت دعتني قديما لنشر مقالاتي في مجلة المنتدى، هداها الله وغفر لها)، ومعها في ذلك العمل أخ لا أعرفه، لعله أيضا من شباب المنتدى، فإنا لله وإنا إليه راجعون! فأنا أعجب والله من هذه الجرأة العجيبة في اقتحام هذا الباب الخطير! هلا سألتم عالما من العلماء الذين تثقون في علمهم قبل الإقدام على عمل كهذا؟؟ الإمام ابن عثيمين نفسه، عليه رحمة الله، قال إن الرجل (مصطفى محمود) تحول من الإلحاد إلى الزندقة، وأن كتبه فيها ما فيها من الكفريات، فهل ابن عثيمين عندكم من العلماء الذين يُنزل على قولهم في هذا؟ أم أن هذا الباب، باب محاورة الملحدين، ليس فيه علماء أصلا عندكم، ولا يفتقر فيه إلى علم، وإنما كل امرئ فيه وعقله وذكاؤه؟؟ نعم! إدارة المنتدى للأسف كانت تقدم من تقدم وتؤخر من تؤخر لا بالعلم والأهلية العلمية والمعرفة بسلامة منهج الكاتب من كتاب المنتدى عندهم! وكيف لها ذلك إن طلبته، والكتاب هناك أكثرهم مجاهيل الأعيان، يكتبون من وراء معرفات وهمية، وكثير منهم هارب من الأمن متخف من أجهزة الشرطة في بلاده؟؟ فهم ما كانوا يفرقون بين الناس علميا بالأهلية كما هي طريقة أهل السنة في ذلك، ولكن بقدرة كل كاتب على وضع تقريرات قوية عقليا، ومبهرة لمن يتابعها منهم، وعلى الصمود في وجه سفسطة الملحد، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله!
نحن لا نقول إن الله “خاضع لقانون السببية”، وإنما نقول إن ضرورة تولد الحادث عن سبب، ترد على أفعاله سبحانه من حيث هي حوادث قائمة بذاته، كما ترد على مخلوقاته من حيث هي مفعولات حادثة ترتبت على تلك الأفعال الحادثة، ولا فرق في ذلك عقلا، ولا يفرق بينهما إلا صاحب نظرية ميتافيزيقية فاسدة كما مر. فهو قبل الفعل الحادث في زمان ليس فيه حدوث، فإذا حدثت لديه مشيئة للفعل، ترتب عليها وقوع الفعل عنه بعد عدمه (زمانيا)، فيما هي حقائق كلية مشتركة بين الخالق والمخلوق، من نفاها أو عطلها عنه سبحانه، لزمه من المصائب ما ذكرنا! الانبعاث المزعوم هذا، أو العقل الفعال كما سماه أرسطو، ليس خالقا أصلا ولا يمكن أن يكون خالقا، لأن الصلة السببية الفعلية الحقيقية بين حوادث العالم وبين ذاته سبحانه ممتنعة عندهم، ولا توجد إلا في الوهم والخيال! والسببية اللازمانية كما يسمونها، لا تغني شيئا عن إثبات السببية الزمانية المتقدمة على كل حادث، بل لابد من تلك العلاقة نفسها بين ذات الباري والموجود الحادث أيا ما كان، أن تبدأ بعد أن لم تكن، فالتسبب في الحدوث شيء، والتسبب في البقاء والاستمرار شيء آخر، وليس إثبات الثاني مغنيا عن إثبات الأول.
ثم يستعرض الدكتور قراءاته الفلسفية فينقل كلاما عن كانط، وكلاما عن أرسطو، ثم ينقل عن ابن عربي قوله: “سؤال من خلق الخالق سؤال لا يرد إلا على عقل فاسد، فالله هو الذي يبرهن على الوجود ولا يصح أن نتخذ من الوجود برهانا على الله، تماما كما نقول عن النور يبرهن على النهار، ونعكس الآية لو قلنا إن النهار يبرهن على النور.” قلت: هذا عند ابن عربي جار على أصله في وحدة الوجود كما هو معروف! الله عنده لا يستدل له بالوجود، لأنه هو الوجود أصلا!! لا موجود بحق سواه!
ثم يتطرق إلى الجواب عن سفسطة الملحد بالسؤال: لماذا إذن يكون الصانع واحدا ولا يتعدد؟ فيقول إنه سيجيب عنه بالمنطق الذي يعترف به، بالعلم وليس بالقرآن. ونحن نقول: هذه هي آفة أهل الكلام عامة! ليس أنهم لا يجيبون بالقرآن، ولكن أنهم يشترطون على أنفسهم أن يكون الجواب “بالمنطق الذي يعترف به” الملحد المستكبر! فما هو المقصود بالمنطق الذي يعترف به هذا؟؟ المقصود الميتافيزيقا المعتمدة أكاديميا في عصره! وهي في زماننا هذا ميتافيزيقا الطبيعيين المعاصرين. ولهذا قال “بالعلم”! ولو كان هذا الرجل أجرى هذا الحوار في القرن الرابع الهجري، لكان مراده بالعلم هنا “المنطق الأرسطي” وميتافيزيقا أرسطو في الوجود والموجود. ولكن لأنه في عصرنا هذا، كان مراده الفيزياء والكيمياء وما شاكلهما، وما تحت ذلك من مسلمات ميتافيزيقية كبرى! وهذه هي آفة الطريقة الكلامية، الراجعة أصلا، كما بسطت الكلام عليه في مواضعه، إلى طمع صاحب الكلام في أن يحفظ لنفسه محلا ومجلسا بين الفلاسفة الكبار في عصره! الجهم لم يستطع أن يقبل فكرة أن يعجزه الفلاسفة عن الجواب وعن تقديم دليل نظري على شرطهم وطريقتهم في إثبات الصانع، إلى حد أن ترك الصلاة أربعين يوما وارتد عن دينه فعليا، ولولا أن أنقذه صاحبه ابن عطاء بالبرهان المطلوب لمات محاربا للإسلام، مصرحا بالعدوان عليه وعلى أهله، نسأل الله السلامة والعافية من تلك القلوب ومما يكون فيها!
يتبع إن يسر الله وأعان
أبو الفداء ابن مسعود
غفر الله له
_______________
الهامش:
(1) وحسبك به من عنوان قبيح مستفز للغاية، ينبيك عن حال المؤلف من قبل أن تقرأ، أن يصف الملحد بأنه “صديقه”، والله المستعان!
(2) ليس هذا ما قاله كلينتون في كلمته التي أعلن فيها إتمام مشروع الجينوم البشري في البيت الأبيض، في حضور فرانسيس كولينز مدير المشروع، تلك الكلمة التي ترجمت وبثت في أنحاء العالم، وإنما قال: “عندما اكتشف غاليليو أنه يمكنه أن يستعمل آلات الرياضيات والميكانيكا ليفهم حركات الأجرام السماوية، شعر، كما عبر عنه واحد من الباحثين الكبار، أنه قد تعلم اللغة التي خلق بها الإله الكون. واليوم نحن نتعلم اللغة التي خلق بها الإله الحياة.”! فلم يذكر القدر في كلامه ولو من بعيد! وهو أصلا لا يؤمن بالقدر، إذ لا يقول به من طوائف النصارى، على تفاوت فيما يقصدونه منه، إلا بعض طوائف الكاثوليك، وكنائس الأرمينيين والكالفينيين! والرجل لا علاقة له بتلك الكنائس أصلا، وإنما تربى بين ظهراني الإفانجيليين في أركانساس!