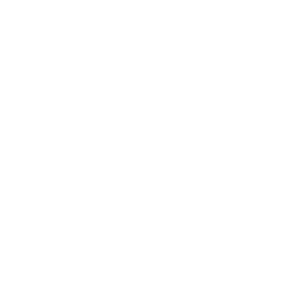الحمدُ لله العليمِ بأدواءِ النفوس، الخبيرِ بخفاياها ودسائسها، لا يخفى عليه اضطرابُ خاطرٍ، ولا يندّ عن علمه وسواسُ صدرٍ، والصلاة والسلام على رسلِ الله، الذين عُرفوا بتمامِ العقول، وسلامةِ الصدور؛ أما بعد:
فإن الناظرَ في مصنّفاتِ العلماء في باب الاضطرابات النفسية، وما يسطرونه من أعراضٍ وتشخيصات، ليجد أن جلَّ ما يوردونه يكاد يتوزع في طباع الناس جميعاً، حتى يخطر بباله خاطرٌ لا يخلو من طرافة: “أفكلنا مرضى نفسيون؟”.
ولما كان المرضُ النفسيُّ – في أنظار كثيرٍ من الناس – مقروناً بوصمة العار، وكان في هذا التصور ما يخالف هدي الشريعة، رأيت أن أبسط القول في هذا المعنى، وأن أتناول هذا السؤال بالجواب في هذا المقال، رجاءَ كشف اللبس، ورفع الوهم، وبيان الحق لمن رام الفهم.
النموذجِ الثنائيِّ في تشخيصِ أمراضِ النفوس (DSM-5)
إن النموذجُ المعتمدُ والسائدُ في تشخيصِ الاضطراباتِ النفسية هو ما يسمى بـ: الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (الإصدار الخامسة) DSM-5، الذي صاغته الجمعية الأمريكية للطب النفسي وفق نموذج تصنيفي صارم، يُحدِّد الاضطرابات بمعايير ثابتة وأعراض محددة.
وقد وقفت على عدة ورقات علمية [1] تنتقد هذه الثنائية الصارمة في التصنيف في هذا النموذج، ويقترحون أن أنّ الاضطراباتِ العقليةَ لا تُمثّلُ حالاتٍ ثنائيةً من الصحة والمرض، أي لا يمكن التعامل معها بمنطق: “مريض أو سليم”؛ بل تتجلّى على نموذج طيفي continuum يُعبّر عن تنوّعٍ دقيقٍ في الوظائف النفسية لدى الأفراد. وقد أخذوا على هذا التصنيف الصارم أمورا:
الأول: كثيرٌ من الأفراد يستوفون معاييرَ تشخيصٍ لعدةِ اضطراباتٍ في آنٍ واحدٍ (كالاكتئابِ والقلقِ مثلًا)، مما يُعقّد التمييز بين العِلّة الأصلية ومظاهرها المتشابكة.
الثاني: أن الناس يختلفون في الدرجة لا في النوع، فليس من المعقول أن نعدَّ مَن ظهرت عليه عرَضان من أعراض اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع سليمًا، لمجرّد أنّه لم يبلغ الحدّ التشخيصي الثلاثي الذي يقرّه الـDSM.
الثالث: أن دراسات الانتشار على مستوى السكان تؤكد أن كثيرًا من الأعراض المصنّفة اضطرابية تظهر – ولو جزئيًّا – لدى نسبة معتبرة من الناس الأصحّاء سريريًا، ما يدلّ على تداخُل الحدّ بين “المرض” و”السّواء”، وعلى أنّ الحدود المصطنعة التي يفرضها النموذج التقليدي لا تعكس حقيقة الواقع النفسيّ.
إنّ النموذجَ المعتمدَ في الأوساطِ النفسيةِ المعاصرةِ لتشخيصِ الاضطراباتِ العقليةِ هو ما يُعرف بـ الدليلِ التشخيصيّ والإحصائيّ للاضطرابات النفسية – الإصدار الخامس (DSM-5)، وهو من تأليف الجمعية الأمريكية للطب النفسي، وقد وُضع على وفقِ تصوّرٍ تصنيفيٍّ صارمٍ، يُحدّدُ الاضطرابَ النفسيّ بمعاييرَ ثابتةٍ، وأعراضٍ محدّدةٍ، تجعل من التشخيصِ عمليةً حاسمةً بين حدَّينِ لا ثالثَ لهما: مريضٌ أو سليم.
غيرَ أنّ عدداً من الورقات العلميةِ [1] قد وقفت موقفاً ناقداً من هذا النموذج، ورأت أنّ هذا التصنيف الثنائيّ لا يفي بحقيقةِ التعقيد النفسيّ الذي يكتنفُ الإنسان، بل تقترحُ بديلاً طيفياً Continuum Model، يُعَبّرُ عن تدرّجاتٍ دقيقةٍ في الأداءِ النفسيِّ لا يُمكنُ حصرها في ثنائيةٍ جامدةٍ.
وقد وُجِّهت للنموذج التقليدي جملةُ مؤاخذات، أبرزُها ثلاثة:
أولها: أنّ كثيراً من المرضى يستوفون – في آنٍ واحد – معاييرَ تشخيصٍ لعدّة اضطراباتٍ نفسيةٍ، كأن يجتمع في الفرد القلقُ والاكتئابُ واضطرابُ الشخصية؛ ممّا يُربكُ التصنيفَ ويجعل التمييز بين العِلّة الأصلية والمظاهر الثانوية أمرًا عسيرًا.
ثانيها: أنّ الناسَ – في حقيقتهم – يتفاوتون في الدرجة لا في النوع، فليس من المقبول أن يُعدّ من ظهرت عليه عَرَضان من أعراض اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع إنساناً سليماً، لمجرّد أنّه لم يبلغ الحدَّ الثلاثيَّ الذي نصّت عليه معايير التشخيص؛ إذ هذا يُغفل التدرج والتفاوت الطبيعيَّ في الشخصية والسلوك.
ثالثها: أنّ دراساتِ الانتشارِ السكانيةِ تُظهِرُ أنّ كثيراً من الأعراض المصنّفة على أنّها مرضية، تظهر – ولو جزئيًا – لدى نسبةٍ معتبرةٍ من الأفراد الذين لا يُصنَّفون مرضى من الناحية السريرية، ممّا يُشير إلى تداخلٍ جوهريّ بين مفهومي “الصحة” و”المرض”، وأنّ الحدودَ التي رسمها النموذجُ التقليديُّ إنّما هي حدودٌ مصطنعةٌ لا تعكس تعقيد الواقع النفسيّ الإنسانيّ.
النماذج الطيفية البديلة: HiTOP وRDoC
وقد برزت في مقابل التصنيفات التقليدية نماذج بديلة، تسعى إلى تجاوز ضيق الأطر الثابتة والانفصال عن الترسيمات الصلبة التي اعتادها العلم الطبي؛ ومن أبرز هذه النماذج: نموذج HiTOP، أي “التصنيف الهرمي للاضطرابات النفسية”. وهو نموذج بُعديٌّ هرميٌّ يُعيد النظر في الطريقة التي تُفهم بها الاضطرابات، إذ ينطلق من مبدأ أن الأعراض والسمات النفسية لا تتوزع توزيعًا عشوائيًّا، بل تتجمّع في أنماط طبيعية متكررة بين الأفراد، فيُصنِّفها ضمن طبقات متدرجة، تبدأ من الأعراض الجزئية الدقيقة، فترتقي إلى بنى أوسع، حتى تنتهي بالعوامل العامة الكبرى التي تهيمن على الطيف النفسي.
ويتميّز هذا النموذج عن سابقاته بأنه لا يَركن إلى الثنائيات الجامدة من قبيل: “مصاب” أو “سليم”، بل يتبنّى تصورًا طيفيًّا يرى كل فرد واقعًا على متصلٍ تتفاوت عليه درجات الشدة في كل عرض من الأعراض، دون حاجة إلى حدود فاصلة بين الحضور والغياب. كما يقوم على تحليل كَمِّيٍّ دقيق للسمات النفسية، بخلاف النماذج القديمة التي كثيرًا ما اتكأت على الإجماع الأكاديمي المحض، دون سند علمي راسخ.
ومن مزايا HiTOP كذلك أنّه أكثر توافقًا مع معطيات علوم الأعصاب السريرية، إذ إن البنية العصبية للدماغ لا تتقيّد بالفواصل الصارمة التي يفرضها DSM، بل تُظهر تداخلاً وتشابكًا بين الأعراض والاضطرابات، يجد صداه الطبيعي في البناء الهرمي الذي يتبناه HiTOP.
وعلى منوال هذا التوجّه الطيفي، دعا بعض الباحثين البارزين – كـتوماس إنسل، المدير السابق للمعهد الوطني للصحة النفسية (NIMH) – إلى تجاوز التصنيفات الصلبة المتعارف عليها، كـ DSM وICD، لصالح أنظمة أكثر مرونة، تراعي الأبعاد النفسية المختلفة، كالمزاج والانتباه والانفصال عن الواقع. وقد أثمرت هذه الدعوة عن مشروع RDoC (Research Domain Criteria)، الذي يطمح إلى بناء تصوّر قائم على الوظائف والميادين النفسية، بدلًا من التقسيمات السطحية التي لا تعكس حقيقة التداخلات العصبية المعقّدة.
من قصور النموذج الثنائي
من أبرز وجوه القصور في النموذج الثنائي ما يتّضح جليًّا في تعامله مع الاضطرابات النفسية، كالاكتئاب مثلًا؛ إذ دلت جملةٌ من الدراسات على أن هذا الاضطراب لا يتجلى في صورةٍ حادّةٍ واحدة، بل هو ذو طبيعة طيفية تتراوح أعراضه بين الخفّة والشدّة، وتختلف باختلاف الأفراد من حيث التكرار والمدة، فلا يصحّ أن يُختزل في حدٍّ قاطعٍ يفصل بين “المرض” و”الصحة”. غير أن النموذج الثنائي، بما ينطوي عليه من تبسيطٍ مخلّ، يتجاهل هذه الفروق الدقيقة، ويُعيق بذلك التشخيص الدقيق، ويَحول دون التوصيف العلاجي الأمثل؛ ولهذا أثبتت النماذج الطيفية جدارتها التنبؤية في الممارسة السريرية [2].
ويتفرع على هذا التقرير = أن ليست كل الأعراض المصنفة عند القوم التي تظهر على النفوس ليست كلها مرضًا، ولا ينبغي أن يُحكم عليها بالحكم العام ما لم تُنظر في أسبابها، وشدّتها، وموضعها من حياة صاحبها. فإن القلق -مثلا- من طبع الإنسان، خُلق معه، يُنذره إذا دنا الخطر، ويوقظه إذا غفل، فهو له عونٌ ما دام في موضعه. وأما إذا طال أمده، واشتد وجعه، وعطّل صاحبه عن معاشه، وأقعده عن واجبه، هنالك يُقال: قد تحوّل من طبعٍ وجبلة إلى اضطرابٍ نفسي.
وكذلك الحزن، فإنه لا يُفارق حيًّا، ولا يسلم منه أحدٌ ما دام له قلب، وإنما يكون في موضعه إذا نزل لمصيبةٍ، ثم انصرف إذا أدّى حقها، أما إذا طالت إقامته في النفس، وأخذ منها مأخذًا، وعطّلها عن شؤونها، وصاحبته الأوجاع في البدن، والظلمة في الفكر، فذاك مرض، لا يُدفع إلا بدواء.
فدع عنك هؤلاء الذين يجعلون الناس صنفين لا ثالث لهما، وارجع إلى من قال بتدرّج الأحوال، وتفاوت الطبائع، وتنوع الأعراض.
ذكر موقف الشرع
والذي يعنيني من هذا النقد، هو تصحيح ما اعوجّ في تصوّر المسلم المتعلّق بهذه العلوم الإنسانيّة، فإنّه قد شاع بين طوائف من الدارسين لها ظنٌّ باطل، يجعل المرء إذا قصد طبيبًا نفسيًّا أو تردّد على عيادته، يحكم على نفسه بأنّه “غير طبيعيّ”، أو يُلبَس لبوس الوصمة والعار تحت ما يُعرف بـ وصمة المرض النفسي illness stigma. وهذا -ولا ريب- مخالفٌ لسنن الشريعة، ومعارضٌ لما جاءت به من تعظيم شأن الابتلاء، وتقدير مقام الحزن والهمّ والغمّ، فإنّ أهل الإسلام يعلمون أنّ هذه الأمراض من لوازم الطبيعة البشريّة، لا ينفكّ عنها ابن آدم؛ يمرّ عليه الحزن تارةً والفرح تارة، والسرور حينًا والضيق حينًا، فتلك سنّة الله في خلقه، وله في ذلك الحكمة البالغة، إذ يُظهر بها مقامات العبودية، من الصبر والضراعة والافتقار، والدعاء والانكسار، وهي من أحبّ ما يُتقرّب به إلى الله. قال سبحانه: ﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَیۡءࣲ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصࣲ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَ ٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَ ٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِینَ﴾ [البقرة ١٥٥]. وتأمل أن لوم النفس من أشهر أعراض الأمراض النفسية، وربنا سبحانه يقول: ﴿وَلَاۤ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ﴾ [القيامة ٢].
قال ابن أبي الدنيا في الهم والحزن ١٦ – حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: «الدُّعَاءُ الْمُسْتَجَابُ الَّذِي تُهَيِّجُهُ الْأَحْزَانُ، وَمِفْتَاحُ الرَّحْمَةِ التَضَرُّعُ». وقال ابن أبي الدنيا في الهم والحزن ٢١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَاتِمٍ الطَّوِيلُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَا عُبِدَ اللَّهُ بِمِثْلِ طُولِ الْحُزْنِ».
فترى المرءَ تُصيبُه الشدائد، ويطيف به الهمّ، فيجزع ويقول: “لست طبيعياً!”، ويحك! وهل كان في الناس أتمّ طبيعة، ولا أصح فطرة، من نبي الله يعقوب؟ قد أكل الحزنُ بصره، وأذاب الدمع أجفانه، فما برح باكياً حتى أُرهقت عيناه، ومع ذلك ما قال: إني مجنون، بل قال: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ﴾. قال ابن أبي الدنيا في الحزن ٦ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ مُنْذُ خَرَجَ يُوسُفُ عليه السلام مِنْ عِنْدِ يَعْقُوبَ عليهما السلام، إِلَى أَنْ رَجَعَ ثَمَانِينَ سَنَةً فَمَا فَارَقَ الْحُزْنُ قَلْبَهُ، وَمَازَالَ يَبْكِي حَتَّى ذَهَبَ بَصَرُهُ. قَالَ الْحَسَنُ: وَاللَّهِ إِنْ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ بَشَرٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ عز وجل مِنْ يَعْقُوبَ». وفي الحديث: «أشدُّ الناسِ بلاءً الأنبياءُ، ثم الذين يلونَهم، ثم الذين يلونَهم»، فكيف لا يكون أمرا طبيعيا؟ وهذا خبر البشر روي عنه في مواضع أنه بكى، أخرج مسلم في صحيحه من طريق يَزِيد بْن كَيْسَانَ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، قَالَ: «زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَبَكَى مَنْ حَوْلَهُ».
وتأمل ما روى الشيخان من حديث عَمْرو بْنِ الحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قَالَ: «اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، فَلمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ، فَقَالَ: قَدْ قَضَى. قَالُوا: لا يَا رَسُولَ الله، فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ، فَلمَّا رَأَى القَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَكَوْا، فَقَالَ: أَلا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلا بِحُزْنِ القَلبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا – وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ – أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ». وكان أبو بكر رضي الله عنه كثير البكاء.
واعلم أن السلف – وهم سادة الدنيا – كانوا يَعدّون الفرح الطويل دليلاً على غفلة، والحزن الطويل دليلاً على حياة قلب، قال ابن أبي الدنيا في الزهد ٨ – ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيِّ، وَنُعَيْمُ بْنُ هَيْصَمٍ وَغَيْرُهُمَا قَالُوا: ثنا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ، قَالَ: «إِنَّ الْقَلْبَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُزْنٌ خَرِبَ، كَمَا أَنَّ الْبَيْتَ إِذَا لَمْ يَسْكُنْ خَرِبَ». أخرج الشيخان من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله من خطاياه». وأخرج مسلم في الصحيح من حديث ثَابِتِ بن أَسْلَمَ البُنانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ الله لِلمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَ المُؤْمِنِ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ فَشَكَرَ، كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ، كَانَ خَيْرًا لَهُ».
فإنك لو نظرت في حال أولي الألباب من الماضين، وفي أخبار الرسل والنبيين، لرأيت أن الحزنَ لم يكن عندهم منقصة، ولا وصفًا يُستنكف منه العاقل، بل كان علامة يقظة القلب، ودليل رقّته، ومادة لتجديد العهد بين العبد وربّه.
قال ابن أبي الدنيا ٥٦ – حدثنا عبد الله بن محمد بن هانئ، أخبرنا مرحوم بن عبد العزيز، حدثني حبيب أبو محمد الهراني، قال: عادني الحسن في مرض فقال لي: «يا حبيب إنا إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا، وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره، ويعطيه عليه الأجر العظيم». وليت شعري كيف يجتمع في نفس أحد الرضا بقضاء الله وقدره، وهذا الشعور الوسواسي؟ يقول وهب بن منبه: «لا يكون الرجل فقيها كامل الفقه حتى يعد البلاء نعمة، ويعد الرخاء مصيبة وذلك أن صاحب البلاء ينتظر الرخاء، وصاحب الرخاء ينتظر البلاء». فتأمل هذه المعاني الإيمانية ومدى مباينتها لهذا الوسواس، قاال ابن أبي الدنيا في التوبة ١٧٠ – حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يُكَفِّرُهَا عَنْهُ، ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِالْحُزْنِ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ».
فليس الحزن عند أهل الإسلام أمرا طبيعيا فقط، بل هو أمر مطلوب! قال ابن أبي الدنيا في الهم والحزن ٢٤ – حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَلْمٍ الْكُوفِيِّ، عَنْ مِسْعَرَ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَوْ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: «يَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يَحْزَنْ أَنْ يَخَافَ أَلَّا يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لِأَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهِبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾». وقال ابن أبي الدنيا في الهم والحزن ٥٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: قَالَ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ: «وَاحُزْنَاهُ عَلَى أَلَّا أَحْزَنَ».
ولولا ضيق المقام، لبسطنا القول في تراجم المحزونين من السلف، من عمار بن ياسر رضي الله عنه، إلى الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وأبي عبد الرحمن الزاهد، ومالك بن دينار وطوائف من أئمة الإسلام؛ وهو حزن على الآخرة لا على الدنيا، قال ابن أبي الدنيا ٣١ – حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْكِينُ بْنُ عُبَيْدٍ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُتَوَكِّلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْعَابِدُ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ: «الْحُزْنُ حُزْنَانِ، فَحُزْنٌ لَكَ، وَحُزْنٌ عَلَيْكَ فَالْحُزْنُ الَّذِي هُوَ لَكَ حُزْنُكَ عَلَى الْآخِرَةِ، وَخَيْرِهَا، وَالْحُزْنُ الَّذِي هُوَ عَلَيْكَ حُزْنُكَ عَلَى الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا». وروى ابن أبي الدنيا: «وَسُئِلَ عَالِمٌ آخِرُ عَنِ الْمَحْزُونِينَ لِأَيِّ شَيْءٍ حَزِنُوا؟ قَالَ: حَزِنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَتَلَهَّفُوا عَلَيْهَا أَنْ لَا تَكُونَ مُطَابِقَةً لِرَبِّ الْعَالَمِينَ». وقال ابن أبي الدنيا في الهم والحزن ٩٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزَّاهِدَ، يَقُولُ: «إِلَهِي غَيَّبَتَ عَنِّي أَجَلِي وَأَحْصَيْتَ عَلَيَّ عَمَلِي، وَلَا أَدْرِي إِلَى أَيِّ الدَّارَيْنِ تَبْعَثُنِي، فَقَدْ أَوْقَفْتَنِي مَوَاقِفَ الْمَحْزُونِينَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي».
ولعل هذه المعاني هي عند أهل الإسلام أظهر من أن ننبه عليها، وليُراجع لمزيد تفصيل: الهم والحزن لابن أبي الدنيا، وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم.
أثر الاعتقادات الطيفية في تقليل الوصمة الاجتماعية
وقد أسفرت جملةٌ من الدراسات عن أنّ التصوّرات الطيفيّة — التي تنظر إلى الاضطرابات النفسيّة بوصفها امتدادًا لتجربة الإنسان ومجرى من مجاري طبعه، لا انقطاعًا عنها ولا انحرافًا شاذًّا عن سوِيّ الفطرة — تُفضي إلى تهشيم قُيود الوصمة التي طالما كبّلت قضايا الصحّة العقليّة وأثقلت كاهل أصحابها. ففي مراجعةٍ علميّةٍ حوت ثلاثًا وثلاثين دراسة، منها ثلاث عشرة تحليلًا تجميعيًّا، تبيّن أن هذا المنظور الطيفيّ يُفضي إلى تقليص المسافة الاجتماعيّة، وتبديد مشاعر الخوف، وكسر تصوّرات الخطورة، مع إذكاء التفاعل الإنساني الإيجابي، ولا سيّما في أعتى مظاهر الاضطراب كالفُصام والاكتئاب [3].
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] “Rethinking the Diagnosis of Mental Disorders: Data-Driven Psychological Dimensions, Not Categories” by Christopher C. Conway, Robert F. Krueger
[2] “A Dimensional Diagnostic Strategy for Depressive Disorders” by Scott B. Patten, published in Journal of Clinical Medicine (2025)
[3] Continuum Beliefs and Mental Illness Stigma: A Systematic Review and Meta-Analysis, by Lina-Jolien Peter, Stephanie Schindler, Christian Sander