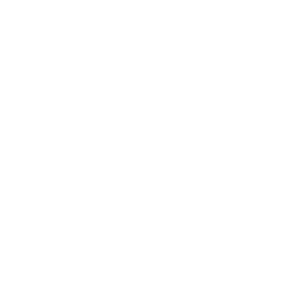الحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله أما بعد، فقد ظهرت في مطلع القرن العشرين مدرسةٌ في علم النفس، عُرفت باسم التحليل النفسي، أرسى أصولها النمساوي سيغموند فرويد، فأُعجب بنظريته قومٌ، وتابعته طائفة ظنّوا أنه كشف الغطاء، وأزال القناع، وجعلوا كلامه علمًا، ونظريته قانونًا، حتى صار الطالب يذكر “اللاوعي” كما يذكر الطبيب نبض القلب.
غير أنّ الناظر بعين الفحص والتمحيص يجدها أقرب إلى البناء الفلسفي التأويلي منها إلى العلم التجريبي؛ فمفاهيمها تفتقر إلى التعريفات الدقيقة، وفرضياتها تَعسُرُ إخضاعها للاختبار، وتطبيقاتها لا تُنتج نتائج قابلة للتكرار أو التعميم.
ونحن نُبصّر الناظر، في هذا المقال، بمباني هذه المدرسة ومقاصدها، ونكشف له مواضع الخلل في أصلها وفرعها، ونقيم الحجة على أنها – وإن زخرفت القول، وتفنّنت في البيان – لا تبلغ رتبة العلم الذي يُعتمد عليه.
شرح مختصر للنظرية
أولًا: التصور الأولي للنفس – النموذج الطبوغرافي
كان أوّل ما بُسط فيه التصوّر الأوّلي للحياة النفسية ما أورده سيغموند فرويد في كتابه تأويل الأحلام (The Interpretation of Dreams – 1900)، إذ رسم نموذجًا طبقيًّا Topographical Model يقسّم النفس إلى ثلاث مراتب أو “أنظمة”، بحسب درجات الوعي والإدراك.
المرتبة الأولى: الوعي (Conscious – Bewusst)
وهذه هي التي يعيها المرء ويشعر بها في الحال، كالإدراك عند النظر، والتفكير الجاري، والانفعال الطارئ. وهي دائمة التبدّل، سريعة الزوال، لا تثبت على حال، إذ تتبع حواسّ العبد وهمّه. وقد شبّهها صاحب النظر بالجبل الجليدي، لا يظهر منه للعين إلا رأسه، وما بقي غاص في لجّ البحر.
المرتبة الثانية: ما قبل الوعي (Preconscious – Vorbewusst)
وفيها تُختزن المعارف التي ليست في الذهن عند اللحظة، لكنها ليست مغلقة ولا ممتنعة، بل يستحضرها المرء إن استدعى، كتفاصيل طفولته، وأسماء من عرفهم. وهي كمنزلة الواسطة، بين الباطن الدفين، والظاهر الجليّ، ومثّلها “فرويد” بغرفة انتظارٍ ذهنية، لا يدخلها إلا من أُذِن له.
المرتبة الثالثة: اللاوعي (Unconscious – Unbewusst)
وهذا موطنُ الأسرار، ومَطْوى الغرائز المردودة، والذكريات المنبوذة، والشهوات التي يأنف الوعيُ من إقرارها. وفيه تُحرَك النفس بحركة لا تعقلها، ولا تضبطها، ويجري فيه “تفكيرٌ بدائيٌّ” Primary Process Thinking، لا يعرف منطقًا، ولا يقيم لزمن وزنًا، ولا يرى في التناقض حرجًا. ولا يُدرك هذا الغور إلا بالتأويل، كأن يكون في المنام، أو زلّة لسان، أو عرضٍ من أعراض العصاب، أو بطريق التداعي الحرّ عند أهل التحليل.
وقد ظلّ موضع اللاوعي من جهة كونه كائنًا وجوديًّا موضع إشكالٍ ونظر؛ فلا يُدرى أهو بنيةٌ قائمة بالفعل، أم مجرد عمليةٍ نفسيةٍ جارية، أم أنه استعارةٌ لمدارك باطنة خفية؟ وقد اضطرب “فرويد” نفسه في تقريره، فتارةً يجعله كيانًا ذا نظام، وتارةً يراه سلوكًا وظيفيًّا، وتارةً يلوّح إليه بلغة الرموز.
ثم جاء من بعده من وسّع هذا المفهوم وجرّده، كـ”يونغ” و”لاكان”، فصبغاه بصبغة رمزية ولسانية، حتى صار أمر الوقوف عليه حسًّا أو التحقق منه تجريبًا مما لا يُرجى.
في نموذج البنية الثلاثية Structural Model
لما رأى “فرويد” أن القسمة الأولى قاصرةٌ عن تفسير بعض الأحوال – كأن يعذب المرء ضميره دون أن يعي ذنبًا، أو أن يقع الكبتُ في غير موضع ظاهر – عدل عن التصوير المكاني، إلى رسمٍ يجمع الوظائف، فجعل النفس مؤلّفةً من ثلاث قوى: الهوى الجامح (Id)، والعقل الموازن (Ego)، والرقيب القاسي (Superego).
الهو (Id): وهو الأصل في كل نفس، يولد به الإنسان، ويجتمع فيه حب البقاء، والتذاذ الجنس، ونزعة الهدم. لا يعرف قانونًا، ولا يصبر على تأخير، يسعى لما يشتهيه في عاجلٍ غير آبهٍ بعاقبة. تعمل فيه قوتان: إيروس Eros للحياة والبقاء، وثارناتوس Thanatos للهدم والعدوان. وتحكمه الأوهام والتخيلات والرموز، لا منطق فيه ولا عقل.
الأنا (Ego): ينشأ من الهو، كما ينشأ العقل من التجربة، وهو ما يضبط الشهوة ويزن الأمور بميزان الواقع. يؤخر اللذة، ويخضع للزمان والمكان، ويحسب للعاقبة حسابًا. يقوم بدور الوسيط بين الهو الغريزي، والأنا الأعلى الرادع، والعالم الخارجي الذي فيه الناس والنظام. وهو موطن التفكير المنطقي، والعمل المتسلسل، وإن كان كثيرٌ من دفاعاته لاواعيًا كذلك. وقد شبّهه فرويد بمن يمتطي فرسًا هائجًا، يحاول كبحه وتوجيهه.
الأنا الأعلى (Superego): وهو صوت التربية، ومرآة الأخلاق، وظلّ الوالدين والمجتمع. ينشأ في سنّ الطفولة، عند استبطان النهي والأمر، ويُقسم إلى:
- المثل الأعلى للأنا Ego Ideal: وفيه صورة الكمال، والطموح.
- الضمير Conscience: وهو السوط الذي يُجلد به النفس إن حادت.
- وقد يكون قاسيًا، يجلد صاحبه وإن لم يذنب، ويحمّله ما لا يطيق.
وتأمل أن مذهب التحليل النفسي يُسنِد أفعالًا وتأثيرات إلى ذواتٍ كـ”الهو” (Id) أو “الكبت” Repression، ويجعلها عللًا لأحوال النفس، دون أن يُبيّن كيف تعمل هذه الذوات في الجسد أو العقل بحسب ما تقرّ به علوم الأحياء العصبية Neurobiology، أو يقدّم ضبطًا إجرائيًّا Operational Definition لماهيتها! فالتفسير السببي عندهم لا يستند إلى آلية سببية مستقلة يمكن امتحانها، بل يُبنى على إعادة تأويل ما وقع وتأويله على ضوء الفرضية.
في جوهر النظرية: صراع القوى Dynamic Conflict
لم ير “فرويد” النفس كيانًا موحّدًا، بل ميدان قتال، تتجاذبه قوى متخالفة.
صراع الهوى والرقيب: فالهو يدفع إلى الشهوة واللذة، والأنا الأعلى يكبح ويقمع باسم الأخلاق. وينشأ من هذا الصراع وجعٌ نفسيّ، يظهر في القلق أو الذنب أو الأعراض المرضية.
دور الأنا: أما الأنا فموكّل بالموازنة، فهو بين ثلاث: شهوة الداخل (الهو)، قسوة الضمير (الأنا الأعلى)، وضغط العالم الخارجي. فيلجأ إلى وسائل دفاع Defense Mechanisms، ليقي النفسَ ألمًا لا تطيقه، ويصون شعورها من الانهيار.
نقد النظرية
الوجه الأول: إن من أعظم ما أُخذ على مذهب التحليل النفسي في الدائرة الأكاديمية، أنه يجعل مخالفة المريض أو مقاومته دليلاً على صحّة الدعوى لا على بطلانها، فيؤول الرفض على أنه كبت Repression، والاعتراض على أنه إنكار Denial، فينقلب كلّ اعتراض إلى تأييد، ويُعاد تفسير كلّ واقعة بما يوافق الفرضية، لا بما يختبرها. مثال ذلك:
- إن أنكر المريض شعورَ البغضاء تجاه أبيه، قال المحلّل: هذا عين الكبت، فالإنكار برهان الخفاء.
- وإن أقرّ بالبغضاء، قال: هذا تأكيد للنزاع الأوديبي Oedipal Conflict، الذي أصلُه كراهية الأب!
فلا يكون ثمة حالٌ تُفند النظرية، إذ كلّ طريق مردّه إلى تصديقها. وكان هذا هو اعتراض بوبر المشهور على مدرسة التحليل النفسي، فقال أن النظرية التي تفسّر كل شيء، ولا تنبئ بشيء، لا تُعد علمًا، بل علم زائف Pseudoscience. ذلك أن العلم الحقّ يعرّض نفسه للخطأ، ويضع فروضًا يمكن نقضها، أما هذه التأويلات التحليلية فليست إلا تبريرات لاحقة Post hoc Rationalizations، تُلصق بالنتائج بعد وقوعها، لا تنبؤات تُختبر قبل حدوثها.
الوجه الثاني: أنّ الطريقة المعتمدة في مدرسة التحليل النفسي – من التداعي الطليق Free Association، وتحليل الأحلام، وتحليل التحويل Transference Analysis – تقوم على تأويل المعالِج وحده، وتمنحه سلطة واسعة في تفسير كلام المريض بما يراه من رموز ومعانٍ، دون وجود ضوابط علمية واضحة أو معايير موضوعية تحكم هذا التأويل. وهذا يفتح المجال لما يُعرف بأثر توقّع المجرب Observer-Expectancy Effect، حيث يرى المعالج ما يتفق مع توقعاته السابقة، لا ما يدل عليه الواقع، وتُصبح النتائج عرضة لتفاوت الفهم، إذ قد يختلف اثنان في تفسير الحالة، ولا يُمكن ترجيح أحدهما بمعيار حاسم.
ولا تعتمد هذه المدرسة على نظام ترميز موحّد Standard Coding System، ولا تراعي الثبات بين المقيّمين Inter-Rater Reliability، كما تفتقر إلى إجراءات يمكن تكرارها واختبارها Replicable Procedures تضمن صحة التشخيص أو التأويل الفرويدي؛ إذ لا يستطيع باحث آخر إعادة نفس الحالة السريرية، أو الحصول على نفس استجابات المريض، أو الوصول إلى نفس التفسير.
وذلك بخلاف ما عليه المدارس السلوكية المعرفية (Cognitive Behavioral Therapy – CBT)، التي تُعرّف مفاهيمها بتعريفات إجرائية واضحة، وتقيس نتائجها بمخرجات قابلة للرصد والعدّ.
ونادرًا ما تُنشر في مدرسة التحليل النفسي تجارب مضبوطة عشوائيًا (Randomized Controlled Trials – RCTs)، وهي المعيار الأعلى في تقييم فعالية العلاج. كما يُلاحظ غياب شبه تام للدراسات التتبعية الطويلة Longitudinal Outcome Studies التي تُعد ضرورية للحكم على استمرارية الأثر العلاجي.
ولا يظهر فيها أيضًا اعتماد على أدوات تشخيصية مقننة سيكومتريًّا Psychometrically Validated Diagnostic Tools، وهي أساس مهم في الممارسات السريرية الحديثة في الطب النفسي.
وعوضًا عن ذلك، يغلب على منشوراتها الطابع النظري أو التأويلي أو الفلسفي، وتُستحضر نصوص فرويد باعتبارها مراجع أصيلة ذات سلطة تفسيرية، لا باعتبارها أطروحات قابلة للاختبار أو النقد. وهذا يعكس انفصالًا واضحًا بين الممارسة التحليلية وبين منهجية التقدم العلمي الحديث.
فمذهب التحليل النفسي لا يُبنى على الملاحظة المحايدة، بل على تأويل مُسبق يُوجّه النظر من أساسه، فلا تُدرك الوقائع كما هي، بل تُرى من خلال عدسة النظرية، فلا يبقى للواقع سلطانٌ على الفرض، ولا للحسّ قدرة على نقد التصور. وهذا ما يعبّر عنه فلاسفة العلم بما يُسمى بـ تشبع الملاحظة بالنظرية Theory-Ladenness of Observation، حيث تُفقد التجربة قدرتها على تقويم الفرضيات أو تعديلها.
ويزداد الأمر تعقيدًا بوقوع هذه النظرية فيما يُعرف بـ الشمول التأويلي Hermeneutic Totalization، إذ تزعم لنفسها القدرة على تفسير كل شيء في حياة الإنسان، من أحلامه وزلات لسانه، إلى عقيدته وفنه، من خلال منهج واحد ورؤية مؤولة واحدة، لا تعطي ظاهر القول قدرًا، بل تفترض دومًا باطنًا خفيًّا لا يدركه إلا من “أهل المهنة”.
وهذا ما سمّاه بول ريكور “تأويل الارتياب” Hermeneutics of Suspicion، أي ردّ كل عبارة إلى باطن مريب، وجعل كل ظاهر يخفي حقيقة دفينة، لا تُدرك بالعقل العام، بل تحتاج إلى “عارف” من أهل الاختصاص يرفع عنها الحجاب. وبذلك يُلغى دور الحس والمشاهدة، ويُحجب العقل المشترك، وتُصبح المعرفة حكرًا على نخبة لا تقبل الاختبار ولا تسمح بالنقد، فتُعزل عن ميزان العلم التجريبي.
الوجه الثالث: أنه قد بيّنت المراجعات الشاملة Meta-Analyses التي جمعت نتائج البحوث المتفرقة، أن أثر العلاج التحليلي ضعيف أو مضطرب، يفتقر إلى الثبات والتكرار. وإن وُجد في بعض الحالات تحسّنٌ على المدى البعيد، فغالبًا ما يشبه أثر التوهّم العلاجي Placebo Effect، أو يكون دون ما تحققه المعالجات القصيرة البنيوية، كالـCBT أو “علاج القبول والالتزام” (Acceptance and Commitment Therapy – ACT).
ومن جهة المعايير العلمية، فإن هذا النمط لا يشتمل على أدوات قياسٍ معيارية، ولا على بروتوكولات ملاحظةٍ محكمة، كما لا يتضمن ضبطًا للمتغيّرات أو شروط المقارنة. ولهذا، فإنّ ما يُسمى بالطريقة السريرية في التحليل النفسي تظلّ، بحسب المعايير المنهجية المعتمدة في العلوم التجريبية، فاقدةً للشروط العلمية الأساسية.
الوجه الرابع: أن غالب فرضيات النظرية الأساسية، كالمراحل النفسجنسية Psychosexual Stages، وعقدة الخصاء Penis Envy، والنزاع الأوديبي Oedipus Complex، فليست لها شاهدٌ في علم النفس التنموي الحديث Developmental Psychology، ولا دلّت عليها التجربة، ولا قبلها المنطق التربوي، بل تُعد اليوم من شوارد التصورات البائدة. ثم إن علوم الأعصاب الحديثة Neuroscience كشفت عن آلياتٍ دماغيةٍ دقيقة، تتعلّق بالحفظ، والانفعال، واتخاذ القرار، تخالف ما افترضه فرويد في نظريته، بل تنقض كثيرًا من أصولها.
- في الذاكرة: ثبت في علم الأعصاب أن الذاكرة ليست خزّانًا يُطوى فيه الماضي ثم يُستخرج كما هو عند الحاجة، بل هي عملية إنشائية Reconstructive، يعيد فيها العقل تركيب الخبرات الماضية كلّما استُحضرت، لا أنها تُدفن في أغوار النفس بالكبت ثم تُستخرج بكلمات المحلل.
- في بنية الدماغ: وقد بيّنت الأبحاث أن الدماغ مُقسّم إلى وحدات وظيفية مستقلة Modular Organization، لكلٍّ منها مهمة مخصوصة، مما ينقض تصور فرويد لوحدةٍ ثلاثية متصارعة: الهو، والأنا، والأنا الأعلى، إذ لا تدل الخريطة العصبية على مثل هذا التقسيم التخييلي.
- في أثر الصدمة: وأما ما يزعمه القوم من أن الذكريات المؤلمة تُدفن في اللاوعي وتُنسى، فقد خالفته بحوث الصدمة النفسية Trauma Research، التي أظهرت أن أكثر هذه الذكريات رسوخًا في النفس، وأشدّها حضورًا في الوعي، بل قد تبقى بحدة صورتها وكأنها لم تفارق اللحظة.
وقد ظهر في السنوات الأخيرة اتجاهٌ يُعرف بـالتحليل العصبي-النفسي Neuropsychoanalysis، يسعى إلى التوفيق بين معطيات علم الأعصاب الحديث، ومفاهيم التحليل النفسي التقليدية. ومن أبرز من مثّل هذا التوجّه: “مارك سولمز” Mark Solms، الذي يرى أن مفهوم اللاوعي ليس مجرد استنتاجٍ سريري، بل هو واقع عصبي-فسيولوجي Neurophysiological Reality يمكن رصده وتفسيره بيولوجيًّا.
غير أنّ النظام الذي وضعه فرويد قائمٌ على التأويل والمعنى، لا على الكمّ والملاحظة الصارمة؛ فهو يتناول الدلالة، والرمز، والدوافع الخفية، وهو منهج سرديّ، فرديّ، تفسيريّ Interpretive, Narrative-Based, Idiographic.
أما علم الأعصاب، فطابعه كميّ، عامّ، اختزاليّ Quantitative, Nomothetic, Reductionist، ويعتمد على قياس الإشارات الكهربائية، ودراسة الشبكات العصبية، وتحليل التفاعلات الكيميائية داخل الدماغ. فمحاولة الدمج بين المجالين غايته انتقاء التشابهات السطحية، دون أن تُنتِج كشفًا جديدًا أو فرضيات قابلة للاختبار.
خاتمة
ختاما: إنّ كلّ حقلٍ يُراد له أن يُحسب في جملة العلوم المعتبرة في علوم النفس، لا بُدّ أن يستوفي أصولًا منهجيةً لا يُستغنى عنها، منها:
1- التحديد الإجرائي Operationalization: ينبغي أن تُضبط المفاهيم الأساسية في أي نظرية بمقاييس قابلة للمعاينة والقياس. أما في التحليل النفسي، فإن مفاهيمًا جوهرية كـ”الكبت” Repression، و”الأنا” Ego، و”اللبيدو” Libido تبقى غامضةً من جهة التعريف، ولا تُعرّف تعريفًا يُمكّن من اختبارها أو قياسها.
2- القابلية للاختبار Testability: النظريات التحليلية تُصاغ غالبًا بعد وقوع الحدث، وتُؤوّل بما يتّفق مع كلّ سلوك، أيًّا كان نوعه، ما يجعلها غير قابلةٍ للتفنيد التجريبي Empirical Falsification. فإذا لم يكن من الممكن تصوّر ما ينقض النظرية، لم يعد للنظرية قوة تفسيرية علمية.
3- القابلية للمراجعة Revisability: من سمات العلم أن يُصحّح نفسه، ويُهذّب مفاهيمه مع توالي الدليل، إلا أنّ التحليل النفسي لم يُجرِ تلك المراجعات المنهجية، بل ظلّت مفاهيم مثل “عقدة أوديب” Oedipus Complex، و”غريزة الموت” Death Drive، و”قلق الخصاء” Castration Anxiety، قائمةً رغم ورود المعطيات المناقضة لها. فلم يخضع هذا المذهب لما تخضع له العلوم الحقيقية من التهذيب والتنقيح، بل بقيت مفاهيمه القديمة محفوظة، لا لقوة الدليل، بل لسلطان النص المؤسّس، وما يحمله من هيبة “فرويد” أكثر من اعتماده على البرهان التجريبي.
انظر:
Grünbaum, Adolf. The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique. University of California Press, 1984.
Is Psychoanalysis Still Relevant to Psychiatry?” by Joel Paris, MD, published in The Canadian Journal of Psychiatry
de Maat, Saskia, et al. “The current state of the empirical evidence for psychoanalysis: a meta-analytic approach.” Harvard review of psychiatry 21.3 (2013): 107-137.