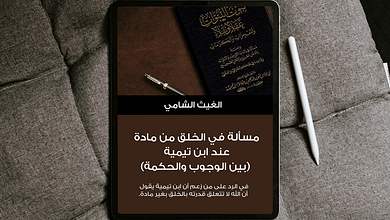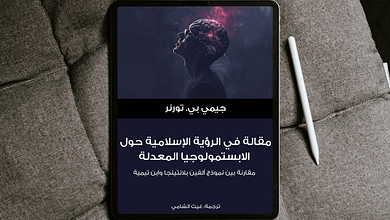قال الدكتور: “سوف نقول له إن الخالق واحد، لأن الكون كله مبني من خامة واحدة وبخطة واحدة ..”
قلت: هنا يظهر لك فساد ذلك المسلك الكلامي الحادث في الانتصار لوجود الباري سبحانه. فمع أنه صحيح أن وحدة الأسلوب في الخلق هي مما يصلح قرينة على وحدة الخالق، فالذي صنع القفل، هو نفسه الذي صنع المفتاح اللائق به ولابد، إلا أن الكلام هنا لا يراد منه استعمال الحدس والفطرة في تقرير التفسير الصحيح لما يدل عليه استقراء العادة من ذلك، أعني وحدة “الأسلوب” في الخلق، وسعة وتعدد وجوه التشابه بين المخلوقات، وإنما يراد منه استعماله في الانتصار لدعوى ميتافيزيقية مفادها أن “الكون كله مبني من خامة واحدة وبخطة واحدة” كما عبر! وهذه طريقة الفلاسفة الأقدمين في استعمال الاستقراء لبناء دعاوى وجودية عريضة تشمل كل موجود بإطلاق! أنت يكفيك أن ترى النظام نفسه يتكرر في خلق الله تعالى في أفراد النوع الواحد، بما يثبت به نوعيته نفسها، حتى تجعلها آية باهرة على وحدة الخالق سبحانه الذي هو مصدر ذلك الاستنواع وتلك الوحدة الصارمة في “الخطة الإجمالية” التي تخرج عليها أفراد كل نوع! لكن الفيلسوف لا يكتفي بذلك! هو وريث لطريقة قديمة لا يكفي فيها ذلك أبدا! لماذا؟ لأنه يتدرب في تلك الطريقة على بناء النظرية بحيث يكون موضوعها هو كل ما في الوجود، أو “الكون” كله، كما عبر الدكتور هنا، وليس فقط ما تطاله عادتنا التراكمية منه. فإن تأملنا في المواد المنتشرة من حولنا في هذا العالم، فوجدناها بحيث تنطبع بطبع معين تتأثر لأجله ببعض الؤثرات على نحو مخصوص بات ممكنا لنا أن نتنبأ به بدقة من استقراء العادة، أصبح لزاما أن يصبح هذا القانون بحيث لا تخرج عنه أي مادة من مواد الكون بإطلاق!! الجاذبية تؤثر على الأشياء القريبة من الأرض، إذن لابد أن تكون هي نفسه مؤثرة على جميع أجرام الكون! وإذن فلابد أن نجهد في تفسير حركات الأجرام السماوية في أفلاكها حول الشمس، على أنها راجعة إلى الجاذبية نفسها! لابد أن يكون قانونا واحدا وقوة واحدة وعاملا غيبيا واحدا، أيا ما كانت حقيقته، هو الذي ينشأ عنه جميع ذلك في الحقيقة! لماذا؟ لأن الفيلسوف لن يرضى ولن يهنأ حتى يوهم نفسه بأنه قد جاء بما فيه كشف لكل حقيقة، وبيان لماهية كل شيء! مع أنه لا يمتنع عقلا أن يكون السبب الغيبي الخفي لحركة الجرم في السماء في الفلك الذي هو مثبت فيه، مخالفا للسبب الغيبي الخفي في حركة المقذوفة القريبة من سطح الأرض وتعلقها في فلك حولها إذا تعلقت، وإن تشابهت الحركتان في مآل الأمر، واشتركا في كثير من النمطيات الظاهرية المطردة التي يمكن محاكاتها جميعا في معادلة رياضية واحدة كما سلكه نيوتن.
فعندما يقال إن دليل كون الخالق واحدا، هو كون الكون كله يعمل بطريقة واحدة، ويخضع لقوانين واحدة، من أوله إلى آخره، فهذا ليس فقط استدلالا فاسدا من جهة أننا لا نعلم ذلك، ولا يمكن لنا أن نعلم ذلك من طريقنا، بل لأننا نعلم أن الأمر ليس كذلك أصلا على الحقيقة! ولا يدل عليه ما يظهر لنا من اشتراك طبعي فيما تفيد به العادة كما مر، مهما اتسعت دائرة العادة والخبرة البشرية وانكشف لحواسنا ما لم يكن السابقون يقدرون على رؤيته ولا يمتد بهم إليه طريق! فالكون إذا كان يطلق ويراد به كل ما في الوجود مما سوى الله سبحانه، وهو ما يعبر عنه أيضا بالعالم World، فإن هذا يشمل العرش والكرسي والسماوات السبع جميعا، والعرش هذا وحده، أعظم في خلقه وسعته من السماوات السبع وما فيها والأرض وما عليها جميعا، قال تعالى: ((وسع كرسيه السماوات والأرض))، والعرش أكبر من الكرسي! والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة! والكرسي ما هو من العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض، كما ورد!! فلو كانت مادة العرش بحيث ركب فيها طبع الجذب بالكتلة Gravitation by mass كما هو مشاهد معتاد في مواد الأرض والسماء القريبة تحت السماء الدنيا، لما بقي من السماوات والأرض شيء إلا تحطم وساخ تحت تأثير جاذبيته! ولما انفصل عنه شيء أصلا!! بل إن العرش هو نفسه محمول على أكتاف ملائكة عظام، كما في قوله تعالى: ((وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ)) [الحاقة : 17]، أي ثمانية من الملائكة! وحملة العرش هؤلاء جاء في السنة من الخبر بعظم خلقتهم ما لا يتصوره العقل أصلا!! “فالكون” على هذا المعنى، إن كان هو حيز جريان هذه السنن والطبائع المعتادة لنا، فمحال أن يكون هو كل ما في الوجود مما سوى الله تعالى!! وأما ما فوق السماء الدنيا، بل السماء الدنيا نفسها، ذلك السقف العظيم المحفوظ، الذي لا يظهر لنا منه إلا ذاك السواد والعتمة التامة فيما وراء النجوم والأجرام السيارة، هذا لا يعلم حقيقته وطبيعة مادته إلا من خلقه سبحانه، ولا نملك الحكم بأنها هي نفس المواد التي نعرفها ونعتاد على طباعها في المحسوس والمشاهد من عالمنا، ولا يمكننا إثبات ذلك ولا نفيه بأيما طريق كان! وقضية تعريف الكون Universe هذه من الأمور المشكلة المبهمة، التي لا يقف فيها الطبائعيون الغربيون على أساس عقلي صحيح، على الرغم من كثرة كلامهم في نسبة الخصائص والصفات والطبائع وخطوات التطور والتغير المتتابعة لذلك الذي يسمونه بالكون إجمالا، حتى صار لديهم “علم” أكاديمي تخصصي يقال له “علم الكونيات” Cosmology كما هو معلوم! التعريف الأشهر لها عندهم هو “جميع المادة والفراغ القائمين في الأعيان” all existing matter and space considered as a whole; the cosmos. ، وهذا في غاية الفساد، إذ على ما في لفظة “المادة” من الإجمال، إذ كل ما له أبعاد وانتشار عندهم فهو “مادة” بالضرورة، فالفراغ كذلك قد يطلق ويراد منه الحيز المحصور بين موجودين، وقد يراد منه كل جهة يوجد فيها موجود ما بإطلاق، وهذا الأخير هو تصور الكافة من الفيزيائيين والأستروفيزيائيين والفلاسفة المعاصرين، بيد أن منهم من يقول إن هذا هو الكون، وهو نفسه العالم World عندهم (على اصطلاح الفلاسفة الأقدمين، أنه كل ما في الوجود)، ومنهم من يقول إن العالم يتركب من “أكوان” متعددة Multiverse، نحن إنما نعيش في واحد منها، ولكل واحد منها “فراغه” الخاص به Its own space وزمكانه الخاص به Its own spacetime، على أنطولوجيا النسبية العامة في حقيقة العلاقة بين الزمان والمكان. وعلى أي من التعريفين، فالكون عندهم بحر واحد من المادة المتصلة، الخاضعة كلها لنفس القوانين، التي كان قانون النسبية العامة سببا في كونها على هذه الهيئة التي نعرفها، من الأزل عند بعضهم، ومن نقطة “الفردية المزعومة” على مراحل من التغير الطويل الرتيب، عند بعضهم الآخر. فأيا ما كان ما يسمونه بالكون، فلا علاقة له على الحقيقة بما نعلم نحن من نصوص الوحيين أنه قائم في هذا العالم المخلوق فيما وراء القدر المحسوس منه، إلا أنه يشترك معه في ذلك القدر المحسوس ظاهريا لا غير! فالذي يستدل بما عليه الكون بكليته من الوحدة الطبعية والنمطية والاطراد القانوني التام، في الزمان والمكان، على وحدة من خلقه، فإنه يسلط أولئك الفلاسفة عليه أتم ما يكون التسليط، لأنهم إذن يعترضون ويقولون: لا نرى من الطريق التي انتهت بنا إلى هذه الأحكام بشأن الكون بكليته، إلا أن الجاذبية وأخواتها من القوى الأربعة الأساسية للمادة (الجاذبية، الكهرومغناطيسية، القوة النووية الشديدة، القوى النووية الهينة)، هي التي خلقت هذا العالم وجعلته على ما هو عليه، وما زلنا ماضين في استعمال نفس الطريقة التي أوصلتنا إلى المعرفة بكيفية خلق العالم، في استكشاف أسباب ذلك المتقدمة عليه وجوديا! فإن قلت ولكن يجب في العقل أن يكون وراء العالم قوة فائقة ليست من موجودات العالم، بحيث تكون هي التي ترجح وتعلل كل شيء فيه، تختار له أن يكون على ما هو عليه، لا على خلافه، قابلوك بأنه بالنظر إلى كون تلك القوانين التي سلمت أنت لهم باطرادها في جميع جهات المكان والزمان مطلقا، على ما كانت عليه، ما كان من الممكن أن ينشأ العالم إلا ليكون على هذا الذي نراه دون غيره! وإذن فمحال أن يكون وراءه إرادة قد رجحت حالا على حال، أو هيئة على هيئة، أو طبعا على طبع، أو حركة على حركة، أو وجودا على وجود! إلى حد أن قال الهالك ستيفن هوكينغ: “الإله ما كان يملك خيارا أصلا في جعل الكون على ما هو عليه”!! بل سبقه إليها أينشتاين نفسه، بقوله متسائلا: “هل كان الإله يملك خيارا في جعل الكون على ما هو عليه؟”؟؟ وكأن الإله هذا رجل مثله، ولد فوجد نفسه خاضعا لقانون أزلي صارم، فلم يملك إلا أن يصنع صنعته تحت ذلك القانون!! سبحان الله وتعالى علوا كبيرا!! فالكون كله على هذه الطريقة، متولد بالضرورة من جريان القوانين على نحو ما ندعي أنها قد جرت عليه، من الأزل بلا بداية ولا تغير (إلا ما يمكن مبدئيا التنبؤ به من معادلات القوم)! وأنت يا دكتور مصطفى، توافقهم على تلك المسلمة الميتافيزيقية الأولى! فيلزمك منها ما التزموه هم، شعرت أم لم تشعر! إذ على تصور الماكينة المغلقة عند نيوتن، التي لا يعمل فيها شيء إلا بالخضوع التام لتلك الثلة من القوانين بالضرورة، وإلا انهارت كلها، وتعطلت كلها، كما تتعطل الماكينة لتعطل ترس فيها، فإنه يصبح، كما قال لابلاس، من الممكن لمن يحيط بجميع المعادلات الواصفة لحركات المادة في الكون أن يتنبأ بمستقبله إذا علم حاضره، تنبؤا كاشفا لا يتخلف عنه شيء! وهذا هو نفس كبر فرعون حين قال لهامان: ((فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ)) الآية [القصص : 38]! يضع الفيلسوف نظريته بشأن الوجود والموجود، ليصبح حكمهم فيها على نظام العالم وحقيقة مادته، طريقا للحكم على صانعه، إن أثبتوه أصلا، بما يجوز له وما يمتنع في حقه!! ومن ثم لم يجد أينشتاين إلا أن يقول إن الإله ليس إلا القانون الطبيعي نفسه، لأنه هو خالق العالم عنده، والله المستعان. والمقصود هنا أن الطريق الذي يسلكه الفلاسفة للتوصل إلى إثبات الدعاوى العريضة الفاحشة بشأن “الكون” بكليته، والمادة بإطلاق، والفراغ بإطلاق، والزمان بإطلاق، ونحو ذلك، إنما هو ثمرة إلحادهم واستكبارهم على خالقهم، فكيف وبأي عقل يجعل ذلك الطريق نفسه مقدمة في برهان لإثبات وجوده سبحانه؟؟ الكون عندهم هو كل ما في الوجود، وهو منبع كل سبب وكل علة، فلا يمكن أن يكون فيه عندهم، من طريقهم، ما يدل على صانع له من ورائه!
ويقال هنا: إذا كان يلزم من الاشتراك في الصفات بين المخلوقات المتعددة وحدة صانعها، فلا يلزم من التفاوت والافتراق والاختلاف بينها فيما تختلف فيه، تعدد الصانعين! وإنما يدل على تعدد الحكم والمقاصد الإلهية عند ذلك الصانع الواحد سبحانه. وسبب هذه الدلالة (دلالة التنوع) هو نفس سبب الدلالة الأولى (دلالة الاشتراك)، وهو الفطرة! فلأننا نعلم في فطرتنا، أن وراء هذا العالم وجميع ما فيه نظام صارم مطرد، خاضع لمشيئة وحكمة من خلقه بالضرورة، كان لتعدد وقائع التكرار في العلاقات الظرفية Repeated Correlations دلالة على النظامية المطردة Regulairty، التي يتوقع لها أن تمضي مستقبلا كما عهدناها سلفا! وكان لتشابه الكائنات دلالة على تشابه الغاية والغرض من خلقها جميعا ومن تركيبها حيث ركبت في بيئاتها التي تناسبها، فجميع الأنواع الحية خلقت بحيث تأكل وتشرب وتتناسل وتنتشر في الأرض، فتكون آيات للناس على سعة قدرة الله وتعدد حكمه الفرعية الكثيرة التي تخص كل نوع بخصوصه، تحت حكمته الكلية من خلق العالم بكليته. فبدون قاعدة الفطرة ودلالتها، يصبح التشابه هذا دليلا على وحدة الأصل الطبيعي الصرف، ويصبح التنوع دليلا على عمل القانون الطبيعي في التطوير والتعديل الطفيف، كما زعمه داروين، فتأمل!!
ثم قال الدكتور: “فمن الأيدروجين تألفت العناصر الاثنان والتسعون التي في جدول “مندليف” بنفس الطريقة .. “بالادماج” وإطلاق الطاقة الذرية التي تتأجج بها النجوم وتشتعل الشموس في فضاء الكون”. قلت: هذا كيف عرفته أنت يا دكتور؟ كيف حكمت بأنه قد حصل فعلا؟؟ بناء على نظرية وضعها صاحبها على أساس من التسليم المبدئي المنهجي بأنه ليس لشيء في الوجود أن يحدث بعد عدمه إلا عن طبيعة ما في مادة ما، تكون هي علته وسببه وتفسير كونه على ما هو عليه، لا تفسير غيرها! فمهما زعم أهل الكتب السماوية أن ربهم قد خلق العالم في ستة أيام، وأجرى حوادث الخلق في كل يوم منها على ما شاء واختار، فهذه المسلمة تنافي ذلك، وتوجب على الجميع أن يعتقدوا أن حوادث خلق العالم وما فيه إنما حصلت كلها على سلسلة من الآثار الفيزيائية لطبائع المواد التي اتفق لها أن كانت تملأ فراغ الكون أولا! هم إنما زعموا أن جميع أنواع المواد في الجدول الدوري نشأت من الهيدروجين بنفس الطريقة، لأن كبرهم الدهري سوغ لهم اعتقاد أنه ليس في الغيب خالق ينوع الأنواع ويفاوت بينها بإرادة وحكمة وعلم!! فلماذا تنوعت إذن وحيف حصل ذلك؟ قالوا لأن حوادث نووية معينة حصلت اتفاقا على مادة أولى، أدت إلى تولد أنواع المواد كلها من تلك المادة الأولى! فهل يجوز أن نفترض ولو مجرد فرض، أن الأمر لم يكن كذلك ولم يكن أثرا لتفاعل نووي كتلك التفاعلات الهزلية (مهما عظمت) التي يحدثونها في مفاعلاتهم وتجاربهم النووية؟؟ أبدا! لا يجوز عندهم ذلك، لأنه لا تفسير للتفاوت الذري والنووي عندهم إلا النشأة النووية على الطريقة التي يعرفونها! الذرات والجسيمات تحت الذرية تتغير أحوالها بتلك التأثيرات التي تعلموا كيف يحدثونها عليها، فلابد إذن أن يكون تفسير نشأة المواد كلها وتنوعها، شيء من هذا النوع!! لا يمكن تفسير ذلك كله “طبيعيا” إلا هكذا! والتفسير إن لم يكن “طبيعيا” عندهم فليس بتفسير!! تماما كما اتخذ داروين من بعض الطبائع الوراثية المشاهدة والمصطنعة بشريا في أفراد الأنواع الحية، دليلا بالقياس الميتافيزيقي المطلق، على أن جميع الأنواع الحية إنما نشأت من مثل ذلك!! هذا هو التحكم الاعتقادي الديني الدهري الصرف الذي صار به هذا الزعم الذي قرره الدكتور هنا بكل أريحية، زعما علميا، وجعله هو دليلا، فيما يدعي، على “وحدة الصانع”!!
قال الدكتور: “كما أن الحياة كلها بنيت من مركبات الكربون “جميع صنوف الحياة تتفحم بالاحتراق” وعلى مقتضى خطة تشريحية واحدة .. تشريح الضفدعة، والأرنب، والحمامة، والتمساح، والزرافة، والحوت، يكشف عن خطة تشريحية واحدة، نفس الشرايين والأوردة وغرفات القلب، ونفس العظام، كل عظمة لها نظيرتها .. الجناح في الحمامة هو الذراع في الضفدعة .. نفس العظام مع تحور طفيف .. والعنق في الزرافة على طوله نجد فيه نفس الفقرات السبع التي تجدها في عنق القنفذ .. والجهاز العصبي هو هو في الجميع ، يتألف من مخ وحبل شوكي وأعصاب حس وأعصاب حركة .. والجهاز الهضمي من معدة واثني عشر، وأمعاء دقيقة وأمعاء غليظة والجهاز التناسلي نفس المبيض والرحم والخصية وقنواتها.. والجهاز البولي الكلية والحالب ، وحويصلة البول .. ثم الوحدة التشريحية في الجميع هي الخلية .. وهي في النبات كما في الحيوان كما في الإنسان، بنفس المواصفات، تتنفس وتتكاثر وتموت وتولد بنفس الطريقة.. فأية غرابة بعد هذا أن نقول إن الخالق واحد؟ .. ألا تدل على ذلك وحدة الأساليب؟”
قلت: هذا الكلام جيد إجمالا، لا بأس به، لولا أنه قدم له بما قبله! مخلوقات العالم تتشابه لكونها جميعا قد خلقت لغايات وحكم متشابهة، متفرعة عن أصل واحد وغاية واحدة من خلق العالم بكليته عند باريه سبحانه. فهي آية عند كل عاقل سوي النفس على الغائية الإلهية السابغة، التي ترجع لحكمة رب واحد وإرادته سبحانه. ولكن جميع الفلاسفة أسقطوا الفطرة ودلالتها في هذا الباب بالكلية! فماذا بقي إذن؟ بقي أن يكون هذا الذي قررته أنا الآن، مجرد نظرية تفسيرية تلائم تصوري الاعتقادي بشأن العالم My Worldview، وتستمد منه، في مقابل نظرية أخرى عند الطبيعيين الدهرية Naturalistic Worldview تفسر ذلك كله بتفسيرات أخرى مخالفة تماما! فإذا أزيلت الفطرة، صور الأمر على أنه نظريتان تتنافسان، ولم يبق إلا أن يلتزم الجميع بمنهج الترجيح بين النظريات عند الطبيعيين! ذلك المنهج الذي ارتضاه الدكتور عندما أقر القوم على نظرية داروين إجمالا (وإن خالفهم في مسألة أصل الإنسان)، وعلى نظرياتهم في نشأة الكون، ولا يملك أكثر الفلاسفة في هذا العصر إلا أن يخضعوا له رقابهم، كما خضع هو وغيره! فالآن يصبح طريق الترجيح أن يقال: ننظر في كل نظرية من هاتين النظريتين، لنرى أيهما هو أكثر ملاءمة لجملة الفروض والنظريات ذات الصلة المقبولة والمعتمدة أكاديميا، وتناسقا معها، وأليق بطريقة العلم التجريبي العصري Modern Scientific Method في الخوض في تلك الأبواب بعموم! فإذا فعلنا ذلك، وجدنا جميع النظريات الطبيعية العصرية Scientific Theories المقتحمة للغيوب المطلقة الزمانية والمكانية، تجري على الطبيعية المنهجية الصرفة، جريانا لا خروج منه، ولا زوال عنه! والطبيعية المنهجية Methodological Naturalism لمن لا يعرف، هي التزام المنظر الطبيعي باعتقاد مفاده أنه لا تفسير يفيد العلم ويضيف إلى المعرفة على الحقيقة، إلا التفسير الطبيعي Scientific Explanation! كل ما يجري وما جرى وما سيجري في أي مكان أو زمان، لا تفسير له إلا أن يكون أثرا ناشئا عن جريان السنن والنواميس الطبيعية في مواد العالم بوجه ما. وعلى هذا، فكل ادعاء لأن أمرا ما، أو ملاحظة ما أو مشاهدة ما، يمكن تفسيرها بشيء متجاوز للطبيعة Super-natural، خرقا للطريقة العلمية نفسها، التي تولدت عنها جميع نظريات القوم في غيوب الزمان المحضة، التي يستشهد الدكتور ببعضها في كلامه هذا وغيره! ويصبح إقحاما لما يسمونه بإله الفجوات God of the Gaps في بنائهم النظري! ويصبح مثل الدكتور مصطفى مطالبا ومضطرا، دون أن يشعر، على المنهج الذي أقر لهم به إجمالا، لأن يرفض التفسير الديني بأمور متجاوزة للطبيعة، لشيء مما يجري في الطبيعة، أو حتى لنشأة الطبيعة نفسها، ولكونها على ما هي عليه. التفسير الأليق والأوفق والأنسب، إذن، هو بالضرورة التفسير الطبيعاني الصرف Naturalistic Explanation!! والتصور الطبيعاني الدهري للعالم Naturalistic Worldview هو، إذن، التصور “العلمي” الذي يتعين علينا أن نقبل كل ما يوافقه ويلائمه، ونرد كل ما لا يلائمه، من أنواع التفسيرات! هذا هو المنطق الذي صرنا لأجله نسمع كثيرا من يقولون، كما يكثر على لسان محمد باسل الطائي وأمثاله، “فرضية الإله” The God Hypothesis! الإله فرضية تفسيرية، كما أن عند من لا يقولون به فرضيات أخرى مخالفة، وعلى الجميع أن يلتزموا “الطريقة العلمية” (زعموا) في الترجيح فيما بينها! وهنا يصبح غاية ومنتهى سعي المتكلم المعاصر أن يثبت أن “فرضية الإله” (كما سلم لهم بتسميتها مضطرا)، هي الأكثر “ملاءمة” للتصور “العلمي” للعالم! ومن ثم ترى التاريخ يتكرر من جديد، والقرمطة والتعطيل الجهمي المحض يطل برأسه من جديد، ولكن في لباس عصري جديد، لباس الفيزياء الرياضية المعاصرة، بعد أن كان قديما في لباس ميتافيزيقا أرسطو! وصرنا نسمع عن الخلق بالتطوير من أصول منحطة، كما أصَّل له هذا الرجل، ومن بعده الدكتور عمرو شريف، وكيف أن نظرية داروين مقبولة كلها إلا ما فيها من ادعاء عشوائية الطفرة! وكذلك نظرية الانفجار الخلاق! وإذن يصبح الرب الذي نؤمن نحن المسلمين بأنه هو الخلاق العليم القدير ذو الحكم العليا والإرادة السابغة، يصبح مجرد مولد عشوائي صرف Random Generator للمحاولات العمياء في الخلق، على طريقة التجربة والخطأ، التي تعاني من الإهدار المبين عبر بلايين السنين، طلبا في التوصل إلى مفتاح يناسب القفل الذي وضعته الطبيعة، ولتحقيق الشرط الذي تشترطه في انتخاب البنية الذرية التي تصلح لأن تكون نوعا جديدا من المادة فيبقى، ثم البنية الحيوية التي تصلح لأن تكون نوعا حيا فيبقى! ويصبح القانون الطبيعي الذي تفسر به جميع مراحل الخلق والتكوين للكون وما فيه عند القوم، بلا صانع ولا صنع ولا إرادة ولا حكمة ولا علم ولا شيء، هو الآلة الخلاقة التي لم يزد الخالق الذي يؤمنون هم به وينتصرون له، على أن يكون قد أحدثها وبناها في لحظة أولى في غاية الضآلة في زمان بلانك في الفردية المزعومة، ثم تركها لتمضي في الخلق والتكوين من تلقاء نفسها، تخلق بالتطوير الطبيعي عبر بلايين السنين، كما تجده في كلام نضال قسوم وغيره! فهو، في نهاية الأمر، إله داروين الربوبي عديم الفعل، عديم الإرادة والحكمة، الذي لا يزيد على أن يكون تعليلهم العدمي الذهني الصرف لجريان الأمر على ما زعموه في نظرياتهم، أو “فرضية الإله” كما باتوا يسمونها، ولا شيء فوق ذلك! سبحان الله وتعالى عما يصفون علوا كبيرا.
وإذن فحقيقة ما ينتهي إليه المتفلسف الإسلامي المعاصر، والمتكلم المعاصر، هو أن ينفي الصانع بدعوى أنه يثبته، كما هي حقيقة إثبات الجهمية الغلاة الأولين سواء بسواء، ولنفس السبب المنهجي الموروث! هو الصانع الذي تجيزه النظرية الميتافيزيقية المعتمدة عند أكابر الأكاديمية في العصر، كيفما اتفق لها أن تكون!! لا يمكن ولا “يعقل” إلا أن يكون كذلك أصلا! لماذا؟ لأن النظرية هي قطع العقل وهي ضرورته التي تقدم وجوبا على كل ما يخالفها! كانوا يقولون “قطع العقل” بلغة أرسطو وأفلاطون، واليوم يقولون: هي “العلم الحديث” بلغة أينشتاين وهايزنبرغ، والمقصود في هذا المقام واحد! فأي صانع هذا الذي تتسع له ميتافيزيقا الفلاسفة اليوم؟
الصانع العدمي بل الممتنع، الذي يوصف بأنه خارج الزمان والمكان مطلقا، الذي لا يفعل، ولا يريد، ولا يجوز له ذلك! أو إن وصف بالفعل، فلا يفعل إلا ما تمليه الطبيعة، وإن وصف بالإرادة فلا يريد إلا ما يقتضيه القانون الطبيعي كما يعرفونه، ولا يجوز له أن يريد خلافه، لأنه لو أحدث فعلا أو قضى أمرا في العالم بإرادة تخالف مقتضى “الطبيعة”، لخرم الآلة الطبيعية الصارمة التي هي الرب ذو السلطان عند الفلاسفة، وهي علة كل معلول في الوجود! ولو جاز ذلك لسقطت مسلمة الطبيعية المنهجية الأولى، وإذن لسقط العلم كله عندهم! ولو وُصف ذلك الصانع بأي صفة ذاتية أو فعلية، وصفا حقيقيا مطابقا للواقع، لتسلط القانون الطبيعي عليه، بأن يصبح هو نفسه مادة matter من جنس المواد المخلوقة، تجري عليه معاني الزمان والمكان والحركة، على تعريف الفيزيائيين لها ولأسباب تحقق الشيء الوجودي بها! كانوا قديما يقولون هو خالق الأعراض في الأجسام، ثم إذا تتبعت أصول النظرية، نظرية الجوهر والعرض أو الجسم والعرض هذه، لم تجد فيها أساسا لوصفه بفعل اسمه فعل الخلق أصلا!! إذ العرض هذا هو كل ما يتسع العقل لجعله “مقولا” على موجود في الأعيان، فيما يمتاز به موجود عن موجود، أيا ما كان! وإذن فمعنى “فعل الخلق” نفسه عرض، لا يتم تنزيه الفلاسفة على الحقيقة إلا بنفيه عن الصانع المزعوم!! وكذلك اليوم يقولون هو خالق الزمكان، ثم إذا تتبعت ميتافيزيقا الزمكان هذا، لم تجد فيها أساسا عقليا صحيحا لوصفه بفعل اسمه فعل الخلق كذلك! ثم ترى التأويلات العصرية لنصوص الوحيين، التي تصيره خارج “الزمكان” هذا، بحيث يرى جميع الحوادث في نفس “اللحظة”، وهي كلها حاضرة أبدا وأزلا بالنسبة إليه، لأنه لا ماضي ولا مستقبل في حقه أصلا، ولا زمان “خارج” ذلك القالب، كما أنه لا مكان!! الكون القالب المزعوم Block Universe هذا موجود أزلي أبدي، لا حقيقة لمر الزمان وجوديا إلا أن تكون هي الانتقال في داخله ما بين “حادث” و”حادث”، فيما لا يترتب وجوديا في ماض وحاضر ومستقبل، إلا ترتبا نسبيا ناشئا عن سرعة الانتقال والحركة عبر أنحاء ذلك القالب المزعوم!
فما أشبه الليلة بالبارحة!
والمقصود أنك إذا أسقطت السبب الفطري البدهي في المعرفة بوجود الباري سبحانه ووحدانيته، لم يبق لك إلا أن يكون كلامك مجرد نظرية، تساويها في المنزلة المعرفية نظريات أخرى! واليوم هي نظرية “تفسيرية”، كما أن نظرية داروين (مثلا) نظرية تفسيرية! وإذن فأنت مطالب، بمقتضى المنهج الذي سلمت بصحته للقوم، أن توافقهم في تركها وترجيح ما رجحوا!! فرضية “الإله” هذه تصبح على موازين القوم وطريقتهم في اقتحام هذه الأبواب: فرضية زائدة، لا تفيد العلم بشيء، لأنها لا يمكن التحقق من صحتها، من مبدأ الطرح! مع أنه ليس من الممكن كذلك التحقق من صحة أي فرضية في تفاسير القوم لوجود الكون ولنشأة الحياة على الأرض، كما بسط الكلام عليه في مواضعه، ولكن لا يريدون هم بالتحقق في هذا المقام أن يتمكن صاحب الفرضية أو غيره من الناس من أن يشهدوها بأعينهم صراحة يوما ما، فيثبت لديهم وجود ما زعموا وجوده بالغيب أو فرضوه سلفا، لا! وإنما يريدون أن يصبح الفرض بحيث يمكن تأويل المشاهدات على نحو يوافقه، ويتناسق، في نفس الوقت، مع البناء الفلسفي الكلي لميتافيزيقا الطبيعيين على ما هو عليه! والصانع ذو الإرادة والفعل، أو “المتشخص” Personal الذي يؤمن به المسلمون وأهل الكتاب، لا يتحقق فيه هذا الشرط من مبدأ الطرح!
ونظير ذلك الخلل والانقلاب المنهجي والتسلط الفلسفي للخصم الدهري، يعانيه المتكلمون المعاصرون في جميع ما يقال له براهين اللاهوت الطبيعي، أو براهين التصميم Argument from Design، وكذلك فيما يقال له البراهين الأخلاقية Arguments from Morality! فالمصمم الذي يثبتونه هذا، لابد أن يكون بحيث يمكن إثبات وجوده من طريق آلة التفسير العلمي scientific explanation، على ما عليه تطبيق الأكاديميين المعاصرين لها في باب النشأة وأصل الأنواع. هذا هو الشرط المنهجي! فهل تلك الآلة تثبت شيئا أو تنفيه أصلا، على الحقيقة، في تلك الغيبيات المطلقة؟؟ أبدا! وإنما يبقى الفرض مقبولا مستساغا ما دام لائقا ومناسبا وملائما للبناء الفلسفي المعتمد أكاديميا في الباب، وإلا رفض! وقد بلغ الرفض عند القوم غايته، حتى توصلوا لجعل تدريس تلك “النظريات التفسيرية” في التصميم في المدارس، ممنوعا بالقانون في بعض ولايات أمريكا كما هو معروف!! وفي فلسفة الأخلاق، مسألة منشأ الأخلاق “الموضوعية” وحقيقتها، تصبح، إذا أسقطت دلالة الفطرة، نظرية تفسيرية كذلك! فمن اعتنق التصور الطبيعي، فسيكون لديه نظرية توافق ذلك التصور، وتقدم “تفسيرا” علميا مقبولا لها، وأما من اعتنق أي تصور مخالف، فلن تتمتع “نظريته التفسيرية” بما يتمتع به التفسير الطبيعي من التناسق والتلاؤم التام مع أصول البناء الأكاديمي المعاصر في تلك الأبواب!! أنت تعتقد أن جميع الأنواع الحية إنما نشأت بالفطرات والانتخاب، فلماذا لا تكون الأخلاق “الموضوعية” قد نشأت عندك بنفس النشأة؟؟ اطرد المنهج كما طردوا، جريا على أصلهم في نفي المرجح الغيبي لخلاف ما قاسوا وما طردوا، أو اترك جميع ما ترتب لديهم على ذلك التسليم الفاسد في مسألة النشأة الأولى! فإن طردت ووافقت، فلن يروا لك خيرا من نظريتهم!
ثم يقول الدكتور: “ولماذا يتعدد الكامل ..؟ وهل به نقص ليحتاج إلى من يكمله ؟ ..إنما يتعدد الناقصون. ولو تعدد الآلهة لاختلفوا، ولذهب كل إله بما خلق ، ولفسدت السماوات والأرض، والله له الكبرياء والجبروت وهذه صفات لا تحتمل الشركة..”
قلت: وهذا الذي ثنى به، هو جواب العقلاء الأسوياء في التشنيع على مقالة من يجيزون تعدد الصانعين! وإن كنا لا نقول إن الكامل لا يتعدد، لأنه لو تعدد لزم نقصه، وإنما نقول إن مصدر كل موجود ممكن، لا يجوز عقلا أن يتعدد. والفارق بين العبارتين دقيق. فإنك إن قلت: الكامل لا يتعدد، بهذا الإطلاق، فصفات الله الذاتية كل واحدة منها بالغة الغاية في الكمال قطعا، وهي مع هذا متعددة. فعينه ليست هي ذات يده، ويده ليست هي وجهه، ووجهه ليس هو ساقه سبحانه، بل كل ذلك من جملة الصفات القائمة بذاته سبحانه. فكل واحد منها هو أكمل ما يكون مما يحصل به معناه للذات الموصوفة به. والتعدد في ذلك ليس ممنوعا عقلا. وإنما الممنوع أن تتعدد تلك الذات الواجبة نفسها. هذه الطريقة في الإجمال الفلسفي، هي التي أوقعت ابن سينا في تعطيل رب العالمين عن جميع صفاته، واضطرته للقول بقدم العالم. فقد جعل برهانه سبيلا لإثبات “الوجود الواجب” بهذا الإطلاق، فوضع تعريفا “للوجود الممكن” اشتمل على جميع ما يوصف به رب العالمين من الأفعال والصفات الذاتية، ومن ثم نفى عنه جميع الصفات!
وقد يظن بعضهم، وانتبه، أن الصواب هنا أن يقال: “ولماذا يتعدد الخالق واجب الوجود؟ وهل هو ممكن حتى يتعدد، فيكون من نوعه ثلاثة أفراد أو أربعة أو أكثر؟” ولكن هذه العبارة أيضا فيها خلل. لماذا؟ لأن لفظة “ممكن” هنا باقية على إجمالها. فالممكن قد يكون بمعنى أنه الموجود المستقل الذي يمكن وجوده كما يمكن عدمه بلا تناقض، وقد يكون بمعنى أنه الصفة القائمة بالموجود المستقل. فمن الصفات القائمة بالموجود الواجب ما يمكن ألا يقوم به بلا تناقض، كالفعل الاختياري المعين. ومنها ما لا يلزم التناقض الظاهر من نفيه عنه، كتعدد بعض آحاد الصفات الذاتية فيما جاء به الخبر، كالعين والأصبع واليد، هذه ليس في عقولنا ما يمنع من تعددها في ذات القديم الواجب، أو يوجب فيه وجها دون وجه! فعلى هذه العبارة، يجب نفي التعدد عن كل ما يمكن أن يدخل تحت معنى الإمكان، وهذا منشأ الغلط عند ابن سينا كما مر.
فالصواب أن يقول: “وكيف يتعدد الموجود الواجب، إذا كانت ذاته هي التي يترجح بها وبإرادتها وجود كل موجود ممكن (مستقل بنفسه في الأعيان)، ويترجح بها كونه على ما هو عليه من الصفات القائمة به، على خلافه مما كان ممكنا له؟؟” ثم يقرر شناعة ما يترتب على تعدده من لوازم جاء بها القرآن كما فعل. وقد كان يكفيه هذا الجواب أصلا، ويكفي كل عاقل، ولكنه ليس جاريا “على لغة العصر”! أنا أريد أن أكتب جوابا أتعلق فيه بأهداب الجيولوجيا والبيولوجيا والفيسيولوجيا وكل “لوجيا” تأتي على الهوى! أريد جوابا مفعما بالذرات والخلايا الحية وصور التلسكوب الإلكتروني، لأن هذا هو ما لا يرى “الخصم” علما ولا معرفة ولا عقلا إلا فيه!! وهذه الطريقة الكلامية في تقديم “ما يطلبه المستمعون” من أنواع الأدلة، بداية من منطق الاستدلال نفسه والمقدمة المعرفية الأولى التي بها يكون الدليل دليلا، وبها يعرف ما يحصل به الإثبات والنفي في هذا الباب أو ذاك، هذه هي منبت الزيغ والضلال في علم الكلام منذ أن بلينا به في أهل القبلة وعند أهل الكتاب من قبلنا! نعم يجوز مبدئيا، ولا شك، أن نستعمل بعض الحقائق التجريبية التي عرفت في عصرنا ولم يعرفها السابقون، في بيان طلاقة القدرة الإلهية في الخلق، وبيان بديع الصنع الرباني في أنواع المخلوقات، وبيان آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق، حتى في الخلية الحية الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة. كل هذا مطلوب قطعا، ولكن كيف يقدمه الداعي إلى الله لمن يدعوه، وفي أي سياق ولخدمة أي صنف من صنوف الاستدلال، وتحت أي شرط من شروط الإثبات المعرفي تقدم تلك الحقائق والبيانات؟؟ هذا هو الفارق بين طريقة أهل السنة وطريقة أهل الكلام في نفس الأمر! فعندما تستعرض حقيقة من المكتشفات العصرية فيما يتعلق بعمل الخلية الحية، في إطار علم الكيمياء الحيوية، تريد أن تحتج بها على وجود الباري سبحانه وعلى كمال علمه وحكمته وقدرته، تسوقها في سياق برهان تأسيسي فلسفي، على طريقة اللاهوت الطبيعي في إثبات “التصميم”، كما سلكه دمبسكي وبيهي وأصحابهما، فهذه طريقة لا توصل المخاطبين بها إلى إثبات الرب الذي نؤمن به أصلا، وإنما يثبت بها “مصمم” ناقص بالضرورة، يخلق عامة خلقه بالعشواء واللاغائية واللاوظيفة واللاحكمة، وإنما يخلق أحيانا بالحكمة والعلم والقصد والإرادة، فيما يمتاز بعضه من بعض عندنا بقياس التمثيل! إذا ظهرت “علامات التصميم” على شيء من المخلوقات، بما نصل إليه من قياس الصنع الإلهي على مصنوعات البشر، فإننا “نفرض تفسيرا علميا” لكونه على ما هو عليه، مفاده أن له “مصمما” ذا إرادة وعلم وحكمة! هذه الطريقة النصرانية المحدثة في الاستدلال على الصنع الإلهي، إنما جرى فيها ويليام بيلي على طريقة معاصريه من الجيولوجيين النصارى في تطبيق المنطق التفسيري Abductive Reasoning طلبا في معرفة الحوادث التي خلقت بها جميع معالم سطح الأرض في الماضي السحيق، وفي معرفة الآثار التي ترتبت على الطوفان العظيم الذي جاء ذكره في الكتاب المقدس! وهذه الطريقة من الأصل في غاية الفساد، كما بسط الكلام عليه في كتاب المعيار وفي سلسلة “بيان منهج أهل السنة والجماعة في التجريبيات” على قناة إقناع. فهي تبدأ بافتراض أن جميع ما وقع على مادة الأرض من الحوادث، لابد أن يكون من صنف واحد، وهو ما يخضع اليوم للمشاهدة والحس في عادتنا البشرية التراكمية من أنواع الطبائع وتأثيراتها! وهذا الفرض في غاية الفساد، لأن حوادث خلق الأرض وتركيب الطبائع في مادتها، هي بالضرورة على خلاف المعتاد مما ينشأ عن طبائع المواد الأرضية في عادتنا اليوم من أنواع الحوادث! وجميع ما على الأرض، سواء عرفنا له وظيفة معينة من أنواع الوظائف المتصورة لنا، أم لم نعرف (كالصخرة الصماء التي مثل بها بيلي في برهانه)، هو مخلوق، بالضرورة، لحكم وغايات إلهية لا يحصيها إلا باريها!! حتى تل الرمال الذي تجده في أي لحظة تنظر فيها في موضع من مواضع الصحراء الفسيحة على هيئة معينة، هو على تلك الهيئة التي تجده عليها لا على خلافها، في تلك اللحظة التي نظرت فيها، لحكم بالغة، لا يصحيها إلا باريه سبحانه!! هذا هو الأصل الذي يثبت عندنا بالضرورة والفطرة كما نعرف أن الواحد نصف الاثنين! فإذا جُعل ذلك الأصل نفسه، دعوى نظرية تحتاج إلى برهان بقياس التمثيل حتى تثبت، فلن يوصل لإثباتها أصلا، وإنما يوصل إلى تغليب التفسير الدهري الدارويني عليها، كما سلكه داروين وأتباعه، وإلى أن يصبح النزاع عليها نزاعا فلسفيا بعيد الحسم، كل فريق منه له عذره في التمسك بمذهبه، على ما يزعمه أدلة تدعمه! وقد بينا أن جميع ما ضربه بيهي في كتبه من أمثلة على ما سماه بالتعقد غير القابل للاختزال Irreducible Complexity قد جاء الدراونة لها بتفسيرات داروينية محضة ولم يعجزوا عن ذلك، لأن أصل النظرية مبني على جعل مجرد التشابه البيولوجي (سواء كان تشريحيا مورفولوجيا أو جينيا أو جزيئيا أو غير ذلك) دليلا على وحدة الأصل التطوري!! فإذا سلمت لهم بذلك المنطق العقلي الفاسد في الاستدلال، كما سلكه بيهي ودمبسكي وغيرهما، لم يعجزهم شيء عن أن يردوا عليك زعمك بأن هذا الجهاز الحيوي لا يمكن أن يوجد إلا كاملا غير ناقص، بمزيد من صور التطبيق لنفس المنطق الذي أقررتهم عليه! بأن يأتوا بصور في بعض الأنواع الحية القائمة حاليا لخلايا تحصل فيها نفس تلك الوظائف التي تعرفونها حاليا لتلك الماكينة البيولوجية الجزيئية التي تضربون بها المثل، أو قريب منها، دون أن تكون على نفس تلك الهيئة بالضرورة! فلعبة التخمين والافتراض التفسيري على هذه الوتيرة، كل أحد يحسنها، ولا انتصار بها لمذهب على مذهب أصلا! نحن نأتي بأمثال تلك الحقائق المشاهدة لنتحدى بها كل سفيه من هؤلاء أن يخلق كخلق الله أو أن يأتي برب يصنع مثل صنع الله تعالى، تأسيسا على المعرفة الفطرية القائمة في نفسه سلفا، لا محالة، بأن هذا كله من بديع الصنع الإلهي! نأتي بالأمثلة نضربها في مقام التشنيع على دعاوى هؤلاء وبيان أنها تصادم الفطرة والبداهة مصادمة فادحة!! أما أن نصيرها هي نفسها دعوى نظرية يراد إثباتها، فهذا مما يتسلط به القوم علينا غاية التسلط، كما تسلطوا على الأقدمين من أهل الكلام، وهو ما أوحى لداروين نفسه بنظريته أصلا، كما بينت ذلك في موضعه، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يتبع إن يسر الله وأعان
أبو الفداء ابن مسعود
غفر الله له