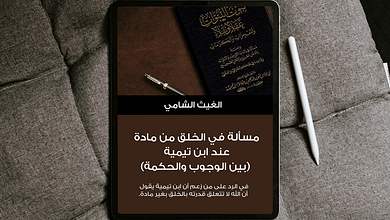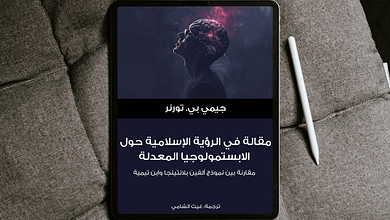كيف يقبل عقل الملحد هذا السخف؟
ثم قال الدكتور: “ويسخر صاحبنا من معنى الربوبية كما نفهمه .. ويقول أليس عجيبا ذلك الرب الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، فيأخذ بناصية الدابة، ويوحي إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تخرج من ثمرات من أكمامها إلا أحصاها عددا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه .. وإذا عثرت قدم في حفرة فهو الذي أعثرها، وإذا سقطت ذبابة في طعام فهو الذي أسقطها، وإذا تعطلت الحرارة في تليفون فهو الذي عطلها، وإذا امتنع المطر فهو الذي يمنعه، وإذا هطل فهو الذي أهطله، ألا تشغلون إلهكم بالكثير التافه من الأمور بهذا الفهم؟
ولا أفهم أيكون الرب في نظر السائل أجدر بالربوبية لو أنه أعفى نفسه من هذه المسؤوليات وأخذ إجازة وأدار ظهره للكون الذي خلقه وتركه يأكل بعضه بعضا؟! هل الرب الجدير في نظره هو رب عاطل مغمى عليه لا يسمع ولا يرى ولا يستجيب ولا يعتني بمخلوقاته؟ ثم من أين للسائل بالعلم بأن موضوعا ما تافه لا يستحق تدخل الإله، وموضوعا آخر مهما وخطير الشأن؟ إن الذبابة التي تبدو تافهة في نظر السائل لا يهم في نظره أن تسقط في الطعام أو لا تسقط، هذه الذبابة يمكن أن تغير التاريخ بسقوطها التافه ذلك.. فإنها يمكن أن تنقل الكوليرا إلى جيش وتكسب معركة لطرف آخر، تتغير بعدها موازين التاريخ كله. ألم تقتل الإسكندر الأكبر بعوضة؟ إن أتفه المقدمات ممكن أن تؤدي إلى أخطر النتائج.. وأخطر المقدمات ممكن أن تنتهي إلى لا شيء، وعالم الغيب وحده هو الذي يعلم قيمة كل شيء. وهل تصور السائل نفسه وصيا على الله يحدد له اختصاصاته؟؟ تقدس وتنزه ربنا عن هذا التصور الساذج! إنما الإله الجدير بالألوهية هنا هو الإله الذي أحاط بكل شيء علما، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الإله السميع المجيب المعتني بمخلوقاته.”
قلت: هذا الموضع قد وفق فيه الدكتور إجمالا، في بيان أن جميع حوادث العالم لها من التبعات والثمرات ما يمتنع معه أن يكون بعضها خاضعا لإرادة صانع مدبر ما، والبعض الآخر غير خاضع لها! فإنه لا يمكن أن أوجد تبعا لإرادة من خلقني، إلا وقد سبق ذلك سلسلة من الإرادات عنده سبحانه، والأفعال الإلهية، التي تسببت في جريان جميع حوادث التاريخ ومتولداتها السببية من قبل مولدي، بما لا يتسبب منه شيء في المنع من مولدي يوم ولدت حيث ولدت كما ولدت، كما أراد سبحانه! فلو أنه لم يرد، في ضوء السنن والطبائع التي ركبها في مواد العالم، أن يولد أبي أو أن تولد أمي، وأن تجري جميع المتولدات السببية التي أدت إلى أن يتزوجا، ما كان من الممكن أن أولد! فالرب الذي أراد مولدي وقضاه وقدره في علمه، لابد وأنه هو نفسه الذي أراد من قبل أن يولد أبي حين ولد وحيث ولد، وجدي من قبله، وهكذا، وأن يجري جميع ذلك على ما يحقق جميع إراداته المستقبلية سبحانه، في ضوء السنن والنواميس السببية التي اقتضت حكمته أن يقيمها في هذا العالم. فالعقل يوجب أن يكون صاحب السلطان التام على حوادث العالم وموجوداته واحدا لا شريك له ولا منافس، ولا ند ولا مكافئ، يعلم كل حادث مهما كان ضئيلا حقيرا، ويشاءه ويخلقه، يقدره تقديرا، ويعلم ما كان منه لو لم يكن كيف كان يكون! هذا من توحيد الربوبية قطعا.
وإن كان يجب أن يبين أن لفظة “تدخل” لا تجوز في حق الله تعالى، لأنه ليس خارجا عن شيء في ملكوته، حتى “يتدخل” فيه! لا يقع شيء في الوجود إلا بأمره وعلمه وحكمته وتدبيره، فمثل هذا لا يقال لشيء من أفعاله إنه “تدخل” Intervention! ونقول إن جواب سؤال الدكتور في نهاية هذه الفقرة، حيث يقول: “هل تصور السائل نفسه وصيا على الله يحدد له اختصاصاته؟” هو أن يقال: ليست آفة الملحد في التصور والفهم أصلا، حتى نتساءل كيف تصور هذا وكيف فهم هذا وكيف ظهر له هذا وذاك! آفة الملحد يا دكتور في الكبر الفاحش في نفسه، في إبائه أن يخضع لرجل مثله يقول: أنا رسول إليكم من رب العالمين، من الذي يجري الدم في عروقكم، ويحرك النفس في صدوركم، والنخاع في عظامكم! من الذي يسمع ويرى ما تخفون وما تعلنون، بل وأخفى مما تسرون، يعلم ما يحدِّث به أحدكم نفسه في ظلمة الليل البهيم، حيث لا يراه من الخلق أحد! أنا رسول ذلك الخالق العظيم الذي صوركم في بطون أمهاتكم، ثم أنشأكم أطفالا، ثم يميتكم ثم يحييكم كما خلقكم أول مرة، ليحاسبكم على كل قول وكل فعل وكل لفتة، في مشهد يوم عظيم! هذا ما يأباه كل ملحد قطعا، سواء سمى نفسه لادينيا، أو لاأدريا، أو غير ذلك مما يتسمون به. وهو مبعث الإلحاد ومنبته في كل نفس ألحدت في تاريخ البشر، فيما أزعم. وقد قلت من قبل في غير موضع، إن المعنى الكلي المشترك الوحيد بين جميع طوائف الملاحدة على اختلاف طبقاتهم وأسمائها التي بدعوها لها، إنما هو الفرار بكل ذريعة من الإقرار لأنبياء الله ورسله بما أوجبه لهم ربهم من الخضوع والانقياد ومحض الاتباع! فإن الكبر وشهوة العلو والرياسة في الناس، وأن يكون الرجل سلطان نفسه أولا، ثم إمام غيره إن استطاع، هذه الشهوة والكبر الذي يغذيها في نفس صاحبها، هي المنبت الأصلي الوحيد للإلحاد ولجميع مقدماته عند الإنسان! وهي سبب إلحادك أنت نفسك يا دكتور من قبل، يوم أن كنت ملحدا مغترا بعقلك وذكائك، شعرت أم لم تشعر. وهي كذلك السبب، للأسف، في بقائك على تلك الزندقات والضلالات الكبيرة بعد توبتك من الإلحاد. بل هي السبب في نشرك هذا الكتاب أصلا، شعرت أم لم تشعر!! كيف أكون قد ملأت الدنيا ضجيجا في إلحادي وتسفيها لعقائد المسلمين، ثم آتي فجأة وأقول قد تبت من هذا كله ورجعت إلى الإسلام، ثم لا أنشر ما أحفظ به منزلتي التي كنت وما زلت حريصا عليها، منزلة المفكر صاحب النظر الدقيق والرأي العميق، أقول لمن يتابعونني: قد تحولت إلى الإسلام لأن عقلي الألمعي الجبار قد دلني عليه، بعد أن كنت تائها من قبل لا أهتدي؟! أو كيف أحظى باحترام وتوقير الفلاسفة المعظمين عندي إن لم أنشر ما يصلح أن يكون سببا فلسفيا دامغا لبراءتي من الإلحاد الطبيعي الذي هو الدين الأثير عند عامتهم في هذا الزمان؟؟ كيف لا أقدم “اعتذاريتي” الفلسفية المفصلة My own apologetic للمصير إلى الإسلام؟؟ هل تريدون من الأكابر أن يظنوا أني آمنت كما يؤمن السفهاء؟؟ تريدون أن يظنوا أني لما أعياني الفكر وتكلف النظر، ألقيت بنفسي في أحضان التقليد الأعمى، ورجعت عاميا مقلدا كما كنت في سابق أمري قبل أن أتفطن إلى أغوار النظر الفلسفي التي قادتني إلى الشك والإلحاد في مستهل شبابي؟؟ لا أقبل ذلك على نفسي أبدا ولا أرتضيه!! يجب أن أنشر فورا كتابا أبين فيه “لماذا أسلمت” أو “لماذا تبت من الإلحاد” أو ما شاكل ذلك، وأروي فيه رحلتي من الشك إلى الإيمان، حتى أصبح إماما في تلك البابة التي يمكن أن يتصدر بها الرجل في كل من الدين والفلسفة معا!
لا يحتاج المتعرضون لفلسفات الملاحدة وشبهاتهم إلى كتاب ألفه رجل لم يشم رائحة العلم الشرعي بأنفه يوما من الدهر، وهو للتو قد خرج من حمأة الإلحاد والدهرية، ولا تزال ثيابه ملطخة بقذرها!! وإنما هو من يحتاج لأن يكسر كبر نفسه، ويجلس عند أهل العلم، ليتعلم ما لا يسع المسلم جهله، إن كان صادقا في طلب النجاة في الآخرة! أنت ما خرجت من الإلحاد لأن عقلك الجبار قد توصل بك أخيرا إلى المعادلة الصحيحة، أو إلى البرهان النظري القاطع لكل شك، القاضي على كل حيرة وارتياب!! أبدا! وإنما خرجت من الإلحاد لأن الله تعالى قد مال بميزان المحبوبات والمكروهات في نفسك وفي عقلك الباطن، إلى محبة الإيمان وما يترتب عليه عند بعض أهله من الثمرة والأثر، فملت إلى ذلك بعد أن كنت تبغضه وتنفر منه البتة! ولهذا يمتن الله تعالى على عباده أعظم المنة بأن يحببهم في الإيمان ويزينه في قلوبهم، ويبغض إليهم الكفر والفسوق والعصيان، لا بأن يرزقهم من الذكاء والنبوغ ما يكفي لأن “يكتشفوا” الميتافيزيقا الصحيحة التي إذا أسسوا عليها برهانا فلسفيا لإثبات الصانع، ثبت تحت أقدامهم وأمدهم بما هو واجب عليهم من الجزم واليقين! أنت تحتاج، أشد ما تكون الحاجة، أيها المتعرض لبضاعة الملاحدة، إلى من يعينك على تزكية قلبك وتطهيره من تلك الأهواء التي علقتك بتلك البضاعة أصلا، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ويدله على صاحب سنة يأخذ بيده إلى سبيل النجاة! أما الذي يقول لك أنا “مفكر إسلامي” قد كنت ملحدا أو دخل علي الشك، فخرجت منه بهذه البضاعة العقلية التي أدلك عليها في كتابي، فهذا أنت تفر منه فرارك من الأسد، إن كنت صادقا في الحرص على تغليق أبواب الشك والريبة، وتحصين قلبك من ألاعيب الفلاسفة ومن لف لفهم! ليس في الفلسفة أرض ثابتة يوقف عليها ولا يقين يبتغى حتى تطلبه من المتفلسفة والمتكلمين ومن سلك طريقتهم! فمن أوهمك بأن الفلسفة هي طريقك إلى اليقين فوالله قد غشك أعظم ما يكون الغش، وخدعك أيما خديعة! ومن كان متفلسفا ملحدا في أول أمره ثم مات على الإسلام، فهذا، مع كونه قليل الوقوع جدا، إلا أنه إذا وقع، فلا يكون أبدا بسبب الفلسفة، بل على الرغم منها ومما تصنعه بعقول الناس! كن جازما بأن هذا المتفلسف الذي خرج من الإلحاد، ومات على الإسلام، إنما حصل له ذلك لأن شيئا قد تبدل في قلبه وميول نفسه، لا لأن برهانا نظريا قد وقع له فأكسبه اليقين المنشود، وحسم لديه الأمر على أتم ما يرام! ودونك أبو حامد الغزالي، الذي ما ترك كتابا في الفلسفة والكلام إلا قرأه وأتقنه، ثم شهد بأن ذلك كله ما أغنى عنه شيئا، حين انتهى إلى التشكيك في كل شيء، حتى في إفادات حواسه! ولولا أن من الله عليه بأن رأى اليقين يحصل من طريق أخرى بخلاف تلك الطريق بالكلية، لما مات على الإسلام أصلا! صحيح إنه تعلق بصوفية مدخولة فاسدة طلبا للنجاة لعقله، إلا أن الصوفية على المعنى السني القديم، التي هي بمعنى مراقبة القلب وإصلاح النفس وتزهيدها في لعاعة الدنيا، هي الطريق حقا لصيانة النفس من الإلحاد، ومن ذلك القيح والقذر الذي تكتسي به قلوب المتفلسفة من حيث لا يشعرون!
ولهذا رأيتني حين هممت بوضع مصنف في مكافحة الإلحاد، من حيث بيان أصل الآفة وسببها الأول، أخرجته مجلدا في التصوف السني وفي علم السلوك، سميته “الكشاف المبين لما في نفوس المستكبرين”! لقد كنت أتتبع سجال الفلاسفة في مسألة الشر وما شاكلها، فلا أرى إلا مريضا مستكبرا يستعرض قدراته وذكاءه على مريض مثله، وكأنما لا يعنيهما الحق من حيث هو حق، وإنما يعنيهما أن يظهر كل واحد منهما الأهلية للتصدر والتقدم بين أيدي تلك الطائفة التي يقال لها الفلاسفة، وأن يحظى بإعجاب من يتصدر باسمهم في الجدال والمخاصمة! كل امرئ منهم كأنما ينادي على الناس أن ها أنا ذا فاعرفوني! أنا الذي ضربت برهانا من سبع مقدمات طويلات لأبرهن على أن هذه التي أراها أمامي هي يدي اليمنى! هل خطر بعقل أحدكم يوما أيها العامة المساكين، الظن بأن هذا الأمر يحتاج إلى برهان؟؟ أنا قد بلغت من الذكاء والنبوغ ما كشف لي ذلك، وقد تكلفته فعلا، فأبشروا بالعقل الذي لا يعلوه عقل! هذا لسان حال “جورج مور” الفيلسوف البريطاني الذي تكلف وضع ذلك البرهان في النصف الأول من القرن العشرين!! وأطول من برهانه هذا، البرهان الذي تكلفه الآمدي من قبل في بعض كتبه ليثبت وجود الله تعالى! فبالله أي عاقل هذا الذي يولي وجهه إلى تلك الجهة طلبا في الخلاص من أسباب الإلحاد، وفي صيانة الشباب منها؟؟
لا يحتاج عاقل سوي إلى كتاب في الفلسفة حتى يعرف كيف يثبت أن ما يضيء جو السماء في وسط النهار إنما هو الشمس الساطعة في كبد السماء كما يزعمه “العامة” من الناس! وإنما يحتاج إلى أن يتعلم كيف يفتح عينيه، ويخلع نظارة الجهل والسفسطة من عليهما، وأن يضرع إلى الله تعالى غاية وسعه أن يعافي عينيه من كل مرض قد أصابهما! حقق مرتبة الإحسان وتعلم كيف تكبح جماح الشهوة في نفسك، إن أردت أن توفق لرؤية الحق حقا والباطل باطلا، فإن هذا هو بيت الداء وأصل الخلل!
ولهذا تجد كل من كثرت شقشقته في الإلحاد على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، ثم مال إلى الخروج من الإلحاد وإظهار التوبة منه، تجده يسارع فورا إلى التأليف في الإلحاد وفي الرد على الشبهات وكذا، بمجرد أن يعلن توبته! لماذا؟ لفساد الأصل في هذا! لأنه يرى أنه إنما خرج من الإلحاد بعقله كما دخله بعقله! نعم قد يرزق أن يقول إن الله هو الذي ألهمه هذا الفتح العقلي الفلسفي، لكنه الذكاء والنبوغ الذي كان سببا في إبصاره ما كان من قبل عاجزا عن إبصاره!! امتن الله عليه أخيرا، فيما يظن، ببرهان صحيح على الطريقة المرضية أكاديميا في عصره! أليس هذا ما يرجى أن تندفع به شبهة التقليد في الإيمان عند الفلاسفة؟ فلابد إذن أن أجتهد في بيان أن إيماني بعد الإلحاد إنما هو مكتسب بالنظر العقلي الذي وقع لي، وجرت به تجربتي الشخصية. وهو أحسن عندي من إيماني قبل الإلحاد والردة، لأني قبل الإلحاد لم أكن قد تحصلت على تلك الأجوبة التي أنا متترس بها الآن، معلق عليها ديني وإيماني! ولو كانت عندي ابتداء ما ألحدت!! وإذن فما أكتبه وأنشره من ذلك يكون علما ضروريا لكل مسلم، لا أنه قد ينفع من تعرض لأسباب الإلحاد فقط! بل كل مسلم يجب أن يكون متحصلا على نفس تلك المادة حتى يخرج بإيمانه من منطقة التقليد إلى العلم العقلاني الموضوعي المحصل للإيمان، المؤصل له! يتعلم كيف يثبت وجود من صنعه في هذا العصر الذي نحن فيه، في عصر العلم، وأكون أنا من يعلمه ذلك، وإذن أكون معظما عند الفلاسفة الطبيعيين الكبار، وعند علماء الدين أيضا، معا في نفس الوقت!!
والمقصود هنا أن الملحد لا يلحد أبدا بسبب أن حجة أو برهانا قد “أقنعه”! ما معنى “أقنعه” أصلا؟ أي أكسبه العلم بدلالة كان من قبل جاهلا بها؟ السفسطة على البديهيات الفطرية إنما هي إحلال للجهل والسفاهة في محل العلم، وليست اكتسابا لعلم جديد أصلا! وإنما الذي يحصل أن نفسه تكون قد مالت لاستحسان كلام الملاحدة وإنزاله منزلة الرأي النظري الوجيه المعتبر، بعد أن كانت تنفر منه أشد ما يكون النفور، وتفر فرارها من المجذوم! لماذا؟ لأنها صارت، من كثرة التعرض والإلف، تطمع في الانقلاب إلى ما عليه هؤلاء من الأحوال الدنيوية العاجلة، تشتهي ذلك وتميل إليه، خلافا لما عليه المسلمون من كبح لجماح تلك الشهوات والأهواء، والتزام صارم لا يلين بالانقياد لرسول رب العالمين، والخضوع لتعاليم الدين! لابد من تحول نفسي شعوري خفي، لا ينتبه إليه صاحبه إن انتبه إلا وقد فات الأوان! كثيرا ما يعجب النصارى الغربيون من المسلمين لماذا يغضبون من سب نبيهم عليه السلام في الرسومات المسيئة وهذه الأشياء، مع أنهم هم لا يبالون بمثل ذلك إذا وقع مع المسيح عليه السلام، الذي هو معبودهم أصلا، وليس بشرا رسولا عندهم!! والسبب في ذلك أيها القارئ الكريم، إنما هو أن نصرانية هؤلاء، فيما طبِّعت عليه بيئتهم الدينية والفكرية والاجتماعية، إنما هي إلحاد مزين ومزخرف ببعض عوائد النصارى لا غير! زيارة الكنيسة واللعب مع الأصحاب فيها، أمر محبب لا لأنه يقرب أحدهم إلى معبوده ومألوهه، ولكن لأنه يشبع جانبا من حياة أحدهم هو يكره أن يتصورها بدونه! بل إن من طوائف الإنسانيين الدهرية Humanists من يرى أن الحفاظ على الكنيسة النصرانية في أوروبا مطلب ضروري ملح جدا، لما يحققه من هوية اعتبارية للمجتمع الأوروبي، يجب الحفاظ عليها، ولما تقوم به الكنيسة من وظائف اجتماعية لا يعرفون بديلها في غيرها، كمراسم الزواج والجنائز وما شاكل ذلك. فالدين مطلوب بقدر ما يشبع الشهوة الدنيوية العاجلة، وإلا فلا حاجة لنا فيه. وأما المسلمون فهم بفضل الله تعالى يحملون الدين محمل الجد ولا يستجيزون الهزل ولا الاستهزاء بمقدساتهم، لأنهم تربوا على أن المعرفة بصحة هذا الدين وبلقاء الآخرة، أمر فطري جبلي لا يتطرق إليه إنسان بالتشكيك إلا كان متهما في عقله وقلبه معا لا محالة، آتيا أمرا في غاية الشناعة والفساد! وهم بفضل الله تعالى، أي جماهيرهم من عموم الناس، لم يبلغوا من التعرض لسفسطة الفلاسفة ولكلامهم الفاسد معشار ما تعرضت له جماهير الغربيين في بلادهم! أو للدقة، لم يتحول مجتمعهم إلى حالة يصبح معها الإلحاد أمرا له وجاهته الاجتماعية وجاذبيته القلبية لمحبي العلوم الدنيوية الطامعين في الظهور بين أيدي أصحابها، ولو بالقوة دون الفعل، نسأل الله أن يكفي المسلمين شر ذلك التحول المهلك! فقد كانت ثورة الغربيين على الكنيسة حين ثاروا عليها، ميراثا لقرون خلت من التحولات القلبية في الميل والهوى، في ظل أكاديمية يونانية تعلم الناس السفسطة والدهرية تحت لواء العقل والعلم! لم تكن تلك الثورة حين اندلعت، وليدة ظرف طارئ في القرن الذي اندلعت فيه! أبدا! وإنما هو التحول والميل القلبي البطيء، وتراكم في الناس حتى يصبح تعليما اجتماعيا يربى عليه كل جيل فوق ما تربى عليه سابقه! وهل انخلعت عرى الإسلام في بلادنا، عروة عروة، كما أنبأنا الرسول عليه السلام، ولم تزل، إلا بنفس ذلك التدرج الطويل عبر الأجيال؟؟ يعجب كثير من الناس كيف استطاعت صفية زغلول أن تنزع عن نساء مصر حجابهن، على نحو ما صنعت! وكأنما يتصورون أنها جاءت إلى مجتمع أغلب النسوة فيه سالمات من الأهواء التي ترغبهن في التخلص من الحجاب! أبدا! وإنما جاءت إلى مجتمع كان قد تمهد من قبلها، قلبيا ونفسيا، لأن ترى النسوة فيه، إلا من رحم الله، الحجاب الشرعي عبئا ثقيلا تود لو أن تتخلص منه دون أن ينالها الأذى من الرجل في بيتها! فلما جاءت تلك المرأة في ذاك اليوم المشؤوم، وخلعت حجابها وداسته بقدميها، لاقى ذلك العمل استحسان الكثرة منهن، واجترأن على الاقتداء به!
فالذي يقع أن النفس تتحرك في تمرد ونقمة على باريها أولا، فتتجيّش آلة العقل والنظر تبعا لذلك الحراك النفسي الباطن (أو الظاهر لصاحبه)، لتسوغه بكل حيلة وبكل سفسطة ومغالطة، وبكل زخرف من القول واللفظ في كل مناسبة، وإذا ما كانت تراه حقا من قبل يصبح باطلا، وما كانت تراه باطلا يصبح حقا، تقوم له الأدلة والبراهين المزعومة أشكالا وألوانا! ولا تتمرد النفس على خالقها إلا من كبر خفي، يبغِّضها في الطاعة والخضوع والانقياد والاستسلام للرسل ولما جاؤوا به، ويجرئها على الاعتراض والتقديم بين أيديهم. وأصحاب ذلك المرض لا يشعرون به عادة إلا وقد أقامهم في أدنى الدركات، نسأل الله السلامة! فالذي يتفلسف تحت راية “المفكر الإسلامي”، مثلا، ذلك اللقب الذي صار ستارا ورمادا يذر في العيون، عوضا عن لقب “فيلسوف إسلامي” الذي أصبح مرادفا في التراث الإسلامي والوعي العام عند المسلمين للزنديق القائل بقدم العالم، لا سيما بعد تكفير الغزالي رحمه الله لابن سينا وابن رشد الحفيد وغيرهما بهذه المقالة، هذا مصاب بنبتة الإلحاد في نفسه، شعر أم لم يشعر! وغالبا لا يشعر! إذ لو شعر لخاف على نفسه، ولأعاد النظر في قلبه وراجع نفسه، قبل أن تنزلق قدمه إلى حيث تتم هلكته! هو ما تفلسف أو “تفكر” على تلك الطريقة إلا لأنه لا يعجبه الدين على ما هو عليه! لا يرتضي أن يكون مأمورا مكلفا بالخضوع والانقياد في هذا المعنى أو ذاك مما يخالف هواه، فيسلك طريقة فلاسفة الإلحاد في إزالة أصل ذلك التكليف من الدين نفسه، كما يتكلف الفلاسفة الدهرية محاولة إزالة أصل العبودية للباري من مبدأ الأمر! يسفسط أحدهم فيدعي أن هذا الذي يكرهه مبني على مقدمات لا يسلم بها، بل عنده ما يدل على فسادها، ثم يظهر ذلك في الناس، ويصبح صاحب “مشروع فكري” يعظمه لأجله أقرانه ومن شاكلوه! مشروع تجديد الدين وتطهيره من جهالات الأولين، فيما يدعي!! فمثل هذا لا يأمن على نفسه أبدا من أن يميل به قلبه إلى إسقاط الدين كله، كما مال به من قبل إلى إسقاط بعضه! وكثيرا ما يكون الواحد من هؤلاء ملحدا زنديقا يخفي كفره وتكذيبه بأصل الدين نفسه، ينتظر أن تتبدل أحوال الناس والمجتمع القريب الذي يحرص على ألا يظهر مخالفته فيتعرض لأذاه أو بطشه، أو يخسر أناسا محببين إليه يكره أن يفقدهم، لأجل أن يظهر إلحاده أخيرا، عيانا صراحا بلا مواربة! أكثر المغترين بعقولهم وذكائهم هكذا يسلكون! الفلسفة طريق كل مغتر بعقله لأن يقدم نفسه بين الناس، يجعلهم تبعا له، عوضا عن أن يكون هو تابعا لأحدهم! فمذاهبهم المعلنة في الحقيقة إنما تتشكل، ببراهينها وأدلتها المزعومة عندهم، وبجميع مبانيها العقلية، تبعا للهوى الاجتماعي الذي يتفق لهم أن يكونوا عليه حال التأليف والنشر! فداروين، مثلا، لولا حبه لزوجته النصرانية، لأظهر إلحاده من أول يوم، ابتغاء لوجوه الفلاسفة من أقرانه، ولخلت كتبه من كل موضع فيه إشارة إلى الباري وصنعه وإبداعه وكذا، مما كان في كتبه الأولى ومراسلاته للناس! وأينشتاين كان يهو_ديا صهيو_نيا في صباه، من يهو_د الأشكيناز الأوروبيين، فكان يظهر ذلك حين كان ذلك يمده بالوجاهة والحماية الاجتماعية، ويضعه حيث يحب أن يرى نفسه! بل كان مستشارا للمنظمة الصهيو_نية العالمية، حين بزغ نجمه في العشرينات من القرن الماضي، حتى عرض القوم عليه رئاسة الكيان الصهيو_ني في فترة من الفترات. ولكن، ومع هذا، كان يقول أنا يه_ودي علماني Secular J_ew (1)، وإذا جالس الفلاسفة والأقران من الفيزيائيين وسألوه عن دينه، قال لا أؤمن ولا أرضى أن أؤمن برب يجيب الدعاء ويرى ما في نفوس الناس، ويشتغل بتلك الأمور، هذا التصور “الطفولي” لا يروق لي! ومهما استعملت لفظة “الإله” فإنما أقصد بها النظام البديع تام الإحكام لهذا العالم الطبيعي، على طريقة سبينوزا، وليس شخصا في السماء يأمر وينهى ويحاسب الناس! فهو في حقيقة الأمر كان كافرا بأصل أصول الملة اليهودية، يرى ما في كتبها المقدسة من وصف لذلك “الشخص في السماء” في أفعاله وأوامره وزواجره وكذا، مجرد أسطورة طفولية اخترعها بعض الجهال!! فالرجل مات على الإلحاد المحض، وما أغنى عنه دم أمه اليهود-ية شيئا!
فالذي يوفق لأن يتوب إلى الله تعالى من تلك الطامة الكبرى والمصيبة التي لا مصاب فوقها للإنسان، التي هي الردة والإلحاد، لا يتم له الخير والتوفيق إلا بأن يرزق تنقية النفس وتطهير القلب بكل ما أوتي من الوسع والقوة، من ذلك الهوى والمرض العضال، ذلك الميل المهلك، نسأل الله العافية. يجب أن يقطع التائب من الردة ومن الإلحاد، كل طريق دونه ودون أسباب ذلك الهوى الذي سبق أن أرداه في تلك المهاوي من قبل، إن صدق في حرصه على النجاة في الآخرة! هو لماذا ألحد أصلا، إن لم يكن لمطمع دنيوي حقير، قد ملأ عليه أنحاء نفسه من حيث لا يشعر، فصار لا يرى من الرأي إلا ما يحقق له ذلك المطمع فيما يرجو، ولا يدين من الدين إلا ما يشبع له ذلك الهوى؟!
دعك من قول أحدهم في الدفع عن نفسه: هذا غير صحيح، أنا إنما سقطت في الإلحاد لأن عقلي لم يستطع أن يقبل تلك المعاني التي تنسبونها إلى معبودكم في دينكم، فمشكلتي معرفية صرفة وليست نفسية كما تزعمون! هو قطعا سيدافع عن نفسه بمثل هذا، لا محالة! وإلا فماذا كنتم تنتظرون؟ هل يشعر المريض النفسي بأنه مريض؟؟ لو وفق لأن يشعر بذلك وأن يقر به ويعترف، فقد حصل له شطر الشفاء بعون الله وفضله! ولكنه لا يشعر! فصاحب الكبر لن يعترف على نفسه أبدا بأنه مستكبر متعاظم، وصاحب الشهوة الخسيسة الذي يفعل الفعل لا يفعله إلا طمعا في تلك الشهوة العاجلة ولهاثا خلفها، هذا لن يعترف على نفسه أبدا بأنه كذلك إن واجهته، إلا أن يشاء الله! وإنما يعترف بين يدي ربه في الآخرة حين تنكشف جميع الأستار والحجب، ويختم على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل! الله تعالى يغفله عن ذلك في الدنيا جزاء لما سبق منه من الترسل مع الأهواء والشهوات، كما في قوله تعالى: ((فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)) الآية [الصف : 5]! مع أن كلا الزيغين من الله تعالى لا من غيره، إذ له الأمر والتقدير والتكوين في الابتداء والانتهاء، ولكن الثانية ترتبت على الأولى ترتب العقوبة على الجريمة! فكما أن الهداية تورث المزيد من الهداية والخير، فضلا من الله ومنة، فكذلك الغواية تورث المزيد من الزيغ، جزاء وفاقا.
فالنفس إذا وقع فيها ذلك المرض الفتاك، نسأل الله السلامة، أعني مرض الكبر والهوى، فإنه لا يكون سبب زيغها وضلالها، الذي قد يصل إلى الزندقة أو التصريح بالإلحاد، هو الجهل أو خفاء الحق في هذه المسألة أو تلك، أبدا، وإنما يكون ذلك الهوى نفسه هو الحامل على جحد الحق واعتناق الباطل في محله، وهو المانع من الشعور بفساد ذلك الباطل وبشناعته وشناعة لوازمه! فالسائل يعلم أنه ليس وصيا على ربه، ولا يمكن أن يكون كذلك! ويعلم أنه ليس له أن يشترط على ربه حالا معينة تكون لهذا العالم أو له هو نفسه فيه، يولد فيجد نفسه عليها! ويعلم أنه ليس يملك حتى جسده هذا الذي ولد فوجد نفسه متسلطا عليه! فكيف تصور ذلك التصور “الساذج” كما عبر الدكتور؟ تماما كما جاز كل اعتقاد سخيف ظاهر الفساد والبطلان عند من اعتنقه وتعلق به! لأن نفس الإنسان وما يتحرك فيها من الميول والأهواء، هي ركن العقل وعمله، بل هي عموده وأساسه على التحقيق. هي التي تشعره بالعلم بما يعلم وبالجهل بما يجهل، تحول بينه وبين قبول الحق الجلي الواضح، وتزين له كل باطل ظاهر فاضح، إن تركها لتميل به حيث تشتهي!
ثم نقول لا يجوز أن يقال في حق الرب سبحانه “أعفى نفسه من هذه المسؤوليات وأخذ إجازة وأدار ظهره للكون الذي خلقه وتركه يأكل بعضه بعضا”، نعم هو يقول هذا الكلام من باب تسخيف قول الملحد، ولكن هذا سوء أدب مع الله تعالى، ولا يجوز الكلام بهذا الأسلوب حتى عند افتراض كلام للملحد للرد عليه. إعفاء النفس من المسؤولية هذه تكون لمن له سائل حاكم عليه من فوقه، والله تعالى لا مستكره له، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. والعطلة أو الإجازة وما شاكلها، كلام قبيح لا يجوز في حق الله تعالى ولو في سياق ما ذُكر.
يتبع إن يسر الله وأعان
أبو الفداء ابن مسعود
غفر الله له
——————–
(1) وقد كذب في ذلك ولا شك، إذ لا يكون الرجل علمانيا حقا إلا وهو يرى وجوب فصل الدين عن الدولة بالكلية، وهذا كان داعما لدولة لا أساس لها إلا الدين!
——————-