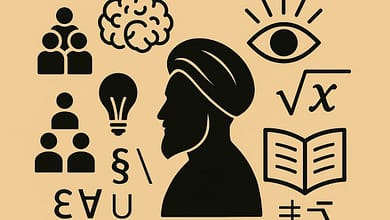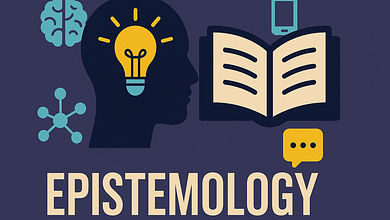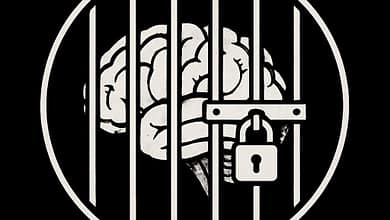الإيمان بصحة المذهب الداخلاني (internalism)—وهو الاعتقاد بأن تبرير المعرفة يعتمد بالكامل على قدرتك على استحضار الأدلة لمعتقداتك—يؤدي بالضرورة إلى النسبية (relativism).
أول ما يظهر من هذا النهج هو التمييز بين الفيلسوف والعامي، حيث يمتلك كل منهما قدراته المعرفية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الفيلسوف أو العالم أنه أرقى من العامة بفضل تدريبه ودراسته الفلسفية. بناءً على هذا، فإن استحضاره للأدلة لتبرير معتقداته سيكون، وفقًا للداخلانية، أكثر قوة وإقناعًا من الشخص العادي. وبالتالي، يمكننا القول إن العامي لا يمتلك أي قدرة على الوصول إلى الحقيقة كما يفعل الفيلسوف أو العالم. وبناءً على ذلك، تصبح الحقيقة بالنسبة للعامي نسبية، إذ لا يمتلك ما يبرر معتقداته وفقًا لمعايير الداخلانية.
لكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فحتى بين الفلاسفة أنفسهم، يعتقد كل واحد أن مخالفه مخطئ، مما يؤدي إلى تعميق التجزئة ليس فقط بين الفلاسفة والعامة، بل حتى داخل أوساط الفلاسفة أنفسهم. ونتيجة لهذا، لن يكون هناك منهجية موحدة يتفق عليها الفلاسفة جميعًا.
علاوة على ذلك، الفلسفة بطبيعتها تتغير وتتطور بمرور الزمن، فما كان مُجْمَعًا عليه في الماضي قد يُرفض اليوم، فما الذي يمنع حدوث ذلك لأي معتقد أو منهجية فلسفية أخرى؟ لا شيء. فالفيلسوف الداخلاني يرى أن أي تبرير لا بد أن يكون مدعومًا ببراهين يمكن عرضها للمخالف، ولكن التاريخ يثبت أن أي برهان يُعتمد عليه يفقد مصداقيته مع الوقت. ولهذا، فإن النتيجة الحتمية لهذا النهج الفلسفي هي نسبية الحقيقة.
ولا يمكنك الادعاء بأن هذا التحليل يقع في مغالطة “تضخيم الصراع” (inflation conflict)—التي تقول إن وجود الصراع بين جميع الأطراف يعني أن الجميع مخطئ أو أن الحقيقة غير قابلة للتحقيق—لأنك أنت من ألزمت نفسك بمنهج النظر الداخلاني في كل ادعاء. فحتى لو وصلتَ إلى الحقيقة، لا بد أن يبقى النظر مستمرًا، وإلا تناقضت مع منهجيتك. وبما أن الفلسفة تعتمد على الإمكان الذهني والتجارب الذاتية للفيلسوف، فلا حدّ لها بطبيعتها، مما يجعل الاختلاف أمرًا ضروريًا لهذا النهج، وبالتالي يؤدي إلى نسبية الحقيقة.
لذا، عندما تدّعي أن أي ادعاء لكي يكون صحيحًا ومبررًا لا بد من استحضار الأدلة، فإن ما أوضحته هنا يظهر أنه لا يوجد لديك دليل حاسم على صحة أي ادعاء. فبناءً على ماذا تدعي صحة الداخلانية من الأساس؟
ولهذا فقد ارتكز العديد من الفلاسفة على المعرفة القبلية a priori وعمموها على جميع البشر، كنقطة بداية نشرع منها، فلا نقع في النسبية. ولكن كنا نبه شيخ الإسلام، فإن هذه المعارف نسبية في طريقة التحصيل والإعتقاد ولا تحصى.
لهذا السبب، نقول إن المذهب الخارجاني (externalism) هو الصحيح عمومًا وإلا وقعنا في المعضلة التي بينتها فوق. لهذا لا بد من قوة مودعة فينا هدفها تحصيل الحق بدون نظر.
إذن المخاوف بشأن ضرورة اختيار المبادئ العقائدية قد لا تكون ذات صلة بكلٍّ من النزعتين الخارجانية والداخلانية، نظرًا لاحتمال زيف الطوعية العقائدية doxastic voluntarism – أي فكرة أن تكوين المعتقدات مسألة اختيار دائمًا.
بدلًا من ذلك، إن العديد من معتقداتنا تنشأ من عمليات عقائدية فطرية أو تكوينية تعمل بشكل مستقل عن الإرادة الواعية. وتشمل هذه العمليات الإدراكية، التي تُولّد المعتقدات تلقائيًا ما لم تُلغِها عوامل معرفية أخرى، والاستدلال الاستقرائي الأساسي، وهو متأصل بعمق في الإدراك البشري، أي بلا تكلف نظر. على سبيل المثال، فإن ميلنا إلى توقع أحداث مستقبلية بناءً على تجارب الماضي ليس أمرًا نختاره بوعي، بل هو بالأحرى عادة معرفية فطرية.
لأن هذه الآليات التلقائية لتكوين المعتقدات موجودة، يترتب على ذلك أننا لسنا بحاجة لاختيار مبادئ عقائدية صريحة (مثل أساليب التبرير أو تقييم المعتقدات) قبل تكوينها. في الواقع، عندما نتخذ مثل هذه الخيارات، فإنها غالبًا ما تتأثر بمعتقدات سابقة تشكلت من خلال هذه العادات المعرفية التلقائية. ونتيجة لذلك، فإن اختيار إطار عمل محدد للقرار العقائدي غير ضروري لتكوين المعتقدات، ولا يتطلب الأمر إطار عمل ذي مستوى أعلى meta لتوجيه هذه العملية.
في البداية، يُكوّن الكائن الحي معتقداته تلقائيًا من خلال آليات معرفية فطرية، تتعلق غالبًا ببيئته المباشرة. ومع نضجه، يبدأ بالتفكير في معتقداته الخاصة، ويلاحظ أن بعض عمليات تكوين المعتقدات تؤدي إلى أخطاء، بينما تكون أخرى أكثر موثوقية.
يحدث هذا الإدراك من خلال التجربة. يتوقع الكائن الحي وقوع حدث ما، ويلاحظ عدم وقوعه، ويدرك أن معتقده السابق كان خاطئًا. للقيام بذلك، يجب أن يمتلك الكائن الحي فهمًا مسبقا للحقيقة والخطأ. بمجرد أن يُميّز بين عمليات تكوين المعتقدات الأكثر موثوقية والأقل موثوقية، فإنه يتخذ الخطوة الأولى نحو التقييم العقائدي – أي تقييم معتقداته الخاصة. وهذا ما نسميه بالمسألة الشرعية العقلية.
عند هذه النقطة، يمكن للكائن الحي إدخال مفهوم غير معياري للتبرير، حيث تُبرر المعتقدات إذا كانت نابعة من عمليات موثوقة. لاحقًا، يمكنه الانخراط في النقد الذاتي العقائدي، وتطوير مبادئ القرار العقائدي التنظيمية لتقليل الأخطاء والتحيزات في تكوين معتقداته.
من أهم النتائج المستفادة أن التبرير، وخاصةً في صورته المعيارية، يأتي بعد أن يكون المخلوق قد كوّن معتقداتٍ ومفهومًا للحقيقة. وهذا يتناقض مع مبدأ الداخلانية، الذي يوحي بضرورة اختيار معيار للحقيقة أو إطارٍ لتشكيل المعتقدات قبل تكوين أي معتقدات. بل إن النص يجادل بأن تكوين المعتقدات يسبق اختيار إطارٍ عقائدي، وليس العكس.
ملحق:
مسألة في الفطرة والمذهب الخارجاني externalism:
مبدأ القرار العقائدي DDP هو قاعدة أو مجموعة قواعد توجه كيفية تشكيل الشخص لمعتقداته أو الحفاظ عليها أو مراجعتها. يأخذ هذا المبدأ مدخلات مثل الأدلة والإدراكات والذكريات والحالات المعرفية الأخرى، ويخرج بوصفات لما يجب أن نؤمن به أو نرفضه أو نظل غير متأكدين منه.
هناك وجهتا نظر رئيسيتان لمبدأ القرار العقائدي:
المبدأ الخارجاني: يركز على الحقيقة الموضوعية، ويتخيل منظورًا كلي المعرفة لتحديد أفضل مبدأ قرار عقائدي.
المبدأ الداخلاني: يركز على وجهة نظر الفرد، ويتطلب أن يكون مبدأ القرار العقائدي شيئًا يمكن للشخص تبريره وتبنيه لنفسه.
إن التوصيف السابق لـ DDP الصحيح يفترض منظورًا خارجانيا، يتخيل مراقبًا شبيهًا بالإله يعرف كل الحقائق والأكاذيب ويمكنه اختيار DDP الذي يقود إلى الاعتقادات الصحيحة ويتجنب الأخطاء. هذا المنظور منفصل وموضوعي، يركز على ما يصفه كائن يعلم كل شيء. ومع ذلك، لم تتبن نظرية المعرفة التقليدية هذه النظرة الخارجانية. بدلاً من ذلك، كانت في الغالب داخلانية أو أنانية، مما يعني أنها تركز على منظور الفرد نفسه. من وجهة النظر الداخلانية هذه، فإن هدف نظرية المعرفة هو بناء DDP من الداخل، بناءً على الموارد المعرفية الخاصة بالفرد ونقطة نظره. باستخدام فكرة كانط، يجب ألا تكون DDP “مغايرة” heteronomous (مفروضة من الخارج) بل “مستقلة” autonomous (منحت ذاتيًا). بعبارة أخرى، يجب أن تكون DDP شيئًا يمكننا تبريره لأنفسنا، وليس مجرد شيء موضوعي.
ولتوضيح ذلك، تخيل أن هناك قائمة طويلة للغاية من المقترحات التي يجب تصديقها تغطي أحداثاً فردية، وقوانين الطبيعة، وما إلى ذلك. وتنص هذه القائمة على الإيمان بهذه المقترحات دون قيد أو شرط، دون النظر في الحالات المعرفية للفرد أي تبريراته الشخصية. والشروط المدخلة لهذه القائمة غير موجودة في الأساس من منظور الشخص. والآن، لنفترض أن كل المقترحات في هذه القائمة صحيحة. ومن منظور خارجاني، قد تبدو هذه القائمة مثالية لأنها تؤدي إلى معتقدات حقيقية، كما هو طريقة الخارجانيين في تصوير المعرفة. ولكن من منظور داخلاني، فإن هذه القائمة غير مقبولة. إنها نوع من القواعد التي قد يفرضها مراقب شبيه بالإله الذي يعلم كل شيء، ولكنها ليست شيئاً يمكننا أن نتبناه لأنفسنا بشكل مشروع. وإذا تبنينا مثل هذه القائمة، فلن يكون ذلك إلا لأننا استخدمنا قائمة أخرى أكثر جوهرية لتحديد ما إذا كانت المقترحات في القائمة صحيحة. وهذه القائمة الأكثر جوهرية التي نستخدمها لتقييم وتبرير المعتقدات من منظورنا الخاص هي التي ينبغي لنا أن نعتبرها القائمة الصحيحة حقاً.
ومنهج الخارجاني هو ما نعتقد به، فالله أودع فينا فطرة تفرق بين الحق والباطل إذا ما كانت سليمة. ولسنا بحاجة لتبرير تفصيلي داخلاني لنعتقد بكل مسألة وافقت الفطرة والشرع معا. ولهذا فإننا ندعي أن الفطرة تعلم معظم الأمور (الحسن والقبح) مجملة وتأتي الشريعة فتفصل، فيحصل نوع من التوافق. ولهذا لا بد من أن يكون الوحي يتحدث عن جميع أسس الحياة وشبهاتها. فالتبريرات الفلسفية غير ضرورية ولسنا مطالبين بها، بل هي أمر زائد عن الحاجة وتطويل وتعقيد للمسائل التي نتوصل إليها بداهة وفطرة ويأتي الشرع ليثبتها. بل كل ما يلزمني هو اعتقاد أن الله أودع في آلية تميز بداهة بين الضرورات وأن هذه الآلية تكشف لي عن التلازمات الضرورية، كقولي أنا موجود إذن لا بد من وجود خالق كامل أوجدني فأسلم له بما يأمرني. فالمدخلات التي تحيط بي والإدراكات وتجاربي كلها راجعة لسلامة فطرتي، فما أن سلمة سلم اعتقادي وعملي بلا شعور ووعي ذاتي مني لكون الآلية التي تعالج المدخلات سليمة. ولا يهم كون هذه الآلية موثوقيتها مبررة من قبلي، كل ما يهم أنها في الواقع كذلك.
قد يقول البعض أن هذا يفتح الباب لصحة أي ادعاء، ما أن يدعي شخص معين أن آليته سليمة، سيدعي صحة ما يشاء من معتقدات. وأقول هذه حيدة عن الموضوع وإلزامي بمذهب الداخلانيين. فإنه في الحقيقة، لا يهمني ما سيعتقده العبد بل ما يهم هو صحة الاعتقاد؛ وكوني أعتقد بوجود الله العليم الحكيم فإن المعتقد بحد ذاته يستمد صحته من الله واعتقادي به كذلك، فهو توفيق من الله.
وكونك تعتقد به أو لا، لا يؤثر على صحته من خطئه. بل تصبح المسألة تبرير شخصي لا أكثر وهذه نسبية، وهذا ما لا يهمني وخارج مذهبي وإلزامي بمذهب لا أتبناه، حيث تعتبر أن صحة اعتقاد الشيء راجع لصحة تبريري به بالأدلة الفلسفية. ووصفي لكيفية عمل الفطرة ليس تبريرا على صحة الإعتقاد بل توصيف لطريقة عمل البشر في تحصيل المعرفة بناء على ما ورد من نصوص من الوحي. فاعتقد ما شئت، مطلبي ليس بيان خطأ تبريرك أو لماذا لست مبررا فيما تعتقد.
التأسيسية الديكارتية ونظرية المعرفة الداخلانية internalism Laurence Bonjour.
الإطار المعرفي الديكارتي:
وفقًا للتأسيسية الديكارتية، لدينا وصولٌ مباشرٌ ومعصوم إلى محتويات عقولنا، بينما يكون وصولنا إلى العالم الخارجي غير مباشرٍ وقبل للشك (قابلًا للمراجعة). وهذا يؤدي إلى بنية هرمية للمعرفة: تُشكِّل معرفتنا الأكيدة بأفكارنا الأساس الذي تُبنى عليه جميع المعارف الأخرى – وخاصةً معرفة العالم الخارجي. ووفقًا لهذا الرأي، تُبنى المعرفة من الداخل إلى الخارج، بدءًا من العقل وانتهاءً بالواقع. هذه هي المثالية الموضوعية.
نظرية بونجور للتماسك ومقارناتها الديكارتية:
على الرغم من أن بونجور يؤمن بالتماسكية، إلا أن بنيته المعرفية لا تزال تُشبه النموذج الديكارتي التأسيسي. لا يزال بونجور يفترض وجود مجموعة أساسية من المعتقدات – وتحديدًا، معتقدات الفرد حول معتقداته meta – تُشكّل أساسًا لمزيد من المعرفة. ومع ذلك، يرفض بونجور الفرضية الديكارتية القائلة بأن لدينا وصولًا معصوما إلى حالاتنا العقلية. إذا لم نكن متأكدين حتى من أفكارنا، فإن الأساس المفترض للمعتقدات الداخلية يفقد مكانته المتميزة. بدون هذا الأساس، لا يوجد سبب واضح لإعطاء الأولوية للحالات العقلية الداخلية على العالم الخارجي في مناقشات المعرفة.
انهيار التمييز الداخلي/الخارجي:
بمجرد التخلي عن افتراض العصمة، ينهار التباين المعرفي بين الحالات العقلية الداخلية والعالم الخارجي. هذا يعني أن وصولنا إلى أفكارنا لا يختلف جوهريًا عن وصولنا إلى العالم الخارجي فنحن نتمتع بوصول جيد إلى كليهما، وإن كان غير كامل. إذا كان هذا صحيحًا، فلا يوجد سبب معرفي لتفضيل الاستبطان على الملاحظة الخارجية. يصبح دافع الداخلانية – أي فكرة أن التبرير يعتمد فقط على عوامل في متناول الذات – غير مقبول.
على الرغم من انهيار التمييز بين الداخلانية والخارجانية، لا تزال الداخلانية مقبولة في الأوساط العلمية. والسبب في ذلك، هو أن رفض العصمة يجعل التبرير مسألة خارجية. إذا أنكر المرء وصولنا الكامل إلى حالاتنا العقلية، فإن التبرير يمكن أن يختلف عن معتقدات الشخص. بعبارة أخرى، قد تكون هناك فجوة بين ما ندركه على أنه اعتقاد مبرر وبين ما هو مبرر بالفعل، على غرار الطريقة التي قد تكون بها تصوراتنا للعالم الخارجي خاطئة في بعض الأحيان.
يُثير هذا مشكلةً جديدة: قد يكون المرء مُبررًا في اعتقادٍ ما وهو يعتقد خطأً أنه ليس كذلك، أو على العكس، قد يكون غير مُبرر وهو يعتقد خطأً أنه مُبرر. يُؤدي هذا الفشل في التوافق بين الاعتقاد والحقيقة إلى فجوة معرفية، تُشبه الفجوة بين المظهر والواقع التي يدعيها المشككون.
وبالتالي إن الداخلانية لا تُبنى على أسس سليمة إلا إذا قبل المرء الفرضية الديكارتية القائلة بإمكانية الوصول إلى أفكاره الخاصة التي تكون معصومة من الخطأ. ولأن هذه الفرضية خاطئة، فينبغي رفض الداخلانية.
اعتراض:
وقد يقع اعترض أحدهم على أن لازم مذهب الداخلانية هو الوصول إلى نسبية المعرفة، ولذلك سأفصل المسألة بشكل أعمق.
بدايةً، لا علاقة لهذا النقاش بالتفسير الفلسفي لمعنى “النسبية” في الإلزام، سواء كانت نسبية بروتاغوراس أو أي شكل آخر من النسبية.
المسألة تتعلق بمذهب الداخلانية وما فيه من معضلات. فعندما تشترط وجوب النظر لتبرير صحة أي معتقد تؤمن به، فإنك بالضرورة لن تتمكن من الوصول إلى الحقيقة، وستقع في النسبية.
تدّعي الداخلانية أن أي ادعاء لكي يصبح معرفة، أي ليصح اعتقادك به، يجب أن يكون مبرهنًا. بناءً على ذلك، تصبح التبريرات نسبية، حيث إن طريقة كل شخص في تحصيل المعرفة تعتمد على قدراته العقلية، ومعارفه السابقة التي يستحضرها عند وقوع الظاهرة أمامه، كما تعتمد على مدى قدرته على ربط المسائل الحديثة بمعارفه السابقة، واستنباط تفسير جديد، والحكم على المسألة المستجدة.
لكن حينما تشترط وجوب النظر في كل مسألة تعتقد بها، وتوجب تبيين هذا المعتقد للطرف الآخر ليحكم على صحته، فإن مجرد اعتقادك بصحة شيء لا يعني أنه صحيح في الواقع، حتى لو كنت تمتلك تبريرات له. وبما أنك أوجبت النظر، فإن على المخالف أيضًا أن ينظر في تبريراتك ويقيّمها، مما يؤدي إلى الوقوع في دائرة مفرغة. فعندما ينتهي من تقييمها، يصبح دورك أن تُقيِّم تبريراته، وهكذا تستمر هذه السلسلة بلا نهاية. وهذه هي طبيعة الفلسفة الداخلانية؛ فلا أنت تستطيع الخروج من هذه التبريرات المتسلسلة، ولا خصمك، لأن كلًا منكما يلتزم بمعيار الداخلانية.
في النهاية، لا يوجد شيء يمكن اللجوء إليه لتبرير الاعتقاد سوى اعتقاد المرء نفسه، مما يعني أن المعتقدات تصبح ذاتية، أي نسبية، ولا يمكن اعتبارها صحيحة موضوعيًا، حتى لو اتفق عليها جميع البشر. فكل فرد يعتمد على معتقداته الخاصة لتبرير مسألة معينة، وهذا يجعل المذهب الداخلاني مثاليًا بحتًا، منفصلًا عن الواقع. فالتبرير هنا لا يثبت صحة المعتقد، بل يوضح فقط كيف توصّل الشخص إليه. وبالتالي، فإن كل معتقد سيكون دائمًا مبررًا وفقًا لهذا المنهج، وإلا اعتُبر الشخص مجنونًا. ولكن كم مرة بدّلت معتقدك؟ لا حصر لها. ولو التزمنا بالقاعدة الداخلانية، لكانت جميع المعتقدات صحيحة ومبررة، إذ كما أنك اعتقدت بمسألة ثم تراجعت عنها، فإن غيرك قد يؤمن الآن بما كنت تؤمن به سابقًا، وكلاكما لديه تبريراته الشخصية، التي ستظل تُراجع إلى ما لا نهاية.
بل إن الداخلاني ذاته مُلزم بمراجعة كل معتقد يؤمن بأنه مبرر، كلما حصل على مدخلات وآراء جديدة.
وفقًا للداخلانية، لا يجوز للمرء أن يعتقد بصحة قضية ما إلا إذا كان مبررًا ومقتنعًا بتبريراتها. لكن هذا يؤدي إلى النسبية، إذ كيف يمكن للشخص أن يبرر قناعاته نفسها؟ مجرد ربط المسائل لتبريرها لا يُعدّ برهانًا وفق المذهب الداخلاني، بل يجب تقديم تبرير لكل خطوة، أي لماذا رُبطت (أ) بـ(ب)، ولماذا (أ) بـ(ج)؟ ما لا يدركه الداخلاني هو أن منظومته المعرفية بأكملها، بما يعلمه وما لا يعلمه، تلعب دورًا في تشكيل هذا الربط، مما يجعل المسألة نسبية بطبيعتها، إذ يستحيل تقديم دليل نهائي على أي مسألة وفق الداخلانية. وبالتالي، لا يمكن الخروج من هذه الحلقة إلا إذا افترض الشخص أنه معصوم في إدراكه، وقادر على التيقن التام من صحة روابطه المنطقية، وإلا فسيظل عالقًا في سلسلة لا نهائية من البرهنة. وعليه، فإن الداخلاني لا يستطيع إثبات موثوقية آلية برهنته إلا من خلال مقدمات يعتبرها صحيحة مسبقًا، وهو ما يهدم مذهبه من أساسه.
الداخلاني يرى أنه لكي يكون اعتقاد ما مبررًا، لا بد أن يكون الشخص على علم بتلك الحقيقة، ومبررًا في الإيمان بها. لكن هنا نطرح عليه سؤالًا: هل هو نفسه مبرر في علمه بهذه الحقيقة التي استخدمها لتبرير معتقده؟ هذا يؤدي بالضرورة إلى النسبية، لعدم وجود معيار معرفي مطلق يخرجه من هذا التسلسل اللانهائي.
أشرت في مقالي إلى أن البعض يحاول تجاوز هذه الإشكالية عبر الإيمان بالمعارف القبلية، لكن هذه مسألة خارجة عن الداخلانية ذاتها، وليست حلًا لمشكلتها الجوهرية كما تم تبيينه في مقال “في الضرورات العقلية وعلاقتها بالقبلية والبعدية“