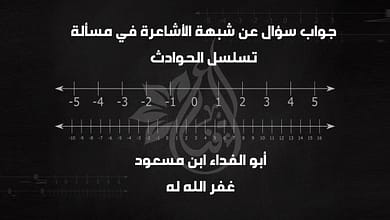الحمدُ للهِ الحكيمِ في أمرِه ونهيِه، البالغِ في تشريعِه غاية الهداية، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبِه وسلّم.
أمّا بعد؛ إن مما يخفى دركه على كثيرٍ من العامة، وتَقْصُر عنه أفهامُ من لا نظرَ له في مقاصد الشريعة وأسرارها: أن الشارع الحكيم لم يَقْصِد بتشريعه مجرّدَ كفِّ الجوارح عن الآثام الظاهرة، ولا حَجْزَ اللسان عن فُحش المقال فحسب، بل جاوز ذلك إلى ما هو ألطفُ مسلكًا، وأدقُّ مأخذًا، وهو صيانةُ قلب المسلم عن الأذى، وحفظُه من التعلّقات الفاسدة، كما صان اللسانَ عن الزلل، والجوارحَ عن العدوان. فالقلبُ هو الملك، وسائرُ الأعضاء له أتباعٌ وخدم، وإذا فسد الأصلُ لم يُغنِ صلاحُ الفرع شيئًا.
وهذا مقال قصدتُ بها بيانَ بعضِ مقاصدِ التحريم التي تخفى عللُها، والكشفَ عمّا أُريدَ بها من صيانةِ التوحيد، رجاءَ أن يتبيّن للناظر وجهُ الحكمة، ويزدادَ المؤمنُ بصيرةً بدينِه، واللهُ الموفّقُ والهادي إلى سواء السبيل.
فليُعلم أولا أن المحرَّمات في الشريعة ليست على رتبةٍ واحدة، بل منها ما هو محرَّمٌ لذاته ومقصودٌ بالمنع عينُه، ومنها ما هو محرَّمٌ لغيره، إذ جُعل ذريعةً إلى فسادٍ أعظم، أو وسيلةً إلى ذنبٍ من ذنوب الجوارح أو القلوب. فكم من فعلٍ في ظاهره لعبٌ ولهو، أو تسليةٌ وتنفيس، وفي باطنه استجرارٌ للهوى، وإثارةٌ للشهوة، وربطٌ للقلب بما يُضعف سلطان الإيمان ويُوهي عرى التوحيد.
وإذا تأمّل العاقل مقاصد الشارع الكلية، عَلِم أن أعظمها وأجلَّها عبادةُ الرب سبحانه، عبادةً خالصةً لا يشوبها شِركٌ خفي، ولا يداخلها مزاحمٌ في القلب، وهذه العبادة لا تتم إلا بكمال المحبة، بل بأعظم الحب للباري جلّ وعلا، حبًّا يستولي على شغاف القلب، ويملأ سويداءه، حتى يخلو العبدُ بربه، فلا يرى في باطنه محبوبًا سواه.
غير أنّ القلب لا يستتمّ له الخلوصُ لربّه، ولا يصفو له الإقبالُ، حتى تُنْفَى عنه علائقُ الأضداد، وتُقطع منه عُرى المنافسات؛ إذ القلبُ وعاءٌ إذا امتلأ بشيءٍ ضاق عن غيره، بل هو شديدُ المزاحمة: إذا نزل فيه محبوبٌ نازع غيرَه، وإذا استولى تعلّقٌ أزاح ما يقابله أو أضعفه. والقلب إنما سُمِّي قلبًا لسرعة تقلُّبه، فلا يزال بين داعٍ يجرّه إلى علوّ، وداعٍ يَهْوي به إلى سُفْل؛ ومن هنا كانت الشريعة تبتدئ في كثير من مسالكها بتخليته قبل تحليته، وبنفي الشواغل قبل إثبات المقاصد.
قال سبحانه: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾، قال الإمام ابن القيم (ت ٧٥١ هـ) في روضة المحبين ونزهة المشتاقين – ط عطاءات العلم (ص٤٠٣-٤٠٤):
«فأنت تجد تحت هذا اللفظ: أن القلب ليس له إلَّا وجهةٌ واحدةٌ، إذا مال بها إلى جهة؛ لم يملْ بها إلى غيرها، وليس للعبد قلبان، يطيع الله، ويتَّبع أمره، ويتوكَّل عليه بأحدهما، والآخرُ لغيره، بل ليس له إلا قلبٌ واحدٌ، فإن لم يفرد بالتوكل، والمحبة، والتقوى ربَّه، وإلَّا انصرف ذلك إلى غيره».
ومحبة الأضداد ليست مقصورةً على عبادة صنمٍ يُنصب، أو وثنٍ يُقصد، بل قد تكون في صورة معن يداخل النفس من حيث لا تشعر: فإذا علّق القلبُ محبته بما لا يستحقها —من خيالٍ مُزيَّن، أو لذّةٍ موهومة— صارت تلك العلائق حُجُبًا بينه وبين مولاه: فهي قيودٌ تُقيد الإرادة، وأغلالٌ تُغلّ القلب، وتُعميه عن مقصوده الأعلى، فيغدو يطلب الراحةَ حيث لا راحة، ويستزيد من الشبع حيث لا شبع، ويستروح من السراب حتى يظمأ.
وليس المرادُ بالأوهام والخيالات مجردَ تصوّرٍ عابر يمرّ في النفس ثم ينقضي، بل المراد ما يصير “معنىً مقيمًا” في القلب، يتردد ترداد الأنفاس، حتى يُنشئ للمحبوب صورةً أعظم من حقيقته، ويكسوه من كمالاتٍ ليست له، ثم يطالبه بما لا يطيق، فيورثه ذلك قلقًا وحِرمانًا، ويجعل العبد أسيرَ ما صنعه خياله بيده. فربّ متعلّقٍ بصورةٍ أو نغمةٍ أو هيئةٍ لو فُتِّش عنها في ميزان الحق لوجدها هباءً، لكنها في القلب تصير ثقلاً لا يُزاحم، وسلطانًا لا يُقاوَم، لأن القلب نُزِع من مقام العبودية لربّه، فأُلقي في رقّ الأوهام.
فكمال التوحيد أن لا يبقى في القلب محبوبٌ مزاحم، ولا مرادٌ معارض، وإن بقيت المحبةُ الطبيعية لما أذن الله به من أهلٍ وولدٍ وصديقٍ ونعمة. غير أن الفرق بين محبةٍ طبيعيةٍ منضبطةٍ بالشرع، وبين محبةٍ مستعبِدةٍ مزاحِمةٍ للتوحيد، أن الأولى تابعةٌ لا متبوعة، وخادمةٌ لا مخدومة، تُحبّ لله وفي الله؛ فإذا تزاحمت المحابّ في القلب، يُقَدَّم حقّ الرب على كل حق، فلا تُرْفَع المخلوقات إلى مرتبةٍ تُحجَب بها الخالق. والثانية تتحول إلى معبود خفيٍّ يتصرف في القلب، فيغضب لأجله، ويرضى لأجله، ويقدم أمره على أمر الله وإن لم يتلفظ بذلك.
قال سبحانه: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾، ثم قال بعدها: ﴿قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران].
ومن أجل هذا المعنى جاء ابتلاءُ الخليل عليه السلام بالأمر بذبح ابنه، قال الإمام ابن القيم (ت ٧٥١ هـ):
«تأمَّل حكمة الربِّ تعالى في أمره إبراهيمَ خليلَه ﷺ بذبح ولده؛ لأنَّ الله اتخذه خليلًا، والخُلَّة منزلةٌ تقتضي إفراد الخليل بالمحبة، وأن لا يكون له فيها منازعٌ أصلًا، بل تخلَّلت محبتُه جميعَ أجزاء القلب والرُّوح فلم يَبْقَ فيها موضعٌ خالٍ من حبِّه، فضلًا عن أن يكون محلًّا لمحبة غيره».
فإن الابن قد يصير عند بعض القلوب معبودًا من حيث لا يشعرون، أي: يُطاع لأجله، ويُؤثَر على أمر الله، ويُرضى بسخط الربّ ليُرضى، ويُخاف فقدُه أكثر من خوف فقد رضوان الله. فجيء بالخليل إلى مفترق طريقين، ليَظهر أين يثبت القلب إذا ازدحمت الدواعي: أإلى أمر الله أم إلى هوى النفس؟ فتمّ له مقام التوحيد، وبان أن محبوبه الأعظم لا يزاحمه محبوبٌ آخر.
فإذا تقرر هذا الأصل، انكشف لك وجهُ طائفةٍ من المحرّمات التي قد يستبطئ بعض الناس حكمتها، مما جاءت الشريعةُ بسدّه أو تحريمه من الوسائل التي تُحدث في القلب تأليهًا لغير الله من حيث لا يشعر صاحبها. فإن المعازف ليست مجرد أصواتٍ موزونة، بل هي مفاتيحُ للوجدان، تُهيّج كوامن النفس، وتستخرج دفائن الشهوة والحزن والحنين، حتى تُنشئ في القلب ألفةً واعتيادًا، ثم يتحول الاعتياد إلى حاجة، والحاجة إلى قهر، والقهر إلى عبودية: يضيق صدره إن فقدها، ويستوحش قلبه إن انقطع عنها، ويطلب بها تسكينًا لا يجده في ذكر الرب، وسلوةً لا يجدها في مناجاته.
فإن الشريعة لا تنظر إلى اللحظة العابرة وحدها، ولا إلى اللذة في حدّها الأدنى، بل تنظر إلى المآلات وإلى ما تصير إليه الأحوال إذا تتابعت الأسباب، واستحكمت العادات، وغلبت الألفة. وكثيرٌ من هذه الأشياء لا يقف عند حدّ “متعةٍ عارضة” كما يتوهّم صاحبها، بل يتدرّج بصاحبه درجًا حتى يملِك القلب: يبدأ هَمسًا ثم يصير حديثًا، ثم يصير خاطرًا غالبًا، ثم يصير همًّا مقيمًا، ثم يصير شغلًا يقطع عن الله، ثم يصير ضرورةً لا يُرى العيش إلا بها.
ولهذا كانت بعض المحرّمات من باب الوسائل لا من باب المقاصد، فإنها قد لا تكون هي الجناية الكبرى بذاتها، ولكنها بريد الجناية، وسُلّم الصعود إلى ما وراءها. والشارع أحكم من أن ينهى عن الغاية ويترك الذريعة، أو يقطع الثمرة ويُبقي أصل الشجرة.
فالمعازف لا تُحدِث في القلب مجرّد لذّةٍ سمعيّةٍ تنقضي بانقضاء الصوت، بل تُنشئ تعلّقًا معنويًّا، إذ تُحرّك الخيال، وتُليِّن الإرادة، وتفتح منافذ الشعور لما لا يُضبط، حتى يأنس القلب بها أنسَ المملوك بسيّده، لا أنسَ المستعمل بآلته. فتصير الأصواتُ موطنَ استدعاءٍ للشهوة، ومحلًّا لإثارة المعاني، ويغدو السماعُ نفسه مقصودًا لذاته، فيقع الاسترقاق من حيث لا يشعر صاحبه، ويُستلب من قلبه قدرٌ من حريته وهو يظنّ أنه إنما يتلذّذ.
وكذلك التصاوير إذا صارت محلّ تكثير نظرٍ، ومجالَ تردّدٍ للنفس، لم تقف عند حدّ الإبصار العابر، بل تنسج بين القلب وبين المرئيّ علاقةً خفيّة، أساسها التكرار، وغذاؤها الخيال، ونهايتها التعلّق. فإن النظر بابُ القلب، وما أُديم الدخول منه استوطن الباطن؛ فلا يزال الرباط يشتدّ شيئًا فشيئًا حتى يصير الصورةَ حاضرةً في الذهن وإن غابت عن العين، فيتحوّل الإعجاب إلى ألفة، والألفة إلى محبة، والمحبة إلى استيلاء، فيغدو القلب أسيرَ ما كان في الأصل مجرّد صورة.
وكذلك عشق النساء إذا استولي على القصد، أضعف سلطان العقل، وجعل المحبوب محور الفكر، ومناط الرضا والسخط، حتى تُقاس الأشياء به، وتُوزن الأمور به. فإذا بلغ هذا الحدّ صرف القلب عن مطلوبه الأعلى، حتى يَغدو العاشق يطيع هواه حيث كان ينبغي أن يطيع ربّه، ويقدّم محبوبه حيث كان ينبغي أن يُقدَّم مولاه.
وسائر ما يُورث الإدمان داخلٌ في هذا المعنى: فإن الإدمان انتقالٌ من الفعل الاختياري إلى الفعل الاضطراري، ومن اللذة التابعة إلى اللذة المتبوعة؛ يبدأ الأمر لذّةً تُطلب على جهة التبع، ثم لا تلبث أن تصير غايةً تُطلب على جهة القصد، ثم تُصبح ضرورةً موهومة تُطلَب على جهة القهر. وعلامة ذلك أن يُصبح التركُ ألمًا، لا مجرّد فوات لذّة؛ وأن يَستوحش العبد من مفارقته وحشةَ من تُنزَع منه روحه، لأن قلبه سلّمه زمامَه، فصار يَسوقه سوقَ المملوك، ويُديره كيف شاء. وحينئذٍ تُفهم حكمةُ الشريعة في سدّ الأبواب التي تُفضي إلى هذا الاستعباد الخفي: فإنها لا تُحارب اللذة المباحة لذاتها، ولكنها تمنع ما يَفسد على القلب حريته، ويُنازع التوحيد كمالَه، ويُقيم في الباطن محبوبًا منافسًا للمحبوب الأعلى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم – ط دار عالم الكتب (١/٥٤٣):
«والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه -ويروى مرفوعا -: (إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن).
ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته؛ استغنى عن طعام آخر، حتى لا يأكله إن أكل منه إلا بكراهة وتجشُّم، وربما ضره أكله، أو لم ينتفع به، ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه، فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته، قلَّت رغبته في المشروع وانتفاعه به، بقدر ما اعتاض من غيره، بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع، فإنه تعظم محبته له ومنفعته به، ويتم دينه ويكمل إسلامه.
ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه؛ تنقص رغبته في سماع القرآن، حتى ربما كرهه، ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاهد ونحوها؛ لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة، ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم، لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع، ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم؛ لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام، ونظير هذا كثير».
وما من إنسانٍ إلا وله مطلوبٌ أعلى يتوجّه إليه قلبه، ويَصْرِف إليه همَّه، إذ النفوس مفطورةٌ على القصد، وهذا هو حقيقة المعبود. و المطلوب الأعلى لا يَصِحّ أن يكون إلا خالقَك الذي أفاض عليك النعم، ودفع عنك النقم، ولا كمالَ يُطلب إلا وهو متّصف به على وجه التمام؛ ولهذا قال سبحانه: ﴿وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾.
وكل ما سواه فغايةٌ خسيسة؛ لأنه ناقصٌ في نفسه، زائلٌ في وجوده، عاجزٌ عن إسعاد من تعلّق به أو إغنائه عمّا سواه. وإنما الغاية الشريفة والمطلوب الأعلى هو الله وحده: معرفته، ومحبته، ورضاه؛ فمن جعله مقصوده بلغ الكمال، ومن جعل غيره غايته خاب وإن ظفر، وشقي وإن نال.
وهذا بابٌ واسع، وفيه من دقائق الحكمة وأسرار التشريع ما يطول بسطه، فمن رام كمال التوحيد، فليطهّر قلبه قبل جوارحه، وليقطع علائقه قبل ظاهره، فإن القلب هو موضع نظر الرب، ومحلّ سرّه، ومزرعةُ عبادته، فإن صَلَح صلَح الجسد كلّه، وإن فسد فسد الجسد كله.
وخِتامًا؛ فهذا ما جادت به القريحة في كشفِ طرفٍ من مقاصدِ التشريع في بعض المحرّمات، وأصل ذلك أن الشريعة إنما جاءت لحفظِ التوحيد، وصيانةِ القلوب من علائق تستعبدُها من حيث لا تشعر. فمن عقل هذا الأصل، استبانت له الحكمةُ، وسَلِم من الشبهة، وأخذ الدينَ من بابِه. ونسألُ اللهَ أن يرزقنا قلوبًا سليمةً، وهممًا إليه متوجِّهة، إنّه نعم المولى ونعم النصير.