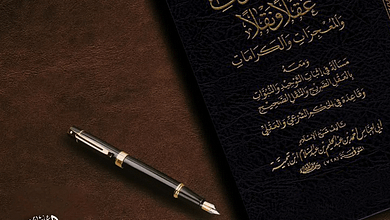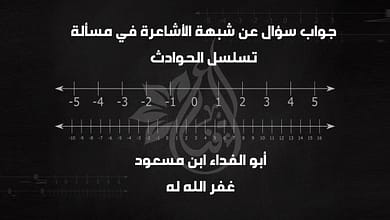الحمد لله الذي أبدع الخلق بحكمة بالغة، وأودع العقول دلائل معرفته، وأقام على عباده حججه، حتى لا تبقى لهم عليه حجة بعد بعثة رسله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادةً تُنجي قائلها يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المؤيد بالآيات الظاهرات، والمُعزّز بالحجج الباهرات.
أما بعد: فهذا مقال في تقرير مسلكٍ مختارٍ في باب النبوات، فيه تقرير النبوة العامة تفريعا على التسليم بكمال الإله فقط، وقد تقدم تقدم ذكر وجوه في إلزام المخالفين فيه في مقال مستقل.
فصل في وجوب وجود غاية من فعل الباري
اعلم أن الفاعل المختار لا يخلو: إما أن يفعل لغاية مقصودة مطلوبة له، وإما أن يفعل لا غاية. والثاني باطل، لأن الفعل بلا غاية سفهٌ وعبث، والسفه نقص، والنقص ممتنع في حق الباري كما قد قامت عليه الأدلة في غير هذا الموضع.
ويقال لكم: لو جاز أن يقع الفعل بلا غاية، لجاز ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح، وذلك باطل بصريح العقل، إذ اختصاص أحد المتماثلين بلا مخصص ترجيح بلا مرجح، وهو ممتنع.
فثبت أن كل فعل يقوم بذات الفاعل الكامل، فلا بد أن يكون لغاية تليق بكماله، إذ لو خلا عن ذلك لزم النقص المنافي للكمال.
فوجب أن يكون خلقه وأمره لغاية مقصودة له سبحانه، فثبت أن خلقه سبحانه للبشر لغاية مطلوبة له، كما قال تعالى: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ [المؤمنون 115]، وقال: ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين﴾ [الدخان 38]
وإذا ثبت أن الفاعل الكامل لا يفعل إلا لغاية، وجب أن تكون تلك الغاية لائقة بكماله؛ فلما قامت البراهين العقلية والفطرة الصريحة أن الباري لا يكون إلا في منتهى الكمال، عُلم أن غاياته من أفعاله حسنة في نفس الأمر ضرورة؛ كما قال سبحانه: ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق﴾ [الحجر: 85].
فصل في تعيين غاية الباري من خلق جنس البشر
لما ثبت أن الخلق لا بد له من غاية محمودة تناسب كمال الخالق، وجب أن تكون الغاية من خلق جنس الإنسان أكمل الغايات التي تليق بطبيعته واستعداده؛ أي أكمل ما هو محل قابل له. لأن إيثار الأدنى مع إمكان الأعلى، نقص في الحكمة.
فإن قيل: لو صح قولك لم يوجد في الدنيا معاصٍ، ولا شرور وليست هي أكمل ما البشر محل قابل له.
أجيب: هذا مقام تعيين الإرادة الشرعية المحبوبة للباري، والاعتراض على المشيئة الكونية، وليس كل مُراد كونا مُراد شرعا، فإن الشرور مرادة كونا مبغوضة شرعا، وإنما هي مرادة لغيرها لكونها شرطا في خير محبوب مراد شرعا، كما يشاء المرض لتظهر نعمة الشفاء، ويخلق المعصية لتظهر عبودية التوبة والانكسار.
واعلم أن الغايات تتفاضل في الشرف بحسب تفاضل المتعلقات بها، فإنه معلوم بصريح العقل أن الفعل كلما تعلق بأمر أشرف وأكمل، كان ذلك الفعل أشرف وأكمل. لأن الفعل يشرف بشرف متعلَّقه، ويكمل بكماله، كما يشرف العلم بشرف المعلوم، والمحبة بشرف المحبوب، والطاعة بشرف المطاع.
وإذا كان الأمر كذلك، وقد عُلم أن أكمل المتعلقات الممكنة على الإطلاق هو الله سبحانه، وجب أن يكون التعلق به علماً ومحبة وتعظيماً وطاعة، هو أكمل ما تتعلق به قوى العبد من علم ومحبة وإرادة وعمل.
وحينئذ نقول: إن أعظم غاية للإنسان أن يتعلق قلبه بربه تعالى، بأن يعرفه حق معرفته، ويصفه بما وصف به نفسه من صفات الكمال، وأن يحبه أعظم المحبة، ويعظمه غاية التعظيم، ويطيعه بأتم الطاعة، ويخضع له أكمل الخضوع. وهذا هو هو تعريف العبادة، فإنها متضمنة للعلم بالله، وثم طاعته المستلزمة لحبه وتعظيمه والخضوع له جل ثناؤه. ومن ثم فيثبت أن غاية الباري من خلق البشر هي معرفته وعبادته سبحانه، كما جاء به محكم التنزيل: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾ [محمد: 19]، وقوله جل شأنه: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات 56].
وإذا ثبت ما قررناه، لزم من وجود الشرور والآفات، وحرية اختيار العباد بين الخير والشر = أن تكون الدنيا دار ابتلاء وامتحان.
فإن قال قائل: لو كانت هذه الغاية مقصودة، لما تخلف حصولها عن أهل الفترات أو بعض الكافرين.
فيقال: ليس من شرط الغايات أن يتحقق أثرها في كل فرد؛ بل قد تتعلق الغاية بشرط، فإذا تخلف الشرط أو قام المانع، تخلف أثرها، ولم يكن ذلك نقضًا للحكمة، ولا إبطالًا للمراد.
ألا ترى أنه لا مماراة في أن غاية الباري من إنزال المطر ما فيه من مصلحة إحياء الأرض بعد موتها، وإنبات الزرع، وإخراج الثمرات؛ وتخلف نزوله عن بعض الأراضي لا ينافي كون ذلك هو المقصود من المطر ابتداء. فكذلك العبادة، قد تتخلف عن بعض الخلق لفقد شرطها أو لقيام مانع يحول دونها، ولا يكون في ذلك قدحا في في تمام المقصود.
ولو لا وجود الكفار لما ظهرت أصناف من الحكم والمصالح، وهاك نصا لابن القيم يعدد فيه الحكم من خلق إبليس، أنقله بطوله لنفاسته:
حصول العبوديَّة المتنوِّعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، ولكان الحاصل بعضَها لا كلَّها. فإنَّ عبوديَّة الجهاد من أحبِّ أنواع العبوديَّة إليه سبحانه. ولو كان الناس كلُّهم مؤمنين لتعطَّلت هذه العبوديَّة وتوابعُها مِن الموالاة فيه سبحانه والمعاداة فيه، والحبِّ فيه والبغض فيه، وبذل النفس له في محاربة عدوِّه، وعبوديَّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبوديَّة الصبر ومخالفة الهوى، وإيثار محابِّ الربِّ على محابِّ النفس.
ومنها: عبوديَّة التوبة والرُّجوع إليه واستغفاره، فإنَّه سبحانه يحبُّ التوَّابين ويحبُّ توبتهم، فلو عطِّلت الأسباب التي يُتاب منها لتعطَّلت عبوديَّة التوبة والاستغفار. ومنها: عبوديَّة مخالفة عدوِّه، ومراغمته في الله، وإغاظته فيه. وهي من أحبِّ أنواع العبوديَّة إليه، فإنَّه سبحانه يحبُّ من وليِّه أن يغيظ عدوَّه
ويراغمَه ويسوءَه. وهذه عبوديَّة لا يتفطَّن لها إلا الأكياس.
ومنها: أن يتعبَّد له بالاستعاذة من عدوِّه، وسؤاله أن يجيره منه، ويعصمه من كيده وأذاه.
ومنها: أنَّ عبيده يشتدُّ خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حلَّ بعدوِّه بمخالفته وسقوطه من المرتبة الملكيَّة إلى المرتبة الشيطانيَّة، فلا يخلدون إلى غرور الأمن بعد ذلك.
ومنها: أنَّهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته، الذي حصولُه مشروطٌ بالمعاداة والمخالفة، فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرتَّبةٌ على مخالفته.
ومنها: أنَّ نفس اتِّخاذه عدوًّا من أكبر أنواع العبوديَّة وأجلِّها. قال تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} [فاطر: ٦]، فاتِّخاذه عدوًّا أنفع شيءٍ للعبد، وهو محبوبٌ للربِّ.
ومنها: أنَّ الطبيعة البشريَّة مشتملةٌ على الخير والشرِّ والطيِّب والخبيث، وذلك كامنٌ فيها كمون النار في الزِّناد، فخُلق الشيطان مستخرجًا ما في طبائع أهل الشرِّ من القوَّة إلى الفعل، وأُرسلت الرُّسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوَّة إلى الفعل؛ فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها ليترتَّب عليه آثاره، وما في قوى أولئك من الشرِّ ليترتَّب عليه آثاره، وتظهر حكمته في الفريقين، وينفذ حكمه فيهما، ويظهر ما كان معلومًا له مطابقًا لعلمه السابق.
وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكتُه حين قالوا: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٣٠]، فظنَّت الملائكة أنَّ وجود من يسبِّح بحمده ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه، فأجابهم سبحانه بأنَّه يعلم من الحكم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه الملائكة.
ومنها: أنَّ ظهور كثيرٍ من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر والشر من النُّفوس الكافرة الظالمة، كآية الطُّوفان، وآية الرِّيح، وآية إهلاك ثمودَ وقومِ لوطٍ، وآية انقلاب النار على إبراهيم بردًا وسلامًا، والآيات التي أجراها الله على يد موسى، وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر كلِّ آيةٍ منها: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} [الشعراء]. فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين لَما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يُتحدَّث بها جيلًا بعد جيلٍ إلى الأبد.ومنها: أنَّ خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضًا، ويكسر بعضها بعضًا= هو من شأن كمال الرُّبوبيَّة والقدرة النافذة، والحكمة التامَّة، والملك الكامل. وإن كان شأن الرُّبوبيَّة كاملًا في نفسه ولو لم تُخلَق هذه الأسباب، لكنَّ خلقها من لوازم كماله وملكه وقدرته وحكمته، فظهور تأثيرها وأحكامها في عالم الشهادة تحقيقٌ لذلك الكمال وموجَبٌ مِن موجباته، فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصِّفات من آثار الكمال الإلهيِّ المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته.
وبالجملة: فالعبوديَّة والآيات والعجائب التي ترتَّبت على خلق ما لا يحبُّه ولا يرضاه وتقديره ومشيئته= أحبُّ إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها.
فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟
فهذا سؤال باطل، إذ هو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرِّك، والتوبة بدون التائب.
ولو شاء سبحانه لجعلهم أمةً واحدةً على الطاعة، ولكن حكمته البالغة اقتضت أن يبتلي بعضهم ببعض، ويُظهر ما أودعه فيهم من قوى الخير والشر، ليميز الخبيث من الطيب، والصادق من الكاذب، والمصلح من المفسد. قال تعالى: ﴿هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور﴾ [الملك: 2]
فصل في تفريع النبوة العامة
فلما كان الثابت المقرر: أن عقول بني آدم قاصرة عاجزة عن الإحاطة التامة والإدراك الكامل بما به يتم العبادة لربهم عز وجل، ويكمل قيامهم بحق العبودية له سبحانه.
فإن العقول البشرية عاجزة مطلقا عن الوصول إلى العلم اليقيني الجازم الذي لا يعتريه شك ولا ريب، بمواطن رضا الرب جل جلاله ومواقع سخطه وغضبه. وكذلك قصورها عن معرفة كيفية عبادته سبحانه على الوجه الذي يرضيه ويوافق مشيئته، وما يتصل بذلك من تفاصيل الشرائع ودقائق الأحكام وتفاريعها.
ولما كانت الغاية العظمى والحكمة البالغة التي لأجلها خلق الله تعالى الإنسان وأوجده في هذه الدار الفانية – كما تقدم تقريره وإثباته بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة – إنما هي: تكليف بني آدم بعبادته جل شأنه على النحو الذي ارتضاه هو سبحانه وتعالى.
فقد لزم لزوما عقليا ضروريا أن يبعث الله تعالى رسلا من عنده إلى خلقه، يكملون هذا النقص الحاصل في إدراكاتهم، ويتمون هذا القصور الواقع في عقولهم، ويبينون لهم الصراط المستقيم الذي يرضي المولى جل وعلا.
إذ لو لم يكن ذلك، للزم من عدم بعث الرسل تخلف ما به تحصل غاية الإله الحكيم من خلق البشر – أي: حصول عبادته في الأرض على الوجه الذي أراده هو سبحانه وارتضاه – وهذا محال ممتنع في حق الحكيم العليم، لأن تخلف الغاية الواجبة نقص يتنزه عنه الكامل جل جلاله.
فثبت بهذا: أن بعث الأنبياء والمرسلين شرط لازم لحصول الغاية الواجبة التي خلق الإنسان لأجلها. وقد تقرر: أنه إذا وجب المشروط، وجب الشرط، لأن المشروط لا يتحقق وجوده بدون شرطه.
وقد نطق القرآن الكريم بتقرير هذه الحقيقة، إذ قال الله عز من قائل – رادا على الجاحدين المنكرين للرسالة والنبوة -: ﴿وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء﴾، فنزه سبحانه ذاته العلية عن هذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل الذي ظنه أولئك الضالون، وبين أن إنكار إرسال الرسل قدح في كمال حكمته جل شأنه.
ومن أجل ذلك كله، فقد وجب – وجوبا عقليا وشرعيا – أن يبعث الله تبارك وتعالى إلى عباده رسلا مصطفين أخيارا، يبينون لهم معالم الدين، ويوضحون لهم سبيل الوصول إلى هذه الغاية العليا، ويرشدونهم إلى الصراط الذي به ينالون رضوان ربهم ومرضاته في الدنيا والآخرة.