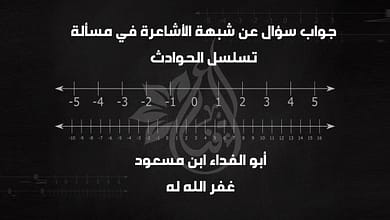مقدمة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمدُ للهِ الذي أرسلَ رسولَه بالهُدى ودينِ الحقِّ ليُظهرَهُ على الدِّينِ كُلِّه، وأقامَ على صدقِ أنبيائِه من البراهينِ والدَّلائلِ ما تَخضعُ له العقولُ ويَنقادُ له كُلُّ ذي لُبٍّ، وجعلَ في فِطَرِ عبادِه ما يَعرفون به الصادقَ من الكاذبِ، والحقَّ من الباطلِ، والنُّورَ من الظُّلمةِ. والصَّلاةُ والسَّلامُ على أشرفِ المرسلينَ، محمَّدٍ الذي جاءَ بالقرآنِ المُعجِزِ نورًا وهُدًى وبُرهانًا، وعلى آلِهِ وصحبِهِ الذين عَرَفوا صِدقَهُ فآمنوا بهِ واتَّبعوا النُّورَ الذي أُنزلَ معه.
أمَّا بعدُ: فإنَّ شيخَ الإسلامِ أبا العبَّاسِ أحمدَ بنَ عبدِ الحليمِ بنِ تيميَّةَ الحرَّانيَّ — رحمهُ اللهُ تعالى وأجزلَ مثوبتَهُ — قد أودعَ في شرحِهِ للعقيدةِ الأصبهانيَّةِ فصولًا جليلةً في تقريرِ دلائلِ النُّبوَّةِ وبيانِ الطُّرقِ التي يُعلَمُ بها صدقُ الأنبياءِ والمرسلينَ، فجاءَ كلامُهُ في ذلك بَحرًا زاخرًا، مُتدفِّقًا بالحُججِ العقليَّةِ والنَّقليَّةِ، مُتشعِّبَ المسالكِ، مُتنوِّعَ المآخِذِ، على عادتِهِ — رحمهُ اللهُ — في بَسطِ المسائلِ وتقليبِ أوجُهِ النَّظرِ فيها حتَّى يَستوفيَها من جميعِ جهاتِها.
ولمَّا كانَ هذا الموضعُ من أنفَسِ ما سَطَّرَهُ قلمُهُ في بابِ النُّبوَّاتِ، وكانَ حقيقًا بأن يُفرَدَ ويُقرَّبَ للأفهامِ ويُيَسَّرَ تناوُلُهُ — رأيتُ أن أُهذِّبَ هذه الفصولَ وأُرتِّبَها على أبوابِها، وأجعلَ لكلِّ مسلكٍ عنوانَهُ الذي يدلُّ عليه، ليسهُلَ على طالبِ العلمِ الوقوفُ على مُرادِ المصنِّفِ، والانتفاعُ بما أودعَهُ من كنوزِ الحِجاجِ والبيانِ.
وقد جعلتُ عملي في هذا التَّهذيبِ مقصورًا على ترتيبِ كلامِهِ وتقسيمِهِ إلى فصولٍ بحسبِ موضوعاتِهِ، من غيرِ تصرُّفٍ في ألفاظِهِ ولا تبديلٍ لعباراتِهِ، إذِ الكلامُ كلامُهُ والحُجَّةُ حُجَّتُهُ، وإنَّما لي فضلُ التَّبويبِ والتَّرتيبِ لا غيرُ.
واللهَ أسألُ النَّفعَ والقَبولَ، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وآلِهِ وصحبِهِ أجمعينَ.
فصل في طرق التمييز بين الصادق والكاذب
إنَّه إذا قال: إني رسول الله»؛ فهذا الكلام إما أن يكون صدقا، وإما أن يكون كذبا. وإن شئت قلت: هذا خبر: فإمَّا أن يكون مطابقا للمخبر، وإما أن يكون مخالفًا له؛ سواء كانت مخالفته له على وجه العمد أو الخطأ؛ إذ قد يظنُّ الرَّجُلُ في نفسه أو غيره: أنَّه رسول الله؛ غير مُتَعَمِّد للكذب، بل خطأ وضلالا؛ مثل كثير ممن يتمثل له الشيطان ويقول: «إنِّي ربُّك»، ويخاطبه بأشياء، وقد يقول له: أحللت لك ما حرمت على غيرك، وأنت عبدي ورسولي»، و«أنت أفضل أهل الأرض، وأمثال هذه الأكاذيب؛ فإنَّ مثل هذا قد وقع لكثير من الناس.
فإذا كان مُدَّعي «الرسالة» إذا لم يكن صادقًا فلا بُدَّ أن يكون كاذبًا عمدا أو ضلالا؛ فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما هو دون دعوى «النبوة»، فكيف بدعوى «النبوة»؟!
ومعلوم أنَّ مُدَّعي «الرسالة» إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم، وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم؛ ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للنَّبيِّ ﷺ – لما بلغهم الرِّسالة ودعاهم إلى الإسلام: «والله لا أقول لك كلمة واحدة: إن كنت صادقا فأنت أجل من أن أَردَّ عليك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك.
فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم، وما أحسن قول حسان: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بَدِيهَتُه تأتيك بالخبر
وما من أحد ادعى النُّبوَّة» من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، وما من أحد ادعى النُّبوَّة» من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز.
فإِنَّ الرَّسول لا بُدَّ أن يُخبر النَّاس بأمور، ويأمرهم بأمور، ولا بُدَّ أن يفعل أمورًا. والكَذَّابُ يظهر في نفس ما يأمر به وما يُخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصَّادقُ يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثيرة.
بل كل شخصين ادعيا أمرًا من الأمور: أحدهما صادق في دعواه، والآخر كاذب فلا بُدَّ وأن يبين صدقُ هذا وكذب هذا من وجوه كثيرة؛ إذ الصِّدقُ مستلزم للبر، والكَذِبُ مستلزم للفجور.
كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قال: «عَلَيْكُم بالصِّدقِ؛ فَإِنَّ الصِّدقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. وَإِيَّاكُم وَالكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللهِ كَذَّابًا».
ولهذا قال تعالى: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾. بَيَّنَ سبحانه أنَّه ليس بكاهنٍ تَنَزَّلُ عليه الشَّياطينُ، ولا شاعرٍ؛ حيث كانوا يقولون: «ساحرٌ» و«شاعرٌ»؛ فبيَّنَ أنَّ الشَّياطينَ إنَّما تَنَزَّلُ على الكاذبِ الفاجرِ، وأنَّهم يُلقُونَ إليهم السَّمعَ وأكثرُهم كاذبون.
فهؤلاء الكُهَّانُ ونحوُهم وإن كانوا يُخبِرون أحيانًا بشيءٍ من المُغَيَّباتِ ويكونُ صِدقًا؛ فمعهم من الكذبِ والفجورِ ما يُبَيِّنُ أنَّ الذي يُخبِرون به ليس عن مَلَكٍ، وليسوا بأنبياءَ؛ ولهذا لمَّا قال النَّبيُّ ﷺ لابن صَيَّادٍ: «قد خَبَأْتُ لك خَبِيئًا»، وقال: «هو الدُّخّ»؛ قال له النَّبيُّ ﷺ: «اخْسَأْ، فلن تَعْدُوَ قَدْرَكَ»؛ يعني: إنَّما أنت كاهنٌ. وقال للنَّبيِّ ﷺ: «يأتيني صادقٌ وكاذبٌ»، وقال: «أرى عرشًا على الماء»؛ وذلك هو عرشُ الشَّيطانِ، كما ثبتَ ذلك في الصَّحيح عن النَّبيِّ ﷺ.
وبيَّنَ الله تعالى أنَّ الشُّعراءَ يتَّبعُهم الغاوُون. و«الغاوي»: الذي يَتَّبِعُ هواه وشهوتَه، وإن كان ذلك مُضِرًّا له في العاقبة؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾. فهذه صفةُ الشُّعراءِ، كما أنَّ تلك صفةُ مَن تَنَزَّلُ عليه الشَّياطينُ.
فمن عرفَ الرَّسولَ وصدقَه ووفاءَه ومُطابقةَ قولِه لعملِه؛ عَلِمَ علمًا يقينيًّا أنَّه ليس بشاعرٍ ولا كاهنٍ. والنَّاسُ يُميِّزون بين الصَّادقِ والكاذبِ بأنواعٍ من الأدلَّةِ، حتَّى في المُدَّعين للصَّناعاتِ والمقالاتِ كالفِلاحةِ والنِّساجةِ والكتابةِ، وعلمِ النَّحوِ والطِّبِّ والفقهِ وغيرِ ذلك؛ فما من أحدٍ يدَّعي العلمَ بصناعةٍ أو مقالةٍ إلَّا والتَّفريقُ في ذلك بين الصَّادقِ والكاذبِ له وجوهٌ كثيرةٌ.
وكذلك مَن أظهرَ قصدًا وعملًا كمن يُظهِرُ الدِّيانةَ والأمانةَ والنَّصيحةَ والمحبَّةَ وأمثالَ ذلك من الأخلاقِ؛ فإنَّه لا بُدَّ أن يَتَبَيَّنَ صدقُه وكذبُه من وجوهٍ مُتعدِّدةٍ.
والنُّبوَّةُ مُشتملةٌ على علومٍ وأعمالٍ لا بُدَّ أن يتَّصفَ الرَّسولُ بها، وهي أشرفُ العلومِ وأشرفُ الأعمالِ؛ فكيف يشتبهُ الصَّادقُ فيها بالكاذبِ ولا يَتَبَيَّنُ صدقُ الصَّادقِ وكذبُ الكاذبِ من وجوهٍ كثيرةٍ؟!
فصل في المسلك النوعي: معرفة النبوة بمقارنة ما جاء به المدعي بجنس ما جاءت به الرسل
لا سيما والعالم لم يخل من نبي أو آثار نبي من لدن آدم إلى زماننا، وقد عُلم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلون، وما كانوا يَدْعُون إليه ويأمرون به، ولم تزل آثار المرسلين في الأرض، ولم يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل، ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل.
فلو قدر أنَّ رجلاً جاء في زمان إمكان بعث الرسل، وأمر بالشرك وعبادة الأوثان، وأباح الفواحش والظلم والكذب، ولم يأمر بعبادة الله ولا بالإيمان باليوم الآخر = هل كان مثل هذا يحتاج أن يُطالب با معجزة»، أو يُشك في كذبه؟!
ولو قدر أنه أتى بما يُظنُّ أنَّه «معجزة»؛ لعلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن والمحنة. ولهذا لما كان الدَّجَّالُ يَدَّعي الإلهية؛ لم يكن ما يأتي به دالا على صدقه؛ للعلم بأن دعواه ممتنعة في نفسها، وأنَّه كذَّابٌ.
وكذلك من نشأ في بني إسرائيل معروفًا بينهم بالصدق والبر والتقوى؛ بحيث قد خبر خبرة باطنة يُعلم منها تمام عقله ودينه، ثُمَّ أخبر بأنَّ الله نباه وأرسله إليهم فإن هذا لا يكون أولى بالرَّد من أن يخبرنا الرجل الذي لا يُشك في عقله وصدقه ودينه أنه رأى رؤيا.
وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه تنازع الناس في أن خبر الواحد: هل يجوز أن يقترن به من القرائن والضمائم ما يُفيد معه العلم؟
ولا ريبَ أنَّ المُحقِّقين من كلِّ طائفةٍ على أنَّ خبرَ الواحدِ والاثنين والثَّلاثةِ قد يقترنُ به من القرائنِ ما يحصُلُ معه العلمُ الضَّروريُّ بخبرِ المُخبِرِ. بل القرائنُ وحدَها قد تُفيدُ العلمَ الضَّروريَّ؛ كما يَعرِفُ الرَّجلُ رِضا الرَّجلِ وغضبَه، وحُبَّه وبُغضَه، وفرحَه وحُزنَه، وغيرَ ذلك ممَّا في نفسِه؛ بأمورٍ تظهرُ على وجهِه قد لا يمكنُه التَّعبيرُ عنها.
كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ﴾، ثمَّ قال تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾، فأقسمَ أنَّه لا بُدَّ أن يَعرِفَ المنافقين في لحنِ القولِ، وعلَّقَ معرفتَهم بالسِّيما على المشيئةِ؛ لأنَّ ظهورَ ما في نفسِ الإنسانِ من كلامِه أبيَنُ من ظهورِه على صفحاتِ وجهِه، وقد قيل: ما أسرَّ أحدٌ سريرةً إلَّا أظهرَها اللهُ على صفحاتِ وجهِه وفلتاتِ لسانِه.
فإذا كان مثلُ هذا يُعلَمُ به ما في نفسِ الإنسانِ من غيرِ إخبارٍ؛ فإذا اقترنَ بذلك إخبارُه؛ كان أَوْلى بحصولِ العلمِ.
ولا يقولُ عاقلٌ من العقلاءِ: إنَّ مُجرَّدَ خبرِ الواحدِ، أو خبرَ كلِّ واحدٍ يُفيدُ العلمَ، بل ولا خبرَ كلِّ خمسةٍ أو عشرةٍ؛ بل قد يُخبِرُ ألفٌ وأكثرُ من ألفٍ، ويكونون كاذبين إذا كانوا مُتواطئين.
وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يُعلم بما يقترن به من القرائن بل في لحن قوله وصفحات وجهه، ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرة أن يدفعه عن نفسه؛ فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله ؟! كيف يَخْفَى صدق هذا من كذبه؟! أم كيف لا يتميز الصَّادقُ في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة لا تعد ولا تحصى ؟!
وإذا كان الكاذب إنَّما يُؤتى من وجهين: إما أن يتعمد الكذب، وإما أن يُلبس عليه كمن يأتيه الشيطان؛ فمن المعلوم الذي لا ريب فيه أن من الناس من يُعلم منه أنه لا يتعمد الكذب، بل كثيرٌ ممَّن خَبَرَه النَّاسُ وجَرَّبوه من شيوخهم ومعامليهم يعلمون منهم علما قاطعا أنهم لا يتعمدون الكذب، وإن كانوا يعلمون أنَّ ذلك ممكن؛ فليس كل ما علم إمكانه جوز وقوعه:
فإنَّا نعلم أنَّ الله قادر على قلب الجبال ياقوتا والبحار دما؛ ونعلم أنه لا يفعل ذلك.
ونعلم من حال البشر من حيث الجملة- أنه يجوز أن يكون أحدهم يهوديا ونصرانيا ونحو ذلك؛ ونعلم مع هذا – أن هذا لم يقع من أشخاص نعرفهم، بل ولا يقع منهم، ومن أخبرنا بوقوعه منهم؛ كذَّبناه قطعا.
ونحن لا ننكر أنَّ الرَّجل قد يتغير ويصير متعمدا للكذب بعد أن لم يكن كذلك، لكن إذا استحال وتغيَّرَ؛ ظَهَرَ ذلك لمن يَخْبُرُه ويَطَّلِعُ على أموره. ولهذا لما كانت خديجة تعلم من النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه الصادق البار؛ قال لها لما جاءه الوحي: إِنِّي قَد خَشِيتُ عَلَى عَقلِي»، فقالت: «كلا؛ والله لا يُخزيك الله! إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِم، وتَصْدُق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وَتَكْسِبُ المعدوم، وتعين على نوائب الحق».
فهو لم يخف من تعمد الكذب؛ فإنَّه يَعْلَم من نفسه ﷺ أنَّه لم يَكْذِب، لكن خاف في أول الأمر أن يكون قد عَرَضَ له عارض سوء – وهو المقام الثاني، فذكرت خديجة ما ينفي هذا ؛ وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق، ومحاسن الشيم والأعمال؛ وهو الصدق المستلزم للعدل والإحسان إلى الخلق. ومن جمع فيه الصدق والعدل والإحسان؛ لم يكن ممَّن يُخْزِيه الله.
وصلة الرحم، وقرى الضيف، وحمل الكل، وإعطاء المعدوم، والإعانة على نوائب الحق = هُنَّ من أعظم أنواع البر والإحسان. وقد علم من سُنَّة الله أَنَّ مَن جَبَلَه الله على الأخلاق المحمودة، ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنَّه لا يُخزيه.
وأيضا : فه النبوَّة في الآدميين هي من عهد آدم؛ فإنَّه كان نبيًّا، وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار، وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسل، وجنس أحوالهم؛ فالمدعي للرسالة في زمن الإمكان:
إذا أتى بما ظهر به مخالفته للرُّسل؛ عُلم أنه ليس منهم.
وإذا أتى بما هو من خصائص الرسل؛ تبين أنه منهم.
لا سيَّما إذا عُلِمَ أنَّه لا بُدَّ من رسولٍ مُنتظَرٍ، وعُلِمَ أنَّ لذلك الرَّسولِ صفاتٍ مُتعدِّدةً تُميِّزُه عمَّن سواه؛ فهذا قد يبلغُ بصاحبِه إلى العلمِ الضَّروريِّ بأنَّ هذا هو الرَّسولُ المُنتظَرُ، ولهذا قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾.
والمسلكُ الأوَّلُ — النَّوعيُّ —؛ هو ممَّا استدلَّ به النَّجاشيُّ على نُبوَّتِه؛ فإنَّه لمَّا استخبرَهم عمَّا يُخبِرُ به، واستقرأَهم القرآنَ، فقرؤوه عليه = قال: «إنَّ هذا والذي جاءَ به موسى لَيخرجُ من مِشكاةٍ واحدةٍ».
وكذلك قَبلَه وَرَقةُ بنُ نَوفَلٍ؛ لمَّا أخبرَه النَّبيُّ ﷺ بما رآه، وكان ورقةُ قد تَنصَّرَ، وكان يكتبُ الإنجيلَ بالعربيَّةِ، فقالت له خديجةُ: «أَيْ عَمِّ! اسمعْ من ابنِ أخيكَ ما يقولُ»، فأخبرَه النَّبيُّ ﷺ بما رأى، فقال: «هذا هو النَّاموسُ الذي كان يأتي موسى، وإنَّ قومَك سيُخرجونك»، فقال النَّبيُّ ﷺ: «أَوَمُخرِجِيَّ هُم؟!» قال: «نعم، لم يأتِ أحدٌ بمثلِ ما جئتَ به إلَّا عُودِيَ، وإن يُدرِكْني يومُكَ أَنصُرْكَ نصرًا مُؤَزَّرًا». فلم يَنشَبْ ورقةُ أن تُوُفِّيَ.
فصل في المسلك الشخصي: شرح استدلال هرقل بأحوال النبي ﷺ على صدقه
والمسلك الثاني – الشَّخْصِي -؛ استدل به هِرَقْل مَلِكُ الرُّوم؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام؛ طلبَ هِرَقْلُ مَنْ كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى غزة، فطلبهم وسألهم عن أحوال النبي ؛ فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كَذب أن يُكَذِّبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار.
فسألهم هل كان في آبائه مَلِك؟ فقالوا: لا.
وهل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا.
وسألهم: أهو ذو نَسَبٍ فيكم؟ فقالوا: نعم.
وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا، ما جربنا عليه كَذِبًا.
وسألهم : هل اتَّبَعَه ضُعَفَاءُ النَّاس أم أشرافهم؟ فذكروا أنَّ الضعفاء اتبعوه.
وسألهم : هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون.
وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سُخْطَةً له بعد أن يدخل فيه؟
فقالوا: لا.
وسألهم: هل قاتلتموه؟ فقالوا: نعم.
وسألهم عن الحرب بينهم وبينه، فقالوا : يُدال علينا المرة، وندال عليه الأخرى.
وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر.
وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا : يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة.
فهذه أكثر من عشر مسائل.
ثُمَّ بَيَّنَ لهم ما في هذه المسائل من الدلالة، وأنه سألهم عن أسباب الكذب وعلاماته؛ فرآها منتفية، وسألهم عن علامات الصدق؛ فوجدها ثابتة:
فسألهم: هل كان في آبائه مَلِكٌ ؟ فقالوا: لا، قال: «قلتُ: لو كان في آبائه ملك؛ لقلت: رجل يطلب ملك أبيه.
وسألتك: هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلت: لا؛ فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله؛ لقلت: رجل انتم بقول قيل قبله.
ولا ريب أن اتباع الرجل لعادة آبائه، واقتدائه بمن كان قبله كثيرا ما يكون في الآدميين، بخلاف الابتداء بقول لم يُعرف في تلك الأمة قبله، وطلب أمر لا يناسب حال أهل بيته؛ فإنَّ هذا قليل في العادة، لكنه قد يقع؛ ولهذا أردفه بقوله: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟» فقالوا: «لا»، قال: فقد علمتُ أنَّه لم يكن ليدع الكذب على الناس، ثُمَّ يذهب فيكذب على الله.
وذلك أن مثل هذا يكون كذبًا محضًا يبتدئه لغير عادة جرت، وهذا لا يفعله إلا من يكون من شأنه أن يكذب. فإذا لم يكن من خُلُقه الكذب قط، بل لا يُعرف منه إلا الصدق، وهو يتورع أن يكذب على الناس كان توزعه أن يكذب على الله أولى وأولى.
والإنسان قد يخرج عن عادته في نفسه إلى عادة بني جنسه، فإذا انتفى هذا وهذا؛ كان هذا أبعد عن الكذب وأقرب إلى الصدق .
ثم أردف ذلك بالسؤال عن علامات الصدق؛ فقال: «وسألتك: أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلت: ضعفاؤهم. وهم أتباع الرسل.
وهذه علامةٌ من علاماتِ الرُّسلِ، وهو اتِّباعُ الضُّعفاءِ لهم ابتداءً؛ قال الله تعالى حكايةً عن قومِ نوحٍ: ﴿قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ﴾، وقالوا: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ﴾، وقال تعالى في قصَّةِ صالحٍ: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ﴾، وقال تعالى في قصَّةِ شُعيبٍ: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾.
بل ثُمَّ قال هرقل: وسألتك: «أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت: يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه سُخْطَةً له بعد أن يدخل فيه؟ فقلت: لا. وكذلك الإيمان إذا خالطتْ بَشَاشَتُه القلوب لا يسخطه أحد.
فسألهم عن زيادة أتباعه ودوامهم على اتباعه؛ فأخبروه أنهم يزيدون ويدومون.وهذا من علامات الصدق والحقِّ؛ فإنَّ الكذب والباطل لا بد وأن ينكشف في آخر الأمر، فيرجع عنه أصحابه، ويمتنع عنه من لم يدخل فيه.
ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أنَّ المتنبئ الكذاب لا يدوم إلا مدَّةً يسيرة، وهذه من بعض حجج ملوك النصارى – الذين يقال: إنَّهم من ولد قيصر هذا أو من غيرهم؛ حيث رأى رجلا يسبُّ النَّبِيَّ ﷺ من رؤوس النصارى ويرميه بالكذب، فجمع علماء النصارى، وسألهم عن المتنبئ الكذاب: كم تبقى نبوته؟ فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء أن الكذاب المتنبي لا يبقى إلا كذا وكذا سنة – مدة قريبة؛ إما ثلاثين سنة أو نحوها.
فقال لهم: هذا دين محمَّد له أكثر من خمس مئة سنة – أو ست منه سنة – وهو ظاهر مقبول متبوع؛ فكيف يكون هذا كذَّابًا؟!
ثُمَّ ضرب عنق ذلك الرجل. وسألهم هرقل عن محاربته ومسالمته؛ فأخبروه أنه في الحرب تارة يغلب كما غلب يوم بدر ، وتارةً يُغْلَب – كما غُلِبَ يوم أحدٍ ، وأنه إذا عاهد لا يَغْدِر.
فقال لهم: وسألتك كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلت: إنَّها دول؛ يُدَال علينا المرة وندال عليه الأخرى. وكذلك الرُّسل تُبتلى وتكون العاقبة لها». قال: وسألتك: هل يغدر؟ فقلت : إنَّه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تَغْدِر.
فهرقل لما كان عنده من علمه بعادة الرُّسل وسُنَّة الله فيهم؛ أنَّه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم، وأنَّهم لا يَغْدِرُون عَلِمَ أنَّ هذا من علامات الرُّسُلِ. فإنَّ سُنَّة الله في الأنبياء والمؤمنين أنه يبتليهم بالسراء والضراء؛ لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قال: ‘وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَقْضِي اللهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاء إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَلَيسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِن أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِن أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ).
والله تعالى قد بيَّن في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أُحد من الحكمة؛ فقال: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾.
فمن الحِكَم: تمييز المؤمن من غيره؛ فإنهم إذا كانوا دائمًا منصورين لم يظهر وليُّهم من عدوِّهم، إذ الجميع يُظهرون الموالاة، فإذا غُلبوا ظهر عدوُّهم. قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ * الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾.
وقال تعالى: ﴿الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾، إلى قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ * وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾، وأمثال ذلك.
ومن الحِكَم: أن يتَّخذ منكم شهداء؛ فإن منزلة الشهادة منزلةٌ عليَّة في الجنة، ولا بدَّ من الموت، فموتُ العبد شهيدًا أكملُ له وأعظمُ لأجره وثوابه، ويُكفِّر عنه بالشهادة ذنوبَه وظلمَه لنفسه، والله لا يحب الظالمين.
ومن ذلك: أن يُمحِّص الله الذين آمنوا فيُخلِّصهم من الذنوب؛ فإنهم إذا انتصروا دائمًا حصل للنفوس من الطغيان وضعف الإيمان ما يُوجب لها العقوبةَ والهوان. قال تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا﴾.
وفي الصحيحين عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تُفِيئُهَا الرِّيَاحُ؛ تُقَوِّمُهَا تَارَةً وَتُمِيلُهَا أُخْرَى، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ؛ لَا تَزَالُ ثَابِتَةً عَلَى أَصْلِهَا حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً».
وسُئل ﷺ: أيُّ الناس أشدُّ بلاءً؟ فقال: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ؛ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، وَلَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ».
وقد قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾، وقال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾.
وفي الأثر فيما يُروى عن الله تعالى: «يا ابنَ آدم! البلاءُ يجمع بيني وبينك، والعافيةُ تجمع بينك وبين نفسك». وفي الأثر أيضًا أنهم إذا قالوا للمريض: «اللهمَّ ارحمه»، يقول الله: «كيف أرحمه من شيء به أرحمه»!
وقد شهدنا أن الجيش إذا انكسر: خشع وذلَّ، وتاب إلى الله من الذنوب، وطلب النصر من الله، وبرئ من حوله وقوَّته متوكِّلًا على الله. ولهذا ذكَّرهم الله بحالهم يوم بدر وحالهم يوم حنين؛ فقال: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾.
وشواهد هذا الأصل كثيرة، وهو أمرٌ يجده الناس بقلوبهم ويُحسُّونه ويعرفونه من أنفسهم ومن غيرهم، وهو من المعارف الضرورية الحاصلة بالتجربة لمن جرَّبها، والأخبار المتواترة لمن سمعها.
ثم ذكر سبحانه حكمةً أخرى فقال: ﴿وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾. وذلك أن الله سبحانه إنما يعاقب الناسَ بأعمالهم، والكافرُ إذا كانت له حسنات أطعمه الله بحسناته في الدنيا، فإذا لم يبقَ له حسنة عاقبه بكفره. والكفارُ إذا أُديلوا يحصل لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكفر والتكذيب ما يستحقون به المَحْق، ففي إدالتهم ما يمحقهم الله به.
وأمَّا الغَدْر؛ فإنَّ الرُّسل لا تَغْدِر أصلا؛ إذ الغدر قرين الكذب، كما في الصحيحين عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثُ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخلَفَ ، وَإِذَا التُمِنَ خَانَ»، وفي «الصحيحين» أيضًا عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قال: أَربَعٌ مَن كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَن كَانَت فِيهِ خَصْلَةٌ مِنهُنَّ كَانَت فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا التُمِنَ خَانَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ).
بل الغدر ونحوه داخل في الكذب؛ كما قال تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَهَدَ اللَّهَ لَينْ آتَيْنَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا وَاتَهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ * إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ).
وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكتاب لين أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا تُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُنَ الْأَدْبَرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ).
فالغدر يتضمن كذبًا في المستقبل، والرُّسل صلوات الله عليهم مُنَزَّهون عن ذلك، فكان هذا من العلامات.
قال هرقل: وسألتك عما يأمر به، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي. وقد كنتُ أعلم أنَّ نبيا يُبعث، ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا، فسيملك موضع قدمي هاتين .
وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي ﷺ قال أبو سفيان : فقلت لأصحابي ونحن خروج : لقد أمر أمر ابن أبي كَبْشَةَ، إِنَّه ليخافه مَلِكُ بني الأصفر، قال: وما زلت موقنا بأن أمر رسول الله ﷺ سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره.
قلت: فمثل هذا السؤال والبحث أفاد هذا العاقل اللبيب علما جازما بأن هذا هو النبي الذي ينتظره.
وقد اعترض على هذا بعض من لم يُدرك غور كلامه وسؤاله – كالمازري ونحوه، وقال: إنَّه بمثل هذا لا تُعلم «النُّبوَّة»، وإنَّما تُعلم بالمعجزة.
وليس الأمر على ما قال؛ بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا السؤال والبحث؛ علم أنه من أدلّ الأمور على عقل السائل وخبرته، و استنباطه ما يُميز به: هل هو صادق أو كاذب»، وأنه بهذه الأمور يتميز له ذلك.
ومما ينبغي أن يُعرف: أنَّ ما يحصل في القلب بمجموع أمور؛ قد لا يَسْتَقِلُّ بعضُها به بل كلُّ ما يَحْصُل للإنسان من شبع وري وسكر وفَرَحٍ وغَم بأمور مجتمعة؛ لا يَحْصُل ببعضها، لكن بعضها قد يُحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بمخبر من الأخبار، وبما جربه من المجربات، وبما في نفس الإنسان من الأمور؛ فإنَّ الخَبَر الواحد يُحصل في القلب نوع ظَنِّ، ثُمَّ الآخر يُقَوِّيه، إلى أن ينتهي إلى العلم، حتى يتزايد ويقوى. وكذلك ما يُجَرِّبه الإنسان من الأمور، وما يراه من أحوال الشخص. وكذلك ما يُستدل به على كذبه وصدقه.
فصل في الآثار التاريخية الدالة على صدق الأنبياء وتواتر أخبارهم
وأيضا: فإنَّ الله ﷺ أبقى في العالم الآثار الدَّالَّة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة، وذلك أيضا معلوم بالتواتر: كتواتر الطوفان، وإغراق فرعون وجنوده.
[…] وبالجملة : فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول: «إنَّه رسول الله»، وأن أقواما اتَّبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأنَّ الله نصر الرُّسُل والمؤمنين، وجعل العاقبة لهم، وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها.
ونَقْلُ هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب في جاهليتها، وأخبار اليونان وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية؛ كأبقراط وجالينوس وبطليموس، وسقراط، وأفلاطن، وأرسطو وأتباعه.
فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأممهم وأعدائهم أكثر وأكثر من نقل أخبار مثل هؤلاء؛ فإنَّ أخبار الأنبياء وأتباعهم ينقلها من أهل الملل من لا يُحصي عدده إلا الله، ويدونونها في الكتب، وأهلها من أعظم الناس تدينا بوجوب الصدق وتحريم الكذب، ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بني آدم ما يمنع اتفاقهم وتواطأهم على الكذب، بل ما يمنع اتفاقهم على كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، وفي عادتهم الخاصة ودينهم الخاص برهان آخر أخص من الأول وأكمل.
وهذا معلوم على سبيل التفصيل من حال أمتنا؛ فإنَّا نعلم علما ضروريًا بالنقل المتواتر من عادة سلف الأمة ودينهم الموجب للصدق والبيان المانع من الكذب والكتمان ما يوجب علما ضروريا لنا بما تواتر لنا عنهم، وبانتفاء أمور لو كانت موجودة لنقلوها، وأهل الكتابين قبلنا عندهم من التواتر بجمل الأمور ما يحصل به المقصود في هذا الموضع.
قَبْلَنا ومن بعض أُمَّتِنا؛ فهو وإن كان قد يجيء كذب أو كتمان في بعض التفاصيل من أهل الكتابين وأقل بكثير مما يقع من الكذب والكتمان بأخبار الفرس واليونان والهند وغيرهم ممَّن يُنقل أخبار ملوكهم وعلمائهم ونحو ذلك.
وما من عاقل يسمع مع الخبر عن هؤلاء وعن هؤلاء – كما هو موجود في هذا الزمان في الكتب والأَلْسِنَةِ ؛ إلا ويحصل له من العلوم الضرورية بأحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم؛ أعظم مما يحصل من العلوم بأحوال ملوك الفرس والروم وعلمائهم وأوليائهم وأعدائهم، وهذا بين ولله الحمد.
فصل في تعدد طرق العلم بصدق النبي ﷺ
(…) والمقصود هنا: أن طرق العلم بالرسالة كثيرة جدا، متنوعة؛ ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم؛ علمنا علما يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة:
منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم، وخذلان أولئك، وبقاء العاقبة لهم أخبارًا كثيرة في أمور كثيرة، وهي كلها صادقة، لم يقع في شيء منها تخلف ولا غلط ، بخلاف ما يخبر به من ليس متبعا لهم ممن تَنزَّلُ عليه الشَّياطين، أو يستدل على ذلك بالأحوال الفلكية وغير ذلك؛ فإنَّ هؤلاء لا بُدَّ أن يكذبوا كثيرًا؛ بل الغالب من أخبارهم الكذب، وإن صدقوا أحيانًا.
ومن ذلك: أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم؛ إذا عرف الوجه الذي حصل عليه؛ كحصول الغرق لفرعون وقومه بعد أن دخل البحر خلف موسى وقومه كان هذا مما يورث علما ضروريًا أنَّ الله تعالى أحدث هذا نصرا لموسى وقومه، ونجاة لهم؛ وعقوبة لفرعون وقومه، ونكالا لهم. وكذلك أمر نوح والخليل، وكذلك قصَّةُ الفيل، وغير ذلك.
ومن الطرق أيضا: أنَّ من تأمل ما جاءت به الرسل فيما أخبرت به وما أمرت به علم بالضرورة أن مثل هذا لا يصدر إلا عن أعلم الناس وأصدقهم وأبرهم، وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب متعمد للكذب مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح، أو مخطئ جاهل ضال يظن أنَّ الله تعالى أرسله ولم يرسله.
وذلك لأن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام والإتقان، وكشف الحقائق، وهذي الخلائق، وبيان ما يعلمه العقل جملة، ويعجز عن معرفته تفصيلا = ما يُبيِّن أنهم من العلم والمعرفة والخبرة في الغاية التي باينوا بها أعلم الخلق ممَّن سواهم؛ فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن جاهل ضال.
وفيها من الرحمة والمصلحة والهدى والخير، ودلالة الخلق على ما ينفعهم، ومنع ما يضرهم ما يُبيِّن أن ذلك صدر عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق.
وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم، وكمال حسن قصدهم؛ فمن تم علمه وتم حسن قصده امتنع أن يكون كاذبًا على الله، يدعي عليه هذه الدعوى العظيمة، التي لا يكون أفجر من صاحبها إن كان كاذبًا متعمدا، ولا أجهل منه إن كان مخطئا.
وهذه الطريق تسلك جملة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتفصيلا في حق واحد واحد بعينه، فيستدل المستدل بما يعلمه من الحق والخير جملة على علم صاحبه وصدقه، ثُمَّ يستدل بعلمه وصدقه على ما لم يعلمه تفصيلا.
والعلم بجنس الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب؛ معلوم بالفطرة والعقل الصريح، بل جُمَلُ ذلك مما اتَّفق عليه بنو آدم؛ ولذلك يسمى ذلك معروفًا ومنكرًا . فإذا عُلم أنَّه فيما عَلِم النَّاس أنه حق وأنه خير؛ هو أعلم منهم به، وأنصح الخلق فيه، وأصدقهم فيما يقول علم بذلك أنه صادق عالم ناصح، لا كاذب ولا جاهل ولا غاش.
وهذه الطريق يسلكها كلُّ أحد بحسبه، ولا يحتاج في هذه الطريق إلى أن يعلم أولا خواص النُّبوَّة وحقيقتها وكيفيتها، بل أن يُعلم أنه صادق بار فيما يُخبر به ويأمر به، ثُمَّ مِن خَبَره يُعلم حقيقة «النبوة والرسالة».
[…] والمقصود هنا: أن طرق العلم بصدق النَّبيِّ، بل وتفاوت الطرق في معرفة قدر النُّبُوَّة» و«النَّبِيِّ متعددة تعدُّدًا كثيرًا؛ إذ النَّبِيُّ ﷺ يُخبر عن الله أنه قال ذلك : إما إخبارًا من الله، وإما أمرًا ونهيا. ولكل من حال المخبر، والمُخْبَر عنه، والمُخْبَر به، بل ومن حال المخبرين مصدقهم ومكذبهم – دلالة على المطلوب، سوى ما ينفصل عن ذلك من الخوارق، وأخبار الأولين والهواتف، والكهان، وغير ذلك.
فصل في أن صدق المخبر وكذبه يُعرف بخُلقه وعادته ومباشرته
فالمخبر – مطلقا – يُعْلَم صدقُه وكَذِبُه بأمور كثيرة؛ لا يحصل العلم بأحادها كما يحصل العلم بمُخْبَر الأخبار المتواترة، بل بمخبر الخبر الواحد الذي احتف بخبره قرائن أفادت العلم.
ومن هذا الباب علم الإنسان بعدالة الشاهد» و«المحدث» و«المفتي»، حتَّى يُزَكِّيهم ويفتي بخبرهم ويحكم بشهادتهم، وحتى لا يحتاج الحاكم في عدالة كل شاهد إلى تزكية؛ فإنَّه لو احتاج كُلُّ مُزَكُ إلى مُزَك ؛ لزم التسلسل. بل يُعلم صدق الشخص تارة باختباره
ومباشرته، وتارة باستفاضة صدقه بين الناس.
ولهذا قال العلماء: إنَّ التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب؛ فإنَّ كون الشخص عدلا صادقًا لا يَكْذِب؛ لا يتبيَّن بذكر شيء معين، بخلاف الجرح؛ فإنه لا يُقبل إلَّا مُفَسَّرًا عند جمهور العلماء؛ لوجهين:
أحدهما: أن سبب الجرح ينضبط.
الثاني: أنه قد يظن ما ليس بجرح جرحًا.
وأما كونه صادقًا مُتَحَرِّيًا للصدق لا يَكْذِب؛ فهذا لا يُعرف بشيء واحد حتَّى يُخْبَر به، وإنَّما يُعرف ذلك مِن خُلُقِه وعادته، بطول المباشرة له والخبرة له، ثُمَّ إذا استفاض ذلك عند عامة من يعرفه؛ كان ذلك طريقا إلى العلم لمن لم يباشره، كما يعرف الإنسان عدل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، وظُلْمَ الحَجاج. ولهذا قال الفقهاء: «إنَّ العدالة والفسق يثبت بالاستفاضة، وقالوا في الجرح المفسر : يجرحه بما رآه أو سمعه أو استفاض عنه.
وصدق الإنسان في العادة مستلزم لخصال البر، كما أن كذبه مستلزم لخصال الفجور، كما ثبت في الصحيحين عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قال:
عَلَيْكُم بِالصِّدِقِ؛ فَإِنَّ الصَّدقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدقَ حَتَّى يُكَتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا؛
وَإِيَّاكُم وَالكَذِبَ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكَتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا.
وكما أن الخبر المتواتر يُعلم لكونه أخبر به من يمتنع في العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب والخبر المُنْكَرَ المُكَذِّبَ يُعلم لكونه لم يُخبر به من يمتنع في العادة اتفاقهم على الكتمان فخُلق الشخص وعادته في الصدق والكذب يمتنع في العادة أن يخفى على الناس، فلا يُوجد أحد يُظهر تحري الصدق وهو يكذب إذا أراد؛ إِلَّا ولا بُدَّ أن يَتَبَيَّن كذبه.
فإنَّ الإنسان حيوان ناطق ؛ فالكلام له وصف لازم ذاتي لا يفارقه، والكلام: إما خبر وإما إنشاء والخبر أكثر من الإنشاء وأصل له، كما أن العلم أعم من الإرادة وأصل لها، والمعلوم أعظم من المراد؛ فالعلم يتناول الموجود والمعدوم، والواجب والممكن والممتنع، وما كان وما سيكون، وما يختاره العالم وما لا يختاره. وأما الإرادة فتختص ببعض الأمور دون بعض.
والخبر يطابق العلم، فكلُّ ما يُعْلَم ؛ يُمْكِنُ الخَبَر به، والإنشاء يطابق الإرادة، فإن الأمر: إما محبوب يُؤمر به، أو مكروه ينهى عنه. وأما ما ليس بمحبوب ولا مكروه؛ فلا يُؤمر به ولا يُنْهَى عنه.
وإذا كان كذلك فالإنسان إذا كان مُتَحَرِّيًا للصدق؛ عُرف ذلك منه.
وإذا كان يكذب أحيانًا لغرض من الأغراض لجلب ما يهواه أو دفع ما يبغضه أو غير ذلك؛ فإنَّ ذلك لا بُدَّ أن يُعرَف منه، وهذا أمر جرت به العادات كما جرت بنظائره فلا تجد أحدًا بين طائفة من الطوائف طالت مباشرتهم له ؛ إلا وهم يعرفونه : هل يكذب أو لا يَكْذِب.
ولهذا كان من سُنَّة القضاة إذا شهد عندهم من لا يعرفونه؛ كان لهم أصحاب مسائل»، يسألون عنه جيرانه ومعامليه ونحوهم ممن له به خبرة. فمن خبر شخصا خِبْرَةً باطنةً ؛ فإنَّه يعلم من عادته علما يقينيا أنه لا يكذب، لا سيما في الأمور العظام.
ومَن خَبَرَ عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وسفيان الثوري. ومالك بن أنس، وشُعْبَةَ بن الحجاج، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، وأضعاف أضعافهم حصل عنده علم ضروري من أعظم العلوم الضرورية أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد الكذب على رسول الله ﷺ.
ومن تواترت عنده أخبارهم من أهل زماننا وغيرهم؛ حصل له هذا العلم الضروري، ولكن قد يجوز على أحدهم الغلط الذي يليق به .
ثم خبر الفاسق والكافر، بل ومن عُرف بالكذب؛ قد تقترن به قرائن تفيد علما ضروريا أن المخبر صادق في هذا الخبر؛ فكيف بمن عُرف به نتصدق دائما؟!
فمن كان خبيرا بحال النبي ﷺ مثل زوجته خديجة، وصديقه أبي بكر – ؛ إذا أخبره النبي ﷺ بما رآه أو سمعه حَصَلَ له علم ضروري بأنه صادق في ذلك، ليس هو كاذبا في ذلك.
ثمَّ النَّبِيُّ لا بُدَّ أن يَحْصُلَ له علم ضروري بأن ما أتاه صادق أو كاذب، فيصير إخباره عمَّا عَلِمَه بالضرورة كإخبار أهل التواتر عما علموه بالضرورة.
وأيضا فالمتنبئ الكذَّابُ كمسيلمة والعنسي ونحوهما – يظهر لمخالطيه من كذبه في أثناء الأمور أعظم مما يظهرُ مِن كذب غيره؛ فإنَّه إذا كان الإخبار عن الأمور المشاهدة لا بُدَّ أن يظهر فيه كذب الكاذب؛ فما الظن بمن يُخبر عن الأمور الغائبة التي تطلب منه؟!
ومن لوازم النبي التي لا بُدَّ منها : الإخبار عن الغيب الذي أنبأه الله به؛ فإِنَّ مَن لم يُخبر عن غيب لا يكون نبيا.
فإذا أخبرهم المتنبي عن الأمور الغائبة عن حواسهم من الحاضرات والمستقبلات والماضيات؛ فلا بد وأن يكذب فيها، ويظهر لهم كذبه؛ وإن كان قد يصدق أحيانًا في شيء، كما يظهر كذب الكهان والمنجمين ونحوهم، وكذب المدعين للدين والولاية والمشيخة بالباطل؛ فإن الواحد من هؤلاء وإن صدق في بعض الوقائع؛ فلا بُدَّ وأن يَكْذِب في غيرها، بل يكون كذبه أغلب من صدقه، بل تتناقض أخباره وأوامره.
هذا أمر جرت به سُنَّةُ الله التي لن تجد لها تبديلا ؛ قال الله تعالى : ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.
وأما النبي الصادق المصدوق؛ فهو فيما يُخبر به من الغيوب توجد أخباره صادقة مطابقة، وكلما زادت أخباره؛ ظهر صدقه، وكلما ) قويت مباشرته وامتحانه؛ ظهر صدقه؛ كالذهب الخالص الذي كلما سبك ؛ خَلص وظهر جوهره، بخلاف المغشوش ؛ فإنه عند المحنة ينكشف ويظهر أن باطنه خلاف ظاهره.
ولهذا جاء في النُّبُوَّات» المتقدمة أنَّ الكذاب لا يدوم أمره أكثر من مدة قليلة – إما ثلاثين سنة، وإما أقل ؛ فلا يوجد مدعي النبوة» كذَّابٌ إلا ولا بُدَّ أن ينكشف ستره ويظهر أمره؛ والأنبياء الصادقون لا يزال يظهر صدقهم، بل الذين يُظهرون العلم ببعض الفنون، والخبرة ببعض الصناعات، والصلاح والدِّينَ والزَّهدَ؛ لا بُدَّ وأن يتميز هذا من هذا وينكشف؛ فالصادقون يدوم أمرهم، والكذابون ينقطع أمرهم. هذا أمر قد جرت به العادة وسُنَّةُ الله التي لن تجد لها تبديلا.
وأما المُخبر به عنه: فالنَّبِيُّ يُخبر عن الله تعالى بـ«أنَّه أَخْبَر بكذا، أو أنه أمر بكذا؛ فلا بُدَّ وأن يكون خَبَرُه صِدْقًا وأمرُه عَدْلًا؛ ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾
[…] فإنَّ المخبر إنَّما تأتيه الآفة من:
١ – تعمد الكذب .
٢- أو الخطأ بأن يَظُنَّ الأمر على خلاف ما هو عليه .
فما كان من العلوم الضرورية التي كُلما دامت قويت وظهرت وزادت يزول معه احتمال الخطأ.
وما كان من تحرِّي الصدق الذي يُعلم معه بالضرورة انتفاءُ تعمُّد الكذب — هو وغيره من الأمور التي يُعلم معها انتفاء تعمُّد الكذب — يزول معه احتمال تعمُّده.
وأما العلم بالعدل المفصَّل فيما يأمر به، وبالصدق المفصَّل فيما يُخبر به؛ فهذا يُعلم تارةً بما يُبيِّنه من الأدلة العقلية ويضربه من الأمثال — وهذا هو الغالب على ما يذكره الأنبياء من أصول الدين علمًا وعملًا — وتارةً يظهر ذلك بالتجربة والامتحان، وتارةً يُستدلُّ بما عُلم على ما لم يُعلم.
وأيضًا: فقد عُلم أن العالم ما زال فيه نبوَّة من آدم إلى محمد ﷺ؛ والنبيُّ اللاحق يُعلم صدقه بأمور:
منها: إخبار النبي الأول به، كما بشَّر بمحمد ﷺ الأنبياءُ قبله، وكذلك بشَّر بالمسيح الأنبياءُ قبله.
وتارةً يُعلم صدقه بأن يأتي بمثل ما أتوا به من الخبر والأمر؛ فإن الكذَّاب الفاجر لا يُتصوَّر أن يكون في أخباره وأوامره موافقًا للأنبياء، بل لا بدَّ وأن يخالفهم في الأصول الكلية التي اتفق عليها الأنبياء؛ كـ«التوحيد» و«النبوات» و«المعاد». كما أن القاضي الجاهل أو الظالم لا بدَّ وأن يخالف سُنَّة القضاة العالمين العادلين، وكذلك المفتي الجاهل أو الكاذب، والطبيب الكاذب أو الجاهل؛ فإن كل هؤلاء لا بدَّ وأن يبين كذبُهم أو جهلُهم بمخالفتهم لما مضت به سُنَّة أهل العلم والصدق؛ وإن كان قد يخالف بعضهم بعضًا في أمور اجتهادية، فإنه يُعلم الفرق بين ذلك وبين المخالفة في الأصول الكلية التي لا يمكن انخرامها.
ولهذا يُميِّز الناس في الأمراء والحكام والمفتين والمحدِّثين والأطباء وسائر الأصناف بين العالم الصادق — وإن خالف غيره من أهل العلم والصدق في أشياء — وبين من يكون جاهلًا أو كاذبًا ظالمًا، ويُفرِّقون بين هذا وهذا؛ كما أنهم يعلمون من سيرة أبي بكر وعمر من العلم والعدل ما لا يرتابون فيه، وإن كان بينهما منازعات في أمور اجتهادية؛ كالتفضيل في العطاء ونحو ذلك.
وأيضًا: فإذا أخبر اثنان عن قضية طويلة ذات أجزاء وشُعَب، لم يتواطآ عليها، ويمتنع في العادة اتفاقهما فيها على تعمُّد الكذب أو الخطأ؛ عَلِمنا صدقَهما. مثل أن يشهد رجلان واقعةً من وقائع الحروب، أو يشهدا الجمعةَ أو العيد، أو موتَ ملك، أو تغيُّرَ دولة ونحو ذلك، أو يشهدا خطبةَ خطيب، أو كتابًا لبعض الولاة، أو يطالعا كتابًا من الكتب أو يحفظاه، ويُعلم أنهما لم يتواطآ، ثم يجيء أحدهما فيُخبر بذلك كله مُفصَّلًا شيئًا فشيئًا، ويُخبر الآخر بمثل ما أخبر به الأول مُفصَّلًا شيئًا فشيئًا من غير تواطؤ؛ فيُعلم أنهما صادقان.
حتى لو كان رجلان يحفظان بعض قصائد العرب — كقصيدة امرئ القيس أو غيرها — وهناك من لا يحفظها، وهناك شخصان لا يعرف أحدهما الآخر، فقال الذي لا يحفظها لأحدهما: «أنشدنيها»، فأنشدها، ثم طلب الآخر وقال له: «أنشدنيها»، فأنشدها كما أنشد الأول؛ عَلِم المستمع أنها هي هي. بل وكذلك كتب الفقه والحديث واللغة والطب وغير ذلك.
ولو بعث بعض الملوك رُسُلًا له إلى أمرائه ونوابه في أمر من الأمور، ثم أخبر أحد الرسولين بأنه أمر بكذا — بأمر ذكره وفصَّله — وأخبر الآخر بمثل ذلك للقوم الذين أُرسل إليهم، من غير علم منه بإرسال الآخر؛ عُلم قطعًا أن ذلك الأمر هو الذي أمر به المُرسِل، وأنهما صادقان؛ فإنه يُعلم علمًا ضروريًا أنه يمتنع في الكذب والخطأ أن يتَّفق في مثل هذا.
ومعلوم أن موسى وغيره من الأنبياء كانوا قبل محمد ﷺ، وقد أخبروا عن الله من توحيده وأسمائه وصفاته وملائكته وأمره ونهيه ووعده ووعيده وإرساله بما أخبروا به. ومعلوم أيضًا لمن علم حال محمد ﷺ أنه كان رجلًا أميًّا، نشأ بين قوم أميِّين، ولم يكن يقرأ كتابًا ولا يكتب بخطِّه شيئًا؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ﴾؛ وأن قومه الذين نشأ بينهم لم يكونوا يعلمون علوم الأنبياء، بل كانوا من أشدِّ الناس شركًا وجهلًا وتبديلًا وتكذيبًا بـ«المعاد»، وكانوا من أبعد الأمم عن توحيد الله ومن أعظمهم إشراكًا به. ثم إذا تدبَّرت القرآن والتوراة وجدتهما يتَّفقان في عامَّة المقاصد الكلية من «التوحيد» و«النبوات» والأعمال الكلية والأسماء والصفات.
ومن كان له علم بهذا عَلِم علمًا ضروريًا ما قاله النجاشي: «إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة»، وما قاله ورقة بن نوفل: «إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى».
قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ﴾، وقال تعالى: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾، وأمثال ذلك مما يُذكر فيه شهادة الكتب المتقدمة بمثل ما أخبر به محمد ﷺ.
وهذه الأخبار منقولة عند أهل الكتاب بالتواتر، كما نُقل عندهم بالتواتر معجزات موسى وعيسى، وإن كان كثير مما يدَّعونه من دقيق الأمور لم يتواتر عندهم لانقطاع التواتر فيهم؛ فالفرق بين الجُمَل الكلية المشهورة التي هي أصول الشرائع التي يعلمها أهل الملل كلهم، وبين الجزئيات الدقيقة التي لا يعلمها إلا خواص الناس، ظاهر.
ولهذا كان وجوب الصلوات الخمس وشهر رمضان وحج البيت وتحريم الفواحش والكذب ونحو ذلك متواترًا عند عامة المسلمين؛ وأكثرهم لا يعلمون تفاصيل الأحكام والسنن المتواترة عند الخاصة.
فصل في دلالة اتفاق الكتب المنزلة على صدق النبوة
فإذا كان في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب وفيما ينقلونه بالتواتر ما يوافق ما أخبر به محمد ﷺ؛ كان في ذلك فوائد جليلة، هي من بعض حكمة إقرارهم بالجزية:
أحدها: أنه إذا عُلم اتفاق الرسل على مثل هذا عُلم صدقُهم فيما أخبروا به عن الله، حيث أخبر محمد ﷺ بمثل ما أخبر به موسى من غير تواطؤ ولا تشاعُر.
الثاني: أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في «أصول الدين»، كما يُعلم أن رسل الله قبله كانوا رجالًا من البشر لم يكونوا ملائكة؛ فلا يُجعل محمد ﷺ وحده هو الذي جاء بها. كما قال تعالى: ﴿قُل مَّا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا يَعْقِلُونَ * حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ * لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾.
الثالث: أن هذه آية على نبوة محمد ﷺ، حيث أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء من غير تعلُّم من بشر، وهذه الأمور هي من الغيب. قال تعالى: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾.
وقال تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ * وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ * قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ * أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ * وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾.
وكثير من أهل الكتاب آمنوا بمثل هذه الطريق؛ قال تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَتَابِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾.
ولا ريب أن منكري «النبوات» لهم شُبَه: منها إنكار أن يكون رسول الله بشرًا، ومنها دعوى أن الذي جاء به شيطان لا ملك، وغير ذلك. وقد أجاب الله عن ذلك كله في القرآن وقرَّره بأبلغ تقرير؛ لكن جواب هذا السؤال لا يتَّسع له هذا المقام.
قال تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا * قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا﴾.
وقال تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ * وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ﴾؛ بيَّن سبحانه أن الرسول لو كان ملكًا لكان في صورة رجل، إذ لا يستطيعون الأخذ عن الملك على صورته، ولو كان في صورة رجل لعاد اللَّبس وقالوا: أبعث الله بشرًا رسولًا!
وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾؛ فأمر سبحانه بمسألة أهل الذكر، إذ ذلك مما تواتر عندهم أن الرسل كانوا رجالًا. وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾.
وبالجملة: فتقرير النبوات من القرآن أعظم من أن يُشرح في هذا المقام؛ إذ ذلك هو عماد الدين وأصل الدعوة النبوية وينبوع كل خير وجِمَاع كل هدى.
فصل في دلالة حال المُخبَر عنه وهو الله تعالى
وأما حال المُخبَر عنه: فإن النبيَّ والرسول يُخبر عن الله بأنه أرسله، ولا أعظم فِريةً ممَّن يكذب على الله؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾؛ ذكر هذا بعد قوله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ * وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾.
فنقض سبحانه دعوى الجاحد النافي للنبوة بقوله: ﴿قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾؛ وذلك لأن تنزيل ذلك الكتاب ظهر معه من الآيات البينات، واتَّبعه من الأنبياء والمؤمنين، وحصل له ما لم يحصل لغيره؛ فكانت البراهين والدلائل على صدقه أكثر وأظهر من أن تُنكر، بخلاف الإنجيل وغيره.
وأيضًا: فإنه أصل والإنجيل تبع له — إلا فيما أحلَّه المسيح عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا يقرن سبحانه بينه وبين القرآن في مثل قوله: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا﴾؛ أي: القرآن والتوراة. وفي القراءة الأخرى: «قالوا ساحران»؛ أي: محمد وموسى.
وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾، وكذلك قوله تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً﴾، وكذلك قول الجن: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾.
ولهذا كانت قصة موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورة في القرآن وأكبرها وأكثرها بسطًا؛ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله ﷺ عامَّة نهاره يحدِّثنا عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظيم صلاة.
ولمَّا قرَّر سبحانه الصدق؛ بيَّن حال الكذَّابين بأنهم ثلاثة أصناف؛ إذ لا يخلو الكذَّاب من: أولًا: أن يضيف الكذب إلى الله تعالى ويقول: «إنه أنزله». ثانيًا: أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد. ثالثًا: أو أن يقول: «إنه هو الذي وضعه معارِضًا».
فقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾.
وأما المُخبَر عنه: فإنه الله تعالى؛ ولا ريب أنه يُعلم من أمور الرب سبحانه بما نصبه من الأدلة المعايَنة الحسية التي يُعقل بها بنفسها وبالأمثال المضروبة — وهي الأقيسة العقلية — ما يمتنع معه خفاء كذب الكاذب، بل يمتنع معه خفاء صدق الصادق.
فالدجَّال — مثلًا — قد عُلم بوجوه متعددة ضرورية أنه ليس هو الله، وأنه كافر مُفترٍ. وإذا كانت دعواه معلومًا كذبها ضرورةً؛ لم يكن ما يأتي به من الشبهات مصدِّقًا لها؛ إذ العلوم الضرورية لا تقدح فيها الطرق النظرية، فإن الضروريات أصل النظريات، فلو قُدح بها فيها لزم إبطال الأصل بالفرع فيبطلان جميعًا. وأيضًا فإنه يظهر من عجزه ما ينفي دعواه.
وكذلك من أباح الفواحش والمظالم والشرك والكذب مدَّعيًا للنبوة؛ يُعلم بالاضطرار كذبُه، للعلم الضروري بأن الله لا يأمر بهذا؛ سواء قيل: إن العقل يعلم به حُسن الأفعال وقُبحها، أو: «لا يُعلم به». فليس كل ما أمكن في العقل وقوعه وكان الله قادرًا عليه يُشكُّ في وقوعه؛ بل نحن نعلم بالضرورة أن البحار لم تنقلب دمًا، وأن الجبال لم تنقلب يواقيت، وأمثال ذلك من المعارف، وإن لم يُسنَد ذلك إلى دليل معيَّن، وإن كنَّا عالمين بأن الله قادر على قلب ذلك؛ لكن العلم بالوقوع وعدمه شيء، والعلم بإمكان ذلك في قدرة الله شيء آخر.
وكل ذي فطرة سليمة يعلم بالاضطرار أن الله لا يأمر عباده بالكذب والظلم والشرك والفواحش وأمثال ذلك مما قد يأتي به كثير من الكذابين، بل يعلم بفطرته السليمة ما يناسب حال الربوبية.
فصل في المعجزات
وهذه الطريق سلكها أكثر أهل الكلام وغيرهم؛ ولهم في تقرير دلالة «المعجزة» على الصدق طرق:
أحدها: أن إظهار «المعجزة» على يدي المتنبئ الكذاب قبيح، والله تعالى منزَّه عن فعل القبيح. وهذه الطريق سلكها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بالتحسين والتقبيح، وطعن فيها من ينكر ذلك.
ثم إن المعتزلة جعلوا هذه أصل دينهم، والتزموا لها لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة، بل وصريح العقل في مواضع كثيرة.
وحقيقة أمرهم: أنهم لم يصدِّقوا الرسول إلا بتكذيب بعض ما جاء به، وكأنهم قالوا: لا يمكن تصديقه في البعض إلا بتكذيبه في البعض. لكنهم لا يقولون: «إنهم يكذِّبونه في شيء»، بل تارةً يطعنون في النقل، وتارةً يتأوَّلون المنقول، ولكن يُعلم بطلان ما ذكروه إما ضرورةً وإما نظرًا.
وذلك أنهم قالوا: السمع مبني على صدق الرسول، وصدقه مبني على أن الله منزَّه عن فعل القبيح — فإن تأييد الكذاب بالمعجز قبيح والله منزَّه عنه.
قالوا: والدليل على أنه منزَّه عنه: أن القبيح لا يفعله إلا جاهل بقبحه أو محتاج إليه، والله منزَّه عن الجهل والحاجة.
والدليل على ذلك: أن المحتاج لا يكون إلا جسمًا، والله تعالى ليس بجسم.
والدليل على أنه ليس بجسم: هو ما دلَّ على حدوث العالم.
والدليل على حدوث العالم: أنه أجسام وأعراض، وكلاهما محدَث.
والدليل على حدوث الأجسام: أنها لا تخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.
والدليل على ذلك: أنها لا تنفكُّ عن الحركة والسكون، وهما حادثان؛ لامتناع حوادث لا أول لها.
ثم التزموا لذلك حدوثَ كل موصوف بصفة؛ لأن الصفات هي الأعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، وقد قام الدليل على حدوث الجسم. فالتزموا لذلك: ألا يكون لله علم ولا قدرة، وألا يكون متكلمًا قام به الكلام، بل يكون القرآن وغيره من كلامه مخلوقًا خلقه في غيره، ولا يجوز أن يُرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هو مباين للعالم ولا مجانس، ولا داخل فيه ولا خارج عنه.
ثم قالوا أيضًا: لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به، ولا أن يخلق أفعال عباده، ولا يقدر عندهم على أن يهدي ضالًّا ولا يُضل مهتديًا؛ لأنه لو كان قادرًا على ذلك وقد أمر به ولم يُعِن عليه لكان قبيحًا منه.
فركَّبوا عن هذا الأصل: التكذيبَ بـ«الصفات»، والتكذيبَ بـ«القدر».
وسمَّوا أنفسهم أهل التوحيد والعدل، وسمَّوا من أثبت «الصفات» و«القدر» من سلف الأمة وأئمتها: مُشبِّهةً ومُجسِّمةً ومُجبِرةً وحَشْوِيَّةً، وجعلوا مالكًا وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وغيرهم من جملة هؤلاء «الحَشْوِيَّة»؛ إلى أمثال هذه الأمور التي بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع.
وأصل ضلالهم في «القدر»: أنهم شبَّهوا المخلوق بالخالق، فهم مشبِّهة الأفعال.
وأما أصل ضلالهم في «الصفات»: فظنُّهم أن الموصوف الذي تقوم به الصفات لا يكون إلا محدَثًا. وقولهم هذا من أبطل الباطل؛ فإنهم يُسلِّمون أن الله «حي» «عليم» «قدير»، ومن المعلوم أن حيًّا بلا حياة، وعليمًا بلا علم، وقديرًا بلا قدرة، مثل متحرك بلا حركة، وأبيض بلا بياض، وأسود بلا سواد، وطويل بلا طول، وقصير بلا قِصَر، ونحو ذلك من الأسماء المشتقة التي يُدَّعى فيها نفي المعنى المشتق منه، وهذا مكابرة للعقل والشرع واللغة.
الثاني: أنه أيضًا من المعلوم أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، فإذا خلق كلامًا في محل وجب أن يكون ذلك المحل هو المتكلم به، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾، ويكون كل ما أنطقه الله من المخلوقات كلامًا لله. وبسط هذا له موضع آخر غير هذا.
والمقصود هنا ما يتعلق بتقرير «النبوة».
وقد سلك طوائف آخرون من نُظَّار المسلمين تقرير «النبوة» بـ«المعجزة»؛ بناءً على أن الله تعالى لا يؤيد الكذاب بـ«المعجزة»، وأنه منزَّه عن ذلك من غير موافقة للمعتزلة على التكذيب بـ«القدر».
ثم هؤلاء يقول كثير منهم: إن الله منزَّه عن الظلم وفعل القبيح، وإن تأييد الكذاب بـ«المعجزة» من ذلك، بخلاف «القدر» فإنه ليس بقبيح ولا ظلم.
ومنهم من يقول: قد نعلم سُنَّة الله في عباده وما جرت به عادته، وإن كنَّا نُجوِّز عليه عقلًا أن يفعل خلاف ذلك، ونعلم من سُنَّته وعادته أنه لا يؤيد الكذاب بـ«معجزة»، كما نعلم من سُنَّته وعادته أشياء غير هذا.
وهؤلاء يقولون: يمكن تقرير كونه سبحانه منزَّهًا عن تأييد الكذاب بـ«المعجزة» من غير بناء على أصل المعتزلة. وقد سلك ذلك طوائف من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومن النُّظَّار: الكرَّامية وغيرهم ممن يُثبت «القدر».
وتقرير هذه الطريق: بما عُلم من حكمة الله تعالى في مخلوقاته، ورحمته ببريَّته، وسُنَّته في عباده؛ فإن ذلك دليل على أنه لا يؤيد كذَّابًا بـ«معجزة» لا معارض لها.
ويمكن بسط هذه الطريقة وتقريرها بما ليس هذا موضعه؛ فإنه كما عُلم بما في مصنوعاته من الإحكام والإتقان أنه عالم، وبما فيها من التخصيص أنه مريد؛ فيُعلم بما فيها من النفع للخلائق أنه رحيم، وبما فيها من الغايات المحمودة أنه حكيم.
فصل في دلالة حكمة الله ورحمته في مخلوقاته على أنه لا يؤيد كذابًا بمعجزة
والقرآن يُبيِّن آيات الله الدالة على قدرته ومشيئته، وآياته الدالة على إنعامه ورحمته وحكمته؛ ولعل هذا أكثر في القرآن؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ * أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ * نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ * عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ * أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ * أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ * لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ * إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ * أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ * لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ * أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ * أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ * نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾، وقوله: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا * وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا * وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا * وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا * وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا * وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا * وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا * وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا * وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا * لِّنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا * وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا﴾، وقوله: ﴿فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا * مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾.
وهو سبحانه في سورة الرحمن يقول في عقب كل آية: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾، وهو يذكر فيها ما يدل على خلقه وعلمه وقدرته ومشيئته، وما يدل على إنعامه ورحمته وحكمته.
وكذلك ذكر في مخاطبة الرسل للكفار؛ كقوله: ﴿قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى * قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى * قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى * كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾. ومثل هذا في القرآن كثير.
وما نُظر فيه من المخلوقات دلَّ على ذلك، وفي نفس الإنسان عبرة تامة؛ فإن من نظر في خلق أعضائه وما فيها من المنافع له، وما في تركيبها من الحكمة والمنفعة — مثل كون ماء العين مالحًا ليحفظ شحمة العين من أن تذوب، وماء الأذن مُرًّا ليمنع الذباب من الولوج، وماء الفم عذبًا ليُطيِّب ما يُمضغ من الطعام، وأمثال ذلك — عَلِم علمًا ضروريًا بأن خالق ذلك له من الرحمة والحكمة ما يبهر العقول، مع ما في ذلك من الدلالة على المشيئة.
ثم إذا استقرأ ما يجده في نوع الإنسان: من أن كل من عظُم ظلمه للخلق وإضراره لهم كانت عاقبته عاقبة سوء وأتبع اللعنةَ والذمَّ، ومن عَظُم نفعه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة خير وأتبع المدحَ والثناءَ والدعاء، وأمثال ذلك؛ استدلَّ بما علم على ما لم يعلم، حتى يعلم أن الدولة ذات الظلم والجُبن والبخل سريعة الانقضاء.
كما قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾، وقال: ﴿هَا أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.
وكذلك سُنَّته في الأنبياء الصادقين وأتباعهم المؤمنين، وفي الكذَّابين والمكذِّبين بالحق؛ أن هؤلاء ينصرهم ويُبقي لهم لسان صدق في الآخرين، وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة.
فبهذا وأمثاله يُعلم أنه لا يؤيد كذَّابًا بـ«معجزة» لا معارض لها؛ لأن في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته، وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته، وفيه من نقض سُنَّته المعروفة وعادته المطَّردة ما تمنعه مشيئته.
قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا * إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا﴾، وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ﴾، ثم قال: ﴿وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، وقال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾، ﴿قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾.
فصل في إعجاز القرآن
قلت: قد تبيَّن أن «النبوة» تُعلم بـ«المعجزات» وبغيرها على أصح الأقوال. وأما نبوة نبينا محمد ﷺ فإنها تُعلم بطرق كثيرة؛ منها «المعجزات»، ومعجزاته: منها القرآن ومنها غير القرآن، والقرآن معجز بلفظه ونظمه ومعناه. وإعجازه يُعلم بطريقين: جُمَلي وتفصيلي.
أما الجُمَلي؛ فهو أنه قد عُلم بالتواتر أن محمدًا ﷺ ادَّعى «النبوة» وجاء بهذا القرآن، وأن في القرآن آيات التحدي والتعجيز؛ كقوله تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ * قُل تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ * أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ * أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ * فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ﴾؛ فتحدَّاهم هنا أن يأتوا بمثله.
وقال في موضع آخر: ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾، وقال في موضع آخر: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾.
وأخبر مع ذلك أنهم لن يفعلوا؛ فقال: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ﴾. بل أخبر أن جميع الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يأتون بمثله؛ فقال: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾.
وقد عُلم أيضًا بالتواتر أنه دعا قريشًا خاصةً والعرب عامةً، وأن جمهورهم في أول الأمر كذَّبوه وآذوه وآذوا أصحابه، وقالوا فيه أنواع القول، مثل قولهم: «هو ساحر» و«شاعر» و«كاهن» و«معلَّم» و«مجنون» وأمثال ذلك. وعُلم أنهم لم يعارضوه ولم يأتوا بسورة من مثله، وذلك يدل على عجزهم عن معارضته؛ لأن الإرادة الجازمة لا يتخلَّف عنها الفعل مع القدرة.
ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد الإرادات على تكذيبه وإبطال حجته، وأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك، حتى قالوا فيه ما يُعلم أنه باطل بأدنى نظر، وفيلسوفهم الكبير الوحيد ﴿فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾.
وليس هذا موضع ذكر جزئيات القصص؛ إذ المقصود ذكر ما عُلم بالتواتر من أنهم كانوا من أشد الناس حرصًا ورغبةً في إقامة حجة يُكذِّبونه بها، حتى كانوا يتعلَّقون بالنقض مع وجود الفرق؛ فإنه لما نزل: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ عارضوه بالمسيح، حتى فرَّق الله بينهما بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ * وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾.
فمن عارضوا خبره بمثل هذا كيف يدَّعون معارضة القرآن وهم يقدرون على ذلك؟
وقوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ خطاب للمشركين، لم يدخل فيه أهل الكتاب، ولا تناول اللفظُ المسيحَ كما يظنه طائفة من الغالطين، بل هم عارضوه بالمسيح من باب القياس؛ يقولون: إذا كانت آلهتنا من حصب جهنم لأنها معبودة فكذلك المسيح. ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾؛ فإنهم جعلوه مَثَلًا لآلهتهم، لم يوردوه لشمول اللفظ له كما يظن ذلك بعض المصنِّفين في الأصول. ولهذا بيَّن الله الفرق بين المسيح وبين آلهتهم بأن المسيح عبد الله يستحق الثواب فلا يُعاقب بذنب غيره، بخلاف الحجارة؛ فإن في جعلها حصب جهنم إهانةً لعابدها من غير ظلم لها.
ثم انتشرت دعوته في أرض العرب، ثم في سائر الأرض إلى هذا الوقت، وآيات التحدي قائمة متلوَّة وما قدر أحد أن يعارضه بما يظن أنه مثل.
ولما جاء مسيلمة ونحوه بما أتوا به يزعمون أنهم أتوا بمثله؛ كان ما أتوا به من المضاحك التي لا تحتاج معرفة انتفاء مماثلتها إلى نظر، وذلك كمن جاء إلى الرجل الفارس الشجاع ذي اللأمة التامة فأراد أن يبارزه بصورة مصوَّرة ربطها على الفرس. كقول مسيلمة: «يا ضفدع بنت ضفدعين، نِقِّي كم تنقِّين، لا الماء تُكدِّرين، ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين». وقوله أيضًا: «الفيل وما أدراك ما الفيل، له زَلُوم طويل، إن ذلك من خلق ربنا الجليل»، وأمثال ذلك.
ولهذا لما قَدِم وفد بني حنيفة على أبي بكر، وسألهم أن يقرأوا له شيئًا من قرآن مسيلمة، فاستعفَوه فأبى أن يُعفيهم، حتى قرأوا شيئًا من هذا؛ فقال لهم الصديق: «ويحكم! أين يذهب بعقولكم! إن هذا كلام لم يخرج من إِلٍّ»؛ أي: من رَبٍّ.
فاستفهمهم استفهام المنكِر عليهم لفَرط التباين، وعدم الالتباس، وظهور الافتراء على هذا الكلام، وأن الله لا يتكلم بمثل هذا الهذيان.
وأما الطرق التفصيلية فكثيرة جدًا متنوعة من وجوه. وليس كما يظنه بعض الناس أن معجزته من جهة صرف الدواعي عن معارضته. وقول بعضهم: إنه من جهة فصاحته، وقول بعضهم: من جهة إخباره بالغيوب، إلى أمثال ذلك. فإن كلًّا من الناظرين قد يرى وجهًا من وجوه الإعجاز تقوم به الحجة وإن لم ير غيره ذلك الوجه. واستيعاب الوجوه ليس مما يتَّسع له شرح هذه العقيدة المختصرة.