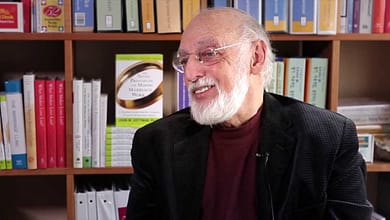مقدمة
الحمد لله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، وخصّه بالعقل والنطق، وأشهد أن لا إله إلا الله، له الحكمة البالغة، والسنن الجارية، والخلق والأمر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد: فإنّ نظر المسلم في العلوم لا يصحّ إلا بعد فقه أصولها، ولا يُثمر إلا بعد تمييز مسلّماتها من مفروضاتها، وتفريق حقائقها من زخرف ألفاظها. فإنّ من تَلقَّى العلم على عواهنه، واستسلم لمناهجه من غير تثبّت، جَرَّه ذلك إلى أوهامٍ يُحسبها يقينًا، وإلى تصوراتٍ تُبنى على فرضٍ مسكوتٍ عنه، لا على برهانٍ منصوص عليه.
وإنّ من العلوم ما يُزيَّن بقالبٍ صارم، ويُروَّج له بمظهرٍ من النظام والانضباط، فيحسبه الناظر علمًا محكمًا، وهو في باطنه مشوبٌ بطبقات من الفروض والتأويلات والتحكمات، يكشف عنها المرء عند التدبر.
وفي هذا المقال، نحاول أن نقف على ملامح المنهج العلمي في علم الاجتماع، وننظر في أصوله ومآلاته، فنُبيّن ما له من القوة، وما عليه من المآخذ، بحسب ما تجود به القريحة؛ والله الموفق للصواب.
مراتب التنظير السوسيولوجي
١- تعيين المشكلة الاجتماعية
وهي المبدأ الأول، إذ لا علم بلا مسألة تُحرّكه، ولا بحث بلا داعٍ يقتضيه. فيُختار موضوع يُعدّ “إشكاليًّا”، أي: موضوعًا ذا أثر اجتماعي ظاهر، قابل للرصد والفحص، كالسؤال: ما الأسباب التي تؤدي إلى بطالة الشباب؟
وها هنا أمر ينبغي التفطن له: وهو أنّ تعيين الإشكال ليس أمرًا مشتركًا بين العقول، بل هو تابعٌ لما في النفس من معتقدٍ، وما في الذهن من تصوّر، وما في البيئة من عرفٍ وسياق. فكم من ظاهرةٍ يعدّها قومٌ بلاءً يجب دفعه، ويعدّها غيرهم حريةً تُحمَد، كمن يرى في شيوع التبرج والرذيلة نذيرَ خسران، ومن لا يراه إلا خَيارًا مشروعًا.
ومن ثَمّ، فإنّ أول مراتب التنظير لا تستقيم إلا بقيادة معيارٍ يُهذّب النظر، ويقوم الاعوجاج، وليس لنا نحن معاشر المسلمين مِعوَلٌ في هذا الباب إلا شرعُ ربنا، الذي أنزل الميزان، وعلّم الإنسان البيان.
٢- بناء الفرضية
ثم يضع الباحث فرضًا Hypothesis، وهو قولٌ يُحتمل فيه الصدق والكذب، يربط بين متغيرين، كأن يقول: “كلّما ارتفع مستوى التعليم قلّت نسب البطالة بين الشباب”.
ويُشترط في الفرض أمورٌ ثلاثة:
١- أن يكون قابلاً للرصد والامتحان، لا يستعصي على الحسّ والعقل،
٢- وأن يصحّ تكذيبه إذا دلّت التجربة على خلافه، فلا يُؤول كلما خالف المعطيات،
٣- وأن تكون ألفاظه مضبوطة المعنى، لا تحتمل وجوهًا شتى، ولا تكتنفها غشاوة أو غموض.
وانتبه إلى أن: الفرضية لا تنشأ من فراغ، بل تُبنى على نظرٍ سابق، وتُحمل غالبًا على أُطرٍ نظرية مضمرة، فينبغي أن يُنظر فيها ومدى حجيتها.
٣- جمع البيانات
ثم ينتقل الباحث إلى الواقع، يجمع منه الشواهد التي تؤيد فرضه أو تنقضه، مستعينًا بما يناسب موضوعه من أدوات: كالاستبيان، والملاحظة، والتحليل الإحصائي، وسواها. ويُشترط في البيانات أن تكون قابلة للرصد والقياس، وأن تُجمَع بطريقة منتظمة تضمن اتساقها الداخلي وصلاحيتها التحليلية.
غير أن هذه المرحلة –على ما يظهر من حيادها– ليست خالية من إشكالات معرفية، إذ ما يُسمى “بيانات” ليس أمرًا معطًى بذاته، بل هو نتاج اختيارٍ مسبق، وتحديدٍ مفهومي، وصياغةٍ تحكمها نظرة الباحث ومصطلحاته. فالمعطى محكومٌ دائمًا بالإطار النظري الذي يُنتقى في ضوئه، وتُفسَّر فيه الوقائع. ومن أبرز أدوات جمع البيانات في علم الاجتماع:
أ) الاستبيانات Surveys: أداة فعّالة في الوصول إلى عيّنات واسعة، وتصلح لرصد الاتجاهات العامة والعلاقات الارتباطية. إلا أنها عرضة لانحيازات عدّة، كعزوف بعض المستجيبين، وسطحية الأجوبة، وضعف الدقة في صياغة الأسئلة، ما قد ينعكس على موثوقية النتائج.
ب) الملاحظة Observation: تأخذ صورتين:
- الملاحظة بالمشاركة: ينخرط فيها الباحث داخل الجماعة محل الدراسة، كما في دراسات العصابات الحضرية أو المجتمعات المغلقة.
- الملاحظة غير التشاركية: يراقب الباحث من خارج، دون أن يكون جزءًا من الحدث.
كلا النمطين مفيد، لكنه مشروط بالحذر؛ إذ تُهدّد الملاحظة بعدة مخاطر، منها: انحياز الباحث، التداخل الأخلاقي، ومحدودية التعميم من حالات جزئية إلى أنماط كلية.
ج) التجارب Experiments: قلما تُستخدم في علم الاجتماع، لكنها ذات قيمة عالية متى توفرت شروطها، خصوصًا في مجالات مثل: علم النفس الاجتماعي، وتقييم السياسات، والمحاكاة المعملية (مثل تجارب ميلغرام حول الطاعة).
غير أن القيود الأخلاقية تضيق مجالها، وتقيّد إمكانات تكرارها على نطاق واسع؛ كما في تجربة سجن ستانفورد، وتجارب ستانلي ميلغرام.
د) تحليل البيانات الثانوية Secondary Data Analysis: يقوم على استخدام بيانات جُمِعت سابقًا من مصادر مؤسسية كالتقارير الحكومية أو السجلات التاريخية. ويمتاز بانخفاض تكلفته، وبإتاحته تتبّع الظواهر على مدى زمني طويل، لكن يعوقه ضعف السيطرة على جودة البيانات الأصلية، ومحدودية القدرة على إعادة ضبط المتغيرات.
٤- التحليل والتفسير
ثم تُعرَض البيانات للتحليل، ويُطلب منها الجواب على الفرضية الموضوعة: فإن كانت من جنس الأرقام، خضعت لأدوات الإحصاء، تُقاس بها الاتجاهات، وتُستخرج منها العلاقات والأنماط؛ وإن كانت من نوع اللغة أو السلوك أو الخطاب، وُجّهت إلى تحليل المضمون، أو تفسير الرموز، أو كشف البُنى الدلالية الكامنة خلف الظاهر.
لكن هذا التحليل –وإن بدا تقنيًّا في ظاهره– لا يقع خارج التصوّر، بل هو مشروطٌ –ضرورةً– بالنموذج المعرفي الذي يحمله الباحث، وبالإطار التأويلي الذي يُحدّد له ما يُعد دليلًا، وما يُفهَم سببًا، وما يُعتَبر نتيجة. فليس ثمة قراءة بلا عدسة، ولأجل هذا ينبغي أن يُنظر في نموذج السوسيولوجي ومدى حجيته كما تقدم التنبيه عليه.
٥- التكرار والنشر والمراجعة
ثم تُعرض النتائج، وتُراجع، وتُختبر من قِبل غيره. وهذا شرط من شروط “العلمية”: أن تكون المعرفة قابلة للتكرار، والمساءلة. ولكن هذه الدعوى أضعف في حقل الاجتماع منها في حقل الطبيعة.
الأنساق التفسيرية في علم الاجتماع
المدرسة الأولى: الوضعية Positivism
الوضعية، كما أسّسها أوغست كونت Auguste Comte وشيّد أركانها دوركهايم Émile Durkheim، تُعامِل المجتمع كما تُعامَل الأجسام في الفيزياء، والغازات في الكيمياء: محكومةٌ بقوانين موضوعية، قابلة للرصد، يمكن التنبؤ بها، وضبطها تجريبيًا.
جعل دوركهايم ما سمّاه “الوقائع الاجتماعية” social facts – كالدين، والعائلة، والسلطة – كيانات خارجية، ضاغطة على الأفراد، لها وجودٌ مستقل، ويجب دراستها كما تُدرس الظواهر الطبيعية، لا بوصفها إرادات فردية بل كموضوعات صلبة.
ومن هذا الأصل نشأت دعواهم بفصل “الوقائع” عن “القيم”، وزعمهم بأن الباحث إذا أراد أن يُحسن النظر، وجب عليه أن يُجرِّد نفسه من كل انتماءٍ، فيكون أقرب إلى الآلة منه إلى الإنسان، لا يُفسِّر من داخله، بل يرصد من خارجه.
ثم بنوا على هذا جملة أدواتهم: من الاستبيانات، والإحصاءات، والنماذج التنبؤية، رجاء أن يبلغوا بها إلى “قوانين اجتماعية” Regularities عامة.
ونوجز بيان عوار هذه المدرسة بأن يقال: أنهم يختزلون الظاهرة الاجتماعية في = السلوك الظاهر من الناس، وهذه مغالطة عقلية جلية كما لا يخفى، هي مغالطة الاختزالية الوجودية causal reductionism fallacy، وتُعرف أيضا بـ: مغالطة السبب الواحد The fallacy of the single cause. صورتها: وتظهر في كل محاولة لتفسير المعقَّد بما ليس في طبيعته تعقيد، حيث يُؤخذ أحد الشروط أو المؤثرات، فيُجعل هو السبب التام، ويُسقط ما عداه، وهذا باطل من جهة العقل، لأن الظواهر المعقدة = لها أسباب معقدة، واختزالها محض سفسطة؛ ولعل المجتمع البشري من الظواهر في المعرفة البشرية بأكملها! فإن السلوك هو أثر للفاعل المختار، ومن أعظم المغالطة اختزال أسباب فيما يبدو لنا من البنى الاجتماعية.
ثم إن النظر إلى السلوك المجرد من غير لحاظ الفاعل يفضي إلى التكافؤ في التأويل undertermination by observation، فرفع اليد قد يكون سلامًا، أو استئذانًا، أو اعتراضًا، أو غير ذلك؛ ولا يُعرف معناه إلا من خلال المقام، والعرف، والعلاقة بين المتخاطبَين. فإذا أُخذ الفعل على ظاهره فقط، وأُخضع لقانون “إذا وقع كذا، لزم كذا”، كان هذا من أفسد القياس، لأنه يُسقط قصد الفاعل، ويفصل الفعل عن معناه.
والحياد المطالب من الباحث محض خيال كما تقدم الإشارة إليه؛ فالإنسان ابن بيئته، وسليل ثقافته، محكومٌ بلغته، منصهرٌ في رموزها، مفسَّر بها ومفسِّر لها، بل هو يدرس المجتمع الذي كوّنه وأعطاه أدواته. فكيف يُدعى بعد ذلك أنه “محايد”؟ بل لو كان مجردًا من السياق، لما فهم ما يراه أصلًا، لأنّ الفهم لا يتمّ إلا بلغة مشتركة، وتفسير الفعل لا يكون إلا من داخل شبكة المعنى.
فإن الباحث الاجتماعي ليس خارج الظاهرة كما في العلوم الطبيعية، بل هو جزء منها، يتكلّم بلغتها، ويُفكّر بمفاهيمها، ويرى بعينٍ صاغها مجتمعه وتاريخه وثقافته. فإذا قيل بعد ذلك: إن بإمكانه أن يكون محايدًا، مجرّدًا عن كل انتماء، فهذا قول لا حقيقة له. بل لو سلمنا إمكان -وهو غير ممكن- التنظير السوسيولوجي المتجرد عن القيم: لكان هذا موقفا أكسيولوجيا وهو فصل القيم عن البحث!
فكل باحث إنما يسأل عن ما يراه “جديرًا بالسؤال”، ويفسّر على وفق ما يراه تفسيرًا “مشروعًا”، ويصوغ النتيجة على وفق ما يقبله من المفاهيم والمواقف. ولا يُسمِّي الفعل “جريمة” أو “انحرافًا” إلا إن حكم عليه بمعيار، ولا يَقبل تفسيرًا دون آخر إلا إن كان له موقفٌ ضمنيّ. فإذا قيل بعد ذلك إن العلم “محايد”، فهذه كلمة تُقال، لا حقيقة لها، بل هي تُلقي الحجاب على الأيديولوجيا بدل أن تكشفها. وقد علم كل عاقل أن الحياد المجرّد في مسائل الإنسان ضربٌ من الادعاء، لا يقوم عليه دليل، ولا يُقِرّه واقع.
ثم إن العلوم التجريبية كالفيزياء، يمكن فيها تكرار التجربة، وضبط العوامل، وعزل المؤثرات. أما في الاجتماع، فالثورات والهجرات والأزمات لا تقع بنفس الشروط، ولا تُفهم إلا في سياقها، ولا يمكن استنساخها كما تُستنْسخ التجارب. وتعميم الحكم على وقائع غير متماثلة، مع انتفاء استقراء تامّ، ضربٌ من الجهل بقواعد الاستدلال.
المدرسة الثانية: التأويلية Interpretivism
خرجت التأويلية لا لتنافس الوضعية على أدواتها، بل لتردّ عليها أصل تصوّرها للإنسان. فالفعل البشري ليس موضوعًا خاضعًا لقياسٍ خارجي، بل تجربةٌ تُفهم من الداخل، لا يُعقل معناها إلا بالنفاذ إلى وعي الفاعل ومقصده وسياقه.
وقد أرسى ماكس فيبر Max Weber أُسس هذا النسق، مُقدّمًا مفهوم “الفهم التعاطفي” Verstehen، أي إدراك المعنى الذي ينسبه الفاعل لفعله، لا المعنى الذي يُسقطه عليه الباحث.
وهذا التوجّه استبدل أدوات الوضعية بأدوات كيفيّة: الملاحظة بالمشاركة، المقابلات المفتوحة، دراسة السياق الرمزي، وتتبع النماذج الثقافية والمعنى المتداول.
وقد مثّلت دراسته -أعني فيبر- في “الأخلاق البروتستانتية The Protestant Ethic” هذا التوجّه؛ إذ فسّر نشأة الرأسمالية الحديثة لا كمحصّلة اقتصادية محضة، بل كتحوّل ثقافي ديني تأويلي.
فتميز هذا البردايم: بتقديم النية والسياق على التكرار والقياس، ورفض “القانون الكلي” لصالح السرد التفسيري الخاص.
وهذه المدرسة وإن تجاوزت سذاجة الوضعية في تسطيحها للظاهرة الاجتماعية، وارتفعت عن اختزال الفعل الإنساني إلى مجرد السلوك الظاهر، إلا أنّها لم تنفكّ عن أصلٍ مشتركٍ معها، وهو الإقرار – بصيغةٍ أو بأخرى – بإمكان الفصل بين المعرفة والوضع القيمي، أو على الأقل إمكان تحييد القيم عن صلب النظر العلمي. فيكون علم الاجتماع وصفيا descriptive بإطلاق لا معياريا prescriptive؛ وقد تقدم إبطال هذه المقالة.
يقول الأستاذ في جامعة ولاية فرامنغهام هنري تيشلر Henry L. Tischler في مقدمته لعلم الاجتماع ص46:
كان ماكس فيبر يرى أنّ وظيفة العالِم الاجتماعي أن يصف الواقع ويبيّنه، لا أن يضع للناس ما ينبغي أن يكون عليه. وقد كان غرضه أن يُؤسّس لعلم الاجتماع على أساس خالٍ من القيم.
إلا أنّ عددًا متزايدًا من علماء الاجتماع اليوم يُقِرّون بأنّ البحث الخالي تمامًا من القيم قد لا يكون أمرًا ممكنًا. بل إنّ من الاتجاهات التي ظهرت في علم الاجتماع حديثًا – وقد تُفضي إلى الإضرار بهذا الحقل العلمي – أن بعض من يغلب عليهم الميل إلى الإصلاح الاجتماعي أكثر من اهتمامهم بالبحث العلمي قد تخلَّوا عن كلّ ادعاء بالحياد والموضوعية.
وعلم الاجتماع، كسائر العلوم، يتشكّل تحت تأثير عوامل تُحمّل البحث حملاً بقِيَمٍ معينة. وقد عدّد غونار ميردال (1969م) ثلاثة من تلك العوامل البارزة:
(1) التقليد العلمي الذي يتربّى فيه العالِم،
(2) والبيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يتلقى فيها العالِم تكوينه العلمي، والتي يجري فيها بحوثه،
(3) وطباع العالِم نفسه، وميوله، واهتماماته، وهمومه، وتجربته الحياتية.
وهذه العوامل تكون أشدّ أثرًا في علم الاجتماع خاصّة، لأنّ الباحث – في الغالب – جزء من المجتمع الذي يدرسه.
المدرسة الثالثة: الواقعية النقدية والنظرية النقدية Critical Realism & Critical Theory
أتت الواقعية النقدية –على يد روي بهاسكار Roy Bhaskar ثم مارغريت آرتشر Margaret Archer– لتجيب عن معضلتين: سطحية الوضعيين، ونسبية التأويليين. فقالت: إن الواقع الاجتماعي ذو طبقات ثلاث:
- التجريبي empirical: ما يُدرك بالحس.
- الفعلي actual: ما يقع في الواقع، وإن لم يُدرَك.
- الواقعي real: ما يوجد كبنية مولّدة، سواء ظهر أم لم يظهر.
وادّعت أن وظيفة العالِم ليست في مجرد ملاحظة ما يكون، كما زعم الوضعي، ولا في التماهي مع المعنى الظاهر كما رغبت التأويلية، بل في الكشف عن البنية المنتجة للظاهرة، كالعلاقات الطبقية، والسلطة الأبوية، والهياكل التعليمية. وذلك بما سمّوه الارتجاع retroduction: أي الانتقال من الأثر الظاهر إلى السبب الغائب، ومن العرض الجزئي إلى العلة التحتية.
وإلى جانب هذه الرؤية الأنطولوجية، جاءت النظرية النقدية، على يد مدرسة فرانكفورت (هوركهايمر، أدورنو، ماركوز)، لتقول: ن المعرفة ليست حيادية، بل مُنتَجة داخل علاقات الهيمنة. وإنّ العقل الحديث قد فسد، بتحوّله إلى “عقل أداتي”، يرى كل شيء أداة، حتى الإنسان نفسه. وإنّ التنوير الذي وعد بالتحرر، انتهى إلى سيطرةٍ أكثر دهاءً: سيطرة السوق، والتقنية، والبُنى الرمزية.
ولا يخفى ما في هذا التصور من الغلو والإفراط، من جهة وقوعها في الاختزالية كأخواتها الأخرى، ونحن لا نعيب التبسيط إن كان غرضه أداتيا، ولكننا ننقم عليهم اعتقاد أن ذلك التصور الاختزالي مطابق للواقع. ومن جهة إفراطهم في تعظيم شأن السلطة، ولنا أن يقال لهم: إذا كان كلُّ تأويل محكومًا بالهيمنة، فإن هذا التأويل النقدي نفسه لا يخرج عن كونه فعلًا سلطويًا، فتسقط دعواكم!
خاتمة
وختام القول في هذا الباب؛ أن علم الاجتماع علمٌ بين منزلتين: لا هو علم تجريبي محض، ولا هو فلسفةٌ محضة. وهو يطمح إلى “العلمية”، لكنه مكبّل بقيود المعنى، والتاريخ، والذات، واللغة. فهو: لا يُمكن أن يكون محايدا كما رامه أنصار الوضعية، وهذا يعود لطبيعة موضوعه نفسه كما تقدم بيانه.
لكنه –مع ذلك– علم نافع، إذا وُضع في نصابه، وعلِم الباحث حدوده، وأبصر منطقه، واستعان بالله على طلب الحق فيه.
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
_______________________________________
Henry L. Tischler’s Introduction to Sociology (9th Edition)
Fulbrook, M. (1978). Max Weber’s “Interpretive Sociology”: A Comparison of Conception and Practice. The British Journal of Sociology, 29
Bohman, J. (2005). Critical Theory (Stanford Encyclopedia of Philosophy). Critical Theory: The Stanford Encyclopedia of Philosophy.