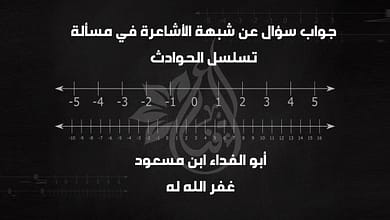الحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله، أما بعد: فقد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح أن الله تعالى متصف بصفات الكمال، منزّه عن جميع صفات النقص، قائم بنفسه، واجب الوجود لذاته، غنيٌّ عمّن سواه، وكل ما سواه ممكنٌ مفتقر إليه، لا قيام له إلا به، ولا دوام له إلا بمدده؛ وهذا مقال في نصب الأدلة العقلية على وجوب الكمال للباري.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الأكملية:
قد ثبت أن الله قديم بنفسه، واجب الوجود بنفسه، قيوم بنفسه، خالق بنفسه، إلى غير ذلك من خصائصه. والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال في جميع هذه المعاني.
فإذا قيل: الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لابد له من واجب، فيلزم ثبوت الواجب على التقديرين، فهو مثل أن يقال: الموجود إما قديم وإما حادث، والحادث لابد له من قديم، فيلزم ثبوت القديم على التقديرين. والموجود إما غني وإما فقير، والفقير لابد له من الغنى، فلزم وجود الغنى على التقديرين. والموجود إما قيوم بنفسه وإما غير قيوم، وغير القيوم لابد له من القيوم، فلزم ثبوت القيوم على التقديرين، والموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق، والمخلوق لابد له من خالق غير مخلوق، فلزم ثبوت الخالق غير المخلوق على التقديرين ونظائر ذلك متعددة.
فإذا صح ما تقدم، فنقول: أن الكمال المطلق هو اتصاف بصفات وجودية لا يلزم منها النقص من وجه من الوجوه، فهي زيادة في الوجود؛ وغاية ما يمكن أن يتصف به الموجود. وأما النقص فلا يعقل إلا أن يكون: عدم كمال، أي وصف عدمي مثل الجهل؛ أو وجود منافِ لكمال آخر، بمعنى أن يكون وصفا وجوديا يستلزم عدميا (أو عدما لكمال آخر)، مثل الألم الذي يستلزم العجز، فهو وجود ووصف ثبوتي يلازم فقدان كمال القدرة. وبيان امتناع اتصاف الباري عز وجل بالنقص من وجوه:
الوجه الأول: في بيان أن المعلول لا يكون أكمل من علته
أن المعلول إنما يستفيد كماله من الأكمل منه، فالذي جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال منه، والذي جعل غيره قادرًا أولى بالقدرة، والذي علم غيره أولى بالعلم، والذي أحيا غيره أولى بالحياة.
لأن النقص لا ينتج الكمال، وقد تقدم ان النقص وصف عدمي أو مستلزم لعدمي، فلازم قول من يقول بأن الواجب ناقص، وأنه العلة التامة للممكنات: أن النقص باعتباره غياب الكمال أنتج الكمال، فيكون عدم الشيء مسببا لوجوده، فينتج العدمي الوجودي = وهو باطل في بداهة العقول.
الوجه الثاني: في بيان ملازمة النقص للامكان
نقول وبالله التوفيق: (أ) كل ما تقبل صفاته الذاتية العدم فهو ممكن. (ب) كل ناقص تقبل صفاته الذاتية العدم. (أ) + (ب) = كل ناقص ممكن.
بيان (أ): أن ما يصدق على ذات الواجب من المعاني: إما أن الذات تقتضيه أو لا، على الأول يثبت وجوبها وهو المطلوب، على الثاني تفتقر الذات في حصول ذلك المعنى إلى غيرها. فإن قيل: لم لا يكون المرجح داخل الذات لا خارجها؟ قيل: يلزم أن تكون صفاته الذاتية معلولة لصفاته وهو دور ممتنع؛ وإن جاز الإمكان في بعض الصفات [المعاني التي تصدق على الذات] جاز في جميعها، لعدم الفارق المؤثر.
بيان (ب): بيانه بالخلف؛ أن النقص بالتعريف غياب للكمال، فلو لم يقبل الناقص أن يكون أكمل لزم أنه غياب كمال ممتنع، والكمال وجودي والممتنع ليس بشيء، وهذا تناقض؛ فعُلم أن أن أي معنى هو نقص قابل للعدم ضرورة. وقد يقال: أنه يلزم على فرض وجوب النقص تناقض مع مسمى النقص نفسه، الذي يلزم من مجرد انطباق مسماه جواز وجود حالة هي أكمل في عوالم الإمكان، وإلا فقد النقص معناه.
ومن ثم فالواجب لا يكون إلا في منتهى الكمال والله الموفق.
الوجه الثالث:
الكمال (الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه) إذا كان ممكنًا لموجودٍ ما، فإما أن: يكون ممكنًا لواجب الوجود، أو يكون ممتنعًا عليه. إن قيل: هذا الكمال ممتنع على واجب الوجود، لزم أن يكون الموجود من حيث هو غير قابل للكمال. فإذا لم يكن الواجب قابلاً للكمال، فالممكن أولى بعدم القبول، لأنه أضعف منه وجودًا وافتقارًا. لكن هذا باطل؛ لأن الواقع يشهد بوجود موجودات (ممكنة) تتصف بكمالات. إذن، لا يصح القول بأن الكمال ممتنع على واجب الوجود، بل هو ممكن له.
إذا ثبت إمكان الكمال، فهذا الكمال الممكن، إما أن: (أ) يكون لازمًا للموجود (بحيث لا يكون إلا متصفًا به). (ب) يكون جائزًا (يمكن أن يتصف به أو لا يتصف به). فإن كان جائزًا، لزم احتياج الموجود إلى مرجّح خارجي يرجّح اتصافه به. فتعين اتصاف الله تعالى بصفات الكمال، وأنها لازمة له.
الوجه الرابع: في لزوم الشك في العقل
نقول وبالله التوفيق: المسلّمة axiom (أ): الضرورات العقلية – كصحة مبدأ الهوية – صادقة.
(1) العلم بالضرورات العقلية حاصلٌ لنا بشعورٍ وجدانيٍّ قهريّ لا يمكن دفعه، وهذا الشعور القهريّ هو علة اتصال العلم بالمعلوم الضروري، لا مجرد صورة معرفية لاحقة عليه.
(2) لو أمكن أن يكون هذا الشعور على خلاف ما هو عليه – أي أن نُخدع فيه – لاقتضى ذلك إمكان وجود علم ضروري كاذب، وهو خلاف المسلمة (أ).
(3) إذن: يمتنع أنطولوجيًا وجود ما لو وُجد لأفضى إلى خداعنا في هذا الشعور الضروري القهري، بحيث يُفضي إلى علم ضروري باطل.
(4) إلا أن هذا الامتناع ليس من قبيل الامتناع الذاتي أي بما هو متناقض في ذاته – بل هو امتناع غيري، أي ناشئ عن وجود مانع في الخارج يمنع تحققه، لا عن ذات الفرض نفسه.
(5) ولو فُرض جواز صدور القبيح من الإله، لجاز منه هذا النوع من الخداع، لأن خداع العباد في الضرورات – مع تعلق قدرتهم به – داخل في جنس القبيح. وقد عُلم أن نسبة فعله للقبيح وتركه سواء، فيلزم التكافؤ ومن ثم يرتفع المانع ويبطل الامتناع الغيري في (4)؛ ولا يقال أن شعورنا الضروري هو مرجح أحد الطرفين، إذ ذلك جائز في احتمال التصور الفاسد أيضا. فيلزم التكافؤ بين:
1- رجح الإله شعوري الضروري بصدق معلوم خاطئ،
2- ورجح الإله شعوري الضروري بصدق معلوم صادق؛ ومتى ما حصل التساوي والتكافؤ بطل ترجيح أحد الاحتمالين، وهو خلاف المسلمة (أ) حيث جزمنا بصدق الضرورات.
(6) فيلزم أن الجهة المانعة التي تحقّق الامتناع الغيري لوقوع الخداع الضروري، لا بد أن تكون: استحالة صدور القبيح من الإله؛ ولما كان ذلك ممكنا في نفسه كان مقدورا، فيكون ممتنعا للغير لمخالفته صفة الإله الواجبة له، ونحن لا نريد بصفة الحكمة إلا هذا.
وإن قيل: بأن ما قررناه دور، أجيب: بأنه دور اقتراني جائز، كما لو قيل: العلم بامتناع جمع النقيضين متوقف على العلم بمبدأ الهوية، والعلم بمبدأ الهوية متوقف على العلم بامتناع الجمع بين النقيضين.
وهذا – أكرمكم الله تعالى – منتهى الكلام في هذا الباب، ولباب العقول والألباب، ومترع في المسألة من التحقيق والتدقيق، يشهد له كل منصف بالصواب.