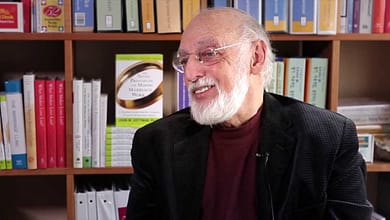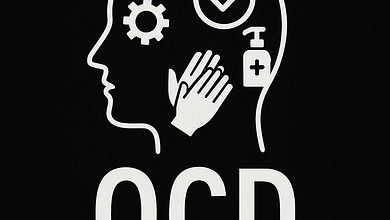مقدمة
باسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم
الحمدُ لله الذي أنزل على عبده الكتابَ تِبياناً لكلِّ شيء، وهدىً ورحمةً للعالمين، والصلاة والسلام على مَن بُعِث بالشريعة الكاملة التي ما تركت من خيرٍ إلا دلّت عليه، ولا من شرٍّ إلا حذّرت منه.
أما بعدُ، فإنَّ من عجائبِ الخَلْقِ وبدائعِ الصُّنعِ أنْ جعلَ اللهُ تعالى في بني آدمَ قُدرةً عجيبةً على مُغالبةِ الخُطوبِ ومُدافعةِ الكُروب، حتى إنَّ الناظرَ المُتأمِّلَ ليعجبُ من قومٍ نشؤوا في أحضانِ المِحَنِ وترعرعوا في أكنافِ الفِتَن، ثم خرجوا من ذلك كُلِّه كالذَّهبِ الإبريزِ الذي تَمَحَّصَ بالنارِ فازدادَ صفاءً وبريقاً.
وقد كانَ من أوائلِ من تنبَّهَ إلى هذه الظاهرةِ من أربابِ الصَّنعةِ النفسانيةِ في النِّصفِ الثاني من القرنِ العشرين الميلادي النفسانيةُ إيمي فيرنر Emmy Werner في دراستِها الممتدة الطُّوليةِ المشهورةِ التي ابتدأتْها في سنةِ 1955، في جزيرةِ كاواي من جُزُرِ هاواي.
وقد تتبَّعتْ هي ومن معها من أهلِ الاختصاصِ 698 وليدٍ من مواليدِ تلك السَّنة، وأطالوا النَّظرَ في أحوالِهم أربعينَ حَولاً كاملةً. وكان ثُلُثُهم – وهم 210 – قد نشؤوا في ظروفٍ من القَسوةِ والشِّدَّةِ ما تَنُوءُ بحملِه الجبالُ الرَّواسي، من فقرٍ مُدقِعٍ يُذِلُّ الأعناق، وإدمانِ الوالدَينِ على الخمورِ والمُسكِرات، وعُنفٍ أُسَريٍّ يَفُتُّ في الأكباد.
والعَجَبُ أنَّ ثُلُثَ هؤلاءِ المساكينِ المُعرَّضينَ للهَلَكةِ – وعِدَّتُهم اثنانِ وسبعونَ نفساً – نَمَوا وشَبُّوا عن الطَّوقِ حتى صاروا من أهلِ السَّواءِ والاستقامة، بل من ذوي النَّجاحِ والفلاح، مما أدخلَ الحَيرةَ والدَّهشةَ على قلوبِ الباحثينَ، وحَمَلَهم على التساؤلِ: ما سِرُّ هذه المَنَعةِ النفسانية؟ وما كُنْهُ هذا الصُّمودِ العجيب؟
ثم تتابعتِ الدراساتُ وتوالتِ الأبحاثُ من بعد ذلك، فجاءَ نورمان جارميزي Norman Garmezy في عَقدِ السبعيناتِ من القرنِ المُنصَرِم، فصَرَفَ هِمَّتَه إلى دراسةِ أولادِ الأُمَّهاتِ المُبتَلَياتِ بداءِ الفُصامِ العقلي Schizophrenia، وهو من أشدِّ أدواءِ النَّفسِ وأعضَلِها. فوَجَدَ أنَّ كثيراً من هؤلاءِ الأطفالِ أظهروا قُدرةً باهرةً على التَّكَيُّفِ السَّويِّ والنُّموِّ الصحيح، رُغمَ ما يُحيطُ بهم من ظروفٍ مُربِكةٍ مُقلِقة. وصولا إلى عَقدِ الثمانيناتِ حيث برزَ مايكل رَتر Michael Rutter الذي وضعَ الأُسُسَ النظريةَ الراسخةَ لنظرية الصُّمود.
غير أنَّ مَن نَظَرَ بعينِ البصيرةِ الإيمانيةِ، وتأمَّلَ في آيِ الذِّكرِ الحكيمِ ومأثورِ الحديثِ الشريف، لم يَستَغرِبْ من ذلكَ ولم يَعجَبْ. فإنَّ الذي أدرَكَهُ أولئكَ القومُ بعد كَدٍّ طويلٍ ونَظَرٍ في أحوالِ الخَلقِ، قد جاءَ به الوحيُ المُنزَّلُ أساساً راسخاً وعِماداً ثابتاً في بناءِ شخصيةِ المُومِن.
وهذا المقالُ – بإذنِ اللهِ ومَشيئتِه – محاولةٌ للاقترابِ من هذا الموضوعِ الجليل. فنحنُ عارِضونَ فيه ما انتهى إليه عِلمُ النَّفسِ المُحدَثُ في تبيانِ حقيقةِ الصُّمودِ النفسيِّ وأُصولِه، ثم نَصعَدُ من ذلكَ إلى مَنزِلةٍ أرفع، ونَستقي من مَعينٍ أعذبَ وأزكى.
فنُجَلّي كيف أنَّ دينَ الإسلامِ شَرَعَ للمُومِنِ نَهجاً قَويماً لتَحصيلِ هذا الثَّبات، بل لتَعَدّيه إلى مَنازِلِ اليَقينِ والتَّسليم. وكيف أنَّ التَّصديقَ بالله، والتَّفويضَ إليه، والأَناةَ عندَ البَلاء، والحَمدَ زَمَنَ الرَّخاء، هي الأُصولُ التي ما قامَت نَفسٌ إلا بها، ولا ثَبَتَ قَلبٌ عندَ النَّوائبِ إلا عليها.
في ماهية الصمود النفساني
اعلم أنَّ الصُّمودَ النفسانيَّ Resilience هو قُدرةُ النَّفسِ الإنسانيةِ على التَّكَيُّفِ الإيجابيِّ الفَعَّالِ في مواجهةِ الشدائدِ والنَّوائب، والمِحَنِ والمصائب، والصَّدَماتِ والكوارث. وليس هو مُجرَّدَ البقاءِ على قَيدِ الحياة، أو النَّجاةِ من الهَلَكة، بل هو النُّموُّ والازدهارُ والإثمارُ رُغمَ الظروفِ القاهرةِ والأحوالِ القاسية.
أما في ديننا الحنيف، فإن المَنَعة النفسانية أعمق من ذلك وأرسخ؛ تتجلى أبلغ تجلي في مفهوم الصبر، قال أبو محمدٍ الجريري: «الصبرُ أن لا يفرِّق بين حالِ النعمةِ والمِحنة مع سكونِ الخاطرِ فيهما».
فالمؤمن الحق لا يكتفي بمجرد التكيُّف مع المحنة أو التعافي منها، بل يرتقي إلى مقامٍ أسمى، وهو مقام الرضا بالقضاء، والشكر على البلاء، واعتقاد أن في طيِّات المحنة منحةً، وفي ثنايا البلية عطيةً. وقد تكرَّرت مادةُ «صبر» في الذِّكرِ الحكيم في مواضعَ كثيرةٍ أمرًا ووعدًا وثناءً ومعيّةً ومحبّة: ﴿واصبرْ وما صبرُك إلا بالله﴾، ﴿فاصبرْ كما صبرَ أولو العزمِ من الرُّسل﴾، ﴿يا أيُّها الذين آمنوا اصبروا وصابروا﴾، ﴿واللهُ يحبُّ الصابرين﴾، ﴿واصبروا إنّ اللهَ مع الصابرين﴾. وقال عليٌّ رضي الله عنه: «الصبرُ من الإيمان بمنزلةِ الرأسِ من الجسد»، وقال عمرُ: «وجدْنا خيرَ عيشِنا بالصبر».
وينبغي للناظرِ أن يَعلَمَ أنَّ الصُّمودَ ليس بالصِّفةِ الثابتةِ الراسخةِ في الإنسانِ، بل هو عمليةٌ مُتحرِّكةٌ مُتغيِّرةٌ تتأثَّرُ بعواملَ شتَّى وأسبابٍ مُتعدِّدة. فتَرى الإنسانَ الواحدَ يُظهِرُ صُموداً في موطِنٍ ويَفتَقِدُه في آخر، ويكونُ صامداً قويّاً في طَورٍ من أطوارِ حياتِه، ضعيفاً واهِناً في طَورٍ آخر.
وقد كشفتْ دراساتُ التصويرِ الدِّماغيِّ بالأجهزةِ الحديثةِ أنَّ الأشخاصَ الذين حَباهُمُ اللهُ بصُمودٍ عالٍ يُظهِرونَ:
- أولاً: نشاطاً زائداً في القِشرةِ الجَبهيةِ الأماميةِ Prefrontal Cortex، وهي المنطقةُ المسؤولةُ عن تنظيمِ الانفعالاتِ وضَبطِها.
- ثانياً: استجابةً أقلَّ في اللَّوزةِ الدِّماغيةِ Amygdala عندَ مواجهةِ المُثيراتِ المُهدِّدةِ المُخيفة.
- ثالثاً: مرونةً أكبرَ في مِحورِ الوِطاءِ-النُّخاميةِ-الكُظْريةِ (HPA Axis)، وهو المِحورُ المسؤولُ عن الاستجابةِ للضُّغوطِ والكُروب.
وظهر في الدراساتُ الطُّوليةُ المُمتدَّة Longitudinal Studies، من أشهرِها دراسةُ جرانت Grant Study في جامعةِ هارفارد العريقة، التي تابعتْ أربعةً وعشرينَ وسبعَمائةِ رجُلٍ على مدى ثمانينَ حَولاً كاملاً. وقد أظهرتْ – بما لا يَقبلُ الجَدَل – أنَّ العلاقاتِ الاجتماعيةَ الدافئةَ الحانيةَ كانت أقوى مُنبِئٍ بالصُّمودِ.
في شروطِ الصُّمودِ ومُقوِّماتِه
اعلم – وفَّقكَ اللهُ لِما يُحِبُّ ويَرضى – أنَّ للصُّمودِ النفسانيِّ شروطاً لا يتحقَّقُ إلا بها، ومُقوِّماتٍ لا يقومُ إلا عليها. منها ما هو داخليٌّ نابعٌ من ذاتِ الإنسانِ وجِبِلَّتِه، ومنها ما هو خارجيٌّ مُتعلِّقٌ بمُحيطِه وبيئتِه.
- أولاً: الوعيُ الذاتيُّ Self-Awareness، وهو معرفةُ المرءِ لنفسِه معرفةً صحيحة، وإدراكُه لمواطِنِ القُوَّةِ فيه ومَكامِنِ الضَّعف. فمَن جَهِلَ نفسَه كان عن معرفةِ قُدراتِه أجهل، ومن ثَمَّ عَجَزَ عن حُسنِ التصرُّفِ والتدبيرِ عندَ حُلولِ المِحَن.
ومن تمام معرفة المرء بنفسه: أن يعلم أنه عاجز عن استجلابِ نفعٍ أو دفعِ ضُرٍّ إلا بحولِ اللهِ وقوتِه. فإذا أيقنَ العبدُ بهذه الحقيقةِ، وعلَّقَ قلبَهُ بربِّهِ، وفَوَّضَ إليهِ أمرَهُ كلَّهُ، فقد أقامَ لنفسِه حِصنًا منيعًا لا تهدمُهُ الخطوبُ، وركنًا شديدًا لا تُزلزلُهُ الكروبُ. فالتوكُّلُ هو الذي يُحوِّلُ المعرفةَ بالضَّعفِ البشريِّ إلى قوةٍ بالإيمانِ، ويُبدِّلُ الشعورَ بالعجزِ إلى سكينةٍ ورضًا.
فمن أعظم ما يُحصِّن النفس ويُقوِّيها هو إيمانها الراسخ بأن الله سبحانه هو المتصرِّف في الكون، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله: “أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد حركاتهم وسكناتهم وإراداتهم… فلا يتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته… فانظر إلى الذي سلطهم عليك، ولا تنظر إلى فعلهم بك، تستريح من الهم والغم والحزن”. وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ رحمه الله: «الصبرُ اعترافُ العبدِ لله بما أصابه منه، واحتسابُه عند الله رجاءَ ثوابِه، وقد يجزعُ الرجلُ وهو متجلِّدٌ لا يُرى منه إلا الصبر».
- ثانياً: التنظيمُ الانفعاليُّ Emotional Regulation، وهو القُدرةُ على ضَبطِ الانفعالاتِ وتوجيهِها الوِجهةَ السليمة. وقد أثبتتْ دراساتُ جروس (Gross, 2014) أنَّ القُدرةَ على إعادةِ التقييمِ المعرفيِّ Cognitive Reappraisal من أقوى مُنبِئاتِ الصُّمود.
ومعناه: أن يُغيِّر المرءُ نظرتَه إلى الأحداث المؤلمة، فيراها من زاويةٍ أخرى تُظهِر ما فيها من الخير المستور، والنفع المحجوب.
وهذا في دين المسلمين واجب وعبادة يتقرب بها إلى الله، وقد نبه إلى ذلك ابن القيم بقوله في عدة الصابرين: “للَّه على العبد عبوديّة في عافيته وفي بلائه، فعليه أن يُحسِن صحبةَ العافية بالشكر، وصحبةَ البلاء بالصبر”.
فقد قرَّر القرآن الكريم أن الابتلاء سُنَّة من سُنن الله في خلقه، وأنه لا مناص منه لأحد. وقد ورد في الحديث: “أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ”. فإذا استقر هذا المعنى في قلب المؤمن، لم يُفاجأ بالمحن إذا نزلت، ولم يستنكرها إذا حلَّت، بل يتلقَّاها بصدرٍ رحب ونفسٍ مطمئنة.
وأعجب من ذلك أن الإسلام يُعلِّم أتباعه النظر إلى البلاء على أنه نعمة ومنحة مُستترة. فهو إما تكفيرٌ للسيئات، أو رفعٌ للدرجات، أو تمحيصٌ للقلوب، أو تذكيرٌ بالآخرة.
قال ﷺ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ، وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «مَا مِنْ وَجَعٍ يُصِيبُنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحُمَّى، لِأَنَّهَا تَدْخُلُ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي كُلَّ مَفْصِلٍ قِسْطًا مِنَ الْأَجْرِ». وقال النبي ﷺ في أمرِ الطاعون: «من مكثَ في بلدِه صابرًا محتسبًا، يعلمُ أنّه لا يُصيبُه إلا ما كتبَ اللهُ له، كان له مثلُ أجرِ شهيد».
– ومن ذلك: تذكُّرُ ما أعدَّ اللهُ للصابرين من الأجر العظيم، والثواب الجزيل. فإن النفسَ إذا علمت أن وراء الصبر على المكروه خيراً عظيماً، هان عليها احتمالُ المشاقّ، وحَلَت لها مرارةُ الصبر. وقد جاء في الحديث: «مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ».
– وأن البلاء سلم يرتقي به العبدُ في مدارج الكمال، ومِعراجاً يَصعَدُ به في درجات القُرب من الحقِّ تبارك وتعالى. فكم من عبدٍ ما بَلَغَ المنازلَ العالية إلا بصبره على البلاء، واحتسابه للمشقّة! وقد جاء في الحديث: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ».
– واتهامَ النفسِ بالتقصير، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾. قال عمرانُ بنُ حصينٍ رضي الله عنه وقد ابتُلي في جسده: «ما أراه إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر». فيرى في بلائه عدل ربه فيزداد بذلك حمدا وشكرا.
بل أبعد من ذلك: أن يَفرحَ العبدُ بالبلاء كما يَفرحُ بالنَّعماء، لِما يَرى فيه من عناية الحقِّ به، واصطفائِه له. قال ﷺ: «أشدُّ الناسِ بلاءً الأنبياء، ثم الصالحون… وإن كان أحدُهم ليفرحُ بالبلاءِ كما يفرحُ أحدُكم بالرَّخاء». وروي عن عبدِ الرحمنِ بنِ عوف: «بلينا بالضَّراء فصبرْنا، وبلينا بالسَّراء فلم نصبر». وقال سفيانُ الثوري: «ليس بفقيهٍ من لم يعدَّ البلاءَ نعمةً والرَّخاءَ مصيبة».
وروي عن السلف أن رجلا من الزَّمنى قد قطع الجُذامُ يديه ورجليه، فما زاد على أن قال: “إن كنتَ إنما ابتليتني لِتُثيبني وتأجُرني وتجعل بلاءَك لي سبباً إلى رحمتك بي، فمَن مِن عبادك أعظمُ نعمةً ومِنّةً مننتَ بها عليّ إذ رأيتني لاختبارك لها أهلاً؟”.
وقد قال شُريحٌ رحمه الله: «إني لأُصابُ بالمصيبة، فأحمدُ اللهَ عليها أربعَ مرّات: أحمدُ إذ لم يكن أعظمَ منها، وأحمدُ إذ رَزَقَني الصبرَ عليها، وأحمدُ إذ وَفَّقَني للاسترجاع لِما أرجو من الثواب، وأحمدُ إذ لم يجعلْها في ديني». وقال الحسنُ: «إن لم نُؤجرْ إلا فيما نحبُّ قلَّ أجرُنا؛ وإن الله كريمٌ يبتلي العبدَ وهو كاره، فيُعطيه عليه الأجرَ العظيم».
- ثالثاً: الكفاءةُ الذاتيةُ Self-Efficacy، وهي ثِقةُ المرءِ في قُدرتِه على التعامُلِ مع التحدِّياتِ ومُجابَهةِ الصِّعاب، كما بيَّنَ “باندورا” Bandura في نظريَّتِه المشهورة. فمَن فَقَدَ الثِّقةَ في قُدراتِه استسلَمَ للمِحَنِ قبلَ أن يُجرِّبَ مُقاومتَها.
وقد شبَّه ﷺ المؤمنَ بالخامةِ من الزرع: تميلُها الريحُ فإذا اعتدلتْ تكفّأَتْ بالبلاء؛ والفاجرُ كالأرزةِ الصمّاء حتى يقصِمَها الله. فالقوّةُ الحقّةُ هي الانثناءُ بلا انكسار، والعودُ إلى الاستقامةِ بعدَ الاهتزاز. وهذه هي «مرونةُ العقل» التي تُحسنُ التكيُّفَ مع الحالِ المتغيِّر، فلا يغلُظُ القلبُ حتى ينقصِم.
- رابعا: القدوات الحسنة، فوجود قدوات صالحة ممَّن تجاوزوا المحن بنجاح وفلاح، يُعطي الأمل ويُنير الطريق، ويُبيِّن أن الخلاص ممكنٌ والنجاة متاحة.
فإن النفوسُ تشتدُّ بالأسوة؛ وأعلى الأسوةِ الأنبياءُ، ثم الصالحون. وقد قيلَ: أيُّ الناسِ أشدُّ بلاءً؟ فقال ﷺ: «الأنبياءُ»، قيل: ثم من؟ قال: «ثم الصالحون… وإن كان أحدُهم ليفرحُ بالبلاءِ كما يفرحُ أحدُكم بالرَّخاء». وعن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رضي الله عنه: «بلينا بالضرّاءِ فصبرْنا، وبلينا بالسَّراء فلم نصبر». وفي قصةِ المرأةِ السوداءِ أنّها قالت: «إني أصرعُ وأتكشّفُ، فادعُ اللهَ لي»، فقال ﷺ: «إن شئتِ صبرتِ ولكِ الجنّة، وإن شئتِ دعوتُ اللهَ أن يعافيَك»، قالت: «أصبر»، ثمّ قالت: «إني أتكشّفُ، فادعُ اللهَ أن لا أتكشّف»، فدعا لها.
- خامسا: التفاؤل المتعلَّم Learned Optimism: ومن الناس من يُؤتى قوَّةً في حُسن الظن بالعواقب، وهو ما سمَّاه “سيليجمان” Seligman بالتفاؤل المُكتَسَب المُتعلَّم. وهذا ضَربٌ من ضُروب النظر يُكتسَب بالمجاهدة والممارسة، حتى يصير العقلُ مائلاً إلى استشراف الخير في المآلات، واستنباط الحِكم من المحن.
فإن من آكدِ أدواتِ الصمودِ كبحُ جماحِ النفسِ عند هجمةِ الخاطر؛ فإن الخواطرَ إن سُكنت صارتْ مُنى، ثم همومًا، ثم إراداتٍ، ثم عزمًا. ومن هديِ الشريعةِ الاسترجاعُ عند الصدمةِ الأولى، أن يقولَ العبدُ: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، ويشغلَ لسانَه بالحمدِ والذكر. وقد سمى النبي ﷺ الصبرَ «ضياءً»: نورًا فيه حرارةُ مجاهدة. وقد ذكر ابن القيم في عدة الصابرين أن دواءَ الصبر مركبٌ من «جزءٍ علميٍّ» (إدراكِ خيرِ المأمور وشرِّ المحظور) و«جزءٍ عمليٍّ» (تعاطي كفِّ الجوارحِ والخواطر)، وأنّ «التصبُّر» تدريبٌ يثمرُ صبرًا.
- سادسا: أن يُلزِمَ المرء نَفسَه بشُكرِ النِّعَمِ والاعترافِ بالفَضل، فيَتَفَقَّدَ في كُلِّ يومٍ ما أنعَمَ اللهُ به عليه من خَفِيِّ اللُّطفِ وجَلِيِّ الفَضل، ويُحصيها إحصاءً، ويَشكُرُها شُكراً، فإنَّ في ذلك دَواءً للنُّفوسِ المَكلومةِ وشِفاءً للقُلوبِ المَحزونة.
واعلم أن الصمود النفسانيّ مَلَكةٌ قابلة للاكتساب والتحصيل، وخَصلة يمكن صقلها وتهذيبها. وقال ﷺ: «ومن يتصبَّرْ يُصبِّرْه الله»؛ فالتكلّفُ أوّلًا يورثُ السجية. ومن كلامِ العقلاء: «العاقلُ عند نزولِ المصيبةِ يفعلُ ما يفعله الأحمقُ بعد شهر»؛ فإذا كان آخر الأمر الصبر، والعبد غير محمود، فما أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره به الأحمق في آخره. وسُئل ربيعةُ: ما منتهى الصبر؟ قال: «أن يكونَ يومُ تُصيبُه المصيبةُ مثلَه قبل أن تُصيبه».
وقد قال أهلُ التحقيق: الصبرُ مصارعةٌ بين باعثِ العقلِ والدينِ وباعثِ الهوى والنفس. والغلبةُ تُنالُ بتقويةِ هذا وتضعيفِ ذاك:
- تضعيفُ باعثِ الهوى: بقطعِ الذرائع، والتفكّرِ في مفاسد المعصيةِ دينا ودنيا.
- تقويةُ باعثِ الدين: بإجلالِ الله أن يُعصى وهو يرى ويسمع، واستحضارِ محبّته ومنافاتِها لمعصيته، وشهودِ إنعامِه الموجبِ للشكر، والخوفِ من غضبِه، ومشهدِ العِوَض: ما وعدَ اللهُ به من عوضٍ لمن تركَ المحارمَ لأجلِه. وليوازنِ العبدُ بين العِوَضِ والمعوَّض؛ فأيُّهما أولى بالإيثارِ اختاره.
- ثمّ التدرُّجُ في المجاهدة قليلًا قليلًا حتى تُدركَ النفسُ لذّةَ الظَّفَر؛ فإنّ من ذاقَ لذّةَ شيءٍ قويتْ همّتُه في تحصيلِه.
ولا يشغل نفسه بما فات فيحزن، ولا بما هو آتٍ فيقلق، بل يصرف همّته إلى ما بين يديه من الأمر، فيُحسن القيام به، ويستفرغ فيه وُسعه.
فاللهمّ أفرغْ علينا صبرًا، وثبّتْ أقدامَنا، وأعنّا على ذِكرك وشُكرك وحسن عبادتِك، واجعلِ البلاءَ لنا سُلّمًا إلى رضاك، والحمدُ لله ربّ العالمين.
المراجع
ابن القيم (ت ٧٥١ هـ)، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين – ط عطاءات العلم .
Southwick, S. M., Litz, B. T., Charney, D., & Friedman, M. J. (Eds.). (2011). Resilience and mental health: Challenges across the lifespan. Cambridge University Press.
Kent, M., Davis, M. C., & Luto, W. J. (Eds.). (2014). The Oxford handbook of stress, resilience, and loss. Oxford University Press.