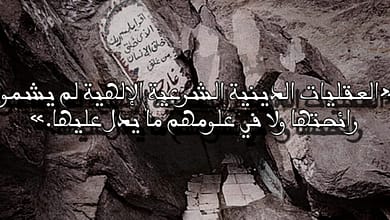الحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله، أما بعد:
يعرّف هيوم المعجزة بأنها: «خرق لقانون من قوانين الطبيعة بإرادة إلهية خاصة أو بتوسط فاعل غير مرئي»[1].
فنقول: أما ما يُسمّى بـ«قوانين الطبيعة»، فليست هي عند التحقيق إلا ما استفاضت به العادة من النظاميات السببية في صورة عبارة كلية. فالأولى أن يقال: خرق لما جرت به العادة، لا لما هو قانون مفروض لا يتخلّف، إذ لا ثبوت لهذا المفهوم إلا في الذهن، لا في الخارج، وإن توهموه كذلك. وإذا ثبت أن كل شيء بمشيئة الله، فكون المعجزة بمشيئة إلهية لا يخرجها عن سائر المقدورات، لكن الفرق إنما هو في إرادة مخصوصة للتصديق بمن وقعت على يده، فهي دالة لا على مجرد المشيئة، بل على إرادة إظهار صدقه.
والمعجزة أنطولوجيا قد تكون: بارتفاع سبب، أو فوات شرط، أو قيام مانع، أو بإيجاد سبب خفيّ أو جديد لم تجر به العادة. وليس لنا أن نحصر النظام السببي في الأسباب المعروفة لنا، فإننا لا نقول بالانغلاق السببي الذي يختزل النظام السببي في الخارج بالأسباب المعلومة في عادتنا، فهذا فرض غارق في مغالطة الاختزالية، والقفز من الجهل الابستمي إلى العدم الأنطولوجي، والحق أن ما نجهله من الأسباب أعظم مما نعلمه.
ذكر هيوم أن الخبر testimony ليس إضافة معرفية بجوار الخبرة، وإنما هو تابع للعادة، فالخبرة وحدها هي التي تعطي الشهادة البشرية سلطة وحجية [2]. ولولا أن الخبرة قالت بأن البشـر تميل فـي العادة الإخبار بالصدق والاستقامة، والشعور بالخجل من كشف كذبهم: لما كنا أولينـا الشهادة البشرية أدنى ثقة [3].
ويقول ما معناه: إن المعجزة لا يُثبتها خبر إلا إذا كان كذب الخبر أعجب وأندر من المعجزة نفسها، فإن حصل ذلك، تعارضت الحجتان، ولم يثبت إلا أرجحهما [4].
وهذا ليس بشيء، فإن حجية التواتر إنما مردّها إلى استحالة التواطؤ على الكذب، وهذه الاستحالة تُعلم بقرائن كثيرة ككثرة العدد، وتباين المواطن، وتنوع الدوافع، وانتفاء موجب الكذب عادة، وما أشبه ذلك من القرائن الدالة على الصدق. فإذا حصل اليقين بامتناع التواطؤ، حصل العلم الضروري من جهة التواتر، دون أن يُفتقر إلى النظر في نفس مضمون الخبر، إذ العلم ها هنا متعلّق بنسبة صادقة أخبر بها جمعٌ يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، لا بكون مضمون الخبر محسوساً عند المتلقي.
وحينئذٍ، فسواء أكان المخبر به أمراً خارعا للعادة أم لا، فإن المعلوم عندنا يقيناً هو أن جماعة من الناس أخبروا عن مشاهدة أمرٍ ما، كأن يكون الخبر (أ) مثلاً؛ وليس في صدق إخبارهم خروج عن العادة، إذ الصدق في الإخبار ليس من قبيل الخوارق، بل الخارق هو ما تضمّنه الخبر من مضمون، إن تضمن ما يخرق المألوف. فالفرق بيّن بين الأمرين: بين صدق الإخبار، وبين كون المخبَر به خارقاً.
فنحن نُسلِّم صدقهم إذا حصل اليقين بشروط التواتر، ثم لا يخلو الأمر من احتمالين: إما أن يكون ما أخبروا به قد وقع في الخارج، أو أنهم وقع لهم توهّمٌ جماعي ونحوه، مع سلامة نيتهم عن الكذب. غير أن الفرض الثاني أبعد في العادة، إذ لا مقتضي له، بخلاف الفرض الأول، فإن له موجباً قويّاً، وهو دعوى النبوة، ومقتضى حكمة الإله الكامل أن يُصدّق رسله، ويجعل لهم آيات تؤيدهم، وتُظهر صدقهم.
فلو أخبرني عدد كثير من الناس بخبرٍ ظاهر الغرابة، كأن يقولوا: “قد احمرّ لون القمر البارحة”، في زمن لا تصوير فيه ولا توثيق صحفي، وكان في أخبارهم من القرائن ما يمنع عادة تواطؤهم على الكذب – ككثرة عددهم، وتفرّق أمكنتهم، واختلاف أحوالهم، وانتفاء الدافع للكذب – لكان مقتضى العقل السليم والعدل في الحكم هو تصديقهم لا تكذيبهم.
ذلك أن الأصل في الناس هو الصدق لا الكذب، إذ الصدق موافق للطبع، والكذب منافر له، وهذا أمرٌ يدركه الإنسان في نفسه إدراكاً ضرورياً، ويشاهده في غيره مشاهَدة تجريبية. والنفس إنما تميل إلى ما يلائمها، وتنفر عما يناقض فطرتها. فإذا عُلم انتفاء الداعي للكذب قطعاً، دلّ ذلك على صدقهم، أي على أنهم لم يتعمدوا الكذب.
ثم ينتقل النظر إلى سؤال آخر: أيهما أرجح عادةً؟ هل يُحتمل وقوع توهّم جماعي، أم يترجّح وقوع الخبر في الخارج؟ فإن كثُر العدد، واختلفت الأقطار، وتنوّعت القرائن المؤكِّدة، استحال عادةً فرض التوهم، فلم يبق إلا أن يكون ما أخبروا به قد وقع في الواقع، فيثبت بذلك صدق مضمون الخبر كما ثبت صدق المخبر.
ولنا القلب: أنكم قبلتم خبر انعدام الجاذبية (أو بعبارة أدق انعدام الوزن) في الفضاء، وهو مخالفٌ لكل ما عهدتموه في الأرض، ولمّا تواتر الخبر، ووردت البراهين، قبِلتم ذلك بلا تردد، فكيف تنكرونه هنا؟ وما تُثبتونه هناك، نُثبته نحن هنا، والحكم في المثلين واحد، وما تجيبون به نجيب به.
فتبيّن بهذا: أن حجّة هيوم في هذا الباب فاسدة في أصلها، ساقطة في تفريعها، قائمة على اختزالٍ مقيتٍ للعلل، وتسويةٍ فاسدة بين المختلفات، والله الموفّق للصواب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] David Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, pp 76-77
[2] ibid, pp.173
[3] ibid, pp.155
[4] ibid, pp.159

![دك حصون المشائين [1]: في أصول الخلاف الابستمية والانطولوجية 1 photo 2025 06 21 22 17 57 دك حصون المشائين [1]: في أصول الخلاف الابستمية والانطولوجية](https://mlugzamz35e7.i.optimole.com/cb:qiT4.d2c/w:390/h:220/q:mauto/rt:fill/g:ce/f:best/https://srajarabic.com/wp-content/uploads/2025/06/photo_2025-06-21_22-17-57.jpg)