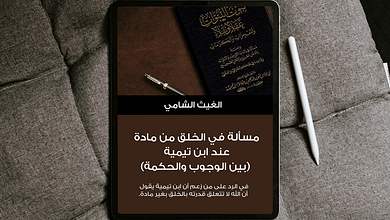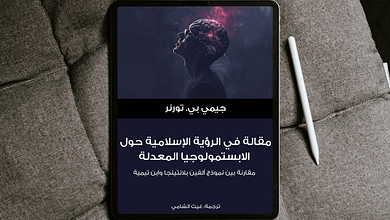التخليط في القدر!
ثم شرع الدكتور تحت عنوان: “الفصل الثاني: إذا كان الله قدر علي أفعالي فلماذا يحاسبني؟” في الكلام على مسألة القدر، فقال (ص. 9):
“قال صديقي في شماتة وقد تصور أنه أمسكني من عنقي وأنه لا مهرب لي هذه المرة: أنتم تقولون إن الله يجري كل شيء في مملكته بقضاء وقدر، وإن الله قدر علينا أفعالنا، فإذا كان هذا هو حالي، وأن أفعالي كلها مقدرة عنده فلماذا يحاسبني عليها؟ لا تقل لي كعادتك، أنا مخير، فليس هناك فرية أكبر من هذه الفرية! ودعني أسألك: هل خيرت في ميلادي وجنسي وطولي وعرضي ولوني ووطني؟ هل باختياري تشرق الشمس ويغرب القمر؟ هل باختياري ينزل علي القضاء وفاجئني الموت وأقع في المأساة فلا أجد مخرجا إلا الجريمة؟ لماذا يكرهني الله على فعل ثم يؤاخذني عليه؟ وإذا قلت إنك حر، وإن لك مشيئة إلى جوار مشيئة الله، ألا تشرك بهذا الكلام وتقع في القول بتعدد المشيئات؟ ثم ما قولك في حكم البيئة والظروف، وفي الحتميات التي يقول بها الماديون التاريخيون؟ أطلق صاحبي هذه الرصاصات ثم راح يتنفس الصعداء في راحة، وقد تصور أني توفيت وانتهيت، ولم يبق أمامه إلا استحضار الكفن.”
قلت: تأمل مبلغ التعظيم عند الرجل لهذه الشبهات التي يوردها على نفسه هنا، من حيث يريد أن يظهر للقراء أنها عنده حقيرة لا قيمة لها! فالواقع أن صديقه الملحد المزعوم هذا إنما هو الكاتب نفسه، وهذه الأسئلة والاعتراضات هي ما كان يتعلق هو به في أيام إلحاده، ويصارع نفسه طلبا للخروج منها! هي ما كان يزين به الإلحاد لنفسه قديما! كانت نفسه تحدثه بأنه لا يملك خيارا في شيء من أمر حياته، لا فيما إذا كان يريد أن يوجد أم لا، ولا في البيت الذي يولد فيه، ولا في الحال التي يجد عليها بيته من الثراء أو الفقر، ولا في جنسه ونوعه، ولا في طوله وهيئته، ولا في شيء من ذلك، فلماذا يحاسب بعد موته وهو لم يخير في شيء من ذلك قبل أن يولد؟؟ وكأن المخلوق الحادث منا إن لم يكن له على نفسه ما لخالقه من سلطان عليه، فلا يقبل سلطانا عليه ولا ربوبية ولا سيادة ولا حكما ولا أمرا ولا نهيا ولا تكليفا!! فهذا أمر ليس بالذي يعقل أصلا، أن يكون للواحد منا خيار فيما إذا كان يحب أن يوجد أم لا!! الخنزير حدث بعد أن لم يكن، والصرصور حدث بعد أن لم يكن، والشجرة الصماء حدثت بعد أن لم تكن، وأنت كذلك وجدت بعد أن كنت عدما، فلماذا لم تكن أنت خنزيرا أو صرصورا أو شجرة صماء، بل كنت رجلا مخيرا مكلفا مسؤولا عن خياره؟ لأن وراء وجودك علما وحكمة وترجيحا وإرادة لم تقم بك أنت وإنما قامت بالضرورة بالذي أوجدك بعد أن لم تكن شيئا!! بالذي اختار لك أن تكون بعد أن لم تكن!! فالذي اختار أن يخلق كل شيء من تلك الأشياء على تلك الصفات دون غيرها، يخلق هذا جمادا وذاك كائنا حيا، يخلق هذا طائرا في السماء وهذا ماشيا على أربع، وذاك زاحفا على بطنه، هو الذي يختار كذلك، سبحانه لا شريك له، وبنفس السلطان الوجودي، أن يفرق بين أفراد النوع الواحد من تلك الأنواع بما تقتضيه حكمته من التفاوت في الصفات! يمن على مخلوق بما لا يمن به على غيره، من نفس النوع، يرفع مخلوقا فوق غيره، يقدم مخلوقا ويؤخر غيره، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر! هذه كلها معان لا يملك أي مخلوق محدث لنفسه أن يكون شريكا فيها للذي خلقه سبحانه، ضرورة وبداهة، لأنه ليس هو الذي وهب نفسه الوجود، أو أقام نفسه من العدم، لعلم وحكمة عنده! ليس هو من أوجد نفسه بعد أن لم تكن، ولا هو الذي ركب أعضاءه في بعضها البعض! حتى هذا اللسان الذي تسب به ربك أيها الملحد آناء الليل وأطراف النهار، ليس ملكا لك! هل كسبته كسبا يجعل لك حقا فيه عند من خلقك؟؟ أبدا! هذا القلب النابض في صدرك، الذي يحرك الدم في أوصالك من غير أن تشعر، هل أنت من ركبه في جسدك؟؟ لا تملك من نفسك ولا لنفسك شيئا على الحقيقة، والله حتى الهواء الذي تنفسه لا تملك منه شيئا!! فالذي لا يملك حتى جسده الذي يولد به، هذا أي حق يكون له في أن يقول: هذا الذي خلقني، لماذا يكلفني وأنا لا أحب أن أكلف، ثم يحاسبني بعد موتي وأنا لا أحب أن أحاسب ولا أن أموت؟؟ هو اختار أن يكلفك وأن يمتحنك وأن يخيرك لتستحق الجزاء في الآخرة، كما اختار أن يخلقك من قبل ولم تك شيئا، فإن رضيت فهو خير لك وإلا فلتهلك كما هلك غيرك، لا تنقص من ملكه طرفة عين!!
هذا هو خطابنا لهؤلاء المستكبرين المجرمين! وهذا هو خطاب القرآن إليهم، فانتبه! لا يؤتى بأحدهم فيقال له في ود ومحبة، في خطاب الأنداد والأقران: تعال إلي يا صديقي أحاورك وأناقشك، لعلي أقنعك بأن الذي خلقك واختار لك كل ما تجد نفسك عليه من النعم والعطايا، على تفاوت بين المخلوقات فيها، من حقه أن يختار لك أن تكون مكلفا ممتحنا مسؤولا بعد موتك عن خياراتك في حياتك، كما اختار لغيرك من خلقه ألا يكلف ولا يمتحن! وإنما يقال له: من تظن نفسك يا هذا، تطالب ربك بأن يجعلك شريكا له في حقه أن يختار ما يخلق وما يكون وما يقضي به في خلقه وملكه؟ وبأي عقل تتمارى في كونك مختارا فعلا لما أنت عليه من الكفر والزندقة، كما اختار غيرك الإيمان، أو تتمارى في حق من برأك وصورك وركب بعضك على بعض، في أن يمتحنك بذلك الخيار، ويؤاخذك عليه، كما يمتحن غيرك ويؤاخذه؟؟ أفق يا هذا إن كان لمثلك أن يفيق! أفق من غفلتك وتنبه، فإن العمر قصير! افتح عينيك اللتين أغلقتهما بيديك نزقا وكبرا وغرورا، وانظر بهما كما ينظر الناس! هذا الذي تماري فيه وأنت تعلم أنك مسفسط مستكبر على الحق الجلي الواضح، آتيك تأويله وتحققه عيانا لا محالة، ولو بعد حين! هذا ليس تخييرا في أن تلبس لباسا ما أو تركب مركبا ما، مما قد تحبه وقد تكرهه، وقد تفضل ألا تخير في بعضه أصلا!! هذا تخيير إلهي في أمر وجودي يترتب عليه مصيرك الأبدي بعد موتك، وإن رغمت أنفك! ربك الذي خلقك اختار أن يخيرك فيه، فإن شئت فلتؤمن وإن شئت فلتكفر، ولكن إن أبيت إلا أن تكفر ومت على الكفر فعلا، ثم لقيت ما توعّد الله به كل كافر، فلا تلومن يومئذ إلا نفسك!! يقول “هل باختياري تشرق الشمس ويغرب القمر”!! الله أكبر!! إذن لا تكون عبدا خاضعا للذي خلقك وخلقهما، تقر له بحقه عليك في العبودية، حتى تكون أنت من يأمر الشمس فتشرق، ويأمر القمر فيغرب؟؟؟ بالله أي نفس هذه وأي قلب هذا، حتى يصنف كتاب في “محاورتهم” يجعل عنوانه “حوار مع صديقي الملحد”؟؟ هؤلاء لم يؤتوا من جهل ولا من غباء ولا من خفة عقل يا إخوان، وإنما أتوا من كبر إبليس!! نسأل الله السلامة! وقد بسطت الكلام على كبرهم هذا وبينت كيف أنه هو أصل جميع اعتراضاتهم، مهما تشدقوا بها وألبسوها زخرف الكلام في تصانيف الفلسفة، في مجلد كبير ترجمت له بقولي “الكشاف المبين لما في نفوس المستكبرين”، فإنه مرض عضال لا يرجى للمصاب به شفاء إلا أن يشاء الله! وأنت يا مصنف هذا الكتاب قد صرت تدرك ذلك وتشعر به بعد أن خرجت من الإلحاد! تشهد بنفسك بعظم الحق الجلي الواضح الذي كنت تتمارى فيه من قبل وتتلكأ في الإقرار به! فلماذا تأبى إلا أن تجلس نفسك في مجلس المتفلسف الذي ينزل هؤلاء الممارين المكابرين منزلة الند المكافئ، يسفسط عليهم بمثل ما يتشدقون به، إن لم يكن قد بقي في نفسك بقية من حب الاستعلاء بالعقل والذكاء والتصدر بالفكر والرأي بين الخلق؟؟
قوله: “هل باختياري ينزل علي القضاء ويفجأني الموت وأقع في المأساة فلا أجد مخرجا إلا الجريمة”، كيف يكون قضاء وينزل عليك باختيارك؟؟ وكيف تكون فجاءة الموت باختيارك؟؟ وما معنى وقوع المأساة؟ كلام مما تجد نظيره عند مؤلفي المسرحيات الأوروبية والروسية التي يتربى عليها هؤلاء ويتشبعون بطريقة أصحابها في الفكر والكلام!
قوله: “وإذا قلت إنك حر، وإن لك مشيئة إلى جوار مشيئة الله ألا تشرك بهذا الكلام وتقع في القول بتعدد المشيئات؟” يقال له: ألأنك لا تكون لك مشيئة مستقلة إلا بأن تكون ربا خالقا لنفسك، شريكا للرب في الخلق والتكوين؟؟ المشيئة لا تكون عندك إلا بحيث يقول صاحبها للشيء كن فيكون؟؟ مشيئة الخالق قطعا ليست كمشيئة المخلوق، فهي مشيئة مخلوقة، وهي سبب مخلوق مع أسباب أخرى مخلوقة لوقوع العمل المخلوق للعبد، فإن شاء الله وقوعه منه، اجتمعت تلك الأسباب وتحققت الشروط السببية وانتفت الموانع، فيقع حينئذ وتكون مشيئة الله تعالى التكوينية هي التي خلقته بأسباب كثيرة منها مشيئة العبد المخلوقة! فالعبد لا يخلق عمله، ولا يخلق مشيئته في نفسه، وإنما الرب سبحانه هو الذي يخلق له ذلك كله إذا شاء. ((وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)) [التكوير : 29]! فإن قالوا ولكن إذا جعلت مشيئة المخلوق تبعا لمشيئة الخالق، فلا تكون إذن مشيئة حرة على الحقيقة، وهي شبهة القدرية من أهل القبلة ومن أهل الكتاب من قبلهم، وأصل كل سفسطة عند الفلاسفة على عقيدة القضاء والقدر التي جاء بها الأنبياء والمرسلون، قيل لهم: المخلوق المحدث مشيئته مخلوقة محدثة بالضرورة، وهو يجدها في نفسه ضرورة، كما يجد كل علم ضروري قائم بنفسه، فلا مراء في كونها مشيئته حقا، لأنه يرى من نفسه الإرادة ويرى القدرة على إنفاذ ما يريد إذا عزم عليه، كما أنه لا مراء في مخلوقيتها وحدوثها، فكونها مخلوقة حادثة لا ينفي كونها مشيئة حقيقية يترتب عليها أثرها وتوجب المساءلة لصاحبها ممن منحها إياه في أصل خلقته. فمن نفى مخلوقية مشيئة العبد، فهذا هو المشرك قطعا، وليس من ثيبتها، لأنه يصيره خالقا لأفعاله من دون الله، ولهذا كفّر السلف وأئمة السنة القدرية، ولهذا صنف الإمام البخاري رحمه الله كتابه “خلق أفعال العباد”، لأنهم صيروا العباد أربابا من دون باريهم، يخلقون أفعالهم من دونه سبحانه، وهذه يسويهم بالثنوية المجوس!
فهل نحن الآن يفترض بنا أن نجلس “لنحاور” كل جاحد مماحك، مسلمين له بأنه “لا يعرف” حقا أن له مشيئة حقيقية يختار بها ما يفعل قبل أن يفعله، بل يرى، لسبب قام بنفسه المريضة، أنه مكره على كل ما يفعل؟؟
قوله: “ما قولك في حكم البيئة والظروف، وفي الحتميات التي يقول بها الماديون التاريخيون” قلت: البيئة والظروف والحوادث التي يتعرض لها الإنسان تؤثر قطعا في خياراته، وقد تضطره إلى أمور لا يضطر إليها غيره من بني جنسه، ولكن الرب الذي كلف الإنسان بخيارات إن خالفها أوخذ في الآخرة، هو نفسه الذي أسقط عنه الإثم والمؤاخذة عند الضرورة، إذا قدرها بقدرها الصحيح! فما لم يكن من الظروف والأحوال وأحكام البيئة .. إلخ، بحيث يتعرض المكلف للهلكة إن عمل بتكليف معين من تكاليف الدين، فلا يكون معذورا لأجله بالتحلل من ذلك التكليف! وكل ذلك مبني كما هو واضح على أن الإنسان مخير ذو مشيئة معتبرة، ينبني عليها التكليف الشرعي والمسؤولية في الآخرة، وعلى أن الأصل فيه أنه غير مكره ولا مضطر لفعل ما يفعل! فما دام عاقلا مميزا يدري حكم الشرع وتكليفه ويقدر على فعله دون التعرض للهلاك المحقق على أثره، فإنه يظل مؤاخذا بفعله، محاسبا على اختياره! أما أن يقال، كما يسلكه الجبرية من الفلاسفة، إن الإنسان الذي يصبح سارقا محترفا، أو المرأة التي تسلك طريق البغاء، هذان قد اضطرتهما ظروف البيئة التي عاشا فيها والمجتمع الذي نشآ فيه، أو “المأساة” على عبارة الدكتور، إلى أن يحترفا العصيان ومبارزة الباري بعظائم الذنوب، على طريقة “جعلوني مجرما”، فهذا من أفسد ما أحدثه الفلاسفة الأوربيون المعاصرون من قيم ومعايير أخلاقية، لها أصولها في أيديولوجيات تضع الفقير والمعوز والمهمش في المجتمع البشري في قالب الضحية التي يسلبها الأثرياء والمقتدرون و”البرجوازيون” حقها بمجرد تسلطهم على تلك الثروات التي هم متسلطون عليها! فإذا صار الفقير لصا يحترف السرقة من الأثرياء، فإنه لا يكون مؤاخذا إذن، ولا ينبغي أن يحاسب على ذلك، لأنه يكون مستردا لبعض حقه المسلوب عند أصحاب تلك النظريات! المادية التاريخية أيديولوجيا فاسدة غاية الفساد، يدعي أصحابها أنه ما من حادث يقع في المجتمع الإنساني في تعامل البشر مع بعضهم البعض، بل وفي تقريرهم جميع صور النشاط البشري غير المادي بإطلاق، بما في ذلك الدين والاعتقاد والنظام الأخلاقي والسياسي، إلا وجب أن يكون ثمرة لسياسة المال أو المادة، وتوزيع موارد الإنتاج المادي في ذلك المجتمع، وهذا قطعا غير صحيح ولا يسلم به عاقل! فصحيح إن الأحوال المادية قد تشعر أناسا بضيق المعاش وبالحرمان مما يتمتع به غيرهم، إلا أن هذا لا يسوغ لهم أن يختاروا الإثم والعصيان، ولا يبلغ أن يكون ضرورة أو ما في حكمها، ما لم يبلغ الفقير حدا يعدم عنده قوت يومه، ويعدم كذلك من يبذل إليه حقه الشرعي في زكاة المال، فيتيقن هلكته إن لم يسرق ما يبقيه حيا! وهذه حالة لا يبلغها الناس إلا في المجاعات العامة وما شاكلها، وحينئذ فإن الشرع لا يؤاخذهم بما هم جميعا مضطرون إليه، فيما يقال له عند الأصوليين زمان الضرورة. أما أن يقال إن تكدس رؤوس الأموال عند ثلة قليلة، يصيرهم جميعا، حتما ولا محالة، مجرمين مبدلين لأديان الناس مستعبدين لهم، آكلين أموالهم بالباطل، فهذا كذب وظلم وعدوان! نعم أكثر الأثرياء أهل فساد وإفساد، ولكن كذلك أكثر الفقراء والمساكين، فهذا عام في الناس كلهم مبتلون به، كما في قوله تعالى: ((ولكن أكثر الناس لا يشكرون)) وقوله ((ولكن أكثر الناس لا يعلمون)) وقوله ((ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)) وقوله: ((ولكن أكثر الناس لا يشكرون)) وقوله ((وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)) وقوله: ((وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً)) [الفرقان : 50]! وصحيح إن الابتلاء بكثرة أسباب الإفساد في الأرض في يدي الثري الفاسد أعظم على جماهير الناس في البلد الواحد من ابتلائهم بأسباب الإفساد في يدي الفقير الفاسد، إلا أن هذا لا يؤخذ منه شيء من تلك “الحتميات” الدهرية الفاسدة، التي يتذرع بها كل مجرم في قوله: حاسبوا المجتمع ولا تحاسبوني، أو لوموا الأثرياء ولا تلوموني! هذه جبرية دهرية، تنزل صفات الربوبية على الأثرياء والمقتدرين مادليا، تصيرهم أربابا من دون الله يتحكمون في انتشار الأرزاق في الأرض، ويسلبون الفقير إرادته وتمييزه وقدرته على أن يختار الحق من حيث لا يشعر، فيبقى غير قادر البتة على أن يمتثل لأمر ربه، ويخضع لشريعته، مهما حاول ذلك! ألا ترى للمرأتين، تنشآن في نفس البيئة، وتعانيان عبر سنوات العمر من نفس البيت ونفس الضوائق ونفس الحرمان، ومع هذا تختار إحداهما محض إرادتها أن تكون بغيا، بحيث إذا سئلت قالت: قد صيرتني الظروف كذلك واضطرتني اضطرارا، وتختار الأخرى أن تكون امرأة فاضلة عفيفة، تأكل بالحلال ولو اضطرت لأن تبيع باكتات المناديل في إشارات المرور، طلبا لقوت يومها؟؟ قد ضرب الله تعالى لذلك مثلا عظيما في القرآن إذ قال: ((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ . وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)) [التحريم : 10-11] امرأة كانت في بيت النبوة، تحت نبي من أنبياء الله، ومع ذلك اختارت الكفر والشرك، وامرأة كانت في بيت فرعون، الذي عد واحدا من أعظم الطواغيت المستكبرين والمتسلطين بالباطل على الخلق في تاريخ البشر، ومع هذا صبرت واختارت الإيمان والعمل الصالح! والتاريخ مشحون بقصص أناس كانوا في طفولتهم لا يجد آباؤهم زيتا يضاء به مصباح في بيوتهم، ثم صاروا رجالا من أفضل الناس، والعكس صحيح!
فلا نستجيز أن يقال إن الثري لن يزداد ثراء إلا ازداد أكلا لأموال الناس بالباطل وتسلطا عليهم بالإفساد لا محالة، كما أننا كذلك لا نستجيز أن يقال إن المسكين ومن قدر عليه رزقه، سيصبح لا محالة سارقا أو مستبيحا للمحرمات، وإذن فيكون معذورا بذلك، هذا أيضا كذب وجهل مبين! بل يبقى الإنسان قادرا، أيا ما كانت أحواله وظروفه، على اختيار الحق والعدل والإحسان، حتى في أحلك الظروف وأشدها ضيقا، ما لم يبلغ الحالة التي وصفنا من خوف الهلاك المحقق! وصاحب الدين والصلاح والعمل بما يرضي الله تعالى، لا يزداد بالثراء إلا إحسانا ونفعا للمسلمين، يعظم خيره ونفعه بتعاظم ثروته، وليس العكس، كما زعم أولئك الملاحدة الأوروبيون أنه واقع حتما لا محالة!
فبأي شيء أجاب الدكتور عن ذلك الكلام الذي حكاه على لسان الملحد المتوهم؟ أجابه بتقرير مذهب القدرية بحذافيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
قال: “قلت له في هدوء: أنت واقع في عدة مغالطلات.. فأفعالك معلومة عند الله في كتابه، ولكنها ليست مقدورة عليه بالإكراه .. إنها مقدرة في علمه فقط، كما تقدر أنت بعلمك أن ابنك سوف يزني .. ثم يحدث أن يزني بالفعل، فهل أكرهته؟ أو كان هذا تقديرا في العلم وقد أصاب علمك؟” قلت: هذا بحذافيره هو مذهب القدرية الزنادقة، الذين قالوا: ليس القدر إلا العلم الإلهي وحسب! العلم بما هو واقع في المستقبل من أفعال العباد! أما أن يكون الرب هو الذي يخلق تلك الأفعال، بمشيئة سابقة لديه لوقوعها عن أسباب مخلوقة، منها المشيئة المخلوقة في نفس العبد، فهذا يكون عندهم جبرا أو إكراها كما عبر الدكتور! وأنا لا أستبعد في الحقيقة أن يكون هذا الموضع خاصة من هذا الكتاب، هو السبب في انتشار مذهب القدرية عند كثير من شباب المسلمين اليوم، إذ تراهم إذا تكلموا في القدر ضربوا نفس هذا المثل: الرجل يعلم أي ولد من أولاده سيفلح وأيهم سيفسد، والمدرس في المدرسة يتابع أداء طلبته فيعلم أيهم سيحسن أداؤه في الامتحان وأيهم سيفشل، ونحو ذلك مما نسمع عندهم. وأصحاب هذه الأمثال لا يشعرون في الحقيقة بأنهم يقيسون ربهم على البشر المخلوقين! فالأب ليس هو خالق أولاده وأفعالهم، فلا يحصل له العلم بها إلا مما يظهر له من متابعتها، وكذلك المدرس لم يخلق تلامذته ولا خلق أفعالهم، وإنما هو مخلوق مثلهم، لا يتحصل على علم كاشف بمستقبلهم وإنما يتنبأ به تنبؤا قد يصيب فيه وقد يخطئ! الرب سبحانه ما سبب علمه بحوادث المستقبل، وبأفعال الناس؟ سببه أنه هو سبحانه الذي قدرها وحكم بوقوعها حكما مبرما قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة! كتب ذلك وقدره فيما جفت به الصحف، فلا يقع حادث واحد إلا كما في اللوح المحفوظ! لهذا لا يرد احتمال الغلط على علمه سبحانه بحال من الأحوال، لأن علمه تابع لمشيئته وإرادته الأولى فيما قدره من المقادير، تلك الإرادة التي أجرى عليها خلقه لكل حادث إذا جاء وقته! وهذا من ضرورة كونه هو خالق كل شيء سبحانه، وحده لا شريك له! الله تعالى لا “يقدر” في علمه ما يفعله الناس، ثم إذا فعلوا كما قدر، يكون قد أصاب، ويكون هذا هو “القدر” الإلهي! الإنسان المخلوق هو الذي ينظر في أحوال غيره من المخلوقات نظر الجاهل الذي لا يدري ما هو كائن منهم غدا، فيحاول أن يتوقع ذلك بالنظر إلى ما دلته عليه عادته، فيقال فيما يسلكه من ذلك إنه “تقدير في العلم”! وأما التقدير الإلهي فهو حكم إلهي مبرم لا يتخلف، بأن الحادث الفلاني سيقع إذا جاء وقته الذي اختاره له جل شأنه! إذا حان وقته المقدور المكتوب، فسيشاؤه الباري وسيخلقه لا محالة ولن يخلق غيره! ومن ذلك أفعال العباد والمشيئات التي تقع في نفوسهم قبلها بالضرورة! كل ذلك من خلقه وحده لا شريك له. ولهذا فالعلم التام الكاشف من خصائص الربوبية، لأنه إنما يوصف به من لا يقع في الوجود شيء إلا بإرادته وخلقه، فهو يعلمه لا لأنه يتنبأ به بتقدير عقلي، يجمع النظير إلى نظيره، كما يصنعه المخلوق، فيرد عليه الغلط من تلك الجهة، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإنما يعلمه لأنه هو من يقدره إرادة وكتابة وخلقا ومشيئة، وهو من يرجح وقوعه على عدمه، فلا يقع في ملكه إلا ما أراد، ومن ذلك مشيئة العبد المخلوق وفعله إذا شاء أو فعل! فهذا الاعتقاد الذي يقرره المصنف في هذا الموضع، اعتقاد القدرية نفاة القدر، وليس من اعتقاد المسلمين.
يقول: “أما كلامك عن الحرية بأنها فرية، وتدليلك على ذلك بأنك لم تخير في ميلادك ولا في جنسك ولا في طولك ولا في ولونك ولا في موطنك، وأنك لا تملك نقل الشمس من مكانها، هو تخليط آخر، وسبب التخليط هذه المرة أنك تتصور الحرية بالطريقة غير تلك التي نتصورها نحن المؤمنين.. أنت تتكلم عن حرية مطلقة، فتقول أكنت أستطيع أن أخلق نفسي أبيض أو أسود أو طويلا أو قصيرا، هل بإمكاني أن أنقل الشمس من مكانها أو أوقفها في مدارها، أين حريتي؟ ونحن نقول له: أنت تسأل عن حرية مطلقة، حرية التصرف في الكون، وهذه ملك لله وحده، نحن أيضا لا نقول بهذه الحرية ((وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ)) [القصص : 68] ليس لأحد الخيرة في مسألة الخلق، لأن الله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار.”
قلت: كلام صحيح، ليس لأحد الخيرة في مسألة الخلق، لأن الله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. ولكن هذا يقتضي بالضرورة أن يكون من معنى التقدير الإلهي خلق الله ما يشاء سبحانه ويختار من أفعال المخلوقين، كما يؤمن به المسلمون، لا شريك له في اختيارها ولا في خلقها! لأنه إن لم يكن هو خالق ذلك كله ومريده، في إرادته الكونية، فإن هذا يجعل له من خلقه شركاء له في الخلق والتدبير والتكوين واختيار ما يقع وما لا يقع في ملكه، وهذا هو شرك الربوبية الذي تقول إنك تفر منه ولا تقبله! ثم يقول: “ولن يحاسبك الله على قصرك ولن يعاتبك على طولك ولن يعاقبك لأنك لم توقف الشمس في مدارها، ولكن مجال المساءلة هو مجال التكليف، وأنت في هذا المجال حر، وهذه هي الحدود التي نتكلم فيها. أنت حر في أن تقمع شهوتك وتلجم غضبك وتقاوم نفسك وتزجر نياتك الشريرة وتشجع ميولك الخيرة، أنت تستطيع أن تجود بمالك ونفسك، أنت تستطيع أن تصدق وأن تكذب، وتستطيع أن تكف يدك عن المال الحرام، وتستطيع أن تكفر بصرك عن عورات الآخرين، وتستطيع أن تمسك لسانك عن السباب والغيبة والنميمة، في هذا المجال نحن أحرار. وفي هذا المجال نحاسب ونسأل. الحرية التي يدور حولها البحث هي الحرية النسبية وليست الحرية المطلقة! حرية الإنسان في مجال التكليف. وهذه الحرية حقيقة ودليلنا عليها هو شعورنا الفطري بها في داخلنا، فنحن نشعر بالمسؤولية وبالندم على الخطأ، وبالراحة للعمل الطيب، ونحن نشعر في كل لحظة أننا نختار ونوازن بين احتمالات متعددة، بل إن وظيفة عقلنا الأولى هي الترجيح والاختيار بين البديلات.”
قلت: الله أكبر. إذن دليلنا على أننا أحرار، أننا نشعر بذلك فعلا شعورا فطريا، ونميز بين حالة نكون فيها مختارين، منفذين لاختيارنا، وهذا هو الأغلب وهو الأصل، وحالات قليلة نكون فيها مكرهين مجبورين على أفعال تخالف خيارنا وإرادتنا. وهذا ما به يمتاز معنى الحرية عن معنى الجبر والإكراه في عرفنا اللغوي أصلا! جميل جدا! فإذا كانت هذه حقيقة فطرية جبلية لا نرد على من يخالف فيها إلا بأن نتهمه بمكابرة الفطرة كما فعلت هنا، فلماذا لا نسلك نفس المسلك مع من يمارون فيما هو أظهر وأجلى من ذلك بالضرورة، وهو وجود الباري نفسه جل في علاه؟؟ لماذا نحتاج إلى أن نؤسس إيماننا وشعورنا الفطري بوجود من خلقنا، على الفيزياء المعاصرة كما سلكته أنت ويسلكه غيرك؟؟ إما أن الشعور الفطري حجة في نفسه، ومن يكابر فيه جاحد مماحك، وإما أنه ليس كذلك! فإن كان حجة في نفسه كما احتججت به هنا، فهو حجة في وجود الباري من باب أولى. وإن لم يكن حجة أصلا، فلا حجة في هذا الذي قررته هاهنا!
يقول: “ونحن نفرق بشكل واضح وحاسم بين يدنا وهي ترتعش بالحمى، ويدنا وهي تكتب خطابا، فنقول إن حركة الأولى جبرية قهرية، والحركة الثانية حرة اختيارية، ولو كنا مسيرين في الحالتين لما استطعنا التفرقة. ويؤكد هذه الحرية ما نشعر به من استحالة إكراه القلب على شيء لا يرضاه تحت أي ضغط، فيمكنك أن تكره امرأة بالتهديد والضرب على أن تخلع ثيابها، ولكنك لا تستطيع بأي ضغط أو تهديد ان تجعلها تحبك من قلبها، ومعنى هذا أن الله أعتق قلوبنا من كل صنوف الإكراه والإجبار، وأنه فطرها حرة، ولهذا جعل الله القلب والنية عمدة الأحكام، فالمؤمن الذي ينطق بعبارة الشرك والكفر تحت التهديد والتعذيب لا يحاسب على ذلك طالما أن قلبه من الداخل مطمئن بالإيمان، وقد استثناه الله من المؤاخذة في قوله تعالى ((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))”
قلت جميل جدا، وكذا فنحن نفرق بالفطرة بين معنى الحدوث وما يقتضيه من الفعل والإحداث والاختيار عند المحدث، ومعنى القدم والأولية، فنعرف من هذا الطريق أن وجودنا على ما وجدنا عليه، لم يكن باختيارنا ولا باختيار مخلوق من أمثالنا، وإنما هو باختيار من خلق كل شيء فقدره تقديرا! باختيار وإرادة وعلم وتقدير من له الخيار في الخلق والتكوين وترجيح جميع الممكنات في الوجود على عدمها! لابد من اختيار وإرادة وراء كل حادث، لأنه لا يحدث أصلا إلا على أثر ذلك، وهذا أيضا شعور فطري لا يحتاج إلى برهان أو نظر! وكل محاولة للبرهنة عليه نظريا، لن تخلو من جعله مقدمة في نفس البرهان الذي يراد سلوكه للتدليل عليه، كما في قول المتكلمين: كل حادث لابد له من محدث، العالم حادث، إذن العالم له محدث. فأنت أصلا لا تقرر أن كل حادث لابد له من محدث، إلا وأنت تقصد أنه فاعل مريد مختار عن علم وحكمة! وخلق الله لا يشتبه بخلق غيره من المخلوقين، وهذا أيضا أمر يعرف بالفطرة، فنحن نعلم من قبل أن ننظر أو نستدل أن بارينا ليس كمثله شيء، وأنه أعلم الموجودات وأحكمها على الإطلاق، وأنه منه يكون كل علم وكل قدرة وكل حياة في الوجود، لا من غيره! فإذا كانت هذه الشبكة من الحقائق الفطرية المتلازمة في نفوسنا، هي التي خرجت منها المقدمة القائلة بأنه لابد لكل حادث من “محدث” يرجحه على عدمه بعلم وإرادة، فصاحب هذا البرهان على هذه الصورة، متلبس بالمصادرة لا محالة، لأنه يؤسس النتيجة على نفسها في الحقيقة! لسنا نحتاج لسلوك قياس الشمول مع جملة موجودات العالم حتى نعرف أنها كلها محدثة من صنع صانع عليم مريد، لأن المقدمة الكبرى فيه تكون هي نفس نتيجته أصلا، وهي معلومة لدينا سلفا!! المعقول، إن قدرنا معقولية طرح هذا المطلب للنظر القياسي مبدئيا، أن نقيس موجودات عالم آخر على عالمنا هذا، لتحصيل ذلك الحكم بقياس التمثيل، وإلا فأين شهدنا نحن موجودات بخلاف هذا العالم، تحدث بعد أن لم تكن، حتى نجعل هذا العالم قضية صغرى، ننقل إليه الحكم من القضية الكبرى المعروفة لدينا سلفا؟؟ ليس من مصدر للقضية الكلية المقررة في المقدمة الكبرى إلا نفس هذا العالم، نفس العالم الذي يفترض أنه هو المنقول إليه الحكم في الصغرى!! فأي شيء هذا إن لم يكن ضربا من السفسطة والعبث بآلة القياس عند الإنسان؟؟ الفيلسوف أو المتكلم يريد أن يقدم نفسه على أنه صاحب نظر وبرهان، مع أن القضية التي يريد البرهنة عليها حاصلة في نفس كل عاقل سلفا، ولولا صحتها ما أمكنه أن يعرف شيئا ولا أن يبرهن على أي شيء البتة، من مبدأ الأمر!
فالتفريق المعنوي الذي يقرره المصنف هنا بين حرية الاختيار وبين الجبر والإكراه، من جهة الشعور الفطري والمعرفة الفطرية، هو نفسه الذي نتعلق نحن به في قضية مخلوقية كل حادث وافتقاره لمحدث حكيم قدير ذي إرادة وعلم وتدبير، ولنفس السبب. فالمؤمن العاقل، الذي يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، إنما هو من علم كيف يخرج هؤلاء المجرمين المسفسطين من دائرة السفسطة والسفسطة المقابلة، من حمأة العبث اللفظي هذه، ليوقفهم على محل العلة والمرض الأصيل في نفوسهم جميعا! وهذا لا يكون إلا لمن برئت نفسه من أهواء الفلاسفة والمتفلسفة، نسأل الله السلامة للمسلمين!
يقول: “والوجه الآخر من الخلط في هذه المسألة أن بعض الناس يفهم حرية الإنسان بأنها علو على المشيئة، وانفراد بالأمر، فيتهم القائلين بالحرية بأنهم أشركوا بالله وجعلوا له أندادا يأمرون كأمره، ويحكمون كحكمه، وهذا ما فهمته أنت أيضا، فقلت بتعدد المشيئات، وهو فهم خاطئ، فالحرية الإنسانية لا تعلو على المشيئة الإلهية. إن الإنسان قد يفعل بحريته ما ينافي الرضي الإلهي ولكنه لا يستطيع أن يفعل ما ينافي المشيئة. الله أعطانا الحرية أن نعلو على رضاه فنعصيه، ولكن لم يعط أحدا الحرية في أن يعلو على مشيئته، وهنا وجه آخر من وجوه نسبية الحرية الإنسانية. وكل ما يحدث منا داخل في المشيئة الإلهية وضمنها، وإن خالف الرضا الإلهي وجانب الشريعة.”
قلت: تقرأ هذا الكلام فتتوهم لأول وهلة أنه سيقرر أن كل مشيئة تخلق في نفوسنا البشرية فهي تبع لمشيئته الكونية سبحانه، أي أنه هو الذي يقضي بأن يشاء أحدنا ما يشاء إذا شاءه، أيا ما كان ذلك، وهو الذي يخلق ذلك فينا ويخلق ما ينشأ عنه من أعمالنا إذا شاء! أليس قد قال إن كل ما يحدث منا داخل في المشيئة الإلهية وضمنها؟ فلابد أن هذا ما يقصده! أليس كذلك؟ ليس كذلك للأسف! فهو يمضي فيقول: “وحريتنا ذاتها كانت منحة إلهية وهبة منحها لنا الخالق باختياره، ولم نأخذها منه كرها ولا غصبا. ومن هنا معنى الآية ((وما تشاؤون إلا أن يشاء الله)) سورة الإنسان، لأن مشيئتنا ضمن مشيئته، ومنحة منه، وهبة من كرمه وفضله، فهي ضمن إرادته لا ثنائية ولا تناقض، ولا منافسة منا لأمر الله وحكمه.. والقول بالحرية بهذا المعنى لا ينافي التوحيد، ولا يجعل لله أندادا يحكمون كحكمه ويأمرون كأمره، فإن حريتنا كانت عين أمره ومشيئته وحكمه..” قلت: فالمقصود إذن بدخول أفعالنا تحت الحرية الإلهية، أن الله قد خلق فينا الحرية بمشيئته وإرادته وأمره، لا رغما عن إرادته سبحانه، فلما أعطانا الحرية، وقعت منا تلك الأفعال التي لا يرضاها من غير أن يكون قد شاء وأراد وقوع كل فعل منها حين وقع وحيث وقع كما هو اعتقاد المسلمين! أي أنه خلق فينا حريتنا لنخلق نحن أفعالنا كما نشاء، لا أنه خلق كل فعل نفعله بجميع أسبابه الحادثة المتقدمة عليه، التي منها المشيئة الواقعة في نفوسنا! وهذا هو تلبيس القدرية في تأويلهم قوله تعالى ((وما تشاؤون إلا أن يشاء الله))!
وهذا المذهب أقرب شيء شبها بالدارويني الذي يقول إن الله قد خلق الأنواع الحية كلها، ولكنه لم يرد لكل نوع منها أن يكون على ما كان فيه من الصفات التفصيلية، وإنما ركب في مادة العالم ما تولدت عنه آلية الطفرة العشوائية وآلية الانتخاب الطبيعي معا، ثم ترك الأمر ليجري على مقتضيات هاتين الآليتين عبر بلايين السنين، وهو يعلم أنه لابد أن ينتهي في نهاية المطاف إلى ظهور نوع مميز هو الأحسن في التقويم، وهم البشر، فلما ظهر أول فرد من ذلك النوع أخيرا، نفخ من روحه وكرمه وخاطبه بالنبوة!! فهو بهذا يكون خالقا للأنواع الحية وليس خالقا لها في نفس الوقت، كمقالة الجهمية الأولين: لا داخل العالم ولا خارجه، لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، وكقولهم سميع بلا سمع وبصير بلا بصر! فهذا خالق بلا خلق! صانع بلا صناعة! فإنه ليس مأذونا له في نظريتهم أن يكون هو الذي باشر خلق كل نوع من الأنواع الحية على ما شاء وأراد واختار سبحانه، بفعل إلهي أو تكوين إلهي يخص كل نوع منها! لا متسع فيها لذلك! ولكن لا يمتنع مع ذلك أن يقال إنه هو الذي خلق السيناريو الدراويني المفصل للتاريخ الطبيعي كما اخترعوه، بأن بدأ الأمر كله على النحو الذي يزعمون أنه بدأ عليه! غرس بذرة الحياة في العالم ثم تركها لتنمو! وبعض الطبيعيين الدهرية يصرح فعلا بهذا الاعتقاد السخيف، ولكنه يجعل صاحب هذا الغرس وفاعله مخلوقا أرقى وأذكى من الإنسان، جاء من كوكب بعيد، في صورة من صور ما يسمونه بالPanspermia، كما تجده في أدبياتهم وفي روايات الخيال العلمي المزعوم عندهم، وكما كان اعتقاد الفلكي الأمريكي الهالك المعروف كارل ساغان، الذي زعم أن جميع الآلهة البشرية التي عبدها الوثنيون عبر التاريخ، كانت في الحقيقة أفرادا من ذلك النوع الفضائي فائق الذكاء! وهو بطبيعة الحال ليس خالقا إلا للحياة، من هذا الوجه فقط. فمن جوز منهم وصف ذاك الصانع العدمي الذي يثبتونه بأنه تام العلم omniscient، فإنه يقول إنه قد علم كيف ستجري تلك المأساة العبثية العشوائية الصرفة عبر بلايين السنين، حتى تنتهي أخيرا إلى إنتاج الإنسان، لكنه لم يوجهها بشيء، ولم “يتدخل” فيها بفعل وبهذا يكون هو خالقه على زندقتهم تلك! خلق في النظام عشوائيته، وهو يعلم أين ستنتهي وأي شيء ستفرز، تماما كما يقول المصنف هنا: خلق في الإنسان حريته، وهو يعلم ما الذي سيفعله بها! ولو سألت صاحب هذا المذهب فلن يتردد في أن يقول: سبحانه هو الرب الكامل الذي تنزه عن كل نقيصة، وكان من كماله أن يخلق جميع الأنواع الحية على هذه الطريقة التي وصفنا! فهو أرقى وأرفع من أن يشغل نفسه بخلق كل نوع من تلك الأنواع الكثيرة للغاية التي تعد بالملايين في البر والبحر والجو، يشاء كل نوع منها ويختار له صفته التفصيلية التي يكون عليها، تمييزا له عن غيره!! نحن نزهه عن أن يكون فاعلا للخلق على تلك الطريقة، طريقة “الخلق الخاص” كما يزعمه “الخلقويون”! هكذا يقولون! فما أشبه الليلة بالبارحة! ينسب إليه أحط صور الجهل والفوضوية والعبثية والإهدار المبين، عبر بلايين السنين، ثم يقال بكل سهولة: هذا هو الأليق به والأكمل له، أو يقال كما قال المصنف نفسه في بعض حلقات برنامجه “العلم والإيمان”: إن الذي يخلق بالتحسين والتطوير أكمل من الذي يخلق النوع الحي على مرة واحدة دون أن يحسن ويطور!! كل هذا لماذا؟ لأن الذي يعترض على نظرية داروين في زماننا هذا، هذا متهم في عقله وعلمه، مطرود من الأكاديمية غير مأسوف عليه فيها، كما كان يطرد فيما مضى من يرد ميتافيزيقا أرسطو ومنطقه الصوري سواء بسواء!
يتبع إن يسر الله وأعان
أبو الفداء ابن مسعود
غفر الله له